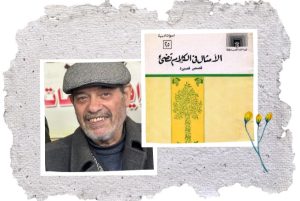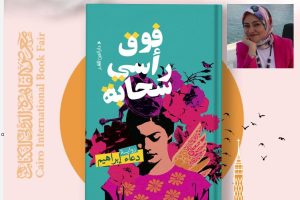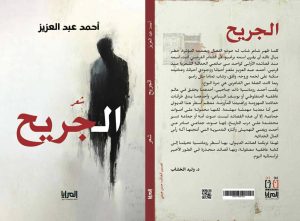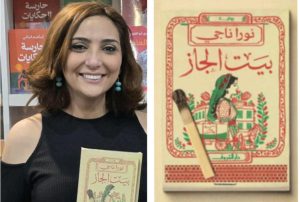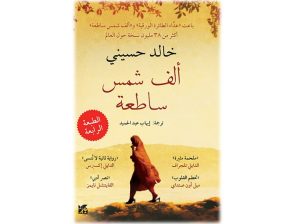محمد حسني عليوة
منذ تحررت القصيدة من الأوزان والقوافي الكلاسيكية، أصبحت فضاءً للتجريب والتساؤل، متجاوزةً الصورة المجازية القديمة، ومنفتحةً على منصات مختلفة من الأطر والأنساق والرؤى. ظهر هذا جليًّا في قصيدة “أنشودة المطر” لبدر شاكر السياب، حيث حرّر الإيقاع من قيود البحور الخليلية، واستخدم صورًا بصرية تعكس روح العصر. وكما في حالة ت. س. إليوت في قصيدته “الأرض اليباب”، التي أعادت تعريف الشعر الحديث بتجريبه اللغوي والفكري. وبهذا كان أكثر انفتاحًا على التجارب الإنسانية، مُتسمًا بروح العصر وتساؤلاته العميقة وتقانة الصورة البصرية الفائقة التطور.
ومع حالة ثورية ناشطة على الأصعدة كافة، تجاوز الشعر الحديث تحديات التعبير التقليدي الصارمة في البحث عن وسيلة لنقل المشاعر، حيث الكلمة تحمل معناها الأصيل، متجاوزةً صعوبات التعبير عن الواقع. وحيث باتت الرموز، الاستعارات، واللغة الرمزية أداة نقل جيدة التوصيل لأفكاره ومشاعره، ما جعل النص أكثر كثافةً وإيحاءً، بل صار فضاءً يتقاطع فيه الإبداع مع تساؤلات الوجود والتكنولوجيا، دون أن يكون مقيدًا بأنماط جاهزة؛ لا تتطلب الفهم الناشئ عن الإنصات فحسب، بل–أيضًا- عن تورط القارئ في حالة ذهنية تجعله شريكًا في البحث عن الذات داخل اللايقين، كأنه يتنفس شهقة لم تكتمل بعد.
لكن التجريب الشعري قد يخلق تحديًا: بعض القصائد تصبح معقدة جدًا، فتبعد القارئ بدلاً من أن تدعوه للحوار والتأمل.
هنا تكون رؤية الشاعر الحديث في حفاظه على أصالته من خلال حوار مستمر مع تراثه الثقافي، مستخدمًا أدوات جديدة تعكس روح العصر، كما في تجارب السياب وأدونيس، حيث يمزجون بين الرموز العربية والتجريب الحديث. أما التوازن بين التجريب والوضوح، فيتطلب من الشاعر أن يجعل القصيدة جسرًا للحوار، عبر لغة تحمل إيحاءات عميقة لكنها لا تُغلق أبواب التأويل أمام القارئ. بهذا، يصبح الشعر الحديث مساحة للتأمل المشترك بين الشاعر والمتلقي، دون أن يفقد عمقه أو يتحول إلى لغز غامض.
كما أن النقلة النوعية في الشعر الحديث، تتسم بالبحث الدائم عن صناعة لغة نص فارقة في تجربتها الحداثية؛ تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والكون، بتعددية في الرؤية والمضمون.
بالإضافة الى تأثره بالتحولات السياسية الهائلة والتحديات الاجتماعية والتكنولوجية، فأصبح أكثر جرأة في طرح قضايا الإنسان المعاصر.
القصيدة اليوم تنفتح على السينما، الموسيقى، والفنون البصرية. فلم تعد تعيش في قطيعة مع التراث، بل تحاوره من موقع جديد؛ جعلت الشاعر فيه ليس منفصلًا عن الماضي، بل هو ابن له، يحمل رؤيته الخاصة، ويكتب بلغة تتناسب مع زمنه.
ولذلك، يتشكل مستقبل الشعر الحديث بوعي وجديّة الشاعر وحساسية القارئ، وبدور البيئة الثقافية التي تستقبل هذا الخطاب.
ومع انتشار منصات رقمية من بينها منصة إكس وفيس بوك وغيرها، صار هناك دور للتكنولوجيا في إنتاج الشعر الرقمي، مثل القصائد المصورة (Visual Poetry) أو التجارب السمعية-بصرية التي تجمع الشعر بالفيديو والموسيقى، أفردت مساحات على الفضاء الأزرق لنشر القصائد كما في تجارب كثير من الشعراء، من مصر والوطن العربي، وليس ببعيد عنا أيضًا تجارب شعراء الغرب.
لذا نرى في كتابها الجديد، الصادر عن بيت الحكمة للثقافة، أسهمت د. سارة حامد حواس، مدرس اللغويات التطبيقية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، في تقديم مجموعة مختارة من القصائد المعاصرة لشعراء حصلوا على جائزة بوليتزر، في مشاريع شعرية تعكس تحولات القرن العشرين من الحروب الكبرى والتغيرات الاجتماعية والانقلابات الفكرية، مرورًا بانهيار اليقينيات وصعود الشك، إلى تبدلات القيم، ومن صدمة الحداثة إلى تفكيك ما بعدها.
القصائد، كما تقدمها حواس، فرصةً لاستكشاف الشعر كأداة لفهم الإنسان والعالم، ما يجعلها مادة غنية للاستدلال على كنز القريحة البشرية الخفي/الظاهر. فلو نظرت من زاوية السياق الثقافي، أو فككت بنيته، سترى أن الشعر يمر هنا من الذات إلى العالم، ورغم تنوع المدارس، من الرومانسي إلى التجريبي، من التجربة الشخصية إلى التأمل الفلسفي، يظل القاسم المشترك هو الرغبة بالتورط العميق في التماهي مع الطبيعة إلى تفكيك الوجود نفسه.
يأخذنا الكتاب في رحلة واسعة، لرؤية الشعر بمنظور آخر، وشعور أعمق، وللتفكير في الحياة بعقل فضولي، فمن خلال غموضه وأسئلته، يعرض لنا أصوات شعراء بارزين مثل “مارك ستراند” و”ويليام كارلوس ويليامز”، ومن “روبرت هاس” إلى غيرهم، بطريقة تجمع بين السيرة والتحليل، بقصائد تختزل الأسئلة الكبرى: الإبداع، الهوية، الموت، وتنحت لغتها من رحم التجريب، وتعبث برمزية الوجود ذاته.
يقدمها مراجعًا ومحررًا هو الشاعر أحمد الشهاوي، مُسلطًا الضوء على كنوز الإبداع البشري بسلاسة ودقة.
*
بدايةً، الوجودية، كما طرحها “سارتر” و”هايدغر”، تركز على الإنسان ككائن يواجه حريته ومسؤوليته في عالم قد يبدو خاليًا من المعنى المطلق.
والقصائد المختارة بعناية شاعرة ومترجمة واعية، رغم تنوعها الثقافي والأسلوبي، تتقاطع في استكشافها للحظات الوجودية: الشعور بالاغتراب، الرغبة في الاتصال، والصراع بين الذات والآخر أو العالم. من خلال عدسة فاحصة، يمكن قراءة هذه القصائد كمحاولات إبداعية في البحث عن معنى أو بالاحتفاء باللحظة الراهنة أو حتى بالاستسلام للفراغ.
يأتي أيضًا، الاغتراب كـ “سمة” أساسية في الفكر الوجودي، حيث يجد الفرد نفسه منفصلاً عن العالم أو عن ذاته.
في قصيدة “ولد في النافذة”، وهو عنوان بسيط لكنه غني بالدلالة، للشاعر الأمريكي البارز “ريتشارد ويلبر”، والتي تعد واحدة من أرق القصائد في المجموعة، تجمع بين البراءة والحزن، بطريقة تثير التأمل بعمق. حيث تكون الرمزية الشعرية واضحة، وقريبة من لغة الحياة اليومية، برع، ويلبر، في تصوير العلاقة بين الطفل ورجل الثلج كتأمل في التعاطف والعزلة:
“رُؤيةُ رَجُلِ الثَّلجِ واقِفًا وَحدَهُ
في الغَسَقِ والبَرْدِ
كان أكثرَ مِمَّا يَستَطيعُ تَحَمُّلهُ.”
فالطفل يرى رجل الثلج الذي يقف وحيدًا في البرد، مهجورًا.. هنا، يمكن القول أن الطفل يمثل الوعي الإنساني الذي يتوق إلى التواصل والاندماج، لكنه محصور داخل جدران بيته (رمزًا للذات أو المجتمع). أما رجل الثلج، بدوره، يذوب بدافع الحنان، لكنه لا يستطيع عبور “الحدود الفاصلة” إلى عالم الطفل. هذا الانفصال يعكس التوتر الوجودي بين الرغبة في الانتماء وحتمية العزلة.
“يَبكِي الوَلَدُ الصَّغِيرُ عِندَما يَسمَعُ الرِّيحَ
تَسْتَعِدُّ لِليلَةٍ مِنَ الصَّريرِ والأنِينِ الشَّديدِ.”
ودموع الطفل، ليست رد فعل عاطفي عابر، بل هي تعبير عن تعاطف عميق، عن قلب يشعر بما لا يفهمه بعد. والفارق، في هذه الصورة، أن العين التي تنظر ليست عين شخص بالغ، بل عين طفل. والطفل لا يعرف أن الوحدة جزء من الحياة، فيتألم منها كما لو كانت ظلمًا شخصيًا.
وبنية النص، كما هو ملاحظ، لا يوجد سرد، لا يوجد تصعيد؛ فالقصيدة تعتمد على التراكم الداخلي للأثر، تنبني على إعادة توليد الانكسار. هذا يمنح النص بُعدًا شعريًا يشبه نمط التداعي الحر، لكنه مضبوط بإيقاع داخلي يُعادل الصمت أكثر من القول.
“مَشْهَدُهُ المُبْكِي
لا يُمكِنُهُ أنْ يَصِلَ إلى مَكانٍ يُوجَدُ فيهِ
رَجلٌ شَاحِبُ الوَجْهِ
بعَيْنَيّْ قَارٍ
يُعِيدُهُ كَرجُلٍ
مَطرُودٍ من رَحمةِ الله
كآدمِ المَنْبُوذِ مِنَ الجَنَّةِ.”
هنا تكون لحظة تحويل القصيدة من مستوى بسيط إلى عمق ديني-رمزي. رجل الثلج لم يعد مجرد لعبة تذوب، بل أصبح رمزًا للإنسان المقهور، المنبوذ، المطرود من الجنة. هذه الصورة تُعيدنا إلى فكرة الخطيئة الأولى، إلى فقدان البراءة، وإلى البرودة الجافة التي تلي طرد الإنسان من النعيم.
لكن من هو “رجل الثلج”؟ هل هو الشاعر نفسه؟ أم ربما وجه آخر للطفل يرى نفسه في المستقبل بتلك الحالة والكيفية؟ هل يمكن لدموع طفل أن تذيب قلبًا متجمدًا؟ هل هناك شيء اسمه الحب الخالص، في عالم مادي عبثي وفوضوي، حتى ولو كان –هذا الحب- غير مفهوم؟
ثم تأتي أيضًا قصيدة “مشكلة القلق”، للشاعر والأكاديمي الأمريكي “جون آشبيري”، على هذا المنوال الخطي، من دراما وجودية الإنسان في الحياة.. التي تعكس سمات ما بعد الحداثة، مثل التفتت، الذاتية المفرطة، والتشكيك في المعنى الثابت، حيث:
“مرَّتْ خَمسُونَ عَامًا
مُنذُ أن بَدَأتُ أعِيشُ
في تِلكَ المُدنِ المُعتِمَةِ
التي كُنتُ أُخبِرُكِ عَنْها.
حَسنًا، لم يَتَغيَّر الكَثِيرُ
ما زِلتُ لا أستَطِيعُ اكتِشافَ
سَبِيلٍ للوصُولِ من مَكتَبِ البَرِيدِ
إلى أرَاجِيحَ الحَدِيقَةِ.”
تُقدِّم هذه الصورة، في واحدة من أكثر قصائد المجموعة عمقًا نفسيًا: مشهدًا دراميًا لإنسان يعاني من التشتت، يعيش في “مدن معتمة” ويجد صعوبة في إيجاد طريقه من “مكتب البريد إلى أراجيح الحديقة”.. إنه الشعور بضياع تام في عالم لا يفهمه، بينما يحاول هو في تعزيز محاولاته في فهمه، وفي أن يجد معنًى بسيطًا للحياة، رغم اعترافه بأنه “لم يتغير الكثير” بعد خمسين عامًا، ما يعكس شعورًا بالتكرار والعبث، وهو مفهوم مركزي في الوجودية.
هنا يلعب “آشبيري” بالمعنى، حيث تتداخل الصور والأفكار دون تقديم إجابات واضحة، مما يعكس الطبيعة المفتوحة لما بعد الحداثة.
وبالعودة إلى الذكريات، يبدأ الشاعر باسترجاع الماضي، وكأنه يحكي لأقرب الناس إليه، لكن حتى ذلك الحد يبدو مشكوكًا فيه.
الى أن يضع بين أيدينا رؤيته لشجر تفاح يزهر في الصقيع بلا اقتناع.. مثل ذلك الإنسان الذي يعيش رغم الألم، لكنه يشعر بطريقة ما باستسلامه لمواصلة حياته في رسم صورة نمطية عن أن القلق – كـ سمة بارزة في الأدب الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية- الذي يعتوره ما هو إلا جوهر للوجود، رغم كونه تجربة لشخص يعيش في عالم مفكك، يفترض أنه يكشف لنا عن فقدان الاتجاه، وعن التواصل الفاشل مع الآخرين ومع الذات.
**
في قصيدة “على خطى الشاعر النبيل” للشاعر الأمريكي روبرت هاس، تُمثّل محاولة تجريبية في هيكلية مفتوحة للقصيدة، تستلهم شكل الهايكو لكنها تتجاوزه بإدخال عناصر سردية وشخصية. هذا التمازج بين التجريب الشكلي والرؤية التأملية يعكس حساسية الشعر الحديث تجاه التجديد برؤية تحتفي باللحظة الراهنة كمفتاح لخلق المعنى.
“رأتْ تِلكَ الفَراشَةُ
ضَوءًا في غُرفَةِ اِمرأةٍ
احتَرَقتْ إلى رَمادٍ.”
فهي تعتمد لغة موجزة ومباشرة، تخلق صورًا بصرية حية تثير التأمل، فيما يحمل العنوان في ثناياه إحساسًا بالاحترام والتقدير، لكنه ليس احتفاءً بشخص معين، بل بحثًا عن الروح الشعرية التي تقود الإنسان عبر دروب الحكمة واتساقه مع الطبيعة.
“أنا وضُفدَعةٌ ضَخمةٌ
نُحدِّقُ في بعضِنا
وكِلانا لا يَتَحرَّكُ.”
هذه الومضات الخاطفة في مشاهد متناهية البساطة: ضفدعة تحدّق، فراشة تحترق، جحيم خريقي مقمر، ببراءتها العميقة، تجسّد قبولًا وجوديًا للواقع بصدقه العاري، دون تزييف أو محاولة لفرض تأويلات خارجية.
*”يُزهِرُ في الَّليلِ
مثِل بَشَرٍ مُتأثِّرينَ بالمُوسِيقى.”
الشاعر هنا، يربط بين لحظة: ذَلكَ الصَّبيُّ/ في الكِيمُونو الجَدِيدِ” كما لو أن خلق فيه معنى التوهج كزهرة برية في الليل، بتأثر البشر –روحيًا- بالموسيقى، وكأنه يقول إن الجمال لا يحتاج إلى ضوء الشمس ليُظهر ذاته. حتى في الظلام، هناك زهور، وهناك إحساس، وهناك حياة. كما أن الموسيقى هنا ليست صوتًا، بل إيقاعًا داخليًا يحرك النفس.
وهذه الصورة المقصودة لا تخلو من توتر، لكنه يكرّس قبولًا رصينًا للوجود كما هو، لا كما نرغب أن يكون. ليس تأملًا رومانسيًا، بل دعوة للنظر إلى العالم بنظرة لا تستعجل الإجابات، بل ترضى بأن تكون في الوسط، حيث لا نهاية، ولا بداية.
**
في المقابل، تأتي قصيدة “مرثاة أخرى” للشَّاعر الأفرو أمريكي “جريكو براون”، بما تتسم بإيجاز لغوي يُكثف المعاني، واستخدام صور بصرية وانفعالية قوية لتجسد حالة من التصدع النفسي والروحي.
“هذا ما يُشبهُ مَوتَنا
أنتِ تُؤمِنِينَ بالشَّمسِ
وأنا أُؤمِنُ بأنَّني لا أستَطِيعُ أنْ أُحبَّك.
كُن مُنغَلِقًا دائِمًا،
هذا ما قالهُ أُستَاذِي المُفضَّلُ
قبل أنْ يَترُكَ البُندُقيَّةَ تندَفِعُ في فَمِهِ.”
في تلك الصورة الشعرية، بإيجازها المكثف وصورها الرمزية، تُشكل نصًا غنيًا بالإيحاءات الفلسفية العميقة، يتجاوز السطح الشعري ليغوص في أسئلة وجودية عن صراع الذات بين الإيمان واليأس، الحب والعجز، والحياة والموت، والمعنى واللاجدوى.
والشاعر، من السطر الأول، يُقدم الموت ليس كمصير محتوم، بل كحالة وجودية تُطارد الذات.. حالة من التصدع الداخلي.. حيث يعيش الإنسان في حالة من العدمية، منفصلاً عن أي إمكانية للتصديق بوجود معنى أو قيمة جوهرية للحياة والواقع.
في السياق، نجد أن إيمان المتكلم بعجزه عن الحب، يُجسد حالة العدمية التي تحدث عنها نيتشه، حيث تتفكك الذات في مواجهة الفراغ الداخلي. أي أنها تُدرك رغبتها في الحب لكنها عاجزة عن تحقيقه، عجز يُعبر عن رفض الانخراط في الحياة.. رفض التمرد في مواجهة العبث، وهو ما يُشير إلى أزمة وجودية أعمق تتعلق بالحرية والإرادة.
كذلك تُمثل وصية أستاذه في أن يكون “مُنغَلِقًا دائِمًا”، دعوة إلى الانعزال عن العالم كوسيلة لتجنب الألم.
وحيث يرى شوبنهاور أن الحياة هي سلسلة من الآلام، والطريق إلى السكينة هو التخلي عن الرغبة. يقوم الشاعر، هنا، بتقديم هذه الوصية بسخرية مأساوية، إذ يتبعها مباشرة فعل انتحار الأستاذ (“البُندُقيَّةَ تندَفِعُ في فَمِهِ”). هذا الانتحار يكشف عن فشل فلسفة الانغلاق، إذ أنه هنا ليس مجرد عزلة جسدية، بل انغلاق وجودي، أي رفض الذات لإمكانية التواصل مع الآخر، مما يُبرز الطابع المأساوي لفلسفة الشاعر.
وعلى هذا النمط يتابع براون بالإشارة الى شعوره بالاغتراب أو عدم الانتماء في الأماكن المؤقتة، في رؤيةً شعريةً عميقةً، باستخدام صورٍ قوية وانزياحات رمزية:
“تُضايقُني الفنادِقُ
إلَّا إذا حصلتُ على غُرفةٍ مُطلِّةٍ على الجبَلِ.
غُرفةٌ لا يُوجدُ فيها شبكةٌ للاتصال،
ولا يُوجدُ شيءٌ نفعلُهُ سوى
رُؤيةِ الشَّمسِ وهيَ تَهبِطُ على الأرضِ
كما لو أنَّ كَفَنًا يحتضنُنا”
هنا تضفير ذاتي، في بناء صوتي متناغم، يعمل على تعزيز المعنى عبر اختيار دقيق للحروف والنغمات، ما يسمح للقارئ بأن يعيش المشاعر والصور بحسّ عاطفي هادئ.. يكشف عن ماهية الصراع بين الإنسان المعاصر وعالَمه؛ فالشاعر يشعر بغضاضة من كل ما هو تقني وصناعي (الفنادق، الإنترنت)، فاختيار الغرفة المعزولة يعكس الرغبة في التأمل الذاتي والانفصال عن العالم المادي. بل الهروب بعيدًا عن قيود الحضارة والعودة إلى تجربةٍ وجوديةٍ خالصة، حيث (رؤية الشمس وهي تهبط) ترسم مشهدًا بصريًا دراميًا في فعل “جمالي” وحيد وممكن. والقصيدة تتوالى في لغة بسيطة لكنها عميقة، والإيقاعُ يتناسب مع موضوع العزلة والتأمل. ما يُعزز شعورَ التدفق الحر للأفكار، كأنها تأملاتٌ عابرة.
“كما لو أن كفنًا يحتضننا”
تمت استعارة “الكفن” لوصف غروب الشمس، في تشبيه، هو جوهر القصيدة وذروتها العاطفية، يجمع بين الجمال والمأساوية. فرمزيته المنطقية إلى الموت، لكنه موتٌ هادئٌ وحميم، كأنه احتضان يتمثل فيما لو لحظةٌ وجودية تُذكرنا بزوالنا، لكنها أيضًا لحظةُ سلامٍ مع الذات والكون. كما أنها –أيضًا- تحمل دلالاتٍ صوفية، تعطي النص بعداً فكرياً وفلسفياً وجودياً، تعكس حالة نفسية داخلية معقدة.
حيث تُقدَّم الطبيعة كملاذٍ نهائيٍ يحتضن الإنسان في لحظاته الأخيرة، مما يثير التساؤلات حول الموت والحياة والعلاقة بينهما.
**
ومن بين أبرز النماذج في الشعر الحديث، قصيدة “أما الشعراء” للشاعر والمفكر الأمريكي “جاري سنايدر”، المعروف بانتمائه إلى حركة “بيت جينيريشن” (وهي حركة أدبية تكونت من مجموعة من الكُتّاب الأمريكيين والتي تأثرت كتاباتهم بالثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية) يُعرف “سنايدر” أيضًا بأنه شاعر عصر النهضة في سان فرانسيسكو إلى جانب “جاك سبايسر” و”روبرت دنكان” و”روبن بليزر”، وارتباطه الفلسفي والروحي العميق بالطبيعة والفلسفات الشرقية، خاصةً “البوذية الزن”. كتاباته تجمع بين البساطة والعمق، وبين التجريب اللغوي والرمزية العميقة.
“أمَّا الشُّعَرَاءُ
شُعَراءُ الأَرضِ
الذينَ يَكْتُبُونَ قَصَائدَ صَغِيرَةً
لا يَحتَاجُونَ مُساعَدةً منْ إنسَان”
في هدوءٍ يشبه نبض الأرض، تبدأ الكلمات رحلتها من تحت قدم الشاعر، من ترابها وصخورها ونباتها، لتنتهي في الفضاء حيث العقل(المجرد)، ما يشير إلى رحلة تصاعدية من المادة إلى الروح.
كل شاعر يحمل في داخله كونًا، يُمثِّل حالة وجودية مختلفة، لكنهم جميعًا يشاركون في رحلة داخلية وخارجية نحو فهم الذات والعالم، وهم في طريق البحث عن المعنى، عن الذات وسط زحام العالم، وعن العالم وسط صمت الذات.
فهؤلاء، الذين ينحتون من تراب الأرض أبياتًا صغيرة، لا ينتظرون يدًا بشرية تمتد إليهم بالعون. قصائدهم تنبثق من صلب الواقع، من الطين والحجر.. غالبًا ما تعكس الحالة الوجودية العامة والخاصة، لكنها، في لحظة سحرية، تتحرر، تصعد نحو فضاءات العقل والروح، كأنها رحلة من الأرض إلى السماء، من المحسوس إلى ما لا يُدرك إلا بالقلب.
“شُعَراءُ الهَوَاءِ
يَلعَبونَ بأسْرَعِ العَواصفِ
وأحيانًا يَرْقُدُونَ في الدوَّاماتِ.”
يظهر بوضوح أن الشاعر جزء أصيل، لا يتجزأ، من العالم الذي يكتب عنه. وهذه العلاقة ليست جديدة، فهي تعود إلى جوهر الفلسفة التي ترى أن الذات ليست منفصلة عن الطبيعة، بل هي امتداد لها، وأن الحدود بين الإنسان والعالم مجرد أوهام ترسمها عقولنا. وهذا ما يجعل أعمال “سنايدر” وهي تحتفي بالشعر كجزء من النظام الكوني، وغيره من الشعراء الحديثين، ليست مجرد تعبير عن المشاعر، بل دعوة لاستعادة الوحدة الضائعة بين الإنسان والكون.
**
في عالم الشعر الحديث، حيث تتجاوز اللغة حدود التعبير لتغدو فعلًا وجوديًا، يبرز الشاعر والمترجم الأمريكي “مارك ستراند” بتجربة تأثره بالسريالية، وهو سمة بارزة في الشعر الأمريكي الحديث خلال القرن العشرين. تأتي قصيدته “أكل الشعر” كنموذج في إعادة تعريف العلاقة بين الشاعر والشعر، وبين النص والقارئ. لا يكتفي هنا بإعادة النظر في طبيعة الإبداع، بل يدفع باللغة إلى حافة الجنون الإبداعي.
“يَسِيلُ الحِبرُ من زَوَايا فَمِي
لا تُوجدُ سَعادةٌ كسَعادَتي
لقد كُنتُ آكلُ الشِّعرَ.”
الفعل هنا مادي. الحبر يتحول إلى مادة جسدية، و “أكل الشعر” لا يمثل استعارة مكثفة عن الثمن الوجودي للإبداع ، بل فعلًا ميكانيكيا يربط عملية استهلاك الفن بطريقة حسية وغريزية.
هذا الفعل يتجاوز القراءة التقليدية ليصبح نوعًا من التماهي مع الشعر، حيث يصبح الشاعر والشعر كيانًا واحدًا. يمكن قراءة هذا الفعل كنوع من تخلي الشاعر عن هويته التقليدية ليصبح “رجلًا جديدًا”، كما يعلن في النهاية. ومع ذلك، فإن هذا التحول ليس بالضرورة إيجابيًا، إذ يصاحبه شعور بالفوضى والعنف (النباح، الصراخ). ولأنه هنا، جنح لذكر بعض الاستفهامات، مثل: هل كل عنصر في القصيدة يجب أن يُقرأ كرمز معقد؟ أم أن بعض الصور قد تحمل قوةً بصريةً أو عاطفيةً دون حتمية تأويلية؟
العنوان وحده يفتح جبهة فلسفية كاملة؛ فمن يأكل الشعر لا يقرؤه، بل يتجاوزه كمنتج لغوي يُعد شيئًا نخبويًا، إلى فعل غريزي، بينما يكون هناك تأويل آخر، ومشروع، لقراءة أكثر إيجابية، مثل اعتبار “أكل الشعر” فعلًا تحرريًا أو احتفاليًا بالإبداع، ويمكن، كذلك، أن يكون هجاءً للمشهد الأدبي الذي يحوّل الفن إلى سلعة؟
و”ستراند”، باستخدامه لكلمات ذات دلالة حسية قوية، مثل “يسيل” التي تُعزز إحساس السيولة والفوضى، ينجح في بناء مشهدٍ درامي غني بالرمزية والغموض، يمزج فيه بين التجربة الذاتية والفلسفة الوجودية. ويمكن أن تُقرأ القصيدة على مستويات متعددة: من التأمل في طبيعة الإبداع، إلى الصراع بين الذات والآخر، وصولًا إلى التحولات النفسية التي تنشأ من التفاعل العميق مع الفن.
ففي المشهد التالي، مثلاً:
“أمِينةُ المَكتبةِ لا تُصدِّقُ ما تَراهُ
عينَاهَا حزِينَتان
تَمشي ويَداهَا في فُستَانِهَا.”
نجد أن أمينة المكتبة تُمثل النظام الثقافي والاجتماعي، وحزنها يعكس إدراكها، وربما شعورها بالعجز أمام هذا الاستهلاك الغريزي للشعر.
هنا، يبرز التناقض بين الرغبة في التحرر والقيود الاجتماعية، وهو تناقض يُشكّل أحد محوريات التوتر في النص.
ومن ثم تبدأ الصور بالتشظي:
“الكِلابُ على سَلالِمِ الطَّابِقِ السُّفلي تَصعدُ.
تَدورُ مُقَلُ أعينِها
تَحتَرِقُ أرجُلُهَا الشَّقراءُ كالعُشبِ.”
من هذه الزاوية، فإن القصيدة تذيب الفواصل بين الذاتي والعام، الإنسان والحيوان، القارئ والنص. اللغة لا تحمل المعنى بل تستهلكه. كل مفردة تتجاوز معناها المباشر، لكنها لا تقدم بديلًا واضحًا لا يكون عاجزًا عن حمل المعنى.
ولعل أحد أخطر أفعال هذه القصيدة، أنها لا تترك القارئ خارج الحدث. عندما يضعك “مارك” داخل دائرته الخاصة، بأنه “يأكل الشعر”، فإنك، بشكل ما، تأكله معه. أنت داخل عالم مضطرب، بروح لا تبحث عن الجمال، بل عن الانعتاق من قيود اللغة والعقل. وقد تكون هذه واحدة من أعمق فلسفات الشعر الحديث: أنه يجرّ القارئ وراءه إلى الهاوية.
**
في عالمٍ تسوده النزعة للصخب والضجيج، حيث القلقُ يغزو الذاتَ البشرية من كل جانب، وتتحول العلاقة بين الإنسان والطبيعة إلى علاقة انفصام أكثر منها انسجام، تأتي قصيدة الشاعر الأمريكي “جيمس برايت” “إلى شجرة كُمثرى مُزهِرة”.
ومن خلال لغة بسيطة (البساطة هنا ليست ضعفًا، بل قوة تعبيرية، حيث تكتسب الكلمات معناها من السياق الوجداني، وليس من الزخرفة البلاغية.) ينجح “برايت” في تأسيس بناء شعري، من تكرار الأفكار وتدفق الصور؛ يمارس تفكيكًا جريئًا لفكرة النقاء.. يطرح أسئلة وجودية عميقة حول الطبيعة، والحب، والموت؛ ويرصد عمق الأزمة الإنسانية الحديثة.
حيث يتصارعُ داخل النصِّ رمزانِ: الشجرةُ؛ تمثل الجمال، والبراءة، والثبات. والكهلُ؛ يمثل الجسد المتآكل والروح الخائفة.. وكأنما يريدُ أن يقول: إن الطبيعة لا تُشفينا، بل تُرينا مدى بُعدِنا عنها، ومدى عجزنا عن أن نعودَ إليها.
“تُوجَدُ زُهُورٌ طَبيِعيةٌ جَميلةٌ
فَكيفَ يُمكِنُكَ أن تَقلقَ
أو تَنزَعجَ أو تَهتمَّ
بِكَهْلٍ خَجُولٍ يَائسٍ
كانَ على وشْكِ المَوتِ
كان يَرغَبُ في الحُصُولِ على أيِّ حُبٍّ
حتَّى لو على حسَابِ شُرطيٍّ سَاخرٍ
أو شَابٍ لَطِيفٍ يُحطِّمُ أسنَانهُ.
رُبَّمَا يَقُودُهُ إلى مَكانٍ مُعْتِمٍ
يَركُلُهُ هُناكَ في فَخذِهِ المَيِّتِ
فقط من أجلِ المُتعَةِ.”
تبدأ القصيدة بمشهد بسيط: زهور طبيعية جميلة، وكأنها دعوة للتأمل والسلام. لكن سرعان ما ينقلب المشهد إلى تأمل مرير في حالة الكهل اليائس، الذي “كان على وشك الموت”. هذا الانقلاب الدراماتيكي هو ما يجعل القصيدة مثالًا على “الانزياح الشعري”، حيث لا تتبع الصورة المتوقعة، بل تكسر الإطار التقليدي للوصف الطبيعي، لتُظهر الجانب المظلم والمخفي منه.. إذ لا تُعيد القصيدة تأكيد فكرة الجمال، بل تخلع عنها طابعها المثالي.. لا تُعيدُ تعريف الإنسان، بل تُظهر كيف أصبح أسير مشاعره الرخيصة وأوهامه العميقة.
كما أن تلك الحالة، تطرح سؤالًا فلسفيًا عن طبيعة الحب في عالم يبدو عبثيًا.. هل الحب في جوهره رغبة أنانية للهروب من الوحدة؟ أم هو بحث عن معنى في مواجهة الموت؟
هنا “برايت” لا يقدم إجابة مباشرة، بل يترك السؤال مفتوحًا؛ ليتماهى القارئ مع حالة الكهل. رغبته في “أي حب” حتى لو كان مشروطًا أو مؤلمًا، تُظهر أن الحب قد تحول إلى “عملة” تُستخدم في مقايضات نفسية واجتماعية، وأن الإنسان قد يقبل بالألم فقط ليشعر بأنه موجود. وهنا يمارس “برايت”، نوعًا من التشريحِ العاطفي، يُظهرُ فيه الفجوة، ويصوّر الانفصال كحقيقة لا مفرّ منها.
والملاحظ، أن ثمّة قطيعة زمنية واضحة في النص؛ فالشجرة تمثل اللحظة التي لا تتأثرُ بما حولها، بينما ذكرياتُه عن كهل (“ظَهَرَ لِي ذاتَ مَرَّةٍ”) تعزز فكرة أن الإنسان العصري يعيش في حالة من التشرد الزمني.
بهذا، يصنع “برايت” شعرية تـتوازن بين الإيجاز اللغوي والعمق الفلسفي، مُتجنبًا المباشرة لصالح إيحاءاتٍ ليست إلا مرآةً صغيرةً وضعها الشاعر أمام وجه الإنسانية، ليُريها كيف أصبحت جميلةً من الخارج، مجوّفة من الداخل.
*