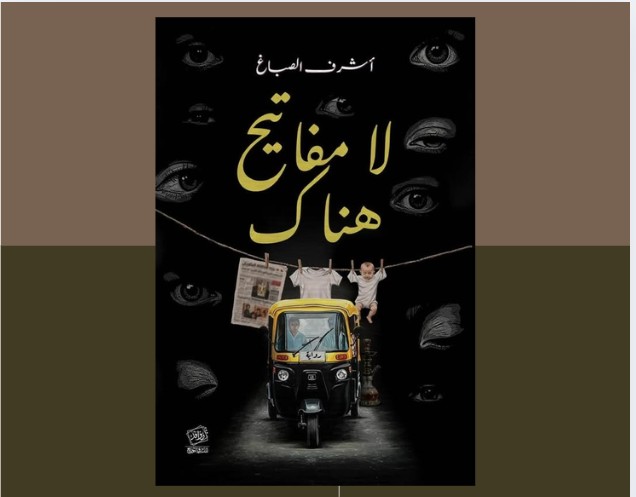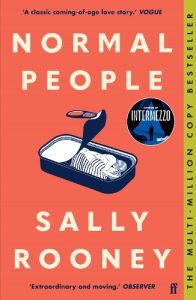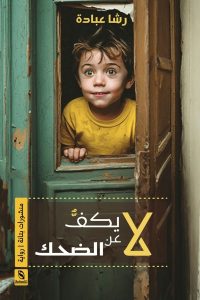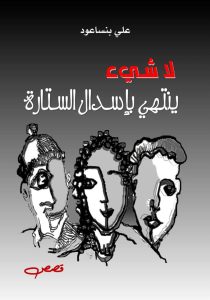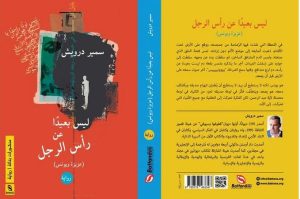شوقى عبد الحميد يحيى
وصل إلى أقصى مراحل العلم، ولكنه –أيضا- ظل ينظر إلى أرض الواقع بوعى وخبرة ودراية. كما طاف الكثير من البلدان، العربية وغير العربية، لكن ظلت مصر فى الأعماق.. يستنشق ترابها، ويعيش مع ناسها، ويحلم بها .. ولها. قرأ الكثير والكثير، من إبداعات ورؤى الكتاب فى المناطق العديدة ..إلا انه لم يأخذ منها.. فظل له أسلوبه ولغته, وصوته الخاص فى كل أعماله، فلا يخطئه القارئ العربى. لا يسعى لتفسير ما يكتب، ولا لتأويله، ويعلنها أنه يكتب وفقط. وعلى النقاد أن يتناولوا أعماله بما يروق لهم. . فهو فقط يكتب ليعبر عن نفسه، فجاءت كتابته صادقة، ومعبرة عن حياته، كإنسان، وحياته كصحفى يرى ويعيش اكثر مما يعيشه الإنسان العادى.
فى روايته “رياح يناير” الصادرة فى العام 2015 كانت رؤيته هى الأمل فى أن سقوط المطر على وشك الوصول. وما كان المطر إلى الثورة التى صاحبها – فى البداية- البِشر والخير. ومن جانب آخر، فهى التحذير مما قد تُحدثه الرياح، من عواصف وزعابيب. ورغم كل ما حدث.. فإن الأمل ما زال قابعا فى الأعماق، فى أن يجد الحبيبة المشتهاة، التى ضاعت منه، ويبحث عنها فى روايته الأحدث “لا مفاتيح هناك”[1]، وإن كان العنوان ينفى وجود المفاتيح، إلا ان السارد يبحث عن تلك المفاتيح، الأمر الذى يؤكد أن بداخله الأمل فى تواجدها، لأنه ينتظر، والانتظار يعنى الأمل، فلم يصل بعد إلى نقطة اليأس الذى يُقعده عن السعى وراءها، ومن خلالها يكتشف ما يود لو أنه غير موجود، متمثلا فى تلك التى يسميها “: طبيبة العيون السريالية نورهان هانم أباظة.
وعلى الرغم من أن القارئ سوف ينَّشدُ وراء تلك اللغة الساخرة- والتى يحبها القارئ المصرى- ولابد أنه ستصيبه نوبة الضحك فى الكثير من المواقف، وهو ما يدعوه للاستمتاع بقصة ذلك البحث، خاصة انه لابد سينظر حوله، ليكتشف أنه يعيش تلك البيئة. غير أن التسمية الكاملة للحبيبة، وكيفية تصورها فى الأماكن الراقية، ثم إنخراطها فى البيئة الشعبية، كواحدة، من بناتها المعجونات فى طين الأرض، ولغة (الحوارى). ليكتشف –القارئ- أنه أمام إنسانة .. ليست من البشر، وينصرف الذهن مباشرة ، إلى الرمز، فإلى ما ترمز تلك الحبيبة؟
فى تأمل الاسم الذى حرص الكاتب على ترديده طوال الرواية، مما يدعو –فى التكثيف الذى حرص عليه فخلت- الرواية- من الحشو والإطناب- إلى التأمل والبحث عن العوالم التى يُخبئها وراء تلك التسمية “طبيبة العيون السريالية نورهان هانم أباظة”. فطبيبة العيون، أى الخبيرة فى لغة العيون، والمعروف، والمشهور أن المصرى القديم برع فى الفنون التشكيلية، ويأتى السياح من أنحاء العالم لينبهروا بتلك الفنون، والمعروف –أيضا- أن الفنون الجميلة هى الشكل الوحيد للفنون البصرية، منفردا. وتشمل –الفنون البصرية- الرسم والزخرفة والنحت والعمارة. فإذا كانت الحبيبة “طبيبة العيون” فهى الخبيرة بالفنون البصرية. وكأن الكاتب قد عاد بهذه الصفة لحبيبته إلى العهد الفرعونى، الذى كانت فيه مصر سيدة العالم، ومحور دراساته، وتشير الرواية إلى ذلك {لكنها صممت على أن أدخل إليها فى الغرفة الواسعة التى تتكون أصلا من ثلاث غرف وصالة ضخمة معلق على جدرانها لوحات تشكيلية لفنانين عالميين من أمثال سلفادور دالى وماكس إرنست ورينيه ماجريت وكاى ساجا ودوروثيا مارجريت تانينج ومارسيل دو شامب، بل وكانت هناك غرفة من الغرف الثلاث جدرانها الأربعة مرصعة بأعمال لرمسيس يونان وكامل التلمسانى وحسن التلمسانى وسمير رافع ومحسن البلاشى وغادة كمال}ص23.
ومن تلك الصفة، ومن الفنون التشكيلية، جاءت السريالية. تلك التى تتميز بالمفاجاءت غير المتوقعة، وعدم الترابط الذى يحمل فى طياته التناقض، وبصفة عامة يمكن القول، غير المفهومة- للعامة- . ذلك الذى يمكن أن نجده فى تصرفات “نورهان أباظة” عندما كانت الأمور تسير سيرا طبيعيا، والترابط بينها وبين السارد “سعد” على خير ما يرام، يأتى قرارها غير المفهوم دوافعه{طردتنى حبيبتى نورهان هانم أباظة من جنتها ونعيمها. حرمتنى ليس فقط من شفتيها المتوحشتين، وصدرها الدافئ الحنون ، ذى الكرامات والمعجزات ….. بل وأيضا من سفراتنا داخل مصر وخارجها، التى كانت تكلفها الكثير من الجهد والمال، وأكثر ما حز فى نفسى هو غياب الأموال التى تغدقها على بطرق لطيفة وراقية لكى لا تشعرنى بالحرج. وكثيرا ما كنت أرفض لولا إلحاحها من جهة، وضيق ذات اليد من جهة أخرى}ص27. وإن حملت الفقرة ما أراده الكاتب من وصف لشخصية السارد. إلا أنه خبأها فى سياق يجذب ذهن القارئ.
وكل ذلك لأنه قال لها عندما سردت له عن ألاعيب “نجفة: وابنها ومحاولة التقرب لها، وقال “ليه بس عملتى كده يا نورهان؟ ليه تقطعى عنى العزومات والأكل والشرب والسفر والفسحة }ص26. وهنا أيضا يواصل -الكاتب- التأكيد على شخصية السارد، والذى هو الطرف الثانى فى معادلة الصراع التى تُشكل سير الرواية، وإن لم يكن صراعا بالمعنى الطبيعى للصراع، وإنما هى عملية البحث عن المدينة الفاضلة التى يسعى إليها، ويحلم بها.
كما يكشف الكاتب -الموسوعى الثقافة، الأدبية والفنية والعلمية- عن الفهم الحقيقى للسريالية، التى صاغ منها شخصية “نورهان” عندما يروى عن الحياة العادية بينهما { اشاركها هواياتها السريالية، وأضحك وأحكى لها النكات والسفالات. وعندما كانت تأتيها الحكمة والرصانة، او تتغير هرموناتها لسبب أو لآخر، احكى لها حكاية الكتكوت، أو اشاركها الحديث عن الفن التشكيلى فى عصر النهضة، او تشريح الفك عند الهنود الحمر، أو تشكيل العيون عند شعوب جنوب وشرق اسيا، لم يعد الأمر صعبا}ص58.
ومن الأمور التى تكشف عن الصفة السريالية، والتى تكشف عن تلك الشخصية فى حياتها العادية، انه رغم أنها {فحياتى محصورة بين عدة مناطق من الصعب أن تتواجد فيها مثل هذه المرأة إلا لظروف قاهرة، أو بنتيجة مغامرة ما من جانبها لأشباع فضولها. أو فى أحسن الأحوال، لسبب ما جعلها تتخلى عن شراء لوازمها من الزمالك أو المهندسين، وتتورط فى النزول إلى واحدة من تلك المناطق التى أسبح فيها مثل السمك فى الماء.. وبطيبعة الحال، لا يمكن أن أكون قد تعرفت إليها فى السيدة زينب أو فى شادر السمك أو دير الملاك أو في عين شمس}ص7.
ورغم كل ذلك يصدر عنها ما يلفت النظر ويثير الفضول، ويدعو للتأمل عن تلك التى تجمع بين كل ذلك التصور الخيالى، والواقع الناضح بالعشوائية{ كنت قد بدأت اضحك منذ أن قالت “شبشبت” لهما، ولكن عندما سمعت منها أنها قالت لهما “من المنقى خيار” سقطتُ على الأرض من شدة الضحك: حبيبتى طبيبة العيون السرياليلة المدهشة نورهانم أباظة، ابنة الحسب والنسب وسليلة حى الزمالك العريق وحفيدة بناة متاحف وعمارات بلجيكا ومعمار لندن القديم، وتماثيل وجداريات روما وباريس وأمستردام، قالت لهما “من المنقى خيار”؟!}ص25. وهو ما يدعونا للتأمل فى البحث عن تلك المرأة الخيالية الواقعية التى تجمع بين الاضداد، ويخرج بها عن مجرد المرأة المشتهاة، والتى أحبت وكرهت وتزوجت العديد من الزيجات، ورغم كل ذلك ظلت تحب السارد، وكأن هناك شئ يجذبها نحوه.
ويسير الكاتب مرحلة زمنية أخرى- دون أن يشير أو يوضح ذلك صراحة، فمن الفنون التشكيلية فى العهد الفرعونى، إلى عصر ما بين الحربين العالميتين ( الأولى يوليو 1914- نوفمبر 1918 ، والثانية سبتمبر 1939 – سبتمبر 1945).
ثم ينتقل -الكاتب – إلى مرحلة زمنية أخرى. تلك التى ساد فيها كلمة “هانم” التى تعقب كل اسم لسيدة من الطبقة العليا، ثم انتمائها إلى “الأباظية” تلك التى اشتهرت بالباشوية، “نورهان أباظة” اى أن هذه السيدة يعود نسبها إلى الزمن الذى كانت فيه الباشوية، اى ما قبل العام 1952. فقد جمع الاسم مع الصفة، كل تلك المراحل الزمانية، وهى موجودة. كما أنها –أيضا- ظلت لما بعد تلك المراحل، التى يكشف عنه الاستثناء الوحىد الذى لم يُشر الكاتب إلى حبيبته بأنها (أباظية)، الأمر الذى يشير أن هنا تغيير فى الصفة. وإن حملت تلك المرحلة، ذات ما كان مشهورا من رجال 1952، لوصف ما قبلهم، وهى السخرة. فبينما كان “عيد” ابن خالة السارد يحكى عن حقيقة ما وقع من غرق الميكروباص فى النيل، وبينما اختفت “نوهان” بكى “عيد” واستعد للسفر إلى منشاة القناطر ليحضر عزاء ابنة صديق (قضى معه الخدمة العسكرية) وفى حديثة عن الطفلة التى كانت ضمن الغرقى{لم تبلغ التاسعة بعد. غرقت قبل يومين مع عشرة أطفال آخرين أكبرهم لم يجاوز الثانية عشر من عمره أثناء عودتهم من العمل بالسخرة فى إحدى “المزارع” . المعدية غرقت بهم مرة واحدة وسط النيل… ولم يكن هناك أحد. لا أم ولا أب ولاأخت. كانوا هناك فى البيوت والغرف ينتظرون عودتهم بالقروش القليلة وربما بقايا الطعام}ص113. لتكشف الفقرة هنا أيضا كم المخزون من المعانى التى تشكل نسيج الرواية، وهى الحال التى عليها الكثير من ابشر، الذين يعيشون فى فى الغرف، رغم العدد الذين يمكن تصوره، ومدى الجوع والحاجة.
لتكشف- أيضا- عن تلك الواقعة، والذى دار فى أعماق الكثير من الناس، أن اشخاصا محددين، ويعتبرون فوق القانون، يستغلون هؤلاء الأطفال، للفقر الذى يعيشونه، ليعملوا فى مزارع مسكوت عنها، وعن كل ما يتعلق بها. إلا ان هذه واحدة من كثير، خاصة عندما بدأت حقيقة ما يدور حول هؤلاء أصحاب المبادئ الستة، عندما وقعت الهزيمة الساحقة فى العام 1967، والتى اختصها الكاتب برواية “رياح يناير”، فها هو ينتقى منها ما يكشف عن بؤرة العمل الروائى ، الكامنة فى عدم وجود الشفافية، والتى تعكس عدم الثقة فى الشعب، أو أنه – فى نظرهم- لا يرقى لمستوى المسؤلية. وقد كان موت المشير الذى أعقب الهزيمة، هو مثار التشكيك، فمن قائل أنه انتحر، ومن قائل أنه تم إغتياله أو تسميمه، والدولة لا تعترف بشئ محدد، ولأغراض فى نفسها { فى هذه الأيام كنا فى الأسكندرية لا نسمع من مطربينا المحبوبين إلا عفاف راضى وأم كلثوم وجمال عبد الناصر، خاصة وأن الأخير كان يعوضنا دوما عن غياب المشير عبد الحكيم عامر الذى أكد بعض جيراننا أنهم سمعوا بعض الأجانب فى منطقة “جليم” يتحدثون عن أنه كان البطل الوحيد لحرب 67، بينما أكد آخرون أنهم سمعوا أثناء جلوسهم على جبل الرمل فى أبو قير أنهم جميعا كانوا فى سهرة حمراء قبل الحرب بيوم واحد، وخرجوا منها ليصلوا الفجر حاضرا}ص95.
بل إن من الأشياء (السريالية). أن بطل الهزيمة النكراء، التى اُستتبع بإحتلال سيناء كاملة، وهو الذى طالما ردد أنه طرد الإنجليز منها.. عندما مات ولم تكن سيناء مازالت محتلة، بكى الجميع عليه، حتى الشعراء منهم فقال فيه نزار (قتلناك يا آخر الأنبياء) {كنا نبكى ونمصص شفاهنا ونمسح الدموع لنبكى من جديد تارة على النكسة، وتارة من خوفنا أن يقدم زعيمنا وحبيب قلوبنا وأرواحنا وأمل الماضى والمستقبل الرئيس جمال عبد الناصر استقالته، وتارة أخرى على كل أولئك الذين تبتلعهم الأرض فى جميع أنحاء الأسكندرية}ص97. وقد أشار -الكاتب- هنا مجرد الإشارة، وكأنه يفتح القوس للقارئ، وتركه يملأ ما بين القوسين، عن أولئك الذى دُفنوا فى سيناء، دون ذنب جنوه سوى عشوائية القرار. وكأن – الكاتب- هنا يُشرك القارئ فلا ملئ الفجوات التى تركها له.
فكانت تلك هى البداية لبناء الجدار السميك بين الشعب وقياداته، وهى نفسها التى أدت للتعمية عن كل ما يهم الشعب معرفته، وتغمض الدولة (عيونها) عنه، بمعرفة أداتها الأساسية، والوسيلة التى بها يمكن أن تنير للشعب طريقه، وهى الصحافة، التى نرى رئيس التحرير فيها تحول عمله إلى مخبر. فحين تمر نورهان على السارد (الصحفى)، يذكر وهو أحد العاملين فى مطبخها {تمر حبيبتى بسيارتها المرسيدس الحمراء التى لفتت أنظار ليس فقط زملائى المحررين القرويين والقاهريين على حد سواء، بل وأيضا لفتت نظر رئيس التحرير الذى يتجسس على المحررين والموظفين، ويعمل لصالح الأجهزة الأمنية. بل ويخصص لذلك وقتا أكثر من الوقت الذى يحتاجه العمل فى الصحيفة، رغم أنه يحصل على راتبه كاملا من الصحيفة وليس من وزارة الداخلية}ص10. ولم يكن المحررون بأفضل من ذلك {إضافة إلى بعض المثقفين العاطلين الحنجوريين من أصحاب المبادئ القديمة الفخمة الذين يحيطون أنفسهم بهالات غريبة من الأكاذيب والضلالات ويعيشون على أطلال الماضى السحيق، مثل السلفيين الذين لم يتحركوا من القرن السادس الميلادى}ص11. وهنا أيضا، يترك الكاتب للقارئ أن تتسع الرؤية لديه ويرى ما كانت- وما هو كائن- عليه البلاد من التمسك بالماضى، والقعود عن الحلم والمغامرة وإقتحام الصعاب. و يستوى فى ذلك الإنسان العادى، والإنسان السلفى، الذى يرفض أن يغادر الماضى.
بل تكتمل صورة رئيس التحرير، بما هو شائع بين الناس، وغير خاف، حينما يطلب رئيس التحرير السارد “سعد” ليكلفه بالذهاب إلى كوبرى الساحل، لأن ميكروباس وقع فى النيل، وأن هناك شبهة إرهاب، ولما ابلغه السارد بأنه ليست شغلته أخبره رئيس التحرير، بانهم لا ينفعون فى مثل هذه المواقف{انهيت المكالمة وأنا فى غابة الاستفزاز والغضب. فهو نفسه الذى جاء بكل هؤلاء المحررين، الذين يقول عنهم أنهم عديمو الفائدة، إما لأن أحدهم ابن أحد أصدقائه، أو لأن واحدة ابنة رئيس زوجته فى العمل. وهناك آخر جاء بتوصية من رئيس مجلس الإدارة، ورابع يعمل ضابطا فى وزارة الداخلية، ويجرى تدريبه وترفيعه لتولى مهمام أخرى فى المؤسسة}ص81.
بينما يعود رئيس التحرير ذاته بعد الحادث، ليعاود الاتصال، ويكشف عن جوهر الرواي:
{أين أنت يا أستاذ، لقد كشفنا الخدعة واتضح أنه لم يكن هناك أى ميكروباص. طبعا أنت الآن نايم فى العسل، وممكن تكون سكران، سألته عن المادة التى أرسلتها بخصوص متابعتى للحادث. فقال إنه ألقى بها فى الزبالة بسبب ما تضمنه من شائعات وتضليل وترديد الكلام الفارغ والشهادات المزورة. وأنه كلف المحررين والمتدربين بمتابعة الأمر من مصادر محترمة وموثوقة. وراح يثنى على الزملاء والشباب المتدربين ويؤكد أن مصر بخير فى ظل القيادة الحكيمة ويقظة رجال الأمن الذين يسهرون على حماية الوطن وأمنه وأمن المواطنين وسعادتهم}ص112.
{كنت بسذاجتى المعهودة أقول له إن الصحافة سلطة يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن شبهة الفساد السياسى وتوارث المناصب وتبادلها وبيعها، مثلما يجب أن يكون البرلمان والقضاء مستقلين أيضا. فينظر إلى نظرته الساخرة ويقول، إن كل السلطات مستقلة فى البلد، والبلد نفسه مستقل تماما وليس فيه إحتلال أجنبى أو فساد سياسى …. ويظل يردد ما ننشره فى صحيفتنا من أرقام إقتصادية مزيفة أو مبالغ فيها، وإحصائيات عن الجريمة ومكافحة غسيل الأموال، والقضاء على الإرهاب، والنجاح الباهر فى تسديد القروض دون أن يتحدث عن القروض نفسها}ص82. وأيضا هنا، يترك الكاتب القارئ ، لينظر حوله، ويتأمل معيشته، وإلى أين تقوده الكلمات، والعبارات، لتتسع الرؤية، ويتم التفاعل المرجو من الرواية خصوصا، ومن الإبداع عامة.
وفى غمرة الحديث عن الميكروباص الذى سقط فى النيل بين مؤيد ومعارض بما ينفى وقوع الحادث اصلا. نكتشف وجود أسرة كاملة تعيش تحت الكوبرى. ويقول “عيد” ابن خالة السارد حيث {يرى أن لمثلث برمودا دخلا، وأن الأمر يشبه إختفاء عبد الحكيم عامر، ويرى فى الوقت نفسه أن المسألة قد يكون لها علاقة بالأمن القومى وبأجهزة أمنية سرية وعمليات لا يمكن للشعب أن يفهمه}ص89. وحاول “عيد” أن يبرهن على ذلك من الناحية الدينية، مثل العمود الواصل بين الكعبة وعرش الرحمن، والإسرائيلى الذى حاول أن يدخل الأزهر وتم ربطه ولم يستطع الحركة إلا عندما أعطى ظهره للمسجد. الأمر الذى يكشف عن غياب الشفافية، وكأنه تغييب للوعى تمارسه السلطة ضد الشعب، الذى لا يجد إلا التفسيرات الغيبية، يُفسر بها ما يحدث أمام عينيه.
ويعرض –الكاتب- لإحدى النماذج (الوصولية)، وهو “د نجفة”، والتى استطاعت أن يصبح ابنها نجما فى ذلك العصر، بعد أن حصل على الدكتوراه، وأصبح يدرس بالجامعة، حيث تجيد هى –نجفة- صيغة الحنجوريين أو السفسطائيين، فيقول عنها السارد {لا أستطيع أن أنكر أن هذه السيدة الجليلة كانت دينامو ومحرك علاقات، ومولدة أفكار عريقة من قبيل علاقة الأرض بالمريخ فى العصر الديناصورى الأول، وفضول سكان استراليا الأوائل لمعرفة عادات وتقاليد العرب والمسلمين، وأن أرمينيا كانت تعتنق الديانة الإسلامية لولا تدخل البيزنطيين والروس. وكيف سيأتى يوم تظهر فيه ملامح وأصول الأدب العربى الإسلامى على آداب وفلسفات الولايات المتحدة وأروبا الغربية، وسيأتى اليوم الذى نشارك فيه العالم منجزات العلوم والصحة والديمقراطية وحرية الإنسان انطلاقا من عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا التليدة وديننا الحنيف}ص15.
إلا أن السارد يخرج عن سخريته، ويحاول أن يكون جادا، إلا أن {أحدهم قاطعنى فى استنكار وقال” ما كل هذه السوداوية والاحباط يا رجل؟ أنت شوهت كل شئ.. هل يعقل أن تكون الأمور على هذا الحال من الدمار؟ نظرت إليه مبتسما، وأكدت له أن فكرة شيلنى وأشيلك، وفكرة طبل لى وأنا أزمر لك، وصلت إلى واحدة من أكثر قممها إثارة للتساؤلات، وربما إثارة للضحك والسخرية، وكأن هناك قانونا فى الطبيعة يعمل ويحافظ على توازن هذه الظاهرة مع الظواهر الأخرى. ويجعل للجميع مساحة لاباس بها فى الحياة.. وألتفت إليهم مبتسما فى حكمة وتسامح، موجزا محاضرتى عن الزريبة التى أعيش فيها}ص64.
وعلى سبيل المثال، يسوق الكاتب علاقته ب”عيد” ابن خالته {عيد ابن خالتى، انهى كلية العلوم قسم الفيزياء، على أمل أن يعمل باحثا فى مجال ميكانيا الكم.. أو ان يواصل تنشئة أجيال من علماء المستقبل، تنتشل مصر من غفوتها العلمية, وتعيد لها أمجادها الغابرة. وتدفع بها إلى المستقبل الزاهر، لكنه فى السنة الثانية بالكلية، اكتشف ان الأمجاد الغابرة على بعد سبعة آلاف سنة ترقد فى الماضى السحيق}ص36. وبعد إكتشاف “عيد” أن استاذه فى الجامعة لا يؤمن بما يقوله فى المحاضرات.. هجر العلم والتدريس، وصناعة المستقبل، فتح كشكا لإصلاح الموبايلات. فاصبح “عيد” خبيرا بما يجرى فى الشارع الذى يورد بعض الحالات التى يمر عليه
{يبحلق فى بعينين حمراوين ويقول ضاحكا: يأتى إلى صبى سرق الهاتف ويريد أن أفتحه له. وبعد دقائق يأتى زبون ليصلح هاتفه ثم يحكى حكايات كثيرة غير مترابطة ليقول لى فى نهايتها إنه أمين شرطة فى قسم المطرية. وأحيانا تركب التوكتوك معى إمرأة مسنة، وبعد أن أوصلها، تخبرنى بأنها لا تملك نقودا. وبعد يومين أكتشف انها تسكن على بعد حارتين من بيتنا. توقفنى مرة أخرى كزبونة قديمة، وتعتبر أن صداقتنا تمنحها تصريحا مجانيا بالركوب. ثم يتساءل مجددا عن إمكانية إحتمال هذا العالم بدون حشيش….. وهل يمكن أن يركب المواطن المواصلات أو يجلس على المقهى، او يقضى مصلحة فى أى مؤسسة حكومية أو غير حكومية بدون إصطباحه؟.}ص35. ومن قناعة عيد، نكتشف أن إدمان (السارد- سعد) للخمر وإعتبارها من أساسيات الحياة، ونكتشف أنها ليست إلا محاولة لنسيان ذالك الواقع الأليم، والذى سار من قمة الهرم إلى قاعدته.
وكما أن “نورهان” لا تخضع تصرفاتها للمنطق ولن يجد من يحاول أن يبحث لها عن كتالوج، فلن يجد. فها هى تعود إلى السارد من جديد، بعد أن كانت قد انقطعت عنه لفترة طويلة، تزوجت خلالها، وأحبت، إلا أنها، تعود للسارد من جديد، وتطلب منه أن يحكى، للمرة ربما كانت العاشرة، غير أنها لم تكن ككل مرة، فهى تطلب من السارد أن يحكى لها “حكاية الكتكوت” فيحكى السارد لنورهان “حكاية الكتكوت” والتى تفيد بوصول ذلك (الكتكوت) إلى الزعامة بين الفراخ الكبيرة، ثم بين الخرفان، ويتحول ظهرة إلى حقل للبطيخ. ويستعمل السكين لقطع البطيخة -التى تشبه الكرة الأرضية- وضياع السكين من يده.. وبينما يبحث الطفل عن تلك السكينة، تبدأ الحكاية من جديد.. وينظر السارد إلى حبيبته وكأنه يعود من حيث البدء {فوجدتها وديعة هادئة، وصوت أنفاسها يتردد فى انتظام، مثل رضيع ارتوى للتو من ثدى أمه وغط فى نوم عميق هانئ لا يعرف أحد فى هذه اللحظة بماذا يحلم وماذا يرى.. مررت بعينى على جسدها الحبيب العارى تماما، شعرت أنه جزء منى}ص107.
{فى المرة الأولى التى حكيت فيها حكاية الكتكوت لحبيبتى طبيبة العيون السريالية نورهان هانم أباظة، جن جنونها من الدهشة، ولم تنتبه إلى أن الحكاية تتكرر إلا عندما التقى الصبى مع الشيخ للمرة الثالثة عند آخر المدى}ص107
{ وأحيانا أراها حكاية سخيفة عن صبى أبله يعيش فى أسرة غبية تعيش فى قرية من الحمقى والنصابين والآفاقين. كومة من البلهاء يعيشون جميعا حياة مملة بدون هدف، يكررون نفس الأفكار، ونفس الأفعال، ونفس الأخطاء، يطبلون ويزمرون ويبكون ويفرحون ويفعلون كل شئ فى تكرار قاتل مميت، ولا ينتبهون حتى أنهم يكررون نفس الشئ فى نفس الموقف وفى نفس الوقت، وكأنهم بلا ذاكرة، أو مجرد ألسنة لا عقل لها …. لكن حبيبتى طبيبة العيون نورهان هانم أباظة، إمرأة سريالية، ربما ترى ما لا يراه أحد…. }ص108.
وعندما أصبحت تلك المشاهد، المستترة، والمعروفة، وكأنها فى مجتمع غير المجتمع.. غابت مصر{ كما أن إختفاءها فى هذا التوقيت، وبعد حادث الميكروباص، الذى نفت كل وسائل الإعلام حدوثه فى الأساس، واشار البعض وكأن شيئا غير مرئ هو الذى أدى للحادث، والذى أعاد للذاكرة عبد الحكيم عامر وما أحدثه فى حرب 67. وعبد الناصر والبكاء عليه رغم ما حدث فى 67. وكأن شيئا لم يتغير.
{استيقظت فى الصباح لأتابع آخر أخبار ميكروباص الساحل. لم تكن حبيبتى نورهان هانم موجودة لا بجوارى ولا فى الصومعة ولا على سطح العمارة . اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا. فكرت أنه ربما تكون قد نزلت إلى “عيد” ابن خالتى. اتصلت به وسألته عنها قال إنه فى الشارع منذ ساعتين ولم يرها}ص111. وبغيابها ضاع الطريق، فيتحدث السارد بعد غيابها {بعد شهور من البحث عن حبيبتى طبيبة العيون السريالية نورهان هانم أباظة، التى وعد عيد ابن خالتى مازحا أن أتزوجها على ضمانته، أنكرتنى الأماكن تماما، أنكرتنى بعد أن صارت تشبه بعضها البعض. لا لون لها ولا رائحة ولا طعم. وفى ذلك اليوم الذى لا أذكره جيدا، شربت زجاجة نبيذ كاملة ونمت على سريرنا فى انتظارها}ص116.
وأمام تلك اللوعة، يشعر السارد بأنه يتمنى عودتها لأنه يحبها، كما وعد “عيد ابن خالته”. فتلك الحالة التى يعانيها، لا تعنى سوى الحب. بعد محاورة مع النفس يتساءل السارد، هل احب نورهان فعلا، وعَدَّد ما يعانيه فى وجودها وعند غيابها، وتساءل عما إذا كانت نورهان تحبه فعلا وتشعر بما يشعر به فى حالى الوجود أو الغياب. ليأتى صديقه الداخلى ويشرح ما هو الحب {قال لى بدون سلام ولا كلام: لا توجد مناطق وسطى فى الحب: إما ان تحب أو لاتحب. المرأة لن تمنحك الفرصة للوقوف فى المنتصف. قد تسمح لك بالمناورة لبعض الوقت، لكنها سرعان ما تضعك أمام الاختيار بطريقتها وببساتينها وأعنابها ومكامن الدفء فيها. وعليك أن تختار. وإذا جاء الحب فعليك ألا تسأل لا عن الله ولا عن الطوفان ولا عن البراميل حتى وإن غرقت السفينة ألف ألف مرة وغرقت أنت معها وفيها. يكفى أن تحب فقط. إما أن تحب أو تحيا حياة عادية كإنسان عادى}ص69. ليكون ذلك الحب هو المكنون فى أعماق السارد، ولكنه يطمح، ويطمع فى أن تتخلص المحبوبة من تلك السوءات التى تؤرق مضجعه.
التقنية الروائية
يؤمن أشرف الصباغ بدور الأدب فى حياة المجتمع، فنجد أنه – فى كل أعماله الروائية والقصصية- يهتم بالمضمون، والقناعة بأنه رسالة إلى الوطن، وإن كان قد اختار الصيغة الساخرة، كلباس يرتديه المضمون، ليعود بذلك إلى التراث العربى، لكنه يتناول أكثر الأمور حداثة، ومن واقع الشارع المصرى تحديدا، وكأنه يؤمن تماما بأن الإبداع –عامة- تربطه علاقة تبادلية مع المجتمع، تأخذ منه، وتعيد إرساله إليه، بعد أن يُلبسه الرداء الذى يتفق وطيبعة الإبداع. فضلا عن قناعة الكاتب – فى تصورنا- بمبدأ (التفاهة) التى تسود الحياة، والتى جعلها (ميلان كونديرا)موضوعا لحفلته (حفلة التفاهة)، حيث تتحول الحياة إلى السخرية، وألا شئ فيها جادا، أو يجب أن لا نأخذها على مبدأ الجدية.
فرغم التكثيف الذى سار عليه الكاتب، إلا أنه استخدم التشويق كعنصر جاذب للقراءة، تضاف إلى الإحساس الذى ينتاب القارئ المصرى خاصة ، والموجه له رسالة الرواية، والعربى الذى لابد أن لديه الكثير منها فى بلاده، مثل تأخير التصريح ب”حكاية الكتكوت” إلى ما قبل النهاية، رغم قراءته عنها طوال الرواية، وكأنه أراد بذلك أن يؤخر بؤرة الرواية إلى النهاية ليكافئ بها قارئه الذى ظل ينتظرها طوال القراءة. وكذلك تعريف السارد لنفسه أمام نورهان بأن اسمه “سوسو” ليقع القارئ فى الحيرة، أهو رجل أم إمرأة. ورغم أنها تسير وفق إسلوب الكاتب الساخر، إلا أنها توحى بأنه من غير المهم أن يكون رجلا أو إمرأة، فالكل أمام ما يسوقه الكاتب من سوءات وسلبيات، سواء، المهم أنها حقائق موجودة، تخرج من سريالية المواقف وعدم منطقيتها، إلى الواقع المعيش، وكأن القارئ يقرأ حياته هو.
ومن بين أساليب التشويق أيضا، مفتتح الرواية، والذى يعتبر أحد عتبات النص، الذى به يتعرف القارئ على الرؤية العامة للعمل، أو على الأقل توقع ما يمكن أن يقدمه الكاتب.
فإذا ما عدنا إلى مفتتح الرواية- بعد القراءة لنكشف عن تلك المفاتيح التى بها يمكن الدخول إلى دهاليزها، والذى يخبئ الكاتب فيه المفاتيح التى يستطيع القارئ أن يفتح مغاليق الرواية، التى استطاع فيها الكاتب أن يستخدم التركيز، وعدم الانسياق وراء الحكى الخارج عن الضرورة، وكأنه أضمر روايته فى ذلك المفتتح. فتقول الافتتاحية، أو ما يشبه الإهداء:
{إلى تلك المدينة التى تُخبئ مفاتيحها حتى عن أبنائها، وكلما خلعوا عيونها نبتت لها عيون أخرى جديدة. تُخفى فيها المفاتيح عن أيدى العابثين}. فلم يُشر الكاتب، أى المدائن تلك المدينة، وكيف يقتل الأبناء العيون، فتنبت العيون من جديد. وتستمر عملية الإخفاء، وكأنه من البداية يقدم الجزرة.. ويدعو للسعى نحو بلوغها.
كما تأتى المفارقة، المستخرجة من الإسلوب الساخر -الذى يمثل أحد معالم الكتابة عند الكاتب-
والتى تعنى أن تكون النتائج مخالفة للمقدمات، فضلا عن توليدها للإبتسامة الساخرةن التى تحمل من المرارة أكثر مما تحمل من الضحك، وهو ما يعبر عنه الكاتب صراحة فى {اخترت قناعى الذى يناسب الولد الذى كانت أمه تناديه ب(الواد) ويناديه زملاؤه بالأسطى أو الأستاذ، حتى كاد أن ينسى اسمه. فهل هناك قناع أفضل من الضحك: قناع السخرية؟ إنه القناع الذى يخفى كل الآلام والتجاهل والاحتقار، ويجرد صاحبه من الرغبة فى الانتقام، يقيه من هلاك الروح حتى إذا تحايل هنا مرة ، ومكر هناك مرة أخرى، وتنطع تارة على الدكتورة نجفة وإبنها الدكتور وجدى .. لكن لاتوجد أى ضمانة فى ألا ينقلب إلى وحش فى أى لحظة}ص20. وهنا تكمن المفاتيح المستترة وراء الأحداث، والخوف من القادم، وأن السخرية التى انتهجها الكاتب، ليست سوى قناع، يستتر وراءه العنف المدمر، وكأنه يقول حينها(علىَّ وعلى أعدائى).
ففى عنوان الرواية “لا مفاتيح هناك” والذى يمكن فهمه على الصيغة الاستنكارية، أو النافية لوجود المفاتيح، وإن كان الكاتب يريد الإشارة لغيابها لدى طرف من المعادلة، إلا أنه موجود عند الطرف الآخر، وهو الشعب. فإن المفاتيح يمكن أن تكمن فى غياب كل تلك السلبيات التى أشارت إليها الرواية. وكذلك نجد المفارقة التى تنبع من استخدام الأسماء ذات المعنى، يأتى فى مقدمتها السارد نفسه “سعد” بينما هو لا يشعر بالسعادة، أمام إحتياجه لمن يمده بالطعام والشراب، وليس بسعد عندما يرى تصرفات رئيس التحرير وغيره من الشباب الذى يمثل مستقبل الصحافة، التى هى أداة السلطة لتغييب وعى الشعب {عشت اياما أسود من قرن الخروب بعد طردها إياى من نعيمها حتى إعتدتُ مرة أخرى حياة الضنك وتأقلمت مع مرتبى من الجريدة، وكتابة بعض الموضوعات الفنية فى المواقع الإليكترونية التافهة. ومع الوقت فهمت لعبة المواقع والصحف الإليكترونية، وبدأت أعيد سير الفنانين، وأرش بعض التوابل والبهارات والمبالغات من أجل التشويق}ص27.
كذلك يأت “عيد” ابن خالته، وليس له من اسمه شئ فى ما يلاقى من مرارة الشارع وتعاملات البشر فيه. ولا عندما يهجر العلم وصناعة المستقبل، ويمتهن قيادة التوكتك، أو العمل فى كشك على الناصية، والذى لم يكن وحده فى هذه المفارقة المُحزنة، وإنما كان الزبال يجيد اللغة الإنجليزية (بطلاقة) ، الأمر الذى يوحى بأنه تعلم اللغة كأرقى ما يكون التعليم {فى الساعة الأولى، حكت لى عن قططها وعصافيرها، ولا أدرى كيف انعطف الحديث نحو عامل النظافة الجديد الذى يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وأنها اكتشفت ذلك عندما صعد على السلم الخلفى للعمارة لجمع أكياس الزبالة، وراح يتكلم مع جارها الأجنبى الذى يسكن فى الشقة المجاورة بإنجليزية فصيحة}ص65.
ثم تأتى “د نجفة” والتى تعنى فى ذهن القارئ، الإضاءة، والنور، أو التنوير، لكن القارئ سرعان ما يتبين أنها “نجفة” فى ظل مجتمع تسوده المحسوبية ويقوم على العزومات والهدايا المُسَيِرة للأمور { وصارت حياتى مرتبطة بالدكتورة نجفة التى وفرت لى كل أسباب الراحة وما لذ وطاب من الطعام والشراب والسهر والنزهات}ص16.. فى الوقت الذى ظلت فيه “نوهان” على اسمها بينما تغيرت الحقب والسنوات، حتى أن الكاتب ظل يكتب عنها “نور هانم أباظة” بينما قبيل النهاية، وعندما أصبحنا نواجه العصر المضارع، لم يذكر سوى “نور هانم” فقط. إلا أن عودنها هذه، تحمل نفس الإشارة إلى التغيير، حيث أنها كانت قد غير غيرت عينيها وأصبحتا واسعيتن، الأمر الذى يوحى من جانب أن عيونها قد أصبحت يقظة لملاحظة ما يحدث، ومن جانب آخر بأن مصر إنتقلت من عصر الباشوات (أباظة) إلى العصر الخالى من الباشوات. وكأن مصر ستظلل مصر مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الأحوال.
رحلة قصيرة فى السطور، طويلة فيما تحمله من رؤى واكتناز للمعانى، المتفجرة من داخل الكلمات والسطور. ومغامرة جديدة فى عالم الرواية، من بين مغامرات أشرف الصباغ المتعددة فى المجالات الأدبية، والتى يحمل فيها الهم الوطنى، الممزوج بالهم الشخصى، والذى يعبر عن التوافق والتناغم بين الحالتين، وألا إنفصام بينهما، فلن نعدم وجود أشرف الصباغ ، الإنسان داخل سطور هذه الرواية الممتعة، والصارخة، بحثا عن تلك المفاتيح، التى تساعد فى الدخول لتحطيم تلك العقبات، وحينها…. لن نقول “لا مفاتيح هناك”. فكل شئ واضح ومتاح.
والصحافة قامت بدورها الجقيقى، او أن الشفافية .. أصبحت هى السائدة بين طرفى المعادلة. فلم تكن حادثة الميكروباص والتى تتلخص فى أن ميكروباص غرق فى النيل، فثارت الأقاويل بين مؤكد لوقوع الحادث، وما أثارته الصحافة من أن شيئا من ذلك لم يحدث، وما أريد بتلك (الشائعة) إلى التشويه بالحكومة، فهى الهم العام، الذي يؤرق الفرد، ويجعله فى حيرة من أمره.
…………………………
[1]– أشرف الصباغ- لا مفاتيح هناك – روافد للنشر والتوزيع- ط1 2025.[1]
اقرأ أيضاً: