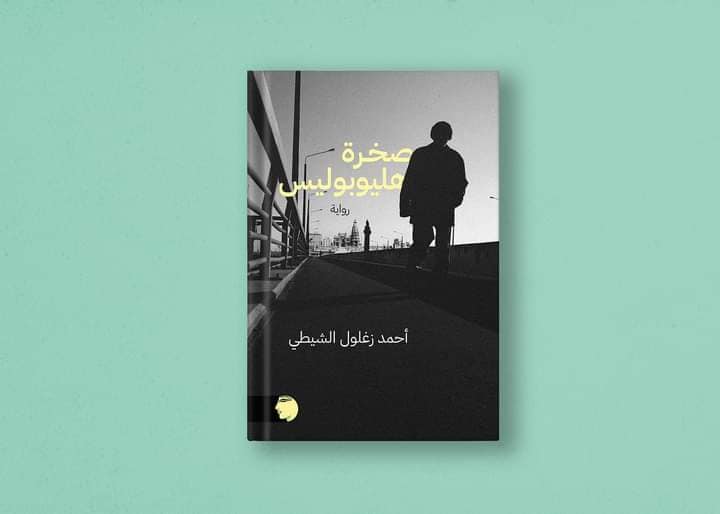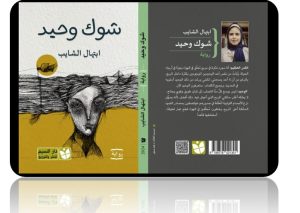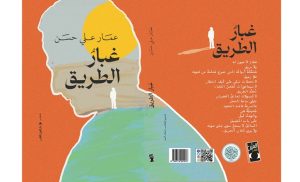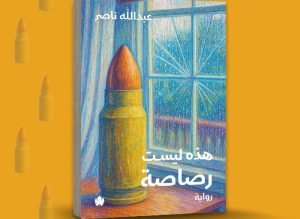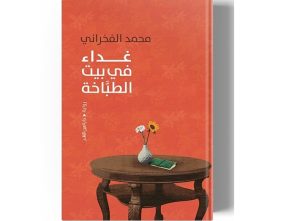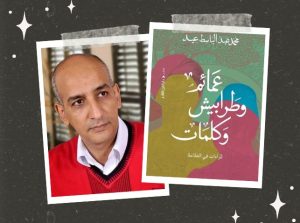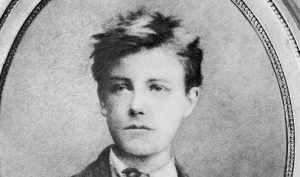د. رضا عطية
يجوب الكاتب أحمد زغلول الشيطي الذي يعود لكتابة الرواية بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من روايته الأولى ورود سامة لصقر في روايته الأحدث صخرة هليوبوليس- في فضاءات متشعبة تتمرأى وتتداعى أحداثها عبر وعي بطل حكايته، “يوسف العلمي” الذي ينتقل من هليوبوليس، حيث مسكنه المحايث والآني، حسب الحكاية ليقدِّم عوالم المهمشين في مدينة دمياط، حيث منشأ بطل الحكاية الذي يطوف في أرجاء مدينته ناثرًا عبر نصه السردي حكايته الشخصية وأسردته وكذلك حكايات أهل دمياط لاسيما في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وصولاً إلى تقاطعه الآني مع مدينته الأم بزيارته مدافنها بحثًا عن قبري أبيه وأمه، فيقدِّم النص الروائي سردية بطله وسردية الجماعة التي خرج منها في نسيج حكائي متضافر المسارات.
I– قلق اللامنتمي واغتراباته
تقدّم الحكاية السردية في رواية صخرة هليوبوليس نموذجًا للبطل الذي يخرج من وجوده في العالم ومحاولاته التوافق معه بموقف لاانتمائي إزاء ما واجهته محاولاته السباحة في بحر هذا العالم من رياح وجودية مضادة وتيارات عكسية ردته إلى ذاته، كما فيفصح بطل الحكاية عن موقفه من عالمه هذا، في نقطة مبكرة من الوجود في مدينة “القاهرة”:
أنا من كنت أسير في شوارع القاهرة شاعر أنّني لا أنتمي لشيء، وأنني أنزلق على سطح الأشياء، لا أحد يريدني، وأنا غير قادر على الاشتباك بأحد. أرى أفواج الناس في شارع طلعت حرب يحتفلون بيوم الخميس الدوري، أصدقاء وصديقات، أسر في ملابس الخروج، يدخلون السينما أو يتوقفون لشراء الآيس كريم أو شرب العصير وأنا لا أنتمي لأحد، لا أنتظر أحدا، أسير، أنحدر عائدا إلى دار السلام. آخذ المترو من باب اللوق، أتعلق بيدي في الذراع المعدنية المثبتة في سقف المترو، يطوحني اندفاع المترو، أنظر إلى الوجوه المتعبة، أتمنى لو أن إحداهن تذهب معي إلى حجرتي، لكن لا أحد يأتي. أتابع اللافتات وكتل المباني الشائهة، السيدة زينب، مار جرجس، الملك الصالح، الزهراء ثم دار السلام. تندفع الكتل البشرية مغادرة المترو. (أحمد زغلول الشيطي، صخرة هليوبوليس، دار العين، 2019، ص123).
منذ البداية في علاقة الذات بعالمها، في مدينة القاهرة، ثمة قطيعة ما وموقف لاانتمائي إزاء ناسها وأشيائها، ثمة شعور برفض الآخر وفقدان الذات القدرة على التواصل معه. وعبر غنائية البث السردي من خلال صوت السارد تتشكل درامية ما، بمقابلة اجتماعات الناس، الأصدقاء والصديقات والأسرة المحتفلة بطقوس يوم الخميس بعزلة الذات ووحدتها في حالها الانفصامي عن الواقع الذي توجد فيه ولا تنتمي إليه. ثمة اغتراب ما وانعدام ألفة تحسه الذات نحو المدينة لا ناسها فحسب وإنّما كذلك نحو مبانيها التي يصدمها تشوهها في إدراك لقبح العالم.
وما بين إعراض الذات عن التواصل مع الآخر/ الناس في الشارع المديني واستجدائها أو تمنيها الاشتباك مع الآخر/ الأنثى في الوسائط العابرة (المترو) تتبدى اضطرابية هذه الذات في سلوكها، وما أشبه موقف بطل هذه الحكاية بموقف الريفي الأصل من عالم المدينة عند أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدته “لا أحد!”:
رأيت نفسي أعبر الشارع، عاري الجسد
أغض طرفي خجلاً من عورتي
ثم أمده لأستجدي التفاتًا عابرًا،
نظرة إشفاق عليَّ من أحد
فلم أجد!
(….)
هذا الزحام .. لا أحد!. (أحمد عبد المعطي حجازي، الأعمال الكاملة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014، ص280).
ثمة تقاطع على نحو ما بين الموقفين، فكل من بطل الحكاية والصوت الشعري في القصيدة يستجدي التفات الآخر: الآخر على العموم عند حجازي والآخر/ الأنثى عند الشيطي إلا أنَّ مساعي كليهما تبوء بالإخفاق، فيرفض الآخر كلية ويحس بلاجدوى وجوده بالنسبة له.
يبرز الخطاب السردي معاناة أهل دمياط من العاملين في تصنيع الموبليا كنموذج دال على اغتراب فئة صغار الصناع، “البورجوازية الصغيرة” كما هو حال “راضي”، الأخ الأكبر لبطل الحكاية:
كان راضي يتجول بدراجته الهوائية في شوارع دمياط، يشاهد السيارات الملاكي التي تحمل أرقامًا من خارج المدينة، سيارات من القاهرة، والإسكندرية، وجميع المحافظات، بداخلها العرائس، أهل العروس وأهل العريس، يدخلون جميعا صالات العرض الكبيرة بشارعي الكورنيش والجلاء، يأتون ومعهم أسماء المعارض التي سيذهبون إليها، يرى صالونه معروضًا وسط الصالة الوثيرة، بعد أن تم تنجيده وتسعيره بسعر خرافي، تقبل عليه العرائس، والعارض يشرح لها مميزات الصالون ومكوناته، وكيف أنه تم إنتاجه بمصانع خاصة بالمعرض. يشاهد راضي صالونه وقد صار لا ينتمي إليه، بعد أن تحول إلى مكاسب رهيبة لصاحب المعرض. يتمنى لو يصرخ فيخترق صوته زجاج الواجهة اللامعة، أن يقول للزبائن «والله ده شغلي»، كان الزجاج عازًلاً محكمًا للصوت. يسير أخي منفلتًا إلى الشوارع الضيقة، مبتلعًا يأسه ودموعه التي تتمنع عليه. (ص ص66-67).
يمثل هذا الموقف الذي يمشهده السرد حالة الاغتراب التي يعيشها العامل أو الصانع الصغير، عبر عدد من الصور أو اللقطات المتتابعة، حيث تبدو الدراجة الهوائية، وسيلة الانتقال البسيطة التي يستعملها العامل في تنقله بشوارع مدينته مقابل السيارات الخاصة للوافدين على المدينة من الخارج الذين يمثلون فئة المستهلكين للإنتاج الذي ساهم العامل أو الصانع الصغير في تصنيعه، كما يبرز البث السردي آليات السوق الرأسمالية من التزين والأسلوب الاستعراضي في عرض الرأسمالين والبورجوازين المتوسطين والكبار للسلع التي حصلوا عليها بأقل مقابل ممكن للصانع أو العامل الصغير الذي دفع الجهد وبذل العرق في تصنيعها ليبيعوها بأعلى سعر ممكن. ثم تكون اللقطة الأوقع والأنفذ في تمثيل اغتراب العامل عن سلعته التي أنتجها عند مشاهدته المستفيد الأخير والأكبر من سلعته، صاحب المعرض ينسب السلعة له فينفيه عنها، فيما يمثِّل تجسيدًا موقفيًّا للنظرية الماركسية التي تقول باغتراب العامل عن منتجه في ظل النظام الرأسمالي الذي يقوم على تقسيم العمل.
ثمة، إذن، موقف رؤيوي ووعي أيديولوجي يمثلان وجة النظر الخاصة بالخطاب الروائي التي يتم تمريرها عبر أصوات النص السردي وتضفيرها من خلال النسيج الحكائي للمواقف والأحداث المتضمنة في ثنايا بنية الحكاية بموائمة فنية بما لا يثقل كاهل النص بحمولات خطابية ورطانات إنشائية.
II– انشطار المكان ونسخ هويته
يمكننا اعتبار أنَّ رواية صخرة هليوبوليس هي سردية المكان بمثل ما هي سردية الذات، حيث يحاول السرد أن يتتبع تاريخ المكان الأول للذات، “دمياط”، وتاريخ بعض جماعاته حتى لو كانت مندثرة، كتاريخ جماعة يهودية كانت في دمياط في القرن التاسع عشر، وكذلك يطرح الصوت السارد بعض التساؤلات حول تاريخ المكان المحايث للذات، “هليوبوليس”.
في رؤية الذات للمكان ممارسة تشريحية نافذة لعلاقة المكان بناسه وجماعاته كما في تمثّل الصوت السارد للبحر الذي يرتاده “علي المهاجر” على مركب صيد:
و«علي المهاجر» في عرض البحر، ليس بحر الكازينوهات التي تفرش الشامسي الملونة والمقاعد والموائد العامرة على الشاطئ. بحر آخر، حيث الريح والملح والموت، بحر الليل الذي لا قرار له، بحر غرق المراكب بما عليها ومن عليها، بحر حرس الحدود على نقطة التفتيش، والنصيب المعلوم من الزفر عند التعليم في الدفتر، وإلا الويل للمركب ومن عليها. (ص105).
تكشف تمثلات الصوت السردي للمكان (البحر) عن تمايزات توزيع المنافع التي يحصل عليها الأفراد والجماعات من المكان، وكأنَّ ثمة انشطارًا ما يقسم المكان بحسب علاقات الناس والجماعات به: فثمة بحر على الشاطئ للملاهي والكازينوهات، هذا الجانب الآمن من البحر، في مقابل البحر الذي يتعمق في عرضه جماعات الصيد بمراكبهم مرتادين أمواج المخاطرة والمغامرة بالحياة والأرواح، ذلك الفضاء الوعر والمخيف.
ويدعّم التقاط الرؤية السردية لمثل هذه التقابلات التي تكشف عن درامية الواقع- شعرية السرد الذي تتأسس حكاياته على مفارقات الواقع والكشف عن خلل أنظمته وغياب العدالة الاجتماعية ما يفضي إلى بون فادح بين الأفراد والجماعات.
يبرز الخطاب الروائي التحولات الاجتماعية الكبرى نتيحة التحولات الاقتصادية في أشكال وأساليب الإنتاج في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين:
لم أعد أبدًا للعمل عند الأسطى عزيز، فقد انتقل مركز الثقل في مهنة الموبيليا إلى القرى المجاورة مع التوسع الكبير بتحويل الأراضي الزراعية إلى مبان وشوارع، واتجاه الفلاحين إلى العمل في الموبيليا، أصبحت ورش الأطراف تعطي يوميات أعلى، وخيار نظام المقاولة عوضًا عن نظام اليومية. (ص39).
تبدو التحولات الاقتصادية والاجتماعية بأثر التحول الاستراتيجي في الحقبة الساداتية بالتخلي نسبيًّا عن الزراعة والاتجاه نحو التجارة أو صناعة السلع الاستهلاكية الترفيهية أكثر من صناعة السلع الثقيلة التي كانت في إطار النظام المركزي للدولة في العهد الناصري، حيث هجر عدد كبير من الأفراد مهنة الفلاحة ركوبًا لموجة التحول الاجتماعي المستجد، وقتها، في المجتمع المصري، بما أتاحه لهم من إغراءات شكلية، وفي نمط الإنتاج الواحد كانت ثمة تحولات تقنية في استراتيجيات وآليات الإنتاج.
ثمة تشابك يقيمه الخطاب السردي بين الشخصي والعام والخاص والسياسي في جدلية منسوجة بإحكام فني كما في قول الأسطى “عزيز”، صاحب إحدى ورش الموبليا عن ذكرياته في لبنان التي عمل فيها قبل اندلاع الحرب الأهلية بها:
قال: إنه سافر بعد حرب النكسة. قال: شفت اللبنانيين بيضربوا نار على السما، غضبانين إن عبد الناصر مات. (ص38).
يتداخل السياسي مع الذاتي والرؤيوي مع المواقفي في نسيج السرد الروائي لدى الشيطي، كما في إبراز الأثر الناصري في الوطن العربي، فيمسي الحدثي الشخصي العابر بمثابة مرايا للسياسي والتاريخي أو بمثابة كوة تنفتح على الواقع السياسي وتطل على الموقف التاريخي.
III– بنى السرد وآلياته التعبيرية
تتشكل هوية النص الروائي في صخرة هليوبوليس عبر عدد من الآليات التقنية المستعملة في أداء النص السردي لمقولات الحكاية تحقيقًا لأغراضه الدلالية وإنتاجًا لمقاصده الجمالية، فتكون هذه الطرائق التعبيرية بمثابة ركائز للبث السردي، وفي هذا نتعرَّض لعدد من آليات السرد:
III–I– التأطير السردي والتفرُّع الوحدوي
في هندسة الصياغة السردية للبناء الروائي في صخرة هليوبوليس ثمة غير نظام تأطيري للنص المحكي، من خلال الصوت السارد للنص الروائي، في تشكيل عنقودي للسرد يتأطر بتهويماته، حيث الإطار الاستهلالي والختامي لفصول النص الروائي يكون عن حياة بطل الحكاية، “يوسف العلمي” في هليوبوليس، وتهويماته وكوابيسه وتوتره إزاء فأر يعبث بأوراقه واستدعائه لقصته مع طليقته وصدامها معه، وحكايته مع المدينة، “القاهرة” وشعوره اللاانتمائي نحوها. فينقسم النص الروائي إلى عشرين فصلاً معنونة معظمها بأسماء شخوص يعرض الصوت السارد حكاياتهم أو حكاية بطل الرواية معهم، وبعضها معنون بوسوم أفعال وأحداث كما في فصل بعنوان (بيع/ سرقة) يصف كيف يجبر أصحاب المعارض الكبرى في دمياط أصحاب الورش الصغيرة على بيع إنتاجهم في مواسم العوز بالخسارة بأقل من التكلفة، كما يتعرض بعض هذه الفصول لشخصيات تعامل معها بطل الحكاية في طفولته وصباه وحداثته. وما يميز هذه الفصول/ الوحدات اتسامها بالاستقلال الذاتي لكل وحدة على حده، أي أنَّ لكل فصل/ وحدة بنية مكتملة، وكذلك تضامها الترابطي مع غيرها من الوحدات في آنٍ؛ لأن الرابط بينها هو حكاية بطل الرواية، “يوسف العلمي” وحكاية المكان وناسه (دمياط/ هليوبوليس).
كذلك ثمة مراوحة بين ما يتداعى من عيانات تهويمية من خلال ما يراه بطل الحكاية من كوابيس وأحداث أخرى يسردها من الذاكرة، ونظرًا للتمفصل الوحدوي لمقاطع الحكاية يأتي الزمن عائمًا في البنية السردية للحكاية، بحسب منطق التداعي الصوري في وعي بطل الحكاية وصوتها السارد الذي يتعالى على علية الزمن وتصاعديته.
وثمة نظام إطاري آخر يتمثل في “الكتب” التي بمعنى خطابات أو نصوص (Text) تبدو كسرد حيادي حول تاريخ المكان: هليوبوليس ودمياط، فتأتي في ست خطابات (كتب)، في نظام سردي يبدو كأنّه يبث وثائق وحقائق في مقابل نظام الحكاية القائم على التخييل الذي يُقدِّم الواقع ووقائعه من خلال وجهة نظر سارد النص (الراوي).
III–II– السرد المضاد
يخرج السرد في رواية صخرة هليوبوليس في بعض مواضع الحكي، في انعطافات تجريبية، عن نمطية الإيهام بالواقع، ثمة توقيف لنمط السرد السائر في مسار التخييل الساعي للإيهام بالواقع، كما في حديث الصوت السارد عن وجود فأر بشقته ثم استدعائه لحيل طليقته بغية مراقبة حالته النفسية:
يوجدُ فأرٌ في الشقة.
يمكن أن يتحول ذلك إلى حبكة، كأن أحكي أنني اشتريت السم ذات ليلة خريفية، أو أنني بينما أشاهد برنامجًا إخباريًّا، رأيت الفأر، وهو من النوع المنزلي متناهي الصغر، يمرق في المسافة ما بيني وبين التليفزيون، وأنني اتصلت بسوبر ماركت في شارع عمار بن ياسر فأرسل لي السم سريعًا مع عامل الدليفري، أو أني استغثت بالبواب الذي نصحني أن أخلط السم بطعام مما يفضله الفأر، وأنني سألته بتجرد طالبًا الاستشارة عن نوعية الطعام المفضلة… إلخ.
كل ذلك لم يحدث، ولم يتحول إلى حبكة متقنة كالمسلسلات، بالرغم من ذلك يوجد فأرٌ في الشقة، وطليقتي لا تكف عن الاتصال بي، وتغلق السماعة في وجهي. ما زالت تعيش وهم أني لا أعرف جميع الأرقام التي تتصل. حدسٌ غريب يخبرني أنها المتصل، حتى دون النظر للرقم على شاشة التليفون الأرضي، هكذا شاهدتها مرارًا مكشوفةً، دون غطاء، وأنا أعلم أنها من يتصل في أنصاص الليالي وأرباعها أيضًا. لا يفاجئني صمتها الملغز المتربص بي، تنتظر خروج الصوت من صندوق حنجرتي إلى فوهة الهاتف ثم إلى أذنها الزوجية المغدورة التي يغطيها الحجاب، لتقتنص الصوت، لتراقبه، لتقيِّم متانته، لتربطه بالحبكة الزوجية، لم يعد هناك جدوى من الهرب، فأنا لم أشتر سمًّا للفأر، ليس لذلك علاقة بالرأفة. الناس تقتل الفأر على مدار التاريخ بضمير نزيه يرقى إلى مرتبة إيمانية رفيعة. هناك اتفاق موغلٌ في القدم حول أن لا بأس بقتل الفأر. لا، لا، بل اتفاق حول أهمية قتل الفأر، لا أدري ما إن كان ذلك اتفاقًا أم تحبيذًا. وقد جاءت فتوى الداعية الوهابي من السعودية بردًا وسلامًا على قلب قاتلي الفأر باعترافه أنه كائن ممقوتٌ شرعًا.
لقد استحال السرد إلى “لعبة” يمارسها الصوت السارد الذي يكسر الحاجز التخييلي الإيهامي ويقوم بنوع من “السرد المضاد” أو لنقل بالسرد الاحتمالي أو السرد البديل باستعراض الخيارات البديلة التي كانت متاحة أمام السارد في طرح ردود أفعاله إزاء وجود فأر بشقته، فيقوم الصوت السارد بتعرية أسلوب السرد في لعب سردي، مضاد لتدفق التتابع الحكائي للأحداث في مسار الإيهام بواقعية الأحداث، وكأنّ الصوت السارد يطرح أوراق اللعبة السردية أمام متلقيه متحدثًا عن خيارات “الحبكة” وضاربًا “الحبكة الأرسطية” الكلاسيكية التي تقوم على التخييل الذي يفضي إلى حدوث التماهي الانفعالي من قبل المتلقي إزاء العمل التخييلي/ النص السردي.
ولكن ما علاقة حديث الصوت السارد عن وجود فأر بشقته وإمكانية قتله والتخلص منه ومدى توافر غطاء إقناعي لهذا العمل كما في فتاوى الدعاة الوهابيين باستدعائه لممارسات طليقته بمهاتفته لاختبار وقياس حالته النفسية؟ هل يماثل الصوت السارد بين طليقته والفأر في ضآلة الحجم/ الشأن مع تضاخم الأثر السلبي والقدرة على إلحاق الضرر والعبث المخرِّب؟ هل يشابه السارد بين أفعال طليقته باتصالاتها المزعجة له ومحاولتها معرفة مدى ثباته النفسي والفأر في عبثه المزعج بأشيائه ما يفضي إلى تهديد ثباته النفسي واستقراره؟ هل يساوي الصوت السارد/ بطل الحكاية بين زوجته والفأر في عدم أحقية أي منهما بالوجود في حياته؟ هل يضمر الصوت السارد في طياته حكمًا على طليقته بعدم استحقاقها الحياة وبوجوب التخلُّص منها وإبادتها تمامًا مثل الفأر؟ في صياغات الشيطي السردية، كما يبدو، هنا، في هذا المقطع، موازاة أقرب تقنيًّا إلى المقاربة الأمثولية بإقامة تناظرات بين الحالات إبرازًا لما بينها من مماثلة تتشكَّل عبر جسر أليجوري.
III–III– ترميزية الوقائع
يعمل التشكيل السردي في رواية صخرة هليوبوليس في نثره للوقائع المحكية عبر الخطاب الروائي على إحالة بعضها إلى سياق رمزي يتجاوز دلاليًا حدثيتها المباشرة، ليمسي للمشهد أو الأحداث المحكية بعد استعاري متعالٍ على وقائعيته.
ومن الوقائع المروية التي عمل السرد على إكسابها غلالة ترميزية، تفاعل بطل الحكاية حين كان طفلاً مع الشوارع المطيرة:
في الصباح وضعت أمي رغيفًا في الحقيبة، وأعطتني قرشين. قالت: ما تتأخرش. كانت الشوارع بحيرات من ماء المطر. عملت مركبًا من الورق وأنزلته البحيرة، كانت البحيرة ساكنة، لم أخش على المركب رغم أنني لا أعرف إلى أين هو مسافر. كانت حقيبتي هي العبء دومًا، إنني لا أستطيع إلقاءها في البحيرة ثم الانطلاق على شريط الديزل، سيرى الحقيبة عمي الذي يرى كل شيء حتى وهو مغمض العينين. (ص34).
ثمة، هنا، مستويان دلاليان للنص الذي يبثه الخطاب السردي، المستوى المباشر، مستوى الحكاية بما يُطرح من وقائع، المتمثلة في تصرّف الطفل في المطر وعمله مركبًا لعبة كما يفعل، لكن هناك مستوى آخر ترميزيًا يتبدى في المآلات الدلالية للمركب التي صنعها الطفل ولا يعرف إلى أين يسافر هذا المركب، بما قد يرمز إلى حيرة الطفل حول مصيره الوجودي، وقد يبدو ذلك أيضًا مؤشرًا على انفتاح أفق الوعي الطفولي الحالم على ارتياد المجهول والسفر إلى مكان آخر يبعده عن واقع أليم يثقل كاهله بما يشق عليه احتماله كتسلطية العم الذي تتفاقم رهبته لدى الطفل لدرجة أنّه يظن أنّ عمه يرى كل شيء وهو مغمض العينين، فالمركب رمز طفولي للرغبة في الإبحار الوجودي. والحقيبة، هنا، تتجاوز حدود واقعيتها إلى كونها ترمز للأثقال الحياتية والحمولات النفسية التي تؤرق الطفل وتكدر عليه حياته، فثمة تشعير للجزئي المبذول من الأحداث وجعله صورة رامزة لأحوال الذوات والوجود.
وفي وصف الصوت السارد لمهاجمة فأر صغير له في شقته بهليوبوليس، تتداعى مقارنته بطليقته:
لقد انتقل من الحركات الأكروباتية الخرقاء ذات الطابع السلمي إلى الهجوم العدواني المستفز. لقد استباح أوراقي وصعد إلى المكتب في حجرة الصالون، وقرض الورقة الأولى من نوتة التليفونات، محولًا إياها إلى حبيبات ورقية من قطعٍ متماثلٍ أضفى طابعًا تشكيليًّا على التمزيق. لقد وصلتني الرسالة التي كانت تصلني دائمً إما في الميعاد المناسب أو بعد فوات الأوان، وهي أن خصومي يختارون ميدان المعركة تمامًا في المنطقة التي تُشل جميع قدراتي بها، حتى إنني أذهل من معرفتهم بشخصي. وقد كنت أظن أنني كتابٌ مغلقٌ، وأنهم يفضلون مشاهدة التليفزيون، حتى إن طليقتي كانت تقارن سوءاتي بحسن أبطال المسلسلات، وأنا لا أجادل في ذلك شرط المعاملة بالمثل، وهي قضية قتلت بحثًا، وخرجت منها بلا شيء. (ص128).
ثمة مشابهة تمثيلية تقيمها الصياغة السردية عبر الصوت السارد للنص بين الفأر الذي يعبث بأشياء بطل الحكاية ويقلقه وخصومه كطليقته في انتقائهم ميدان معركتهم معه، وتنبني المشابهة على التناظر الترميزي بين سلوك الفئران وسلوك الخصوم في الإضرار ببطل الحكاية. فيأتي التشبيه هنا مقلوبًا مقدمًا المشبه به (عبث الفأر بأشياء البطل) على المشبه (عبث الخصوم بالبطل باختيار ميدان معركتهم معه) بما يعكس إحساس البطل بعبثية الواقع الذي يخوض فيه معاركه.
III– IV– شعرية الصور والتشبيهات
مع انضباط اللغة المستعملة في السرد عند أحمد زغلول الشيطي في رواية صخرة هليوبوليس فإن ثمة بعض التشبيهات والصور الجزئية المستعملة في عمليات الوصف بما يضفي على لغة السرد شعرية ما، كما في وصف على لسان الصوت السارد/ بطل الحكاية لتمثله لحياته:
يشعر أن كل ما عاشه ملتبس عصي على التفسير، مثل الشباك الممزقة المتشابكة، غزل لا تعرف مبتدأه ولا منتهاه. (ص108).
يكشف هذا التشبيه المستل من نسيج البيئة، حيث وجدان مشبع بعوالم الصيادين عن شعور نفسي محبط بفقدان الذات القدرة على تفسير مسارات حياتها ومآلاتها، والإحساس بمتاهية وجودية تعجز عن حلها أو استيعاب أسبابها.
ويتكرر نفس المشبّه به، “شباك الصيد” في تصوير حالة النساء بعد انهائهن من شجارهن:
في الشجارات المعتادة بين النساء يقلن كل شيء دون مواربة، يغسلن الوعي من أدرانه، يتركنه نظيفًا مثل شباك مغسولة. (ص107).
يأتي هذا التشبيه، كسابقه، عاملاً على تجسيد المفاهيم والتصورات المجردة، كالوعي لدى النساء، بعد تخلصهن من عوالقهن المكبوتة بالشباك بعد تنظيفها من عوالقها، بما يمنح للتصورات الذهنية والمفاهيم النفسية وجودًا ماديًّا مجسمًا.
وأحيانًا ما تكون التشبيهات المستعملة في الوصف السردي مركَّبة كما في وصف إحضار بواب العمارة لبلاطة سراميك لبطل الحكاية، ليعدها لاصطياد فأر يضايقه بوضع لاصق وطعام عليها:
أحضر لي “عيد” البواب، بلاطة سيراميك، بتواطؤ محير، أحضرها بحس من يحضر لي فتاة ليل. (…) قلت له: إيه ده يا عيد؟ وهو السؤال التاريخي الذي ما زال يحكم موازين القوى ما بيني وبين “عيد”، وهو من نوع الأسئلة التي تكمن أهميتها في طرحها بغض النظر عن الإجابة عليها، وبالتالي كان عليه أن يأتيني بصخرة سيزيف لأجل فأري العزيز، فالليلة ستكون الواقعة، فقد اكتملت الأدوات بعد أن تكاملت الرؤية. (ص ص125-126).
ثمة إحالة تشبيهية في وصف إحضار البواب لبلاطة سيراميك إلى العمل التواطئي لبعض من يمتهنون هذه المهنة في إدارة وتسيير أعمال الدعارة، ثم تتنقل العملية التصويرية لتشبيه بلاطة السيراميك بـ”صخرة سيزيف” في مبالغة لا تخلو من رؤية تهكمية كما في وسم السارد فأره بـ”العزيز” بما يعكس إحساسًا ما بعدم التآلف مع العالم وعجز الذات عن تحقيق غايتها منه، فيبدو أن وصف البلاطة بصخرة سيزيف يعكس شعورًا ما مباطنًا في وعي السارد/ بطل الحكاية بمعاكسة أشياء العالم له ومقاومتها لرغباته واحتياجاته.
……………………………
(*) نشرت هذه الدراسة في مجلة الثقافة الجديدة، عدد يناير2021.