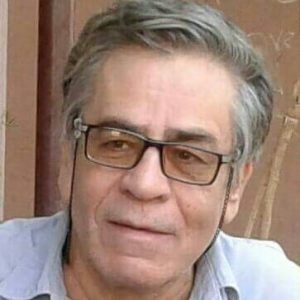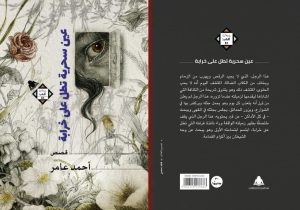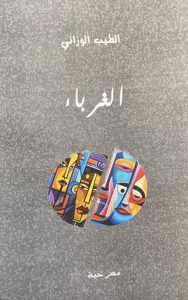عبد الوهاب عبد الرحمن
يضعنا الشاعر أحمد طه في ديوانه إمبراطورية الحوائط في مواقف احتفاء بظواهر أدبية/ تاريخية تمثلت بشخوص ألقت بصداها وتأثيرها الحداثي في حركة الزمان والمكان؛ ليكون الإبداع مقابل التاريخ في صيرورة مستمرة لم يقطع الشاعر فيها صلته بالماضي، بل باندماج فاعل مع اللحظة الراهنة العابرة، ومع التجربة الإنسانية كما هي في لحظتها الآنية التي تضع الشاعر في حالة تكامل تصل – بتعبير لاكان – لأن يأخذ بعداً حاسماً، لأنه يشكل ويؤسس تكوين “الأنا”(1). ويضعنا الشاعر في عرضه لتلك الشخوص في معادلة يتعذر تكاملها بين وجود ناقص وماهية كاملة، أو نزوع إلى تكامل يصعب تحقيقه بوجود ناقص، والشاعر يتماهى مع شخوصه محاولاً أن يتلبس كيان كل منهم وهو يعانى وجع الذكرى والسنين في معايشة معاناتهم وأزماتهم، حتى أحالهم شعرياً إلى رموز حاضرة بالدليل والمثال، وكأنه يريد تصحيح الذاكرة ونقدها حتى لا “تنكمش على ذاتها وتغلق أبوابها لتعيش داخل عذاباتها وآلامها الخاصة بها، حتى إنها تصبح عمياء خرساء أمام آلام البشر”(2). مما جعله يقرن وجودهم الواقعى بوجود تاريخى ليس بمعنى التحديد الكرونولوجي، بل بانفتاح روحى يحيل الذكرى إلى صور وأصوات حيّة، فالشاعر بين زمنين يتجاذبانه وشخوصه، زمنه الخاص المعيش وزمن مفقود يتوق إليه، ولايزال في صراع نوستاليجي أورثه الإحباط واليأس حينا ويبعث فيه الزهو والنشوه حينًا آخر، وهو في تمثل روح ذلك العصر الذي “ليس هو سوي روح المرء نفسه ينعكس ذلك العصر علي مرآتها” كما عبر جوته، ليضع نفسه داخل التاريخ وخارجه، ويدخلنا عبر المرآة/ الزمن في عوالم يرى فيها الوجوه كلها في وجه واحد، فالآخرون ليسوا إلا نحن في صور مختلفه، وفي بحثه عن جمال هو في انعكاس لاشياء قد لا تبدو جميله بذاتها، مدركا مثل إيجلتون “بأن القيمة الجمالية مطلقة، بل ترتبط بشخص معين في موقف معين كما أنها ترتبط بظرف تاريخي وثقافي محدد”(3). وقد تحقق ذلك في قصائده، وقد اجتمع فيها الجمالى والأيديولوجى لآن الشاعر بوصف نيتشه هو ” من الأمس ومن الزمن القديم ولكن فيه من الغد ومن الآتي العيد”. ويضيف، نيتشه، منتصراً للشعر والشعراء قائلا على لسان زرادشت: “فإن بين الأرض والسماء أمورًا كثيرة لا يحلم بها إلا الشعراء”.
والشاعر اختزل المرحلة بستة أشخاص/ أعلام رأى فيهم ست عتبات تمهد للخروج من مرحلة زمنية والدخول إلى أخرى، فالمراحل القديمة– كما يراه – باعتقاده تمثل “شكلاً من علاقة مع الحاضر ونمطاً من العلاقة يجب ربطة مع الذات في محاولة للبحث عنها وعن أسرارها وحقيقتها الغامضة المختبئة”(4). والعملية تشبه إعادة الخلق أو الإنتاج بفعل الحداثة الذي “لايحرر الإنسان من وجوده الخاص فحسب، بل يفرض عليه مهمة صنع ذاته”(5). والشخوص / الأعلام هم: (أنور كمال، جورج حنين، رمسيس يونان، كامل التلمساني، بشير السباعي، والشاعر نفسه أحمد طه).
ويضعهم الشاعر في قصائده بأسمائهم الصريحة، باعتبارهم شخوصاً لها غيريتها وأصالتها، واستطاعوا بما قدموه من منجز أن يكرسوا لأنفسهم صوراً ذهنية فارقة في ذاكرة التاريخ، والشاعر في وقفات استذكارية لهم بما قدموه من وعى جمعى شكّل ذاكرة جمعية وحققق في النهاية تاريخاً مشتركاً. والتجربة بها أثارته من أسئلة عديدة منها: “هل بإمكان الشعر أن يجعل من العرضي والزائل لحظة خالدة في تاريخ الإنساني؟”، هذا الشك ساور رولان بارت قبل أن يدفع شاعرنا للإجابة بأن عطاءهم بتنوعه وقدرته على التحرك في اتجاهات إبداعية متعددة حمل دلالات فلسفية وفكرية واجتماعية فضلاً عن دلالات حداثية استمدها من الموروث الغربي عبر إحلالات لافتة للواقع العربى ولا يزال المنجز حياً ومؤثراً، ولنأخذ الكاتب والفنان رمسيس يونان الذي رحل عن عالمنا عام 1966، ليصبح جزءاً من غياهب المجهول الذي عاش مأخوذاً به، ومضت رحلة موته كرحلة حياته في صمت واعتزال، واعتبره الباحثون والنقاد ممن عاصروه، رائداً من رواد الحداثة شارك مشاركة قعالة في معارك الفن والثقافة، ومثَّل قيمة مهمة لفنان من شبرا عالج الواقع برؤى سوريالية، واتصل خلال الثلاثينيات بجماعة الدعاية الفنية التي أسسها حبيب جورجى، لتكون تجمعاً لفئة من أصحاب الفكر النظري والثقافة من رجال التعليم المشتغلين بالفن، وأصبح رمسيس يونان داعية للفن الأوروبي الحديث، كما سيكون بعد ذلك من دعاة ومقدمي ثقافة الغرب الطليعية حين ترجم مسرحية كايجولا لأليبر كامى والجحيم لرامبو، كما شهدت تلك المرحلة تجمعات لفنانين وأدباء في أواخر العشرينيات في “جماعة الخيال” وتحديها بشعار “لن يجبرنا الخوف من الجنون أو المحرمات أو منكم على أن تبقى راية الخيال مكنسة”، والتي كانت ملتقى رواد الفن المصري المعاصر. وكان لقاؤهم حول فكرة الفن القومي واتصاله بحضارة البحر الأبيض، واتصلت برجال الفن والأدب، منهم هيكل والعقاد والمازني ومحمود عزمي ومي زيادة.
وقامت جماعة أخرى أطلقت على نفسها جماعة “المحاولين” على أنقاض جماعة “الخيال”، وكانت لهم لقاءات ثقافية اتخذت من قاعة بممر بهلر مكاناً لها، وأصدرت الجماعة مجلتها “إيفور” لنشر الثقافة الحديثة وتنافح عن حرية الفن، إلى أن جاء جورج حنين ليشكل جماعة “الفن والحرية”، وهى استجابة لنداء السوريالي الشهير أندريه بريتون الثوري من أجل فن حر مستقل، ظهرت الجماعة إبان حقبة النازية التي مارست إرهاباً وقيداً على حرية الإبداع، وفي هذا الجو البائس القاتم أطلقت جماعة الفن والحرية صرخة تمرد واحتجاج في منشورها الصوري “يحيا الفن المنحط”، وبدأ بمعارضتهم ميلآد الحركة السوريالية في مصر بثورة على المفهوم التقليدي للجمال والمنطق والنظام في الفن، وكان للسوريالية الأثر العميق على الشعراء والكتاب والفنانين في العالم كله، وكان صداها قوياً في مصر الذي تجلى في جماعة ” الفن والحرية” مع جورج حنين ورمسيس يونان والأخوين أنور وفؤاد كامل وكامل التلمساني*.
وقد جرد الشاعر شخوصه من ملامحها الواقعية وأحالها إلي كليات مجردة ليرتقي بها إلي رموز وعلامات أيقونية تلتمع في فضاء قصائده بتمظهرات نصية كما تخيلها الشاعر، لا بمعنى المحاكاة أو المشاكلة بل بمعنى التمثّل والتحول والأثر، لتدخل في تجربة المتلقى المعاصر خارج سياقات التأويل المعيارى بحدوده الثابته ودون نمذجة أو إغلاق، ليصبح التلقي “ممارسة وتطبيقا لا نهائيا وعملا لا مركزيًا لا نهاية له ولا ختام”(6). وبقيت قصائده تدور بين رثاء لهم واحتفاء بهم لأنهم يمثلون إرثا نحتاجه لتفعيل وجداننا الوطني، ودائما “يسمو بنا الشاعر إلي الزمن الأول ” بتعبير هولدرين، فالشاعر غالبا ما يبحث في غير نفسه عن نفسه ليضعها في صورة وجود مختلف يفصل فيه الذات عن الموضوع ليعيش أوهامه التي تشبه بشكل ما أوهام دون كيخوته ليستنطقها واقعا حقيقيا، لأنه آخر الفرسان واقف على تخوم عوالم تمحو الفروسية بكل قيمها، ويحرص الشاعر على بقاء فرسانه كما يريدهم، وقد أحالهم إلي غيلان حقيقيين، وليسوا مجرد طواحين هواء كما توهمها دون كيخوته غيلانا، وكما يراها أحمد طه حقيقة يجب أن تكون. لأنه تمثلهم رمزًا أو دلالة تتخذ صفة الكينونة في انتمائها لروح الشاعر وانتمائها إلي عصره، ولكن بدلالات عامة مباشرة أو ضمنية، في إشارة إلى عصر أو حقبة زمنية تُعرف برموزها، فنيرون دلاله طغيان، وجيفارا دلالة ثورة، وسبارتكوس دلالة تحرير، ومثلهم ماركس وتروتسكى وأنور كامل ورمسيس يونان وغيرهم؛ “لأن التاريخ كله هو تاريخ الحاضر، فنحن لانبغي حقا من دراسة التاريخ غير التعرف على الإطار الذي نعيش فيه ومعرفة أصوله ولا يتسنى لنا معرفة الحاضر وتفسيره مالم ندرك الماضى بالبحث في حقيقة وجوده، والواقع أن كل مايتناوله التاريخ بالبحث حاضر موجود، أما ما مضى وانقطع فلا سلطان للتاريخ عليه”(7)، وهذا ما حرص الشاعر على اجتماعه في شعره وكأنه يؤكد رأى غادامار” أن الإنسان تاريخ يتواصل ولا ينقطع”، وهو جذر أنثروبولوجي للأدب والفكر، والشاعر كان بقصائده مقتحما حقول الأزمان القديمة بوعى حداثى إن اتخذ لنفسه صفة المنشد والحكاء، فهو إنما أراد إعادة المرحلة إلى أصلها التاريخي بأسلوب الاتصال بالحاضر لأنه مدرك تماما بأن الشعر بات يراوح بين أصل وانتحال وتناص واقتباس، والشاعر في كل ذلك ينأى بنفسه أن يكون جزءا متمما أو مكملا أو معقبا شارحا لمن سبقه بمعنى التبعية أو الاحتفاء، بل هو شاعر عرض أيقوناته لتؤكد وجود من انتفى وجوده، وليتماهى مع الآخر الغائب الحاضر ليؤكد به وجوده هو، وهذا إليوت يؤكد ما ذهبنا إليه:
“إننا نموت مع من يموتون
انظر، إنهم يرحلون فنذهب معهم
وإننا لنولد مع الموتى،
انظر، إنهم يعودون فيأتون بنا معهم”
من كل ماتقدم وجدتني أقف عند “أنور كامل يوسع منفاه”. قصيدة لافتة اجتمعت فيها كل ملامح شعره وشخوصه التي أدخلها منفاه وهى تحبو وتلبس الكاكي وهو يوسع لها منفاه (قبره)، وكأن الشاعر يصور أنور كامل كأحد فراعنة مصر في زمن امتد عبر جذر عريق، وعاش موته بحياة أسلافه العظماء بكل ما خلفوه من آثار سجلها أنور كامل في شخوص صحبه كما تمثلهم وهم يتنبأون بواقع رآهم فيه متلبسين بتجربة التحريض لأيديولوجية اليسار عبر خطوط وأهداف مرورًا بمعاناة وأزمات عانى منها أصحابه الذين _ رحمة بهم _ استدرجهم إلي منفاه. بذات الطريق الذي عرفه هو منذ ثلاثين عاما خلت:
“ثلاثون عاما
كنت وحيدا في منفاك
ونحن نحبو
ونصيح
ونلبس الكاكي
وكنت تعلم
أن طريقنا يمر من هنا
فكنت توسع منفاك
تبنى ضريحك والعسكر حصنا
من أسماء:
فهذا جورج حنين
يخرج من تحت إبطيه الخرائط
ليختار أين يولد
وأين يضيع”
وهل لمن يلبسون الكاكي طريق آخر غير النفي (حياة أو موتا)؟ ومن غيرهم يكونون له حصنًا؟ فهم الأسماء التي تبحث لها عن كيان ووجود، فهذا جورج حنين في غربة الولادة والضياع في خرائط يحملها تحت إبطيه، خرائط المكان والزمان وأسرار الوجود التي ينحنى عليها تروتسكي:
“وهذا تروتسكي
منحنيا على الكتاب
يشير إلى أوجاع القلب”
وأي كتاب ينحني عليه غير الوعي الشقي، قرين الفكر الثائر الذي يريد تحرير القلب من أوجاعه؟ الفكر الذي قاده إلى المنفى قبل أن يصله أنور كامل بعد أن حطم آماله وتطلعاته وعاش هاجس الموت حتى جاءه من يفتك به غدرا في منفاه في المكسيك عام 1940، هنا تسبق نهاية تروتسكي بداية الطريق، والشاعر يلعب على توازي الخطوط وتقاطعها بحثاً عن نقاط افتراق أو التقاء في منفى أو غيره، أما المنفى فموجود حتى قبل الولادة. في خرائط جورج حنين يحدد الوجود الذي لا يلبث أن يضيع في بلدة رمسيس يونان التي يرسمها قبل أن تضيع في خيالات الشعر وتغرق في أمواج اللون وخطوط التكوين الحلمي ليغيب في دورب عصفت بها الأزمات:
“وهذا رمسيس يونان
يرسم بلدة من الوهم والأحلام
ويغيب في دروبها”
ويعود الشاعر ليثبت تاريخياً فاصلاً في تاريخ الفكر والسياسة، ويختار بشير السباعي الكاتب والمترجم ليكتب اعتذاراً لتخلفه عن الموت في 1848 سنة ميلاد البيان الشيوعي، والعام الذي كتب فيه ماركس كتابه رأس المال في ظروف تاريخية صورها تشارلز ديكنز في رواياته ورسمها فان كوخ في لوحته الشهيرة لمأساة عمال المناجم وما جسده فيها من إرهاق وبؤس:
“وهذا بشير السباعي
يكتب اعتذاراً رومانتيكياً
لتخلفه عن الموت فى 1848
ويجد أحمد طه لنفسه مكاناً في هذا المنفى:
وهذا أحمد طه
يقيم حوله الشراك والحفر
مطارداً طفولته
التي هربت منه”
وهذا ضياع من نوع مختلف يجد الفرد نفسه فيه محاصراً بالشراك والحفر، مدفوعاً لاستعادة براءته (طفولته) الهاربة منه أبداً، ومن عتمة المنفى الذي يتربص بهم، يلوح لهم وهج القاهرة، ملتقى الأزمان والأماكن والوجوه، موعد التقاء أو افتراق:
“وهذه قاهرتك
ليست هناك حرف يمكنه اختراقها
ليشى بشوارعها التي ترقد في أركانها الأزمنة
كعجائز مشردين
وتتحاور فيها الآلهة
كندماء في مقهى”
مدينة الحالمين ممن يصنعون من الحرف عزاء لهم دون جدوى، فالمدينة الأم قد تتنكر لأبنائها وتمسخهم عجائز وترميهم في شوارعها مشردين راقدين في أركان شوارعها، مثل أزمنة أسطورية تتحاور فيها الآلهة بأصوات سرية مثل ندماء في مقهى:
“وهذه شبرا
جسد يمتد كمقبرة
تسع الجميع
ولاتتسع لأحد
تخجل من اهتراء صدرها
فتنحني
يتساقط الموتى
والجياع
والأطفال
ولابسات السواد
كما يتساقط اللبن الدافئ
وتبقى جيوش الأمن المركزي
وعربات الترام الخاوية”
والشاعر كمن لا يجد بدأ للانعطاف إلى حى من أعرق أحياء القاهرة، فقط ليبث شكواه ويعلن حزنه على حي يمتد كمقبرة تسع جميع الأموات ولاتتسع لفرد حي واحد. شبرا نضبت الحياة فيها، ولا بد من الانحناء للخلاص من ثقل الموت والجوع والأطفال، وفي صورة مريعة لحي تتقلب فيه الأحوال بين همهمة وصراخ وبكاء وضحك:
“ويبقى
عيال بلون التراب
رجال تهمهم في الليل
تصرخ في النهار
نسوة يبكين – كما يضحكن –
تحت أزواجهن
وخلف نعوشهم
نسوة ينتفخن بأنفاس الرجال اللاهثة
فتسعى تحت جلاليبهن العيال”
تصوير في غاية التركيز والعمق، صورة تمزقها انفعالات تتردد في جنبات هذا الحي الممتلئ حياة وموتاً وبزخم شعري يحدث تياراً شعورياً يخترق الأعماق ليصيبنا بصدمة الخيبة واليأس وفقدان الأمل.
فكثافة السكان يتزايد عديدها بسرعة أنفاس الرجال اللاهثة “فتسعى تحت جلابيبهن العيال” ليضعنا الشاعر في مفارقة المأوى الذي نضبت فيه الحياة:
“عربات الترام الخاوية
وجبانة القطارات على طرفها العلوي
والعيال التي تسعى تحت جلاليب أمهات ينتفجن
بأنفاس الرجال اللاهثة”.
ولايزال الشاعر عالقاً في عوالم جافة قاسية يريد أن يفنى فيها ولا يريد، ولكنه يصر أن يضع نفسه في حكاية عن موته الأول مغرقاً في الضحك:
“كنت تحكي عن موتك الأول
مغرقاً في الضحك
كنت ميتاً محترفاً
لكني كدت أقهقه حين رأيت الكاكيين
كانوا يبكون بحرقة أم ثكلى
فقد أفلت التلمساني
وجورج حنين
ورمسيس يونان
وأنا الآن آخر الناجين”
ورغم أن صحبه أفلتوا من الحياة، والشاعر سيكون آخر الناجين ووحده باقياً يعاني اغتراب المكان وقسوة الزمان وفراغ الذاكرة ولكن:
“ثلاثون عاماً
كنت أردد موعظتي
كيلا أنساها”
وها هو بقوة الأسطورة يتسلق أسوار “هليوبوليس” الشمس ليقود عربة يصعد بها إلى السماء ثم يهبط بها إلى المغرب ساعة الغروب، حيث يأخذ زورقاً ذهبياً يعبر به الأوقيانوس (المحيط) إلى نقطة البداية أي الشروق. هذا الاستطراد الميثولوجي يحتاجه الشاعر وهو في غمرة التواصل مع الواقع أو بالطواف في فضاءات الشعر يعلو:
“فأراكم تقتتلون وحولكم العسكر والأعراب
يرمون إليكم بقصاع الأصوات الموزونة
بينما يتبادلون الطلقات
كأوراق اللعب
كالعناق
كالمضاجعة
لا دم يسيل
ولا عروق تنتفض
ولا جنين يتكون”
وكأني به يحذر من وجود يجد نفسه فيه على غير إرادة منه فهو في استلاب وضياع بعد أن غادر الكل الحياة وهو آخرهم، هل يقصد الموت أم ميلاد ما بعد الموت/ البعث الذي يدفعه إلى ترديد موعظتة لثلاثين عاماً كيلا ينساها. ولكن هذا الاغتراب صار حتمية قد تطال من بقى يصارع الحياة، ممن يراهم يقتتلون ويقصعون بعضهم بعضاً قمعاً وكسراً، هل يدعو– رافضاً ومحتجاً – إلى قطع النسل أم هى حتمية قدرية لحياة تجف فيها دماء الحيض وشرايين لعضو ينتفض:
“لا دم يسيل
لاعروق تنتفض
ولا جنين يتكون”
هل الشاعر يقطع كل ما يشير إلى التواصل، لأنه يختزل الزمن في واقعة أو موقف وكأنه يقترح أسلوباً للفهم والتفاعل يلم به أطراف المشهد الصاخب المضطرب؟ فهو يعرض للظواهر بهاجس الشعر الذي من مهامه إحالة الخارج الواقعى إلى الداخل الشعرى في دعوة إلى نوع مغاير من التطهير يفيد في تهيئة النفس لتقبل كل ما يواجهها من مآس وأوجاع، ولو تعمقنا في إشارات الموت والمنفى في غير مقطع من شعره لوجدنا أحمد طه يدعو إلى هذا النوع من التطهير الذي باعتقاده يرتفع بصاحبه ويحرره من عبودية الوجود ومشقة الحياة، فهو ومعه رفاقه ممن اختزل المسافات باتجاه مستقبل مبهم غامض، وكل وحيد في منفاه يفكر بالآخر وهم فاقدون الاسم والكينونة في وطن يتنكر لهم:
“ثلاثون عاماً
كنت وحيداً في منفاك
كنت تفكر أين تنام القاهرة الأولى،
وكيف امتدت تلك الثكنات
فطالت نافذتي
وكنت تفكر كيف يكون لجورج حنين الضائع
وطن
يتأبطه في النزهات
ويجالسه في المقهى
وقد يتحسس أعضاءه بعد الكأس
الثانية”
والشاعر أو أنور كامل لا فرق يكون مع رفاقه يفكر في تحولاتهم واختلاف توجهاتهم وهم يبحثون عن ملاذ ولا يجدون:
“فالوطن الجالس بجوارك لا يعرف
اسمك
حتى بعد الكأس العاشر…
قد يتمطي
وقد تدعك عينيك قليلاً
ثم يعاود رحلته اليوميه
وتعاود رحلتك اليومية
ليكن
ليس لك إلا هذا الصدر الخالى من الحَلمَات
بعد أن رحل الرفاق إلى الأبد
كفراشات هائمة
فالشَقة تتسع في هذا اليباس الذي أصَاب الوجود
وأحاله إلى الموت يدفن “في مقابر يوليو”
ليكن
سوف تسلمهم جسدك
بغير أثر يشير إلى احتراف الموت
لثلاثين عاماً
فليدفنوه في مقابر يوليو
ولتعد كما كنت روحا تهيم
في أطلال هليوبوليس”
وهكذا يغدو الصحاب روحا تهيم في أطلال هليوبوليس لتبعث من الأزمان القديمة الآتية من مدينة الشمس التي اقترب زمن أفولها. فالشاعر يصل الإنساني بالتاريخي كحالة حتمية، وإن انحرف بحدسه الشعرى عن الأسباب الواقعية، فهو بتأثير من تجربة جدل بين الوهم والحقيقة، لايستطيع الشاعر أن ينظر إلى نفسه كما ينظر إليه الآخرون، كما يعبر (لانج)، وحين يكون الجدل شعرياً تتفتح له آفاق لا نهائية، يتراوح بين الحياة والموت، والمصري منذ الأزل احتفي بهما، ورأى فيهما امتداداً أبدياً وروحاً لا تغيب.
وشخوص الشاعر أحمد طه كانوا هم في حياتهم ومماتهم غاية وقيمة في حالة تشكّل ونقض لهذا التشكّل حققها الشاعر في شعره وجوداً أصيلاً وحياً، ليضع القارئ المعاصر في مواجهة مسؤولة مع الذات والآخر عبر زمن يتجدد.
ويبقى شاعرنا يردد مع أمل دنقل عن قساوة الجُدر:
“آه… ما أقسى الجُدر
عندما ينهض في وجه الشروق
ربما ننفق كل العمر… كى ننقب ثغره
ليمر النور للأجيال…مرة”.
……………………………………………….
الهوامش:
1) ميجان الرويلى، سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، (الدار البيضاء، 2002)، ص225.
2) محمد بهاوي، الفلسفة من خلال نصوص فلسفية مختارة، 2011، ص203.
3) نهاد صليحة، التفسير والتفكيك والأيديولوجية، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000)، ص17.
4) محمد بهاوي، مصدر سابق، ص201.
5) المصدر نفسه ص201.
*) استفينا هذه المعلومات بتصرف عن كتاب بدر الدين أبو غازي، رواد الفن التشكيلي، (كتاب الهلال، 1985)، عن الفنان رمسيس يونان.
6) عزت محمد جاد، نظرية المصطلح النقدية، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002) ص417.
7) حسين فوزي النجار، التاريخ والسير، (الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1964)، ص10.
8) انظر: صلاح عدسي، ملامح الفكر الأوروبى المعاصر، (كتاب الهلال، 1976)، ص127.
* نقلاً عن مجلة فصول ـ العدد93… ربيع 2015