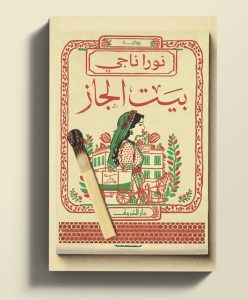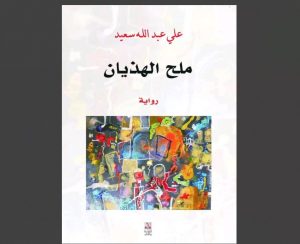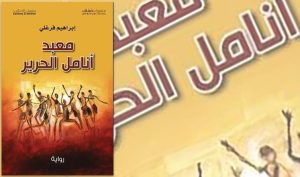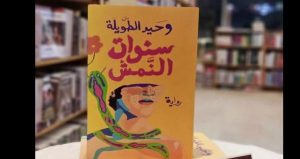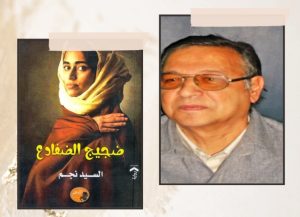د. شاكر عبد الحميد
كان يوسف عمران السارد الرئيسي في هذه الرواية هائمًا في المدينة، مثل شبح ينتاب المدينة يجوس خلال طرقاتها وباراتها. هكذا بحث خلال الليل وفي البارات عن ألفة ليلية افتقدها في نهار المدينة. وهكذا ظهرت لديه الازدواجية الخاصة على نحو تحول من خلاله إلى ما يشبه الشبح الذي يقوم بالتجول والسكن في ليل المدن، بينما قد تسكن القرية ذاكرته ووجدانه.
لم يكن يوسف زائرًا، أو متجولًا فقط، عبر المكان يقوم بالشراء ويراقب الجموع كما كانت الحالة لدى بودلير، أو يهيم بالعلامات المضيئة للأعمال والتجارة والسلع ويحدق فيها كما هو حال “المتسكع” لدى فالتر بنيامين، بل أصبح روحًا هائمة أو شبحًا، خلال الليل وخلال النهار وفيما بين المدينة والقرية وبين التاريخ والعزلة والغياب.
في التمثيلات الحديثة للمدينة، نجد ذلك الإحساس القديم بالعزلة، عزلة كانت قديمة نتيجة تباعد المباني، وعزلة جديدة نتيجة تقاربها، حيث ذلك التواصل المستمر كرهًا أو طوعًا، حيث الوحشة والتشكك والاستغراق في الذات وغياب الألفة، وحيث الوجود النهاري المعتم والغامض والمجهول والوجود الليلي الأكثر غموضًا وسرية.
أماكن الغياب
هكذا أصبحت الأماكن الحديثة أماكن للغياب، إنها الأماكن التي بلا هوية، الأماكن التي ليست مكانًا ولا يعول عليها، الأماكن التي تقاوم الإغلاق، الأماكن المفتوحة على المجهول، الأماكن المتاهات، الأماكن التي يكون الإنسان فيها رقمًا وتحسب قيمته بالأرقام: يكون حيًا وميتًا في الوقت نفسه، وحيث تغيب عن حياته الألفة وتحضر الوحشة والخوف، فأين توجد الحياة هنا؟ إنها توجد هناك عند الطرف الآخر من الحلم، أو بالأحرى من الكابوس، إنها توجد عبر الذاكرة تتعلق بالطفولة والماء والحرية والقمر والقرية والطيران ووحدة الوجود أو وحدة الغياب.
ترتبط المدن بأدب الازدواج، ومثلما ترتبط فكرة الحياة العائلية بالبدايات والنهايات، بالمغادرة والعودة والألفة، بالحياة والموت، فإن أدب الازدواج يهتم كذلك بذلك الجانب النفسي والاجتماعي المتعلق بالغياب، أو الاختفاء، غياب الإنسان عن بيته، عن مكانه الأليف، واختفاء شعوره بالأمن، ورغبته في العودة إلى الجذور، خوفه من الضياع بعيدًا عن بيته أو وطنه، عن أمنه الذي يظن أنه موجود في بيته أو وطنه، والذي قد يعود إليه فيجد هذا البيت أو الوطن أيضًا قد ألفته القديمة.
عندما يصبح الإنسان غريبًا، بلا بيت مألوف، فإنه يصبح في حاجة إلى أن يبني مكانًا خاصًا به: بيتًا، مدينة، قانونًا، ذاكرة، إبداعًا، كل ما يضع أساسًا راسخًا لوجوده، وهي تلك الأسس التي قد تتحول أيضًا إلى قيود أمام حريته، إنه قد يخلق مكانه الخاص، يحاول أن يعلو فوق حالة فقدانه المأوى السابقة، لكنه قد يفقد أيضًا طبيعته، حريته، يكتب مقدمات موته، ومن ثم يكون بيته الجديد هو الشاهد الخاص الموضوع على قبره.
لدى فالتر بنيامين تنشأ مشاعر الوحشة والغربة والاغتراب والغرابة عن ذلك التراكب- وليس التركيب- الذي يحدث بين القديم من الأفكار والصور والمباني والخبرات وبين الجديد منها، فيتعايشان معًا على نحو غريب يجمع بين المألوف وغير المألوف في سياق واحد. وقد لا يتعايشان ويتصارعان أيضًا كما في صراع الموت مع الحياة والحياة مع الموت.
وسط القاهرة
من وسط القاهرة وعالم البارات، تبدأ هذه الرواية التي تقوم على أساس عدد من التداعيات والتذكرات لحياة السارد، هنا وهناك، في المدينة والقرية، وعبر الذات والآخر، حيث عالم وسط القاهرة، والبارات التي هي المؤشر الحقيقي لذلك العالم الداخلي عند فئات- على الأقل هذا ما تقوله هذه الرواية- كثيرة من المصريين من تجار المانيفاتورة إلى البوابين والصحفيين والشعراء وغيرهم.
في البارات “كان يوسف عمران يقرأ العيون والأفكار من حوله، ويقيس شدة الأنفاس وحرارتها، ليتسلل حثيثاً إلى روح الجالسين”. كان يلاحظ كذلك “أن الجلسات لا تتغير، بل شبه متكررة. والوحيد الذي كان ينقذه من ذلك الركود السميك، وتلك الرتابة الثقيلة، هو عم أرمين سارويان بحكاياته عن أرض الأجداد وعن أرمينيا ومذابح الأتراك هناك في مطلع القرن العشرين. كانت تلك الحكايات هي التي كان يمكنها إحداث قيمة التغيير في مسارات الطقس والتحليق نحو تاريخ أكثر إنسانية”.
في البار يهتم يوسف عمران، كما قلنا، بقراءة العيون والأفكار، وكان يهتم كذلك بالنظر إلى عدد الزجاجات والكؤوس التي استهلكت في الجلسة. فالبار لديه أصبح مكانًا “يقاس الزمن فيه بعدد الزجاجات الذي يمثل عقرب الساعات، بينما عدد الكؤوس هو عقرب الدقائق. أما عقرب الثواني، فكانت حالته هي التي تتحكم في العقربين وتضبط الزمن بالثانية الواحدة”.
وقد كان هناك شعور جارف قد هيمن عليه، بأن الحياة قد أصبحت خانقة وشديدة الصعوبة إلى الحد الذي بدت الأمور معه، “وكأن هناك مؤامرة ما لتدمير العلاقة، ليس فقط بالمكان بل وبالناس أيضًا”.
يقول: “المكان لم يعد يعني أي شيء. صارت الأماكن محطات، مجرد محطات عابرة تعبره ويعبرها في آن معا.. لتتضاعف سرعة تقاطعه، وتمر اللحظة وكأنها لم تكن أصلًا”.
يتذكر ذهابه في طفولته إلى المدرسة، وكيف كان يسير المسافة أربعة كيلو مترات ذهابًا وإيابًا وسط الغبار والبهائم والحمير والماعز والخراف، ومع ذلك فقد كانت المدرسة مكانًا مؤقتًا للراحة من توبيخات الكبار وأوامرهم الغريبة وتسلطهم، وبخاصة الجد.
وأثناء المرحلة الثانوية لم يكن الحال أفضل، ولم تكن الأحوال أفضل. كذلك أثناء عمله في الورشة “لم تكن هناك تلك الحالة التي يكتبون عنها في الروايات والقصص، حالة الألفة مع المدرسة أو البيت أو المصنع والورشة. وكلما كانت السن تتقدم، كانت الحالة تنسحب على الناس الذين تشيأوا أيضًا. أصبح كل شيء عابرًا مع بشر عابرين، فتتضاعف سرعة الجميع ليرى كل منهم الآخر- المكان والإنسان، مثل الأشباح المتطايرة”.
والأشباح هنا ليست أشباحًا متجولة عبر المكان والذاكرة والماضي والخيال والأحلام والعلاقات أو بين المدينة والقرية، وليست كذلك أشباحًا معتمة مخيفة مرعبة مراودة مفاجئة، لكنها كانت أشباحاً عابرة طيارة سريعة المرور، لا تقيم، لا تتفاعل مع المكان ولا مع البشر، ولا يتفاعل البشر الذين يحضرون من خلالها على نحو مفعم بالألفة، فيما بينهم، من ناحية، وفيما بينهم وبين المكان الذين يحلون فيه ويسكنون من ناحية أخرى.
دوائر مغلقة
علينا أن نلاحظ هنا أن يوسف عمران مولع على نحو خاص بذكر الأرقام والسرعات والمسافات والزمن. يقول “المسافة من البيت إلى المدرسة الابتدائية أربعة كيلو مترات ذهابًا وإيابًا، وإلى المدرسة الثانوية خمسة كيلومترات، وجلسات البار تقاس بعدد الزجاجات والكؤوس وعقارب الساعة والدقائق والثواني”. وعلينا أن نلاحظ أيضًا أن ولعه بالتفاصيل هذا قد انعكس أيضًا على شغفه بمراقبة ذاته ومراقبة الآخرين، وكذلك على مراقبته للمكان والزمان والتاريخ والإنسان والتحولات التي جرت على الزمان والمكان والإنسان.
هكذا صارت حياته، كما قال، “موزعة بين بيت ومقهى ومصنع وجامعة ومظاهرة وطابور جمعية يقتطع من حياتك ساعتين وثلاث ساعات للحصول على دجاجة مثلجة تنظر إليك بعينيها المغمضتين ساخرة، أو كيلو من اللحم الذي يجب أن تتركه عشر ساعات كاملة ليذوب الجليد عنه، ويظهر الشحم والجلد الدامي، وبعض قطع العظام القذرة”.
هكذا يشعر يوسف عمران بأنه موجود في دائرة مغلقة محكمة الحصار قد فرضها الزمان والمكان والإنسان، “هكذا تأخذه الخمر بعيدًا، ليرى مؤامرة مدهشة لتدمير العلاقة بالمكان والبشر وانتزاع حواس ومشاعر وقدرات مثل: الدفء والألفة والتأمل”.
ترتبط الأرقام بالزمن ويرتبط الزمن بالمحدد الذي يقاس بالساعات والدقائق والثواني والمسافات والجزئي والحرفي، بينما يرتبط المكان بالكلي والمتزامن، بالحضور الآني والفوري والعفوي. الزمن متتابع، متسلسل خطي. والمكان تمثيلي مجازي إيحائي مفعم بالدلالات والاحتمالات. ويرتبط المكان كذلك بالانفعالات السارة أو غير السارة، ومن ثم كان حديث باشلار عن روح المحبة وعن محبة المكان.
هكذا تستمر تساؤلات يوسف عن المكان والبشر، وعن الألفة والدفء والتأمل، ثم تصل به تساؤلاته إلى الوطن، يتساءل: “عن أي معنى للوطن يمكن أن يدور الحديث؟ هل تم تجريد الوطن إلى هذه الدرجة التي باتت تكشف عن كل عوراته وسوءاته؟”. أما عندما يصل به تفكيره إلى المرأة، فإنه “يمد يده بتلقائية إلى ياقة قميصه، يُعَدِّلها، وكأنه يجهز نفسه أمام المرآة لموعد غرامي”، وكذلك يملأ الكأس عن آخرها ويعبها حتى النهاية. لحظتها فقط يبتسم في شماتة من دون أن يفصح، ويغمغم بكلمات غير مفهومة.
ومن الاستعراض للجالسين في البار وعدد الزجاجات والتذكر لمرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية والورشة والوطن والمرأة، يستغرق يوسف في تداعياته، فيحاول تذكر تاريخ العالم كما درسه أو قرأ عنه أو خبره. ذلك العالم الذي كان بلا صواريخ أو قنابل أو إنترنت أو مواقع تواصل اجتماعي، العالم الذي كان بسيطًا ولم يعد كذلك، تعقدت الحياة وازدادت مشكلات البشر. ويستمر ويوغل في تداعياته وما قد يرد إلى ذهنه من أفكار وصور تتعلق بقصة الخلق وتاريخ العالم والبارات وجمالها وبساطتها والعقول الساكنة بداخلها أو خارجها، يتذكر قريته التي نشأ فيها وعائلته، وجده الذي كان شديد القسوة وعماته وخالاته والعضاضة ومحفوظة ونعيمة ومقام سيدي الخراشي والهضبة والحرش وشجرة السنط وشجرة النبق، ويتذكر محفوظة والقط الذي تتلبسه روح البشر. يتذكر الثورة وما حدث فيها ولها، ويقول “إن التاريخ يكرر نفسه ربما حتى من قبل الميلاد، ثورة تقوم لتتخلص من نظام فتأتي بنظام أسوأ منه”. يقول لنفسه: “قد يكون المكان ثابتًا وراسخًا بحكم قوانين الجغرافيا والهندسة المعمارية وقوانين الفلك، وقد تكون الكائنات الهائمة بداخله عناصر أساسية مكملة لصورة الواقع في المكان”.
يتذكر أمه التي كانت تنادي الأحفاد بأسماء الطيور، والتي تعلم منها “أن المكان يمكن أن ينهد على رأس من فيه، ويمكن أن يبتلع من فيه، ويمكن أن يصبح لعنة على من فيه”. يتساءل أيضًا وهو يغادر البار: “هل كانت تبتسم لهذا السبب أم كانت تسخر من المكان ومن فيه”. يتساءل أيضًا: كيف وصلت الحكمة بها إلى أن تستبدل بالمكان الأحفاد والطيور والعقل خارج الحدود والمكان؟ يبتسم ساخرًا ويقول: لقد أصبحت هي نفسها خارج الزمان والمكان فمتى تغادر الذاكرة؟
يتحرك إلى كورنيش النيل، يتجول قليلًا. لم يكن هناك أي جديد، لا في الشوارع، ولا في وجوه البشر من حوله، ولا في حركة السيارات العشوائية، ولا في الطقس. لم يندهش، بل ردد في تحدٍّ: “نعم، يمكن أن ينزل الإنسان إلى النهر مرتين وخمس وعشر وألف”.
وقد كان في نفيه لمقولة هيرقليطس الشهيرة: “إنك لا تستطيع أن تنزل النهر مرتين لأن مياهًا جديدة، تأتي إليه في كل مرة”، تأكيدًا منه لهذا الركود المخيم، والثبات المقيم، على المكان، وعلى البشر وعلى الوعي، إنه ذلك التكرار الذي يبدأ السعي ثم يعيده، كما بدأه أول مرة. وإثباتًا لذلك الموت الموجود في الحياة، ولذلك التكرار الذي يعلو فوق الحياة والذي يكون أيضًا مصاحبًا لها يعمل معها ويعمل ضدها أيضًا، وإلى الدرجة التي يبدو فيها دالًا على حضور دافع آخر يكون موجودًا وراء المعنى أو وراء الحياة، ألا وهو دافع الموت. ويتكرس هذا التكرار ويتعمق الشعور به عندما يستأجر مركبًا في النيل و”قد كان هو المركب نفسه، من العجوز نفسه، بالسعر نفسه، سأل الأسئلة نفسها، وتلقى الإجابات نفسها، قال الكلمات نفسها، وسمع الردود نفسها. وجاء الرجل بالأكواب والمازة نفسها، وداعبه بالدعابات نفسها عن النساء والذي منه”.
رمزية الماء
الماء رمز محوري في هذه الرواية، والماء هنا ليس كأي ماء “إنه المكان الذي يتماهى مع حابي، وعندما يتماهى الزمان والمكان مع حابي يكتمل جوهر الوجود وتتشبع به الروح”. إنه حابي، ومعناه السعيد أو جالب السعادة، وهو يرتبط بالخصوبة والتدفق والحياة وقوة الحضور.
يتذكر يوسف عمران اهتمام قدماء المصريين “بمشروعات الري وبراعتهم في بناء الحياض وشق القنوات”، ويتساءل عن تلك الديانة الجديدة التي كانت لإله جديد، وكيف تحول المصريون عن عبادة النيل وتقديم الأضحيات والهدايا من الكعك والفاكهة وحيوانات الأضحية له والتمائم إلى التبول فيه. يتذكر الماضي والحاضر، والقرية والمدينة، ويستمر في مراقبة عقارب الساعات، وهي تطارد بعضها البعض ويتذكر زمانه الخاص ومكانه الخاص وحزنه الخاص وغيابه الخاص. وفي قلب الخاص يتوالى حضور العام، فتتوالى على وعيه ولا وعيه تلك التداعيات حول الروح المصرية وعن علاقة الإنسان بالماء، والمكان والنهر والتاريخ والمدينة، والشوارع والبارات، والحب، والقرية، والجامعة، والثورة. وتهاجم عقله تساؤلات حول الحب والألم والدم والعدم، يتذكر زمنه الخاص، ومكانه الخاص، وكذلك تلك “التي قالت له يومًا: شرطي هو الفرح، لا شيء اسمه السعادة الفرح هو الحياة”. (ص ١١)، والتي قالت أيضًا: “إذا أردت أن تفهم، اذهب إلى المدرسة، وإذا أردت حنان الأم فدعني وشأني، واذهب إلى حضن أمك، أو ابحث لنفسك عن مربية.. أنا امرأة للحب”. تتطور العلاقة بينهما لكنه يدرك في النهاية أنه “مهما صنع لها في رأسه من صور وأطياف. قد تجد هي ذلك مبهجاً كأي امرأة، لكنها تفضل أن تبقى من لحم ودم لكي تشبع من الدنيا” (ص ٤).
الهويات المنقسمة
ويستمر يوسف عمران في تداعياته كذلك حول تلك الفروق الموجودة بين أبناء المدن وأبناء القرى، وتثار في عقله شكوك متتابعة حول كل شيء، وحول كل تصنيف. فالمدينة ليست شيئًا واحدًا، والقرية أيضًا ليست شيئًا واحدًا. هناك تفاوتات في البيوت والمباني وأنواع الطعام وطرائق تناول الطعام والأخلاق وأساليب الحياة بين أبناء المدن وأبناء القرى، وهناك تداخلات أيضًا، وثمة ثبات وركود وتكرار يعم الجميع، والمتغير الوحيد بين ذلك كله هو الماء، هو الجريان هو السرعة، هو الحياة، هو الوجود. يتساءل عن الحب، عن أسبابه غير المفهومة عن طبيعته، وعن الصمت والفقدان للمحبوب، والنسيان والابتسام والشرب، وعن تلك المدن التي قد تنتزع منك الأحلام القديمة، وقد تمنحك بدائل لها لكن لا تكون أبدًا مثل أحلامك القديمة.
يحن إلى القرية إلى الطفولة، إلى النهر، والماء، والحرية. ويتذكر عمله في الورشة والحارة التي كان يقطعها وهي نائمة وحركته من شارع إسكندر مينا المؤدي إلى سوق الوايلي والمساكن الشعبية في شارع بورسعيد والترمواي وورشة الحاج صبحي ومن كانوا يعملون فيها، والعلاقات التي كانت بينهم والمصائر المؤلمة التي لحقت بغالبيتهم. يتذكر العمل والذهاب للسينما وموت الأصدقاء والورشة التي تغيرت أحوالها والمدينة التي أصبحت شائخة ومشوهة. “لا أحد يعترف بذلك إلا في القصص والأشعار كلهم يفخرون بعراقتها ومجدها ويتجاهلون عمدًا تلك البثور والتجاعيد التي تغطي وجهها القبيح، يتغنون بجمالها ويتمنون العودة إلى الوراء، إلى أزهى العصور، بينما الجيوش من أطفال الشوارع يراقبون الوضع مثل القطط الجائعة من تحت الكباري والجسور ومن الحواري المظلمة، ومن مكانهم خلف صناديق القمامة”.
يرى يوسف أيضًا أن المدينة مسكونة بالأرواح والأشباح المخيفة، وأن سكانها “يخشون النظر إلى المرايا، والاختلاء بأنفسهم ولو للحظة واحدة. سكان يقسمون بعضهم إلى قرويين وأبناء مدينة، مسلمين وكفار، يحددون درجة التحضر والمدنية بقدرتك على الإمساك بالشوكة والسكين، أو بطريقة تناولك للطعام وهم يدركون جيدًا أن الخبز والماء لا يحتاجان إلى أي أدوات سوى بطن جائع وفم مفتوح”.
وعلى الرغم من أن يوسف ذاته يمثل أيضًا تجسيدًا لهذه الهوية المنقسمة فإنه يرى نفسه كذلك قادرًا على الرؤية والملاحظة والنقد والتقييم والتأمل… وهكذا يستغرق في تأملات وتداعيات حول تلك الازدواجية الموجودة في الشخصية المصرية، والتي تتجلى في هذه القسمة العدائية والصور النمطية حول الآخر سكان المدن/ سكان الريف/ المسلمون المسيحيون/ الرجال/ النساء.. إلخ.
ما يدركه يوسف ويؤكده هو أن ما نحتاجه في حياتنا، أكثر من غيره، هو الحاجة إلى الاهتمام، العطف، الحنان، التعاطف، الكلمة الطيبة، الفطرة، البساطة، والعفوية والتلقائية لا التصنع والتكلف، وتحميل الأشياء أكثر مما تحتمل: الرقة والشعور بالآخر وحب الخير له، هذا هو الحب الحقيقي في رأيه، لا الحب بين رجل وامرأة، هذا هو الحب الذي لا ينتهي.
العودة إلى الذات
ويستمر بحثه عن الهوية المصرية المنقسمة، والتي أصبحت شائخة في المدن ويمثلها النهر الذي يتدفق ويتم التبول فوقه، والأشجار والجوع والظلم. يعود إلى ذاته، يمجدها، ومن خلال تمجيده لذاته يخاطب كل الوجوه التي تشبهه ويمجدها، يمجدها في ظلام المقابر الذي ولدت منه، في حياتها التي عاشتها “في أعمق أعماق المدافن وتحت الكباري والجسور وبين أكوام القمامة”، ويقول له: “لا تبتئس ولا تيأس. فرع نهرك ينتظرك. لم يفش أسرارك طالما لم تقع أنت بعد في المحظور”.
يهرب يوسف من المدينة الشائخة ويتخذ من القمر بوصلة ودليلًا، يتذكر حياته، طفولته، قريته، مدرسته، الورشة التي عمل فيها، كفاحه وصلابته وعزمه وإصراره وضعفه. يقول: “المجد لك، وأنت تهز رأسك موافقًا، وفي قرارة نفسك تلعن الواقف أمامك.. أنت تبتسم له، ولسان حالك يردد أجمل ما رضعته من شتائم”، ويقول كذلك وهو يستدعى الصور المخيفة المرعبة لمصائر كثير من المصريين: “المجد له عندما ينفذ صبره، وعندما يطرد كل هواجسه مع مواء القطط وعواء الكلاب في الأحلام، عندما يكتسب جسارة الفهد، وعندما تهرس جسده الصغير الجائع عجلات أية سيارة عابرة، ويلملمون أشلاءه في ورق الصحف ويدفنونه في مقابر أهل الصدقة أو مجهولي الهوية، بينما أمه تبحث عنه وتظل إلى الأبد بحسرة الغائبين”.
يتذكر يوسف طفولته وكيف كان، ومازال موجودًا في مكانين في حلمين، في تيارين من تيارات التذكر، يمجد نفسه المنقسمة الموجودة على ضفتي النهر، ثم وهو في المدينة، وهو أيضًا في القرية، وهو في حالات الخوف والرهبة والرعب أو في حالات الضحك والحلم والدهشة والتحليق، يتذكر الماء الذي يفصل بين عالميه والذي يوحد بينهما أيضًا.
وفي القرية أجيال من البشر والطيور والحيوانات، وثمة قنطرة ترابية تصل بين الناس والمقام، مقام سيدي الخراشي، لا يعرف أحد من أنشأها ومتى، وثمة أفكار وهواجس تتعلق بفرع النهر المحاذي للهضبة، فحواها وجوهرها أن المياه التي تمر منه مياه ملعونة وينبغي منع الأطفال من الاقتراب منه، وكذلك من شجرتي السنط والنبق الواقفتين هناك.. مقابل الحرش من الجهة الأخرى القريبة من المقام. هناك مقام غامض وهضبة مخيفة ذات أحراش تثير الرعب ليلًا ونهارًا وفرع من النهر يعتقد أن مياهه ملعونة، ومع ذلك فقد كان لدى يوسف إحساس يتزايد كل يوم يجذبه نحو تلك المياه الموجودة في ذلك الفرع الملعون.. يرتبط المقام بطقوس صوفية أثيرية، وبأصوات غامضة، قد تصدر منه، وكذلك بطقوس عبادة وولادة ورغبات في الإنجاب أو الصحة والشعور بحسن الحال، تتم من خلال الدوران حوله سبع مرات.
قط أسطوري
وتحضر عبر السرد صور الجد والأب والعائلة الممتدة ذات الاجيال المتتابعة، وحكايات خاصة حول الكثير من الشخصيات داخل العائلة وخارجها، حيث نجد حكايات حول اعتماد توكل زوجه اللحاد أو التي لقبت بالعضاضة (بفمها الخالي من الأسنان) والتي كانت قادرة على أن تتلبس روح المكان في حالات الفرح أو الحزن، وكانت قادرة كذلك على أن تتحول إلى صوفية زاهدة أو راقصه تضيء الفرح وتبعث فيه الحياة أو صوفيه (أشبه بالبهلول) تتطواح في الموالد والأذكار، وهناك أيضًا ابنتها محفوظه التي كان يوسف يرى ملامحها تتجسد في صور من دخان وبخار وأحيانًا في شكل أصوات متداخلة لا يمكن تمييزها، وقد كانت قادرة على التحول والحركة والدخول إلى مقام سيدي الخراشي والخروج منه وخلع ملابسها والسياحة في الماء حتى تبدو كالحوريات أو جنيات البحر. وقد كان يوسف يخاف منها وينجذب إليها أيضًا. وهناك أيضًا حالات من الفرح والحزن وشخصيات تظهر وتختفى واشارات إلى حروب ١٩٦٧، و١٩٧٣، والهجرة إلى الخليج، وتغيرات وأساليب الحياة والتدين الشكلي، وعلاقات بين البشر والحيوانات والملائكة والعفاريت وعمليات موت غامضة، وخرافات شعبية وهلاوس وكوابيس، وهذيانات، وطقوس شعبية من أجل الحمل والإنجاب، وبئر ترتبط بالخصوبة والرغبة في الانجاب، وجنون يحدث للبشر بسبب ما يشاهدونه من أحداث غير قابله للتصديق، و”من يفقد عقله يطير”، وهناك أحلام بالطيران لدى كثيرين، وثمة قط يظهر ويختفي، يموت ويعود بعد الموت وهو يؤثر في الأحداث ويحاكي أفعال البشر، بخاصة الجد في مشيته وطريقه رفعه لرأسه إلى أعلى في خيلاء، “بينما شواربه الطويلة منتفضه في كبرياء وثقه”. ويشبه القط الجد في حركاته ونظراته وتفقده للمكان وقوته ومراقبته للنساء، كما أنه يطير في الاحلام وينبت له جناحان. والقط هو رمزيًا وسيط بين عالمين، عالم الواقع وعالم الروح. وفي التراث الشعبي، هو بسبعه أرواح، أي يربط بين الحياة والموت، أو هو الحياة بعد الموت. والقطط ميثولوجيا ورموز متعددة الدلالات قد تربط بالشر والموت وقوى التحول والحظ العاثر والمرض والشيطان والظلمة والشهوة والكسل والاسترخاء، هي رموز لإيزيس وباستيت وإنانا وفينوس وعشتار. وهي أيضًا رمز مزدوج، ذكرى وأنثوي، يرتبط بالخصوبة والحمل، وتعبر من خلال عيونها عن القوة المتغيرة للشمس، وإلى تحولات القمر، وإلى المد والجذر، وإلى فخامة الليل، وإلى الشكل الخفي، والاختلاس، والرغبة، والحرية. والقطط بشفاهها المشقوقة رموز توأمية ترمز إلى التشابه والاختلاف، وكذلك إلى الذات المنقسمة بين عالمين كما كان حال يوسف عمران في هذه الرواية، الذي كان أشبه بقط برى يجوس خلال الديار وخلال الزمان والمكان والإنسان والتاريخ والوعي.
الكل في واحد
وفي محاولة منه للتغلب على هذا الانقسام والازدواجية التي يشعر بها في كل قسم، يحاول يوسف عمران أن يتوحد مع الكون. وقد ظهرت وتجلت له رؤية كليه عندما انزوى ذات ليلة في مقام سيدي الخراشي، وأتبعها بليله أخرى وثالثة ورابعة إلى أن اكتمل القمر، خرج من المقام وظله كان تحت قدميه، احتضن شجرة السنط، صعدها وكأنه يفعل ذلك للمرة الأولى. كان جذعها يابسًا وجافًا، ثم اتجه نحو شجرة النبق، شعر بانجذاب نحوها، أثارته جنسيًا كامرأة، وعاشرها كامرأة. سقط من فوق صدرها مباشره في النهر، سبح وذاب جسده وتحرر. كان في حالة تشبه الحلم، اتجه نحو الهضبة وصعد في اتجاه الحرش الذي تحول إلى ما يشبه فم العضاضة المظلم. وعلى الباب وجد محفوظة تقف عارية، حلق كطائر فوق الحشائش القصيرة في اتجاهها، وصل إليها غطته بصدرها، انزلق داخل بطنها كطفل تنتابه الرغبة في العودة إلى رحم أمه، فتح عينيه، رأى بابًا ينفتح أمامه، كان بابًا من نور وكانت محفوظة هناك تتشكل من جديد، من نور وفرح وشهوة، لكنها لم تكن شهوة كالشهوة. ثم انفتح العالم كله، امتدت فيه الطرق. وتفرعت الطرق إلى طرق أخرى أقصر، لكن لا بداية لها ولا نهاية. صار الوجود كله موجودًا كلحظة فورية خاطفة، فيها تتحقق الرغبات قبل أن يتم النطق بها، حالة أشبه بالحلم الكوني الشفاف الموجود في ذاته وبذاته ولذاته، وحيث كل الحقائق التي كانت خافيه قد أصبحت موجودة، وحيث لا نفي ولا إنكار ولا كراهية ولا حب ولا تذكر ولا أجساد. والقط الأسود كذلك ليس أسود، وجواهر الاشياء تظهر من داخلها وتدل عليها، لا ملمس ولا ذاكرة، لا تلصص ولا نميمة، لا خطأ ولا ثواب ولا عقاب، لا صراع ولا أوهام، لا ضحك ولا بكاء، لا مرض ولا شباب ولا شيخوخة لا أمر ولا نهى، لا قبول ولا رفض، لا حيرة ولا تيه ولا انقسام ولا وجود ولا عدم “أنت فقط الذي يحدد أيهما الوجود وأيهما العدم”. هكذا رأى يوسف نفسه عندما وقف على رأس الجبل يعلو فوق اللحظة والإدراك والكون. وكان الوجود الآخر الموجود على الشاطئ الآخر المقابل للحرش والهضبة وجودًا كاملًا يهمهم ويصطخب ويتزلزل، وكانت هناك دوامات وصراعات وطائرات وصواريخ ولهب يشتعل ونار تحرق الجبال، رؤيا أشبه برؤيا يوحنا المعمدان أو نهاية العالم أو بداياته، ودوامات الماء تسوق البشر في طوفان يبيد الكون. ثم تنفتح من الطوفان، بعد أن يهدأ، طاقة لا هي بالنور ولا هي بالظلام.. ومنها تنطلق أجساد بشرية عارية تركض فوق حشائش نبتت لتوها، تلهو وتتعلم أبجدية الشهوة، والكون يضاء بنور وانفجارات، وكان يوسف ينزل من قمة الجبل، فيمتد الطريق، يرى كل الذين رحلوا، لا كلام ولا زمن ولا اختبار كل الناس يعرفون بعضهم ولا يعرفون أي شيء. حتى المعرفة تتحرك في ذاتها ولذاتها. وهم لا يبحثون بل يجدون.. هنا اللاوجود.. هنا لا شر ولا خير.. هنا لا توجد تصنيفات ولا انقسامات.. هنا كلية الوجود وهنا الوجود الكلي الذي لم يسبقه وجود ولن يأتي بعده وجود.. هنا الخلود وهنا الأزل وهنا الأبد.. وهنا السرمد وهنا اليقين. هكذا تتوالى عبر هذه الرواية مجموعة من المشاهد هي مزيج من الأحلام والرؤى الصوفية، والأحلام التي فتحت بوابات الإدراك فذابت الحدود وانزاحت الفواصل والتقسيمات التي فرضها الإنسان على نفسه وعلى الآخرين وعلى المكان وعلى الإنسان. وقد كانت الحركة في المكان، في هذه الرواية، عبر شوارع المدينة وباراتها ومراكبها، وكذلك عبر الذاكرة والخيال والأحلام والقرية ومدارج التصوف والضريح والسباحة والطيران وعلاقات الحب والجنس والمعرفة بالآخر والحركة بين المقام والبئر والنهر والهضبة والحرش والاشجار وغير ذلك من معالم المكان. كانت هي وسيلة السارد الرئيس يوسف عمران للوصول إلى ما أراد الوصول إليه من معرفة أو يقين، ومن تجسيد لأسطورته الخاصة التي هي أسطورتنا أيضًا.
…………….
* مجلة “إبداع”- مارس 2018