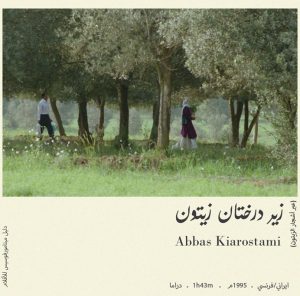محمد العبادي
في المشهد الافتتاحي لـ”أنورا” يبدأ المخرج “شين بيكر” بلقطة طويلة.. تسافر فيها الكاميرا عرضيا عبر صالة في أحد أندية التعري.. لتستعرض الكاميرا الأجساد العارية للعاملات في النادي وهن يمارسن “عملهن” مع الزبائن.. في النهاية تقترب اللقطة أكثر من جسد إحدى العاملات ثم تغلق على وجهها.. لينزل بجواره اسم الفيلم.. ونكتشف أنها هي: آنورا!.. صدمة متعمدة من المخرج ليدخل المشاهد لعالمه.. لكن الحقيقة أن هذه الصدمة قد تكون مناسبة لتعبر عن موسم الأوسكار ككل لهذه السنة!
فالبحث عن الصدمة يصلح عنوانا لموسم الجوائز الحالي، بدت الأكاديمية كأنها تبحث عن المواضيع المغايرة والصورة الجريئة.. بغض النظر عن القيمة الفنية للفيلم.
إنها سنة عودة ترامب.. لذلك فبالإضافة لالتزام الأوسكار وكل الجوائز الأمريكية بعوامل غير فنية للتقييم.. إلا أن عودة ترامب للصورة زادت من قوة الالتزام السياسي للمجتمع السينمائي الأمريكي، يجد ممثلو “قوة أمريكا الناعمة” أنفسهم أمام التزام أخلاقي واختيار مصيري للدفاع عن قيم الحرية والتنوع الأمريكية.. في وجه ترامب وكل ما يمثله اليمين المتطرف والقوى المحافظة الإمبريالية الحديثة.
لذلك من النادر ان تجد بين الأفلام التي رشحت للجوائز فيلما خارج دائرة المواضيع المدعومة من النخبة الليبرالية، لدينا أفلام عن التحول الجنسي، العمل الجنسي، التمييز على أساس الجنس أو اللون، خبايا الكنيسة الكاثوليكية، وبالطبع اليهود والمحرقة وما بعد المحرقة إلى أبد الآبدين، تبقى المشكلة أنه مهما كانت درجة نبل الأفكار التي تدعمها هذه الموجة.. فأنها بالتأكيد ليست كافية لتقييم العمل بشكل فني.
أبرز أفلام هذا الموسم هو “أنورا” – الذي يجعل راعي بقر منتصف الليل يبدو كفيلم أطفال – يقدم لنا قصة أنورا/آني فتاة ليل – لا مؤاخذة – أقصد عاملة جنسية وقصة حبها وزواجها من ابن أحد زعماء عائلات الجريمة الروسية، عبر سرد بصري جرئ ونمط مونتاج مختلف يقدم لنا شين بيكر قصته التي تبدو كنسخة معكوسة وجريئة من قصة سندريلا الكلاسيكية، هنا المال والقوة – وليس الحب – هما جوهر الحياة وبالتالي هما المحرك الرئيسي للأحداث.. سندريلا هنا تقابل أميرها ابن المجرمين في عملها في نادي التعري، وتتوطد علاقتها بها كرفيقة مدفوعة الأجر قبل أن يتخذ قراره المجنون بالزواج منها، هو فعلا فيلم جيد وقدم طرحا طازجا ومختلفا.. لكن.. هل كان يستحق حقا الفوز بخمسة من أهم جوائز الاوسكار؟.. لا أظن.. ربما لو أزلنا “أنورا” من السياق التاريخي لسنة الأوسكار وما ارتبط بها من رؤى سياسية وأخلاقية لم يكن ليحصد كل هذا التقدير، في ظل سياق اكثر اعتدالا ربما لم يكن ليتجاوز حاجز الترشيح لجائزة أو اثنتين، والسؤال الأهم الآن: هل سيصمد “آنورا” في وجه الزمن؟.. هل يستحق أن يحجز له مكانا في الذاكرة السينمائية؟.. أيضا لا أظن.. وهو ليس توقعا صعبا بصراحة.. نظرا لأن معظم الأفلام التي حازت جائزة الأحسن في العشرة سنوات الماضية اختفت من الذاكرة السينمائية.. من يتذكر “الكتاب الأخضر” مثلا، أو Nomadland؟!.. بل من شاهد CODA؟
القصة ليست فقط في الصوابية السياسية، بل هي جزء من موجة أكبر للأكاديمية لتقدير الأفلام المستقلة ذات الصوت المختلف، لهذا نجد أن غالبية الأفلام المرشحة لأحسن فيلم هي أفلام محدودة الميزانية مثل آنورا، أولاد النيكل، المادة… وغيرها، كذلك التزمت الأكاديمية بسنتها الحسنة في ترشيح فيلم غير أمريكي في فئة أحسن فيلم، وكان الاختيار للفيلم البرازيلي “لازلت هنا” إخراج والتر ساليس.
لكن تقدير الصوت المختلف شابه الارتباك، فلم تكتف هوليود بالأفلام محدودة الميزانية بل فتحت الباب لأفلام ضخمة الانتاج لأنها قدمت رؤية إبداعية مؤيدة للتنوع مثل “ويكد”. وويكد تحديدا هو فيلم مثير للدهشة.. لم أستطع أن أجد فيه جانبا من التميز الحقيقي يدفعه للترشح لأكبر جائزة أمريكية.. لذلك هو فيلم مدهش.. مدهش في عاديته بل قد نقول في سوئه.. قصته الضحلة المأخوذة من مسرحية ناجحة، رؤية غير ناضجة مبنية على دعم الأقليات والاختلاف بدون أي عمق حقيقي.. حوارات وأحداث مستهلكة.. وحتى على مستوى الصورة حدث ولا حرج.. ديكورات وملابس سيئة الذوق وخالية من الطموح، وتمثيل يجعل ترشيح أحسن ممثلة وممثلة مساعدة أقرب لنكتة عملية!.. إن تقدير هذا الفيلم ونجاحه في الفوز بجائزتين في النهاية هو مثال على سيطرة العوامل غير الفنية للتقييم.. يكفي أن نقول أن بول تيزويل الفائز عن فئة الملابس هو أول رجل أمريكي من أصل أفريقي يفوز في هذه الفئة، وهو أيضا – لا مؤاخذة – مثلي جنسيا.
رغم كل هذا القبول والتسامح لم يتسع صدر هوليود لصوت المخرج الأمريكي المخضرم “فرانسيس فورد كوبولا” ومشروع حياته “ميجالوبوليس” الذي أنتجه من ماله الخاص، بالعكس قررت هوليود ان تقذف في وجه فيلمه ست ترشيحات لجائزة “التوت الذهبي” للأسوأ.. حصل منها على جائزة أسوأ مخرج!.. حالة كبيرة من العدوانية من هوليود تجاه مخرجيها الكبار رغم أنهم – ياللعجب – أصحاب أصوات مستقلة ومختلفة. ماحدث مع كوبولا هذا العام هو نسخة مكبرة مما حدث من قبل مرارا وتكرارا مع مارتن سكورسيزي، وربما بشكل اقل مع سبيلبرج.
مفارقة دعم الصوت المختلف والأقليات ظهرت أيضا في حالة واحد من أكبر الخاسرين في موسم الأوسكار: إيميليا بيريز.. الذي بدأ موسم الجوائز كواحد من أكثر الأفلام تقديرا وحصل على أكثر عدد من الترشيحات للأوسكار.. لتصيبه تصريحات كارلا سوفيا جاسكون في مقتل.. يحكي الفيلم قصة رجل عصابات يقرر أن يتحول لامرأة – لا مؤاخذة – أقصد قصة امرأة محبوسة في جسد رجل عصابات وتكافح لتخرج منه لصورتها الأصلية. حصل الفيلم على تقدير كاف ومستحق في جوانب الموسيقى والاستعراض، لكن البحث الإعلامي خلف بطلة الفيلم – لا مؤاخذة – العابرة جنسيا كارلا سوفيا جاسكون كشف عن آرائها العنصرية المناهضة للملونين والمسلمين، بضعة تغريدات سحبت السجادة من تحت قدمي أول ممثلة عابرة جنسيا ترشح للجائزة، بل عرضها لهجوم حتى من زميلتها في الفيلم زوي زالدانا.. وانتهى الموسم بتجاهل الفيلم الذي بدأ الموسم بدعم هائل.. لكن لسوء حظ “إيميليا بيريز” أن ما بني على الصوابية السياسية.. هدمته الصوابية السياسية!
وماذا بعد؟.. تنتظرنا سنوات أخرى مع ترامب.. وجزء ثان من ويكد.. والضحية الحقيقية هي السينما بصورتها الطبيعية.. وتقديرها للجودة والجمال. والضحية الأكبر الأفكار الجديدة المبتكرة التي تتركها الصناعة مهجورة بحثا عن أفكار تفتقد للأصالة، تارة أفكار ذات رؤية سياسية معلبة، وتارة إعادات وزيادات لأفكار قديمة معتادة.. حتى سينماهم المستقلة أقرب لتقليد غير متقن للسينما الأوربية.