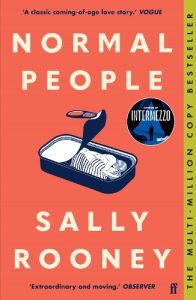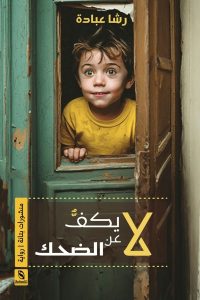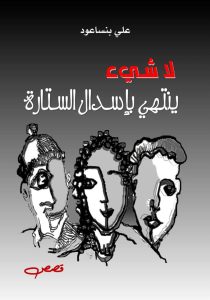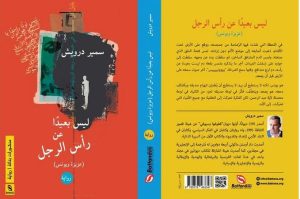د. داليا سعودي
في حياة عمالقة الأدب، لحظة زمنية يطالعون عندها منجزهم الأدبي فيدركون حدوده المترامية، لحظة ينظرون عندها إلى سنوات العمر المتبقية فيدركون أن الباقي من الزمن لم يعد مديدا. وتتلبسهم عندها رغبةٌ في قول عبارة أخيرة يميزها الإيجاز والتكثيف. إيجاز الرحلة وتكثيف أدواتها ومعانيها. عادةً ما يكون ذلك حال الأدباء الذين يمتلكون وعياً حاداً بمحطات أعمالهم، ويطمحون إلى إضفاء نوع من الوحدة العضوية عليها. فعلها جوستاف فلوبير على سبيل المثال، حين كتب قبيل رحيله بثلاث سنوات كتاب “ثلاث قصص قصيرة”، الذي كثف فيه مصادر إلهامه الثلاثة : الواقعية، والأسطورة، والتاريخ، جمعها خيط ناظم يمثل وحدة الإنسان أمام مصيره. وفعلها نجيب محفوظ حين كتب “صباح الورد” (1987) في السادسة والسبعين، لغرض أدبي آخر، وهو لا يدري أن العمر سيمتد به ليفوز بنوبل، وليتعرض لمحاولة اغتيال، وليستمر في الكتابة نحو مزيد من التكثيف التعبيري غير المسبوق. فما هي الرسالة التي تركها لنا النجيب في ثلاثية “صباح الورد” ؟
***
بداية، يختلف المصنفون في تصنيف “صباح الورد”، أهي سيرة ذاتية متخفية في مخايل التخييل، أم هي ثلاث قصص قصيرة منفصلة، أم هي رواية متصلة ممسرحة في ثلاثة فصول: “أم أحمد”، و”صباح الورد”، و”أسعد الله مساءك” ؟
ويبدو أنه عمل بلا ضفاف عصي على التصنيف، رغم حرص صاحبه على أن يكسبه بنية صارمة التقسيم، فهنا ثلاث قصص لكل منها بداية ونهاية وعنوان، لكن ثمة خيط جامع بينها هو صوت الراوي الواحد غير المُسمَّى الذي يأخذ على عاتقه التعبير بضمير المتكلم، وفق تسلسل زمني يعبر الطفولة والشباب والكهولة على التوالي، ويصنع منها رواية متماسكة، تحفل تفاصيلها بكثير مما نعلم من سيرة كاتبها. رواية تحمل في بنيتها متتالية قصصية تحتفي بالبنية الثلاثية التي عُرفت بها درة أعمال الكاتب وأضخمها حجماً، حين خضعت لاعتبارات الناشر، فقسمها محفوظ إلى “بين القصرين” و”قصر الشوق” و”السكرية”. تذكرنا البنية الثلاثية هنا بتلك الرواية الواقعية الاجتماعية الكبرى، وهو في “صباح الورد” يؤوب إليها، برغبة واضحة في استكمال قراءة الواقع الذي امتد به الزمن لمطالعته على وجه الوطن. فلئن توقفت “الثلاثية” بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعاصر أبطالها ملكاً، تمتد “صباح الورد” حتى منتصف الثمانينات ويعاصر أبطالها ملكاً وأربعة رؤساء، فهي تستكمل بطموح كبير ما توقفت دونه “الثلاثية” زمنياً، لتوجز قصة صعود الطبقة الوسطى المصرية وهبوطها عبر الزمن. بالطبع ليس ثمة تناظر في نسيج السرد بين الثلاثيتين، الذي يتسارع ويتكاثف في “صباح الورد”، لكن هناك استدعاء لرائحة الأمكنة الأولى كما تستدعيها الذاكرة، واستعادة لملامح من السيرة يكملها الخيال المتضافر بصورة فنية مع حال المجتمع المصري. إنها عودة أخيرة لأماكن الثلاثية بعدما فعل التاريخ أفاعيله، وبعدما أحس محفوظ أن تجربته في الكتابة قد شارفت على محطات العمر الأخيرة.
تمهيد: لقاء الذاكرة والخيال
في الأعمال الموسيقية، يصنع التمهيد لحن البدايات. هكذا يبتدئ الجزء الأول من “صباح الورد” (أم أحمد) بجملة افتتاحية تستدعي الذاكرة وتبين قصورها في آن واحد : “لو رجعت إلى الذاكرة ما وجدت إلا صورا متناثرة لا تعني شيئاً”. والعجيب أن هذه العودة إلى زمن الطفولة، وهي تستند إلى الذاكرة وتتبرأ منها في الوقت ذاته، تتطابق مع الصيغة التي استهل بها نجيب محفوظ نص السيرة الذاتية الوحيد الذي كتبه في حياته، ألا وهو نص “الأعوام”، الذي نسجه صبياً على منوال “الأيام” لطه حسين، والذي خبأه طوال حياته حتى قال لمن ألحوا في سؤاله عنه أنه أحرقه. إذ يبدأ ذلك النص الذي ضمنه الكراس المفقود بقوله: “لا يذكر أول شيء أدركه حسه وتَحققه عقله، ومن ذا الذي يذكر ؟“
وقد يقول قائل إن هذا التماثل في افتتاحيتي النصين هو لعبة مصادفات محضة لكاتب تجنب دوماً كتابة السيرة الذاتية الخالصة، وأقر بمحدودية المساحة التي تشغلها في العمل الفني. لكن إكمال قراءة العبارة الأولى في مستهل “صباح الورد” يُظهر “قمراً يطل في نافذة عالية” وبالعودة إلى نص “الأعوام”، نرى الطفل الصغير نائماً على ظهره فوق سطح البيت يستمع إلى حكايات أخته متأملاً السماء و” قمرها الزاهي“. فإن أكملنا قراءة الفقرة الأولى في الرواية نجد أم أحمد تطعم الدجاج بين مهامها اليومية تماماً مثلما كانت تفعل أمه في عشة الدجاج فوق السطح في نصه الذاتي. أهي أيضاً مصادفة أن تتردد صورتا القمر والدجاج بعد فكرة تمنّع الذاكرة واستعصاء التذكر ؟
بالطبع لا أدعي أن نجيب محفوظ قد عاد بعد كل تلك الأعوام إلى “الأعوام” لينقل عنها مستهلها وصورها. ولكنها أثر تجلي صورة استقرت في اللاوعي منذ الطفولة واستدعاها القلم عند اللزوم. فهذه المشابهة التي تطل عبر افتتاحية “صباح الورد” تطلعنا على دور الذاكرة في إشعال شرارة الخيال، وتخبرنا بتأثير الحقيقة على الفن. وهو دور يعزز شرط تصديق التخييل، تماماً كما يفعل السرد عبر ضمير المتكلم في العمل الروائي، وكأننا بصدد ما كتبه أونوريه دو بلزاك في مستهل رواية “الأب جوريو” :” كل ما ستقرأونه في هذه الرواية حقيقي!” (All is true). إنه الإيهام بصدقية المحكي رغم اعتراف صاحبه بأن الذاكرة فقيرة وأنها لا تسعفه. فيقول : “الزمن القديم في الحي العتيق، لم يبقَ من حياته الحافلة إلا ما تعيه الطفولة. مناظر غائمة، وأصوات غائبة، وحنينٌ دائم، وقلب يخفق كلما حركته روائح الذكريات.”
أم أحمد : ميلاد الحكايات
القمر الحقيقي حقيقةَ الجرم السماوي المطل من السماء فوق الرؤوس في “الأعوام” يعود قمراً مجازياً “يطل من نافذة عالية” في مستهل حكاية “أم أحمد”. والفرق بين القمرين هو الفرق بين الذكرى والخيال، فرق يسكنه الحنين الذي يبثه محفوظ منذ البداية مع ظهور بطلته أم أحمد. وأم أحمد هي متعهدة الحكايات والخدمات الدوارة على البيوت في حارة قرمز العتيقة بالجمالية، التي تستنقذ الذكريات من براثن النسيان، وتجسد بصفاتها الروح الشعبية المصرية في صورتها الشهرزادية المروجة للأسرار والأساطير عن “السادة الممتازين” في حي الحسين وبعد انتقالهم إلى العباسية. أم أحمد التي عرفها الراوي منذ طفولته وحتى رحيلها في أواخر الثمانينيات “ما هي إلا الثمرة الأخيرة لصراع طويل مع الألم كُتب لها فيه النصر“. لقد ورث عنها الراوي المتماهي مع محفوظ ثروةً من الحكايات “تضاف إلى التجارب التي حصّلها الإنسان بنفسه وبحواسه وقلبه.” ولا يكتمل الموروث الشعبي من دون جذور ضاربة في تاريخ النضال الوطني وإلا صارت أم أحمد معنى مجرداً يفتقر إلى المصداقية. فلا ينسى الراوي أن يصورها مكتملة المعاني : “حظيت بإعجابي لقوتها الذاتية وصلابتها وشجاعتها وذكائها وانتزاعها من الصخر الأصم مكانة مرموقة بين أرقى سيدات ذلك الزمان. ولن أنسى أيضاً منظرها وهي واقفة فوق الكارّو بين جاراتٍ لها في إحدى المظاهرات الوطنية تهتف بصوتها المدوِّي لسعد ومصر.”
لكن القمر المطل من النافذة العالية لم يكن أم أحمد، وإنما فاطمة العمري، “حلم الطفولة المجهول”، الذكرى المتبقية للحب الأول، وإبنة واحدة من كبرى العائلات. أتراها صورة أخرى لعايدة شداد في “الثلاثية” تعود بعذوبتها النقية وبصوتها الرخيم وبطبقتها الأعلى اجتماعياً؟ قد لا يكون ذلك دقيقاً، فقد لا تستقيم مقارنة حب كمال عبد الجواد المزلزل لكيانه مع حب الصبا المستعاد هنا على لسان الراوي بعد زمن. وسترحل فاطمة عن الحارة مع أسرتها وتتزوج فيسلاها الراوي، حتى تغيب صورتها تماماً عن مخيلته : “فلم يبق منها في خيالي -يقول- إلا نفحة من جمال مجرد وصدى صوت رخيم شديد التأبي والتمنع على الذاكرة.”
ولعل الحب الضائع هنا مجازٌ لانفصام العلاقة بين الطبقات الاجتماعية بعد الانتقال من الجمالية إلى العباسية، بعدما كانت الحارة تشبه أسرة كبيرة لا تعترف بالتفاوت الطبقي. إذ يرصد الراوي انتقال الأعيان إلى العباسية الشرقية حيث شيدوا قلاعهم العملاقة، وانتقال “المستورين” إلى العباسية الغربية ليسكنوا فيها بيوتاً صغيرة. “ولم تتواصل الرابطة القديمة بين الطرفين فسرعان ما شُغل كل فريق ببيئته الجديدة، وكأن شارع العباسية الذي يفصل بين الجانبين أصبح سداً لا يُعبر إلا في الملمات وقد لا يُعبر أبداً. عدنا غرباء أو كالغرباء، بل صرنا مع الوقت أعداء أو شبه أعداء، وحمل إلينا الزمن أفكاراً جديدة تكرس العداوة والانفصام، وختى الانتماء لحزب واحد لم ينجح في محو تلك غربة الزاحفة.”
ينفرط عقد الحارة ويتبدد الحب في الحي الجديد، لكن يبقى تراث أم أحمد فياضاً بحكايات الطبقة المخملية. وتتغير الأزمنة فتحكي عن تقلب أحوال العائلات المصرية، ونشهد تناقضات ضباط يوليو ووحوش الانفتاح عبر مصائر الناس. وحين قرأ الراوي نعي فاطمة الجميلة في صحيفة الأهرام، ساوره حزن من نوع خاص : “إنه حزنٌ يـتأدى كأنه شعيرة تُتلى في محراب الوجود على لا شيء أو على كل شيء.”
إنه اندثار العالم القديم بمُثُله قبل وجوهه.
صباح الورد : مرايا الأسرة المصرية
تتخذ ثلاثية “صباح الورد” اسمها من اسم حكايتها الثانية. وبعد أن كان الراوي يتلقى الحكايات من أم أحمد، صار هو “ترجمان شارع الرضوان فيما لديه من قصص”. وهو في ذلك يهتدي بمنهج واضح لا يحيد عنه. فهو يُنصت إلى الشارع، إلى المكان، صاحب العبقرية الأولى في صنع الحكايات، ويصغي إلى ما تطاير في جنباته من أخبار وأسرار، ويعلم أنه عليه ألا يصدق كل ما يسمع. لذلك يتجمل بالصبر ويراقب الزمن وهو ينقي الأخبار من شوائبها ويسندها بالشواهد. منتهجاً في ذلك نهج المؤرخ العليم، لكنه يفاجئنا بقوله إن “العبرة في النهاية بما يقال لا بما حدث، ورُبَّ كذبة أصدق من حقيقة، فاستمِع إلى شارع الرضوان ولا تكن من المتشككين.“
والحقيقة أن ثمة سؤال محدد يطرحه الترجمان خفية من وراء قص الأقاصيص، فالحكايات عند محفوظ ليست تُطرح بأي حال لذاتها، وإنما هي دوماً أمثولة لسؤال فلسفي أكبر. إنها أقرب إلى مقاربة فينومينولوجية تتفحص الواقع وتختبره عبر التجربة الذاتية طلباً للحكمة والتماساً للتدبر. وهو هنا يرصد حالة التحديث التي وُعد بها المجتمع المصري. فيصف شارع الرضوان في بواكير مجده كواحة للجمال والرفاهية والفرنجة. يطالعه القادم من الحي الشعبي العتيق بانبهار وحبور، حتي باتت “النقلة من الجمالية إلى العباسية في ذلك الزمان تُعتبر وثبة من القرون الوسطى إلى أعتاب العصر الحديث.” فما الذي حدث لسؤال التحديث ؟
تخبرنا قصص العائلات التي يسردها الراوي بعناصر الإجابة. وهو في سرده يهجر النهج الفلكلوري الانطباعي الذي اتبعته أم أحمد في حكاياتها في الجزء الأول، فيورد قصصه منتظمةً كأنها مدرجة في سجل تحريري دقيق يحمل كل منها اسم العائلة، ليحكي لنا بين السطور ما سجله من مفارقات تجيب على سؤال إخفاق التحديث.
أولى تلك المفارقات هي التي يجسدها آل إسماعيل، وهي مفارقة الاستلاب الثقافي. والطريف أن محفوظ قد اختار لهذه الأسرة اسماً يعود إلى أبي العرب إسماعيل وجدهم الأكبر، لكن ما من شيء في حياة هذه الأسرة المتفرنسة المتفرنجة يشي بتمسكها بأي من مقومات العروبة. ولا عجب أن ابنها عثمان يموت سجيناً في سجن جزيرة الشيطان في فرنسا. وكأن محفوظ يريد أن يحذر من مآل الاستلاب الثقافي الذي يسجن أصحابه في ثقافة غير ثقافتهم ولغة غير لغتهم. تهجر الأسرة المكلومة شارع الرضوان، وكأن مآلها أن تهاجر جسدياً بعدما هجرت روح المكان معنوياً.
من المفارقات أيضاً ما تمثّل عبر آل مراد من إخفاق ثورة يوليو في تحقيق آمالهم رغم قربهم منها. وكأن البؤس مقرون بهامات أفرادها لا سيما أصغرهم، عبد الخالق، الذي تنكر له حظه بصورة مؤسفة. ولا يفوت الراوي أن يبث تفسيراً لهذا الإخفاق بقوله : “وخطر لي خاطر أن أولئك الضباط في ثورتهم يمثلون مصر المقهورة في معاناة مشاعرهم بالنقص، ولكن يُخشى أن ينقلب الأمر في ذواتهم إلى مركب عظمة، ولا يجدوا من يمارسونه عليه إلا المصريين التعساء!”
وتتوالى القصص والمفارقات مع آل القِرَبي وشذوذ عميدهم وقربه من إسماعيل صدقي باشا عدو الشعب الأول ومعذبهم ويد الإنجليز في احتلال مصر ؛ وآل الجمحي الذي وصموا بالعنف والشراسة وعُرف عميدهم ببطشه وبارتكاب جرائم قتل ونشأ ابنه ناقماً على الثورة وزعيمها، حتى أبدى شماتة كبرى عندما وقعت هزيمة 67. لكن المفارقة هي إثراؤه ثراءً فاحشاً في عصر الانفتاح عبر “نهب البلد باسم الوطنية”، ثم تفكيره في الهجرة بلا رجعة في عهد مبارك لمَّا تبين له استحالة “إنقاذ السفينة من الغرق”.
وفي وسط مخازي العائلات، يبرز نموذج آل قيسون في أبهى صورة. لعل المفارقة الوحيدة فيه هي رثاثة مظهر رب الأسرة وما ادخره لابنيه عزت ورأفت من عناية وتعليم وتوفير المظهر اللائق، فنشأ الاثنان آيتين في الاستقامة والاستنارة والنبوغ، حتى صارا قدوة لشباب شارع الرضوان، وتخرجا طبيباً ومهندساً من جامعات إنجلترا. ونظراً لأن الحوار المحفوظي يبث في السرد إضاءات حيّة تنقل لنا الأصواتَ بصورة مباشرة طازجة، يأتي حوار عزت مع الراوي مضيئاً بالأفكار الذي أراد محفوظ أن يطرحها على قارئه :
” – لا يكفي التفوق في الدراسة، ولا الانتماء في الوطنية، وليست الوطنية هي يحيا سعد، ولكن يجب أن تكون أنت أيضا مثل سعد. وحدقنا به في دهشة ، فواصل: الرياضة .. الفن .. الثقافة .. العمل .. هذا هو مستقبل وطننا الحقيقي (..) أعداؤنا أاااااااأعداؤنا ليسوا الإنجليز والملك فقط، ولكن أيضاً الجهل والخرافات.”
ولعل شخصية عزت قيسون في “صباح الورد” هي المرآة التي يتجلى لنا فيها وجه محفوظ الحقيقي، فيكتب عنه “أن وفديته العريقة حالت بينه وبين التفاهم الكامل مع ثورة يولية، فاعترف بإيجابياتها ولمس بخفة السلبيات”. ثم يدير بينه وبين الراوي الحوار من جديد، فنسمعه يسأل سؤالاً جوهرياً :
“- ولكن أين الشعب ؟.. إنه يخسر كل يوم بعضاً من إيجابياته.
فقلت ببراءة:
– كأنما أصبحنا دولةً عظمى.
فقال باسماً :
– دولة عظمى بلا شعب تُساوي صغرى!”
ولا عجب أن يؤقت محفوظ رحيل عزت قيسون بالتزامن مع هزيمة يونيو المشئومة…
وتستمر الإجابة على سؤال فشل التحديث عبر الدخول إلى البيوت، فنرى كيف قفزت إبنة بائع الدندورمة لتصبح أكبر معلمة خردة أيام الحرب، تتاجر في مخلفات الجيش البريطاني، وتهدّ السرايات لتحولها إلى عمائر، وتتوسع في الثراء والنفوذ حتى أُطلق عليها في العباسية “مسز تاتشر”! لم يكن محفوظ في ذلك طبقياً لكنه عمد إلى رصد الظواهر التي خلخلت نسيج الطبقة المتوسطة، مبيناً تغير توزيع الثروة كما في حالة “مسز تاتشر”، وفي حالة الرأسمالية غير الوطنية “المرتمية في حضن الاستعمار الأمريكي” إبان الانفتاح عبر نموذج آل ضرغام المرابي.
كما لا يفوت محفوظ رصد ظهور الحركات الدينية التكفيرية، فيظهرها هنا بوصفها ردة فعل للتحلل من القيم الدينية والغرق في الحياة المادية المتحررة، باختصار كرد فعل للحداثة المنبتة عن قيم المجتمع الروحية، وفشل النخب السياسية والفكرية المسئولة عن 5 يونيو67 في إعادة التوازن إلى جيل الهزيمة، كما تبدى كل ذلك في حالة آل شكري بهجت وابنهم سامح “الخواجة بلا قبعة”، وحفيدهم شكري المتطرف.
وبالطبع يفرد محفوظ عرضاً فريداً لنماذج الفساد، لا سيما في نهاية الفصل، عبر نموذج عديلة الحرة السيدة المتحررة وابنتيها من كل أخلاق، والطريف هي روح السخرية التي كتب بها محفوظ مقطع عديلة الحرة، والنميمة المستترة التي يروي بها قصة ابنتها سناء وانسلالها إلى فئة المحترمين اجتماعياً، على نحو يشي بكثيرٍ من المكر بالوجوه الحقيقية التي استلهم منها شخوصه. لكن عديلة بفسادها تصبح رمزاً مصغراً وتافهاً لفساد أكبر يلخصه محفوظ عبر تشبيه فائق التميز في حبكته، إذ يكتب: “وقد عاصرتُ من ألوان الفساد بألوانه وطبقاته وأنواعه ما يجعلني أذكر عديلة وابنتَيها كما أذكر أحيانًا مكتشف النار في تاريخ الحضارة بالمقارنة بغزاة الفضاء.”
***
ولعل المقارنة مع كتاب “المرايا” تفرض نفسها أمام هذا الأسلوب في الوصف القائم على مزج الذاكرة والخيال، لكن الفارق الكبير هو أن وجوه “المرايا” هي بورتريهات شخصية تتراءى في خلفيتها أحداث أثّرت في الوطن، أما لوحات “صباح الورد” فهي رصد فني لتطور الأسرة المصرية عبر الزمن وتاريخ ميلاد الطبقة الوسطى وصعودها وهبوطها. وهي بذلك تتميز أيضاً عن رائعة “حديث الصباح والمساء” التي ترصد عبر قالب الأبجدية المحير شجرة العائلة، وتجليات تَناوب الموت والحياة عليها، وأحداث التاريخ التي شكَّلت نسيجها.
***
أسعد الله مساءَك أيها الوطن
يُشابه نجيب محفوظ أم كلثوم في تطبيق أسلوبية التكرار (Stylistique de la reprise)، فكلاهما قد يعمد إلى تكرار القالب الشكلي نفسه، مع تبديل المعنى المتحصّل عند المتلقي في كل مرة، باعتماد تنويعات متباينة على النسق ذاته. فعند محفوظ هناك تنويعات لا تكاد تنتهي على قالب الحارة، فهناك الحارة الجغرافية (زقاق المدق، بداية ونهاية)، وهناك الحارة الكونية الوجودية (أولاد حارتنا، الحرافيش)، وهناك الحارة الوطن (الثلاثية، صباح الورد). وهي في “صباح الورد” حارة مضمخة بالنوستالجيا العارفة بصعوبة العودة إلى الماضي، وملبدة بغيوم ترجئ شمس المستقبل. إنها حارة أصابها التحلل الاجتماعي والشلل التنموي على نحو يُثقل الذاكرة. “وإنها لنقمة أن تكون لنا ذاكرة، ولكنها أيضاً النعمة الباقية”.
تتعذَّب الذاكرة وتعذِّب الراوي، الذي يسرد حكايته الشخصية في الجزء الثالث من الكتاب تحت عنوان “أسعد الله مساءك”. فيكتب في صدرها : “الذاكرة تُعذِّبني والخيال، فلعلَّه من حسن حظ الحشرة الهائمة في القمامة ألا يكون لها ذاكرة أو خيال، بل الأغلب أن الحشرة تهنأ بالقمامة، بالقياس إليَّ لا فارقَ يُذكر بين مسكني البالي وبين القمامة. إنه لظلمٌ وأي ظلم ألا أكون اليوم في بيئةٍ جديدة تزهو بالنقاء والنضارة.” ها هو الراوي بطل القصة، الذي لم يسَمِّه محفوظ، يصل إلى سن التقاعد من الوظيفة في الثمانينيات من القرن العشرين. فيواجه حياته في شقته العتيقة المذرية في شارع “أبوخودة” وحيداً. فلم يستطع الزواج بحبيبته مَلَك ولا بغيرها، بعدما منعته ظروفه العسرة بعد وفاة أبيه، وتعلق أمه وأختيه برقبته في غياب الأب، فضاع حلمه البسيط في الحب والزواج وتكوين أسرة. والحقيقة أن محفوظ قد وصف حالة البطل البائسة في بيته المتهالك القذر وصفاً مفصلاً دقيقاً، فجعل منه مرآة تتراءى فيها كل من مروا بمحنته، بل تجعل للمحنة طاقة رمزية توحي بانسداد الأفق إثر فشل التنمية. فهذا بطلنا قد مات حبه في الزمن البعيد، أو هكذا ظن، وشهد زفاف حبيبته من صديقه كالغريب (كما حدث مع كمال عبد الجواد مع اختلاف السياقين)، وعاش أسيراً لمطالب أمه وأختيه اللائي لم يكفّ شجارُهن داخل البيت (هل ترى معي النسوة الثلاثة رمزاً لحروب ثلاثة عطلت الوطن وملأته هماً وغماً ومشكلات اقتصادية ؟). فيكتب محفوظ منتقياً الكلمات على لسان بطله : “وألعن تقلبات الزمن التي اجتاحت وطني والعالم وغزتني في عقر داري، وأصبُّ لعناتي على موطني بين أبو خودة وميدان الجيش.”
ومما يزيد من محنة البطل أنه، في سالف الزمان، كان ابن عز يرفل في النعم، محاطاً بالدفء والحنان والكرامة، يتنبأ له من حوله بمستقبل باهر لذكائه ولمظاهر الثراء الواعدة من حوله بغد مشرق تتخايل فيه إطلالة حبيبته ملك التي كاد أن يتزوجها. لكن النوستالجيا ليست وحدها ما يثير حنق البطل الذي هبط في سلم الحياة إلى القاع فراح يبيع أثاث بيته العتيق ويقتات على الكفاف وسط هواجس المرض والموت. فما يفجر الغضب والحسد في نفسه هو ذلك “الإثراء المتفجر في كل مكان” و “الأفراح الذهبية في الفنادق” وإعلانات التلفزيون “الموجعة لقلب المحروم”. وكل ما يجعله يصرخ “ما جدوى ارتفاع المرتب قيراطين إذا ارتفع التضخم أربعة ؟!”، “وجدتُ نفسي وحيداً في الستين في عالم جُنّ جنونُه وانقلبت موازينه وأصبحت فيه الليمونة بعشرة قروش!”
لكن العم نجيب محفوظ عظيم الرأفة بقارئه رغم قساوة ما يكتب، فرغم تشاؤم العقل المتواري تحت مبضعه التحليلي هناك دوماً تفاؤل الإرادة. وهي جزء من الحل في معظم ما كتب. فيلوح تحسّن طفيف في حياة البطل حين يلتحق بوظيفة تدر عليه ثلاثمائة جنيه (في نهاية الثمانينات) في شركة “جنرال إلكتريك” (رأسمال أجنبي ولكن ليكُن!)، وحين يعود طيف قمره يلوح له في أعلى النافذة كما أطل بوجه حبيبة أولى في حارة أم أحمد في الجزء الأول. ومع تكرار ظهور القمر المجازي في النهاية يعود الأمل خجولاً إلى القارئ، بعدما يتجدد الوصل بالحبيبة مَلك بعد ترمُّلها. فتفتح مصراعي النافذة وتلوح له شبه مرحبة. يتّشِح وجه القمر العالي بالضبابية ولكنه يرسم بصيصاً غائماً من النور. وعلى أي حال، النافذة تناديه، تهمس في قلبه، فهل يفوز بعد العمر بالنعيم والهدوء والطرب ؟
***
وبعد، لو أن قادماً جديداً إلى عالم نجيب محفوظ سألني عن قراءة أُولى يتخذها منطلقاً إلى منجز العميد الهائل، لعلّي هذه المرة لن أرشح له كعادتي الثلاثية ثم الحرافيش، بل سأنصحه بالبدء بثلاثية آخر العمر : “صباح الورد”. فهي آخر ما نشر نجيب محفوظ قبيل حصوله على جائزة نوبل عام 1988، وقبيل الفرحة العارمة التي رافقت الجائزة واحتفاء الدولة والناس بالجائزة “العالمية”، مما غيب النقد عن تفحص رسائلها. وهي مكتنزة برؤية العميد في أوج اكتمال قراءته للمكان والزمان والإنسان، وتقدم عصارة اختلاط السيرة الذاتية بالخيال في أدبه وقد اكتمل.
ولعلي أنصح بعد هذه العتبة القرائية بالحرافيش !
***