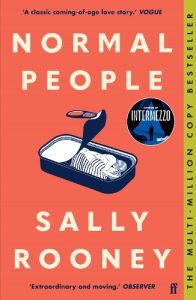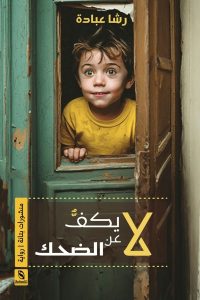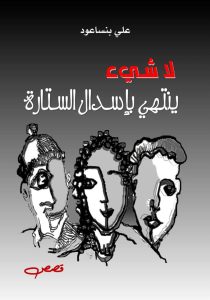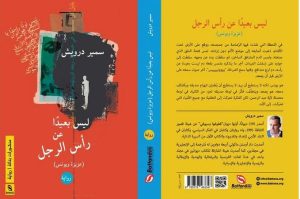زينب محمد عبد الحميد
تصبح الكتابة الاستشرافية عن مستقبل ما بعد الثورة أيقونة شديدة الفاعلية والدلالة. كما أنها قد تبدو غزيرة أمام غيرها من الاتجاهات؛ لا لأنها تلعب دور مواكبة الأحداث التي يمر بها المجتمع والتنبؤ بما بعدها فحسب، بل لأنها في مجملها تثبت علاقة جديدة بين المفكرين والشباب والروائيين بكل ما تحمله الكتابة من خلفيات، وتدعم قدرتهم على انتقاد السلطة والمشاركة في القرار السياسي والمجتمعي. ربما كانت هذه التصورات المأمولة عن الكتابة تتمثلها اليوتوبيا بصفة خاصة؛ إذ تستطيع أن ترسم مشروعًا ينبئ بوعي مستقبلي وشجاعة متاخمة السلطة في تصوراتها عن مستقبل هذا الوطن والذي من المأمول له بعد هذا النضال الثوري والأرواح المزهقة أن يحظى بمستقبل أفضل، وهنا يمكن الإشارة إلى العلاقة الضرورية بين ازدهار الكتابة اليوتوبية، وفترات التغيرات العلمية والسياسية. الشرط المهم لإحراز الروح التفاؤلية بالارتباط بهذه التغيرات، هو الرغبة المتمركزة حول الذات، في تناول التاريخ بوصفه ظاهرة معرفية ويمكن التحكم بها
يأتي عدد من الكتابات الروائية كغيرها من الكتابات؛ ليتبنى مشروعا مستقبليا، لكن ليس من الضرورة أن تثمر أحداث الثورات وتبعاتها مستقبلا قابلا للتشكل وفق قواعد من إحقاق العدل؛ حيث يكمن السبب في واقع ما بعد الثورة و “الرؤية” التي يتصورها الكاتب لهذا المستقبل. قد تصبح الكتابة عن يوتوبيا القيم والمشروع مرحلية، وقد تتوازى مع ديستوبيا المأساة.
ربما لا تحمل الديستوبيا ذلك الوجه القبيح من الخيبات وحده؛ إذ إن حضور الفساد متجسدا ثم متفشيا ومكررا في أيقونات متوغلة؛ يجعلنا نتصور غيابه. أي أننا نستدعي من جديد الحلم اليوتوبي الغائب. يمكن للمرء أن يرى، مبدئيا، فكر نقيض اليوتوبيا بوصفه تحولا معاصرا للخطاب اليوتوبي أكثر منه نهاية له. إنه تحول ضمن الجنس نفسه من الموقف الإيجابي إلى السلبي. هذا التحول الذي لا ينفي قابلية تحقيق مشروع يوتوبي أو تصور تحققه وبالتالي الدفع لمد ثوري جديد بين الحين والآخر . …. ونخلص من ذلك الجدل بفكرة أنه مهما كان الفكر المناقض لليوتوبيا مبررًا، فلا يمكن عده نهاية لليوتوبيا، شريطة أن تكون الروح المتقدة لليوتوبيا من أجل تقليل الفجوة بين الحقيقي والمثالي) قابلة بمعنى ما في أي لحظة، للتراجع والخضوع لليأس، عند ذلك نفهم الديستوبيا جيدا على أنها تحول اليوتوبيا إلى الطرف المعاكس .
.
اكتسبت لفظة “الثائر ” مدلولا وطنيا يحمل من الشجاعة والانتصار للحق ما يبجل من يوصف به، كما طبعت كلمة “الثوار” – في تداولها الأول – استشرافا الأمال عريضة؛ فقد يسعى حاملو هذا اللقب إلى سيادة العدل والمساواة في سياق ثوري داعم لمطالبهم. وقد أثر حدث الثورة على فئات عديدة من المجتمع، فأتاح لهم فرصة للتعبير عن أزماتهم ومخاوفهم ومطالبهم، كسرت الثورة حاجز الخوف عن التعبير واستقطبت عدة فئات للمشاركة فيها خاصة بعد الأيام الأولى التي أربكت النظام، ومثلت دليلا عمليا على قوة تأثير الشارع على القرار السياسي عبرت شخصيات رواية باب الخروج عن بعض التحولات التي طرأت عليها بعد الثورة، وكيف زجت بها الأحداث إلى “الحضور” بالتأييد أو المشاركة في الفعل الثوري، وإنني أرصد بعض الفئات المشاركة فيه، في محاولة لفهم مواقفها من الثورة بما في ذلك أهدافها وتحولاتها عنها وبالتالي فهم الرؤية التي تتبناها رواية الديستوبيا للثائر. طبقات متباينة وثورة واحدة عرضت رواية باب الخروج مساحة لتعميق الفارق الطبقي بين المجتمع الواحد؛ إذ قد تجمع الوظيفة بين فئات اجتماعية متنوعة إلا أن مثل هذا النوع من التلاقي الطبقي لا يدفع بالضرورة إلى اندماج أفراد الطبقات المتباينة أو قبول كل منهم للآخر. يتعرف علي شكري” المترجم بمؤسسة الرئاسة إلى “عفاف” الموظفة البسيطة التي تعاني وأسرتها احتياجا ماديًا وتمثل وظيفتها مصدرا مهما لتماسكها الاجتماعي يتقرب “علي” من “عفاف” فيستعرض كل منهما عالمه فيكتشف أنه …. إلى أي مدى كانت قصتي قصيرة وغير مثيرة (…) أذهلتني بعالمها الذي لم أكن أعرف عنه شيئا، تقريبا.”
قد تحتك طبقات عليا بأخرى فقيرة؛ إلا أن معرفة أحوال فقراء المجتمع ممن يعانون في حياتهم لا يعني بالضرورة تضامن الطبقات الأعلى معهم، بل نجد أن الديستوبيا تركز على فضح العلاقة التي تنشأ بين طرفين يجهل كل منهما عالم الآخر . تبدأ هذه المعرفة بإضفاء نوع من التغاضي والتعامي عن طريق تبرير الطبقات الغنية لحال الفقراء بأنهم لا يريدون التخلي عن حالهم طوعا، وأنهم لا يستوعبون سوى الوعي القائم الآني لحالهم دون أن يعبأوا بإدراك وعي ممكن يبدل حال الفقر إلى ثراء ركز علي” على ضحك عفاف وسخريتها من عالمها المأساوي، متغاضيا عن المعاناة التي تسردها في ضحك كالبكاء” ؛ يقول : لم أعرف ماذا أقول ولا كيف أرد لم تحك لي كل هذه الأمور الشخصية؟ وكيف تحكيها بهذه البساطة؟ لم يبد عليها أنها متأثرة أو تشعر بأن هذه الحياة معاناة من نوع خاص، بل على العكس، كانت تضحك وسط القصة على نفسها وأهلها وأحوالهم. أما أنا فلم أعرف أحدا مثلها من قبل (باب الخروج، ص 68-69)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاطع من الدارسة .. الصادرة مؤخرًا عن دار صفصافة 2025