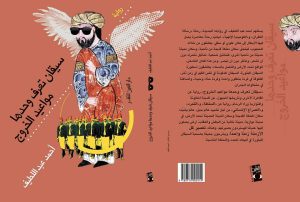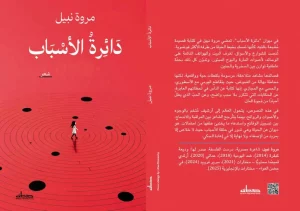د.مروة تميم
في حوارٍ نُشر في الجريدة الكويتية في 12 سبتمبر 2019، قال السنعوسي: “كُنت وما زلتُ أكتب عملاً روائيًا في الحاضرة البحرية القديمة… عملاً لا أريد أن انتهي من كتابته، لشدة تعلقي بعوالمه وشخوصه وزمنه ومكانه”، وبعد أربع سنوات صدر الجزئين الأول والثاني من هذا العمل الروائي “أسفار مدينة الطين”، وانتقل تعلق سعود بهذا العالم وشخوصه إلى قرائه في كل مكان، وأنا منهم، وكنت انتظر ثالث الأسفار بصبرٍ نافذ، لا لأعرف حلول الأحجيات التي أوقعنا الشايب في حبائلها، فهذا أمره هَيِّن وتطوَع كاتب الأسفار، دون أن يدري، بكشف مفاتيح حلول تلك الأحجيات كلها فيما كتبه في السِفرين الأول والثاني. بالطبع كنت متشوقة للتأكد من صحة ما خمنته، ولكن كان الشوق أكبر لمعرفة الكيفية التي سيقدم بها سعود حلول تلك الأحجيات، وكيف سيُجيد حَبك قصته ليصل للحقيقة التي عرفتها مع قراءة السفرين السابقين، وكيف سيغطي أحداث سبعين عامًا ليربط ماضي الديرة “زمن مدينة الطين والحاضرة البحرية”، وحاضرها “زمن كتابة الأسفار”؟
كنت أعرف من هو الشايب ومن هو غايب، وأعرف ماذا حل بالرضيعين “ابن الحلال وابن الحرام” بعد أن توهم الجميع موتهما، أعرف ما مصير كل واحدٍ منهما ومَن أصبح في كهولته، أعرف حقيقة كاتب الأسفار الذي لا يعرف حقيقته، أعرف من هو والد رضيع فردوس ومَن التي أخذت سيف بن سليمان، أعرف كل هذا ومع ذلك كنت انتظر على أحر من الجمر كيف سيكتب سعود هذه الحقائق، وكيف سيصل إلى حل للمشكلات التي وضع نفسه بها؟ كيف سيفُك كل هذه الخيوط المتشابكة ويقدم لي رواية مُقنِعة تتناسب مع سقف التوقعات العالي الذي مَهَّد له طوال السِفرين الأول والثاني؟
والحقيقة أن سعود كان على قدر التحدي، ونجح في تقديم سِفر فاق كل توقعاتي. كنت أراه يقف في زاوية كل صفحة اقرأها مبتسمًا ويقول: تحسبين أنكِ كشفتِ ألاعيبي وتوصلتِ لمفاتيح الرواية؟ حسنًا، تعالِ للعبة جديدة أَدُس لكِ فيها مفاتيح زائفة، فهل تبتلعين الطُعم؟
من الصفحات الأولى في مسودة السِفر غير المنشور، وبعد كشف بو حَدَب لكيفية تحقيق الصاجة أم صنقور لأمنيات سليمان الثلاث، صحت بابتسامة كبيرة: “يا ابن اللذينا! هو ده سعود اللي أنا عارفاه”.
ومع كل فصل جديد يتجدد الصياح؛ مرات من الدهشة والمفاجأة بالأحداث، ومراتٍ من الفزع والخوف على شخصياتٍ أحببتها وكتب لها بو حَدَب نهاياتٍ لا تستحقها، ومراتٍ من الفرح بنجاة أحبائي من المصائر العبثية التي كتبها لهم. وفي كل المرات كان إعجابي يتزايد بالجميل الذي ما راهنت عليه وخذلني أبدًا… وارث لغة البحر: سعود السنعوسي.
– تساؤلات حول الكتابة الروائية:
في سِفر العَنْفُوُز أصبح صادق بو حَدَب جزءًا من الرواية بشخصه، لا بصفته كاتب الأسفار فقط، ومن خلال تورطه بما يكتبه ناقش سعود السنعوسي الكثير من الموضوعات المتعلقة بالكتابة الروائية، وكأنه يدخلنا معه إلى عوالم ما وراء الكتابة “كواليسها”، ويطرح التساؤلات المؤرِّقة له ككاتب، فنجده يتحدث عن ماهية الكتابة وجدواها، والعلاقة بينها وبين الخيال، كما يسميه صادق، أو السِّحر، كما يسميه الشايب.
منذ الصفحات الأولى يضعنا سعود أمام خوف الكاتب من تورطه بكتابة ما يتخيله، فيصير حقيقة: “صرت أخاف أن أكتب الشيء فيصير حقيقة.. كأنما أقول له صِرْ فيصير، مثل معجزة لا تُصدَّق إلا في رواية فنتازية”.
وعلى مدار صفحات مسودة السِفر الذي لم يُنشر، يأخذنا الكاتب معه في رحلة بحثه عن ماهية ما يكتبه متأرجحًا بين ثنائية “الحقيقة”/ “الخيال أو السِّحر”، ويبدأ بسؤاله لنفسه: “ما الحقيقة في ما كتبتُ يا حقيقة، ما الخيال؟”.
والحقيقة أن هذا السؤال يؤرق سعود حتى من قبل أن يعُلن عن نفسه كروائي، ويُصدِر روايته الأولى؛ ففي مقاله “على متن الكتاب.. تجاوز حدود المكان والزمان” المنشور بمجلة أبواب في إبريل 2009 يقول: “أتساءل أحيانًا حين أقف أمام مكتبتي، أيعقل بأن بعض الشخصيات والأماكن التي قرأت عنها لا وجود لها على أرض الواقع؟ تلك الصفات التي تحملها بعض الشخصيات والطباع والملامح والمعاناة، تلك الأماكن والأشجار والغيوم والطرقات، كل ذلك من صُنع المؤلف؟”
وفي سِفر العَنْفُوُز تتردد أصداء هذا السؤال، سواء في حوارات الكاتب مع نفسه: “ما الخيالُ وما الحقيقة في هذه المسوَّدةِ يا كاتب الأسفار؟” أو في أحاديثه مع الشايب، بعد أن أوشك أن يفقد صوابه في اللعبة التي ارتضاها منذ البداية، ولكنه بعد أربع سنوات من كتابة ما يُمليه عليه الشايب، ثم مع ما حدث مع بداية السِفر الثالث واختلاط الحقيقة بالخيال في ذهنه، يدور بينه وبين الشايب حوار قصير كاشف:
“قلت لي كل ما صار في الماضي.. هذا مفهوم.. لكن كيف تعرف الذي اليوم يصير؟
– سِحر. ألا تؤمن بالسِّحر؟ وكيف تكتب ما لا تؤمن به؟
= هذا خيال.
– ما تُسميه الخيال أُسميه السِّحر.. والسِّحر هو الخيال الذي إن صدَّقته يصير”.
هنا يقدم سعود رؤيته الخاصة للكتابة الروائية التي قال في مقاله “الفتى الذي يكتب اللاشيء2-2”، المنشور بمجلة زهرة الخليج بتاريخ 16 نوفمبر 2018، أنه عن طريقها “يُثبت أن كل ما في هذا العالم زيف إلا ما همست به جدته قبيل نومه طفلاً”، وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة السادسة عشر من مهرجان طيران الإمارات للآداب في 31 يناير 2024 يقول: “الحقيقة أن أكاذيب الرواية المتمثلةِ بالخيال إنما هي مجازٌ وطريقٌ يُفضي بالضرورة إلى الحقيقة التي ينشدها الإنسان… والرواية بصفتها جوهر الحياة مُختزَلاً بين دفتي كتاب.. تقدم لك الحقائق، وإن بالخيال، لكنها حقائق مشفوعةٌ بعاطفةٍ وحسٍ إنساني”.
وهو ما أكد عليه صادق بو حَدَب في حواره المفترض مع القاصة الشابة ليلى العثمان في جريدة القبس بتاريخ 21 يونيو 1978 بأن: “الخيال رغم تماديه فإنما هو يؤدي إلى الحقيقة بصورة أو بأخرى”.
وإمعانًا في الخيال تدور على صفحات هذا السِفر حوارات عابرة للزمن عن الكتابة بين صادق بوحَدَب والطبيبة إلينور، بين كاتبٍ يؤمن بالخيال سبيلاً للحقيقة، وطبيبة لا تُقَدِّر الخيال حق قدره ولا تؤمن إلا بما يصدقه العقل، أو هكذا كانت تظن، فكما يقول لها بوحَدَب: “الكل يسمع الحقيقة، وأنتِ تسمعين. ولا أحد يكتب الحقيقة، ولا أنتِ تكتبين”.
ورغم أنهما يتشاركان الخوف والحيرة إزاء ما يجري في الديرة، إلا أن كتابتهما جاءت واحدتها على العكس من الأخرى، بل والأكثر أنها جاءت على العكس من قناعات صاحبها أحيانًا؛ فكاتب الأسفار يكتب بحثًا عن الحقيقة، في حين أن الطبيبة تكتب لإخفاءها! ويورد سعود تلك المقابلة في عباراتٍ ساحرة، يفتتحها مُقسِّمًا بمفرداتٍ تدور في فلك “الكتابة”: “أُقسِم بالقلم، وبمن علَّم بالقلم.. أُقسِم بالخيال، وبربِّ الخيال.. أُقسِم بالكلمة، وبربِّ الكلمة.. أُقسِم بالحروف، وبربِّ الحروف أني كابوسك الأبدي ما لم تقولي الحقيقة. غادري فراشك واهبطي إلى حجرة المكتب. واعزفي على أزرار آلتك الكاتبة فكلانا خائفٌ لا يفهم. كلانا حائرٌ لا يغفو من الليل ساعة. وكلانا يقضُّ مضجع الآخر بالكتابة على مبعدة سبعة عقود. أحدٌ يكتب ليجتثَّ الحقيقة من حُفرةٍ سحيقة، وأخرى تنقرُ على أزرار الآلة الكاتبة لتُهيلَ على الحُفرةِ التراب”.
ويظل بوحَدَب يقضُّ ليالي إلينور بوساوس كاتب الأسفار، وزعزعته لمعتقداتها وأنها يجب أن تدع آلتها الكاتبة تقول ما تصدِّقه، وأن “ما تسميه الخرافة يجيء بالعجب”، وحين يجدها مستمرة في أكاذيبها، يفرد صفحاتٍ لما ترويه ثم يقوم بإعادة ما كتبته في مقابلةٍ جديدة بين “مذكرات إلينور” التي يعتبرها البعض، أو ربما الكثير، حقائق تاريخية، وبين ما أغفلته تلك المذكرات تحت زعم البُعد عن الخرافة. وفي عبارةٍ ساخرة يحذر صادق إلينور من عواقب كذبها: “أقسم بالخيال وبرب الخيال إنكِ تُصدِّقين.. وأنا أحذرك يا طبيبة.. لا تُباريني في الخيال.. ولا تلعبي مع كاتب الأسفار الذي منذ سنين يلعب مع أُم حَدَب”.
إن تكرار مفردات “اللعب” عند الحديث عن الكتابة لا تأتي عبثًا، بل هي جوهر ما يؤمن به سعود، فالكتابة عنده “لعبة” يدخلها، كما يقول في مقاله “المحترم في كل مكان..إلا!”، المنشور في مجلة زهرة الخليج بتاريخ 25 نوفمبر 2018: “متحررًا من كل شيء إلا إيمانه بأنه كاتب وحسب، لا ينتمي إلى شيء إلا عالم الكتابة والخيال”، كل رواية يكتبها هي مغامرة جديدة يبدأها بعد إعدادٍ وقراءة ومعايشة، ثم يترك قلمه/خياله يتفاعل مع شخصيات العمل وأحداثه، يلعب معها وربما بها، فالكتابة كما قال عنها بصفحته على “فيسبوك” بتاريخ 8 إبريل 2014، لا تكون إلا حين يجهل ما سيحدث في الصفحة المقبلة، أما عدا ذلك فما هو إلا مجرد تفريغ ذهني!
وعلى مدار صفحات السِفر الثالث يُجسد سعود أكبر مخاوفه ككاتب: النسيان/الخرَف؛ يبدو صادق متشككًا في ذاكرته رغم احتفاظها بكل شيء! يكتب لكي لا يَنسى ولا يُنسى، يخشى فقدان صوابه وأن تأخذ كتابة الخيال عقله: “لِمَ أنت هُنا يُناوشك النسيان وما يُشبه الخَرَف؟”، “هذه الكتابة سوف تُفقدك عقلك يا بو حَدَب”، “اكتب خشية أن أخرف ذات يوم وأنسى نفسي وأضيع فيما أكتب فلا أعرف ما الحقيقة وما الخيال”. إلى أن يصل- سعود- إلى هاجسه الأكبر، وهو أن يجد نفسه كصادق بو حَدَب وهو على مشارف السبعين من عمره: “كاتبًا على حافة الجنون يُطارد الوهم، أفرطَ في كتابة الخيال فابتلعته أوراق خياله”.
هل أوجد سعود علاجًا لمخاوفه تلك؟ لم يقدم إجابات قطعية، وإنما كعادته، طرح المخاوف التي تؤرقه، وقدمها بصورةٍ حية عشناها مع صادق وكتابته اللحظية لأحداث رواية تدور بينما يكتب/نقرأ، لا نعرف حدًا فاصلاً بين الحقيقي والمُتخيَّل فيها، وحتى ما حاول صادق طمأنة نفسه به حين قال: “اطمئن أيها الكاتب الذي ابتلعته الكتابة. سوف يعود إليك عقلك. اِمضِ في الكتابة وحسب، فكل هذا سوف ينتهي”. لم يجعله حلاً قاطعًا وختم سِفره بـ“مَن يكتبُ سِفرَ المُوُلاف؟” وكأنه يخبرنا أن الكتابة وحدها هي المأزق والخلاص في الوقت نفسه.
– الرواية والتاريخ:
كثيرة هي الروايات التي يتم تصنيفها كرواية “تاريخية”، دون الأخذ في الاعتبار أن كل رواية هي بشكلٍ أو بأخر “رواية تاريخية”؛ فالرواية ما أن تتم كتابتها تُصبح “تاريخًا”. ويخلط البعض بين التعامل مع الرواية- أي رواية- كمصدر للتاريخ، وبين كونها “تاريخًا”؛ فالمؤرخ حين يرجع للرواية يجب أن يتعامل معها كنصٍ أدبي يمكن من خلاله أن يرى ما لم تسجله الكتابات التاريخية الجافة، لا أن يحاكمها ويراجع أحداثها وشخوصها ومدى مطابقتها لوقائع التاريخ.
هذه النقطة التي انتبه لها سعود منذ صفحة الإهداء في السِفر الأول، والكلمة التي وجهها صادق بو حَدَب إلى “حُرَّاس الغُبار؛ دهاقِنةَ المعرفةِ أساطين التُّراث، الغيارى حُرَّاس التَّقاليد، عَسس الماضي، وحمَلَة أختام التَّاريخ.. هذا النَّص بأحداثه وأسمائه- وبطبيعة حاله- لا يعدو كونه رواية؛ نتخيَّل بها التاريخ ولا نكتبه“. وبعبارته الأخيرة يرد سعود على من يحاكمون الرواية، بل ويحاكمون حتى الكتابات التاريخية غير الممهورة بأختامهم! فهو يؤكد أن ما سيُكتبه في الصفحات المقبلة هو “تخيل” لما قد يكون حدث في الماضي، وهذا ما تراه بعض مدارس التاريخ الجديدة التي تقول أنه لا توجد رؤية أُحادية للتاريخ، وأن ما يكتبه المؤرخون هو “وجهة نظر” لما حدث، وأن الحدث الواحد له عدة أوجه ويمكن التعبير عنه بأكثر من سردية تاريخية.
وفي السِفر الثالث يقدم سعود نموذجًا لما يمكن أن يستفاده دارس التاريخ من قراءة الرواية، أي رواية، وبسلاسة آسِرة يوضح الفرق بين كتابة التاريخ وكتابة الرواية/الخيال، وحتى في كتابة التاريخ نفسها يتطرق لمسألة التاريخ “الرسمي” والتاريخ “غير الرسمي”، واختلاف المرويات التاريخية حول الحدث الواحد باختلاف “هوية” الراوي؛ فنجد صادق بو حَدَب عند حديثه عن معركة الجهراء، لم يصِف تفاصيل المعركة ولا أحداثها وإنما مهد لكتابته عنها بقوله: “ودُوِّن كثيرٌ وقيل أكثر. وسُطِرَ في الكُتُب ما تسطَّر، فيها الحقيقةُ وما تأسْطَر. وكتبت الكويتُ وكَتبت نجدٌ وكتب الإنكليز مروياتهم. وما ذُكِرَ في كتابٍ ولا نُطِقَ على شِفاهٍ ما يقول كاتبُ الأسفار في مرويته..”
وفي تفريقه بين ما تضمنته كتب التاريخ، وما تتضمنه أسفار مدينة الطين، يؤكد بو حَدَب بعباراتٍ مسجوعة على أن ما يروِّه هو “تخيُّل للتاريخ لا كتابة له”؛ “دُوِّن كثيرٌ وقيل أكثر، والخيالُ في دروب التَّاريخ يتبختر، وسطَّرت الكُتب ما صار وما لم يصِر، وما جاء أحدٌ على ذِكر… ولا مرَّ سطرٌ في هامش كتابٍ يُشير إلى… ولا ذُكِر ضمن مشاهير الشهداء…”
هكذا أورد كاتب الأسفار مرويته الخاصة لمعركة الجهراء، موضحًا فيها مآل شخصياته دون سردٍ جاف لأحداث المعركة، ولا تعدٍّ على حقائق التاريخ. وكأنه يعطي درسًا لكل من أراد أن يكتب رواية يكون التاريخ خلفية لأحداثها، فما عليه إلا تنفيذ وصية بو حَدَب لإلينور في حواره العابر للزمن معها: “اتركي تاريخ السَّاسة والحُكَّام فإن له من يدوِّنوه ويُبروِزوه بإطاراتٍ من ذهب، وإنما جئت إلى الكويت يا طبيبة- بأمر الله وإرادته على ما تقولين- من أجلِ النَّاس فاكتبي عنهم”. وهو ما طبقه في أسفاره حتى عند كتابته لحقيقة تاريخية وهي لجوء الشيخ سالم لطلب المساعدة من الإنجليز؛ فكُتب التاريخ تذكر أن الشيخ أرسل رسالة للميجور مور يطلب فيها مساعدته، وقد تضع نص الرسالة كوثيقة تاريخية، ولكن ما قدمه كاتب الأسفار هو ما أغفلته تلك الكتب، وهو حالة الشيخ سالم وقت إملائه هذه الرسالة للمُلاَّ صالح سكرتير الحكومة، تحت ضغط التجار والوجهاء، وخاصةً في ختام الرسالة وهو ما صوره بو حَدَب بأروع الكلمات: “لمعت عينا الحاكم وهو ينظر إلى بِن حامد والتجار، وارتعشت شفتاه قبل أن يُفضي بختام الرِّسالة على ما لا يشتهي”.
وفي مكالمة بو حَدَب وفياصل حول “حُراس التاريخ” من “لا يسمحون لأحد أن يتحرَّش بالتاريخ أو يعبث به”، سواء في فيلم سينمائي “بس يا بحر” مثلاً، أو مسرحية مثل “هذا سيفُوُهْ”، أو رواية كما حدث من منع للجزئين الأول والثاني من أسفار مدينة الطين. نجد صادق يدافع عن كتابته بأنها “خيال” وما تعرضت له من تاريخ فهو مثبوت بكتاب الفقيه الرشيد “تاريخ الكويت” الموجود بالمكتبات ويُباع دون اعتراض من الحكومة. فكان رد فياصل بأنه حتى هذا التاريخ الذي يستند إليه لا يعدو كونه “تاريخ غير رسمي” و“غير معترف به”، فطبعتي الكتاب المذكور كانتا بالخارج، ولم تتبنى الحكومة طباعته محليًا رغم مرور أكثر من أربعين عامًا على امتلاك الحكومة لمطابع رسمية!
لا يقدم السنعوسي في أسفاره صورًا من تاريخ الكويت في ماضيها البعيد في 1920، ولا القريب في 1990 فحسب، بل يقدم لنا سجلاً حيًا لملامح من تاريخها المعاصر في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، وهذا يقودنا بالضرورة للحديث عن السبب “الحقيقي” – من وجهة نظري- لكتابة هذه الأسفار.
– “الشَّمسُ تخذلُ وردتها”:
هل يوجد أصدق من هذا العنوان، الذي وضعه بو حَدَب للفصل الحادي والستين في مسودة سِفر العَنْفُوُز، للحديث عن سبب كتابة سعود، في رأيي، لأسفار مدينة الطين؟ لنبدأ الحكاية.
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان الصبي المفتون بالكتاب، حتى من قبل أن يعرف قراءة حروفه، يستعجل مرور الأيام ليبدأ يومه الدراسي الأول ويحصل على كتابه الخاص ويقرأ به الجملة التي بدأت بها كتب من سبقوه من أطفال العائلة وزادته حبًا في الكتاب: “مع حمد قلم”، ولكن وزارة التعليم كان لها رأي أخر وصدمته بتغيير المناهج التعليمية، فأصبح درسه الأول: “أنا أكل وأشرب لأعيش وأكبر”! خذلانٌ أول ترك في نفس الصبي مرارة ربما لا تزال بقاياها للآن.
بدأ الصبي يتهجى حروف كتابه الجديد، وقبل أن يُكمِل عامه العاشر جاءه الخذلان من الجار القريب، فغادر بيته في “رحلة” مع العائلة لأسبوعين ويرجع، كما كان يخبره والده في كل مرة يسأله فيها: “متى نعود؟” فتتجدد الإجابة ويتجدد الأسبوعان حتى أصبحا ثمانية أشهر! وبعيدًا عن بيته العُوُد اشترى دفتره الأول وبدأ رحلته مع الكتابة عن محبوبته وبطلة كل كتاباته “الكويت”.
عاد الصبي لبيته، وكَبُر ولم ينسى أبدًا حمد ولا قلمه، خرجت كلماته من دفاتره الصغيرة، فصار ينشر في المنتديات الأدبية على الإنترنت، ثم في الصحف والمجلات المحلية، حتى شارف الثلاثين من عمره، فنشر روايته الأولى “سجين المرايا” عام 2010، وفازت بجائزة ليلى العثمان في عام صدورها، وشجعه حسن استقبال الرواية، وما تلقاه من نقدٍ عليها، على البدء بكتابة روايته الثانية “ساق البامبو”، ونشرها في عام 2012، وهذه المرة تكافئه محبوبته “الكويت” بجائزتها التشجيعية في الرواية في العام نفسه، وتحتفي به الأوساط الثقافية هناك، ويزيد من فرحته ترشح الرواية لجائزة البوكر العربية ووصولها للقائمة الطويلة، ثم القصيرة، فالإعلان عن فوزها في إبريل 2013. لم تكن فرحته بالفوز شخصية وإنما كانت فرحته الأكبر لوصول “الكويت” لمكانة هي جديرة بها، ولأنه السبب فيها؛ فبعد شهرين من إعلان فوزه حَلَّ سعود ضيفًا على ديوانية جريدة “الوطن” وفي حديثه عن الفوز قال: “حين سافرت الى إعلان الجائزة في أبو ظبي كنت في نفسية محطمة بسبب الأوضاع السياسية المتردية في البلاد، فكل الأطراف تفتقد إلى الحكمة وأصبح النقد مشوبًا بالكراهية، ونحن تعودنا من الكويتي فيما مضى أن ينتقد الكويتي بحب. حاليًا أشك أننا نحب بعضنا كما الماضي. هناك كنت مضطربًا، عين على الكويت وعين على نتائج البوكر، لم أكن أدري كيف تسير الأوضاع في بلدي، وربما ارتحت قليلاً لأنني قطعت الانترنت. لكن في اليوم الأخير عندما رأيت الأقطاب المتنافرة تتفق أن تفرح لفوزي شعرت بسعادة غامرة، وأسعدني أكثر أن أكون أنا السبب. لو أن أي إنسان أدخل السرور لقلوب أهل الكويت كنت سأقبله على رأسه وأقول له «جبت لنا الفرح» فما بالكم وأنا من أدخل هذا الفرح، تلقيت التهاني والتبريكات على جميع المستويات ورغم الفرح شعرت بشيء من حزن، فالناس ولهانة على الفرح، ومتحسرة على كويت الستينيات والسبعينيات خصوصًا المبدعين والفنانين والمثقفين، نحن شعب يليق بنا الفرح ولكن لا أدري ما الذي فعلناه بأنفسنا”.
انطلاقًا من هذا السؤال “ما الذي فعلناه بأنفسنا؟” وبعد تجربتين روائيتين حصدتا جوائز محلية وعربية/عالمية، والاحتفاء به بوصفه نموذجًا لما يجب أن يكون عليه الشباب لضمان مستقبل أفـضل يليق بالكويت. وجد الشاب المسكون بحب وطنه بعض المثالب التي تشوه وجه بلاده الذي يعرفه، وبات يتعجب وهو يرى بلاده التي عرفها حاضنة لكل غريب، ما بالها اليوم تُضيِّق على أبنائها؟!
تألم لمأساةٍ يشهدها تتفاقم وتكاد تبتلع بلدًا ما أحب سواه، لا زال هو نفسه الطفل الخائف الذي لا يجد مأمن إلا في كلماته، يداري بها خوفه، ويطلق صيحة تحذير علَّها تصادف آذانًا مُنصِتة. أطلق صيحته التحذيرية في روايته الثالثة بكل الحب لبلاده، شد خطًا عريضًا تحت كل ما يراه يُفَرق أبناء ديرته، ودون أي وعظٍ أو خطابة، قال ببساطة: هكذا كنا بالأمس القريب، وهذا هو حالنا اليوم، وذلك ما قد نصير إليه قريبًا إذا استمر الحال على ما هو عليه. وترك للقارئ حرية الاختيار.
فكيف كانت الاستجابة لتحذيره؟ لم يهنأ بإصداره إلا لسويعاتٍ قليلة، ثم تم سحب نسخ الرواية ومنعها من التداول، دون إبداء أسباب، ودون حتى الإفصاح عن أنها “ممنوعة”، هي “ليست ممنوعة” و”ليست مفسوحة”! حالة من الميوعة وانعدام المسئولية تُنذِر باقتراب المستقبل المظلم الذي تنبأت به الرواية.
ماذا يفعل الفتى ولا سلاح لديه إلا “قلمه”؟ كيف يواجه خصمًا “جاهل”، رغم شهاداته ووصوله لرئاسة أرفع الأماكن الأدبية؟ ماذا يملك إزاء “مسئول” لا يبالي لحنقه وسخطه ويرى فيما حدث “ترويجًا” للرواية؟!
يقول السنعوسي أنه بدأ في كتابة روايته “أسفار مدينة الطين” في يونيو 2015، وهي في تقديري واحدة من أصعب الفترات التي عاشها خلال تجربته الإبداعية؛ فجأة خلال بضعة أشهر، ألفى الفتى نفسه غريبًا وسط مكانٍ لا يُشبهه، هو لا يحب شيئًا قدر حبه لهذا الوطن، ولا يستطيع العيش خارجه، يحب أهله الذين عرفهم عبر حكايات جدته- التي تزامن فقده لها مع الأسابيع الأولى لمنع روايته ودوامة البحث عن أسباب هذا القرار- وعاصر أواخر ما بقي من أيامهم، كيف يمكنه العيش، فضلاً عن الإبداع، في مكانٍ كل ما فيه يقف ضده ويحطم أحلامه بجرة قلم؟ كان الوجع هو دافعه الأول للكتابة، وأي وجعٍ يمكن أن يشعر به من يعشق وطنه حد الجنون، أكثر من أن يرى هذا الوطن “مختطفًا، لا يشبه وطنًا يعرفه”، على حد قوله في مقاله “رسالة إلى من بيده الأمر” المنشور في الجريدة بتاريخ 13 أغسطس 2015؟
أظن أن فكرة “التبة” جاءت في هذه اللحظة، وأن أمنيات سليمان الثلاث ما هي إلا أمنيات سعود نفسه وقتها بشكلٍ ما: هو يحب الكويت ولا يقوى على مفارقتها، لكنه لا يريد رؤية من “يشوهون وجه الكويت الثقافي”، ويريد أن يعرف أبناء بلده وجه “الكويت” الحقيقي كما عرفه من حكايات جدته وأعمامه، وقراءاته في تاريخ بلده، وأن يترك رسالته لكل من ينظر للخليج على أنه ليس سوى نفط، كما أشار في ديوانية الوطن السابق الإشارة إليها : “أن بلاد النفط، تنتج ما هو أهم من النفط”. إنه لم يُرِد إلا أن “يمارس محبَّته لوطنه انتقاداً لكل ما يخدش صورته، لأنه لا يجيد الغناء مع الجوقة متشابهة الأفراد، ولأنه لا يعرف إلا أن يُشبه ذاته في مصنع النُّسخ المكررة”، كما قال في مقاله “مصنع النُّسخ المكررة” المنشور بمجلة زهرة الخليج بتاريخ 9 ديسمبر 2018.
لم يكن اختياره البحر وجهةً له في روايته الجديدة بالأمر الغريب، فهو الثابت الوحيد في عالم مُتغَيِّر، كما قال في مقاله “وارث لغة البحر”، المنشور بمجلة الأهرام العربي في فبراير 2015: “وحده البحرُ يشبه البحرَ في بلادي، مُذ كان ومُذ كانت. يطلُّ من الشرق، يحملُ الشمسَ فوق أمواجه كلَّ نهار، قبل أن تتلقَّفها الصحراء وتُغيِّبها في الطرف الآخر البعيد. وحده البحر ضدّ أي ثابتٍ صامتٍ متواطئ باستسلامه لنا، ضد أن نغيِّره وقتما شئنا. وحده بهدير موجه يصيُح بنا مذكِّرا بأنه لا يقبل إلا أن يكون البحر، مهما غيَّرنا الحياة وغيَّرتنا على ساحله”.
فكانت تبته إلى كويت الـ1920، زمن الحاضرة البحرية وكويت ما قبل النفط، ليروي حكايات “إنسان” مدينة الطين، بمختلف انتماءاته العرقية والدينية والسياسية وحتى الجنسية. ثم يغوص في تبةٍ أخرى إلى كويت الـ1990 ليرصد مآلات هذا الإنسان قبيل الاحتلال العراقي للكويت، وكأنه بهذه المقابلة يضعنا أمام مرآة تتجسد فيها صورة كويت 2015 وقت بداية كتابته للرواية، ويبدو ذلك واضحًا في تكرار الحديث عن الشمس في الثلاثية بدايةً من السِفر الأول واختيار أسطورة العباءة لتكون عنوانًا له، وما تحكيه الصاجة أم حَدَب عن قدرة من يمتلك هذه العباءة على “حجب مدينة عن عين الشمس”، ثم الشمس ومحوريتها في سِفر العَنْفُوُز، سواء في ضيق سليمان بشمس كويت الـ90 الباهتة المنطفئة أو كما قال عنها “شبه شمس”، مقابل عدم احتمال غايب لشمس الديرة الساطعة التي لم يشهد مثلها في حياته قط!
كذلك الاختيار البديع لعنوان الفصل الثامن والخمسين: “كسوفٌ إلا قليل” والاقتباس من سِفر التبة في مدخله: “ولو وقعت في أيديهم. تخيَّل!”، والذي يتكامل مع مضمون الفصل ليرصد رؤية سعود لحال الكويت بعدما حُجِبَت شمسها بفعل عباءة الرقابة بكافة أشكالها، ويبدأ الفصل بسؤال سليمان لنفسه: “كيف يألف الناسُ شمسًا كهذه، لا وهج ولا دفء، ولِمَ أكثرهم يرتدي النظارات السود تحت شمسٍ تُشرق آفلة، مثلما تغرُب على وعدِ شروقٍ يُشبه الأُفول؟ّ!” حتى أنه يصفها: “ديرة الشمس المنطفئة هذه”. ولعل إجابة سؤال سليمان فيما كتبه سعود نفسه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي في 21 اغسطس 2017، حين وضع صورة تضم بعض أعلام كويت الماضي مصحوبة بتعليق: “ينظُر إلى إشراقة أمس بلاده.. يقول مُهوِّنًا: “من خلف ما مات”.. يقول آخر: لم يَمُت ولكنه، في الجوِّ الخانق، لا يُنجِب إلا الخُدَّج!”.
– الكويت قبيل الغزو:
عند قراءة سِفري العباءة والتبة، توقعت أن يكون للغزو مكانًا في السِفر الثالث، وفقًا لتاريخ كتابة بو حَدَب للصفحات الهاربة من مذكراته “ذخيرة أيام الخرف”. ولكن سعود كان واعيًا بما فيه الكفاية وخالف توقعاتي واكتفى بإشارات مهمة ودالة للكويت في الشهر الأخير قبل الغزو العراقي، وهذا ذكاء شديد وبراعة من كاتب قدم شهادته عن أحداث هذا الغزو في رواية كتكوت “إرث النار” المتضمنة في “فئران أمي حصة”، وكما قال في عدد من لقاءاته لمناقشة سِفر العَنْفُوُز أنه توقف قبيل الغزو بيومين ومن أراد استكمال الأحداث عليه الرجوع لفئران أمي حصة، وكأنه بهذا يؤكد فكرة “التكامل” بين رواياته.
في سِفريّ العباءة والتبة قدم لنا صادق بو حَدَب، عبر المناوشات الذكية بينه وبين محرر وزارة الإعلام في الهوامش، وفي العبارات المطموسة في المتن، صورة لما يعانيه المبدع من الرقابة الرسمية، وفي إشاراته للشتائم والقضايا والاتهامات التي واجهها هو وفياصل المشيعل قدم معاناة المبدع مع الرقابة المجتمعية، وهي الأصعب في مجتمعاتنا العربية.
أما في سِفر العَنْفُوُز فيقدم بو حَدَب أحوال الكويت قبيل الغزو، بصورة شبه تفصيلية دون أن يكون ذلك مُقحمًا على الرواية، وإنما قدمه بسلاسة وبشكل تدريجي بدايةً من أواخر يونيو 90 زمن بداية أحداث هذا الجزء وحتى الأحد الأخير من يوليو قبل الغزو بثلاثة أيام. ومن الصفحات الأولى نرى جانب من “الحياة الليلية” لشباب هذا الزمن وسهراتهم على ساحل الخليج عند بوابة القرية التراثية، حيث يتعثر صادق بمخلفاتهم من علب المشروبات الغازية وزجاجات الكولونيا الرخيصة، ثم يحدثنا عيَّاد عن مداهمات الشرطة للساحل ليلاً للقبض على شاربي الكولونيا وشمَّامي صمغ الـ”باتكس”. وفي القرية نفسها، قرية يوم البحار، التي تم بنائها تخليدًا للتراث القديم وتاريخ الديرة، نجد أن الطلاب الصغار الذين رتبت لهم وزارة التربية والتعليم زيارات للقرية للتعرف على هذا التراث ومعرفة لمحات عن ماضيهم، يتركون كل هذا ويلتفون حول شبيه بطل المسلسل الأمريكي الشهير ليأخذوا الصور التذكارية معه!
وفي الصفحات الأولى أيضًا يظهر مبنى البرلمان، بشكله الشهير كخيمة أو شراع، والتعليق الذكي من سليمان بأن هذا المبنى “غير حقيقي” في إشارة إلى تأثره بدخان نارجيلة عيَّاد ولكن في الحقيقة هي إشارة ذكية للبرلمان المُعَطَّل وكأنه لا وجود له.
وفي رحلة البحث عن كاتب الأسفار بين أروقة المركز الوطني للثقافة والفنون والآداب، ذلك المبنى الذي تم افتتاحه قبل أحداث سِفر العَنْفُوُز بأيامٍ قليلة، ومبنى رابطة الأدباء، يقدم بو حَدَب مقارنة بين المبنيين من حيث فخامة البناء والشكل الخارجي، ثم يقدم صورة لأحوال الموظفين في الاثنين؛ فالمبنى الفخم ذو الطوابق والدهاليز واللوحات الفاخرة لم يكن المسئول المُراد سؤاله موجودًا بمكتبه “في باكر الصباح، ولا في منتصف ساعات العمل، ولا في آخرها”. أما المبني المتواضع متوسط الحجم كان رئيسه موجودًا، في فترة العمل المسائية، يقوم بمهامه!
وعدم تواجد الموظفين لم يكن قاصرًا على الأماكن الثقافية، فحتى المخفر لم يكن الضابط موجودًا في فترة مناوبته! ناهيك عن رحلة كاتب الأسفار في مكتب البريد بحثًا عن رسالة لم تصل، واستماعه للشكاوى المتعددة عن تأخُر البريد.
نحن أمام صورة بلد هذا حال أطفاله وشبابه ومسئوليه ثقافيًا وخدميًا، فهل كان وصف سليمان لبيت المصوقر هو وصف لهذا البلد وقتها: “البيت الغريب، يدخله الجديد، والقديم لا يخرج”؟ وقوله عن لاعبي البيبي فوت في صالة المنزل: “لا رؤوس لكم!” هل هو حكم بو حَدَب على أهل 1990؟ ربما.
وفي الثلث الأخير من السِفر يعرض بو حَدَب التطورات السريعة سياسيًا، بدايةً من سماعه في موجز الأخبار لمقتطفات من خطاب الرئيس العراقي في الذكرى الثانية والعشرين لثورة تموز، وتحذيره من التلاعب بأسعار النفط للتضييق على العراق، مرورًا بمانشيتات الجرائد عن بوادر الأزمة الخارجية بين الكويت والإمارات من جهة، والعراق من جهةٍ أخرى، وبمنتهى المهارة يقدم بو حَدَب الموقفين الأمريكي والبريطاني من هذه الأزمة، وكأنه يضعنا أمام صورة طبق الأصل لما حدث قبيل معركة القصر الأحمر في 1920، وموقف الكويت الثابت من “الاحتكام للعرب” ورفض التدخلات الدولية بين “الأشقاء”، وأن ما يحدث من خلاف ما هو إلا “سحابة صيف”!
– الولاء للأسطورة:
منذ البداية والأسطورة هي عِماد هذه الثلاثية، بدءًا من اختيار “العباءة” عنوانًا للسِفر الأول، وحتى “العَنْفُوُز” في عنوان السِفر الثالث، مرورًا بكم من الأساطير التي ترد في متن الأسفار الثلاثة، خاصةً في هوامش وملاحق السِفر الأول.
لكن ما يُحسب لسعود تأصيله لثلاث أساطير كانت تشغل بال الطفل الذي كانه، وهو يستمع لحكايات جدته أو للأغنيات الشعبية التي يحبها، فمن هُن الصَاجَّات؟ ومن هي أم السعف والليف؟ ومن هو الطَنْطَل؟ ظلت أسئلته هذه دون إجابة إلى أن قَرَّر هو إيجاد إجابة تُطفئ هذه الأسئلة، على حسب ما قاله في لقاءاتٍ عديدة حول الأسفار كان أخرها حواره مع الأستاذة نجوى بركات في برنامج “مطالعات” على تلفزيون العربي 2، الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
لن أخوض في تفاصيل تلك الأساطير ليستمتع بها من لم يقرأ الرواية، ولكن الملاحظة الواجب ذكرها أن سعود كتب هذه الأساطير لنفسه ليفهم أولاً، كما ذكر، ثم ليخبرنا أن الأسطورة أصلها أُناس مثلنا؛ فالصاجَّات مثلاً كُن من أهل مدينة الطين ويعملن بأسواقها، وكذا أم السعف والليف كانت واحدة من سكان المدينة والطنطل أيضًا، ولكن أهل مدينة الطين هم من نسجوا الشائعات واختلفوا حول تفاصيلها “فرجَّح الناس اللامعقول على المعقول وصدَّقوه”، فتحَوِّل هؤلاء الأناس العاديون إلى أساطير تتوارثها الأجيال.
وفي ملاحظة ذكية جدًا يشير سعود إلى تزايد تلك الشائعات في ظل غياب أي رد رسمي حولها، في حين تموت الأسطورة حين تُكَذَّب بشكلٍ رسمي، حتى وهي موجودة أمام الناس وشهدوا تفاصيلها كما تنبأت بها أم حَدَب، كما هو الحال مع “بودرياه” الذي انتهت أسطورته بمجرد أن صافحه المُلاَّ صالح سكرتير الحكومة أمام الناس على مقهى بوناشي!
لم يُكَذِّب سعود في روايته هذه الأساطير، ولم يؤكدها، وإنما تركها تثير الأسئلة في أذهان القراء، حتى بعد أن أوجَد لها أصل مُقنِع ومُحكَم، فبين السؤال عن كيفية تجاوز أم حَدَب لسور المدينة دون العبور من أبوابه، وغرق ابن الصَاجّة في تبته الأخيرة، تبقى الأسطورة حية بل ومُنقِذة في بعض الأحيان، كما أنقذت صيحة أم السعف والليف “فضة” قبل أن تُجيب سؤال النوخذا بن حامد.
– تكامل الأجناس الأدبية:
في هذا السِفر يُكمل سعود توظيف باقي الأجناس الأدبية في روايته؛ فنجده يُفسح مجالاً لفن المقال الصحفي في حوار صادق بوحَدَب مع القاصة الشابة ليلى العثمان، والمقابلات التليفزيونية كمقابلة كولمن الكويتي مع التليفزيون في قرية يوم البحَّار، والخبر الصحفي، وحتى إعلانات الوفيات بالجرائد.
ولا يخلو السِفر من إشارات للأغاني والموسيقى والسينما والمسرح، وحتى نشرات الأخبار الإذاعية التي تحتل مكانًا مهمًا ودالاً في صفحات هذا السِفر، فضلاً عن الرسائل والمذكرات.
– المرأة في أسفار مدينة الطين:
تشغل المرأة مكانًا خاصًا في كتابات سعود بدايةً من ريم/مريم في سجين المرايا، مرورًا بماما غنيمة وميرلا وخولة وهند وجوزافين في ساق البامبو، وأمي حصة وحوراء وفوزية والست الناظرة في فئران أمي حصة، وبصيرة وقطنة في حمام الدار، وصولاً إلى السرد بصوت امرأة في ناقة صالحة. وفي الأسفار يقدم لنا النماذج المختلفة للنساء في الديرة عبر زمنين: زمن الحاضرة البحرية، وزمن قبيل الغزو.
وقبل الدخول في تفاصيل هذه النماذج، تجدر الإشارة إلى الحوار الصحفي لصادق بو حَدَب مع “القاصة الشابة” ليلى العثمان، والذي لا يمكن قراءته بمعزل عن سعود نفسه وموقفه من الكتابة والمرأة والحياة بشكلٍ عام، فعند سؤال بو حدَب عن المرأة في حياته، أجاب أنها: “صاحبة الفضل في ما أنا عليه الآن. هي الرمز في ما أكتب، يتجلى فيها الوطن أحيانًا، أو الحُلم، أو الإنسان في ذروة عواطفه وتناقضاتها”. هنا وجدتني أتذكر شهادة سعود الروائية “ابن الزرزور”، التي ألقاها في الذكرى السنوية الأولى لمكتبة تكوين بتاريخ 21 إبريل 2017، حين قال على لسان جدته: “لم يسعفني بكائي على قول شيءٍ حين أشار صوبي يشكر من كانت دافعه ليصير كاتبًا، أشار إليَّ من فوق المسرح يضحك- يا عساها ضحكةً ما تنطفي، وزولٍ ما يختفي- قال: جدتي”، وتذكرت فوزية “كويت” كتكوت في فئران أمي حصة، وريم/مريم حُلم عبد العزيز في سجين المرايا، وماما غنيمة بقوتها وجبروتها في الظاهر، وضعفها وقلة حيلتها أمام عادات مجتمعها في ساق البامبو.
على أية حال، تعددت صور المرأة وحضورها في أسفار مدينة الطين، ويمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى ثلاثة أقسام: النساء الحرائر، العبدات/الإماء، الصاجَّات. وداخل كل قسم تتباين أطياف النساء وتتناقض في بعض الأحيان، ولا يعني انتماء شخصية ما لأحد هذه الأقسام أنها حبيسة هذا الإطار، بل تتداخل الانتماءات و”الهويات” النسوية إن جاز التعبير داخل الشخصية الواحدة. ومن خلال هذه الشخصيات يجعلنا سعود نتساءل حول مفاهيم مثل: “الحرية”، “التمرد”، “الانتماء”، “الإيمان”، “العيب”، “الحرام”، “الخير”، “الشر”؛ ففضة “الحرة” تبدو مكبلة بأغلال العادات والتقاليد، في حين تتحرك مبروكة “العبدة” بحرية حتى من قبل التحاقها بمستشفى الإرسالية. وبنات حمدية “حرائر” ظاهريًا، لكنهن لا يملكن الحياة التي تنعم بها بخيتة السوداء أو وردة أو مبروكة “العبدات”. والصاجة أم اللَّوْه من تدبر المكائد وفرقت بين سليمان وزوجته وولده لا يمكن أن نراها نموذج للشر الخالص، فهي نفسها من “طارت” لتحفيز سند بن هولين وقبيلته لنجدة الديرة في معركة القصر الأحمر، وفي المقابل تقف “شريفة” التي تملك كل شيء ومع ذلك تشتهي ما بيد فضة وتبذل المال والحيلة في سبيل نيله، فيمكننا التعاطف مع أم حدَب رغم كل أفاعيلها السوداء، وحتى فردوس “ابنة الحرام” يمكن التعاطف معها، لكن شريفة “الحرة/ بنت الحلال”- رغم محاولات بو حَدب إيجاد أعذارٍ لها في حديثها مع نفسها- لا يمكننا التعاطف معها خاصةً بعد جملتها الأخيرة التي حسمت كل شيء: “لا نلتِ ولا نالت فضة”. وبهيجة وفردوس من تمردتا على قوانين حمدية، فكان نصيب الأولى إدمان الضرب والإهانة، وخسرت الثانية اسمها وشعرها ورضيعها ومن قبلهم روحها وباتت مقصِد “المكسورون في دواخلهم”. وإلينور “المُبشِّرة” المؤمنة امتحن كاتب الأسفار إيمانها عبر ما مرت به من أحداث الديرة، واختلاط الأسطورة بالخيال بالحقيقة في عقلها، وما آل إليه أمرها في بيت خادمة المقام، وحيرتها المتجسدة في عبارتها: “جئت لأهديكم فلا تُضِلُّوني”! ويختلط مفهوم الحرام لدى بنات حمدية، فلا يقبلن في عِشَشِّهن “كافرًا” مثل سركيس وبن شاؤول أو العنكريز والهنود! رغم كسر “بهيجة” لهذه القاعدة بعد وفاة سعدون.
هكذا كان الحضور النسوي في مدينة الطين، خليطٌ متباين لا حدود فاصلة قاطعة بين أطيافه، رغم التمييز الظاهري بينهن حتى في أماكن السكن. أما زمن التَبَّة فيظهر الجانب المشرق للمرأة في كويت قبيل الغزو، متمثلاً في الحضور المهم والمؤثر في الأحداث للفنانة التشكيلية “فياصل المشيعل” وموقفها الرافض لمنع المعارض والكتب، وهيئتها المختلفة اللافتة “كأنها شخصية هاربة من إحدى لوحاتها التشكيلية”، ووجودها المُحّبَّب المُطَمْئِّن- رغم صوتها المرتفع وعدم محبتها للموسيقى الشعبية التي يسمعها صادق- فهي الصديق المختلف معنا في الذائقة، لكنه صديق يظهر وقت الاحتياج، وهي من تدفع الأحداث لتصير، ولولاها ما تلاقى الابن وأبيه.
وظهرت المرأة أيضًا في إشارة لافتة لفاطمة حسين “هدى شعراوي الكويت”، ومسألة حرق العباءة، واستفادة سعود من هذه الواقعة في الإشارة إلى عباءة بودرياه والتشكيك في التخلص منها/من شبيهتها للمرة الثانية. وكذلك الظهور الهادئ للقاصة الشابة “ليلى العثمان” في أقصوصة الجريدة المتضمنة لحوارها مع صادق بو حَدَب في السبعينيات، وما تُظهِره الأسئلة من ثقافة المحاوِرة الشابة وذكائها.
يطول الحديث عن المرأة في كتابات سعود السنعوسي، وفي أسفار مدينة الطين تحديدًا، ويحتاج مقالاً منفصلاً أتمنى إنجازه يومًا ما، لكن بشكلٍ عام يمكن القول أن سعود نجح في تقديم المرأة بكل أطيافها في أسفار مدينة الطين، وخصص السِفر الثالث لتقديم تحية امتنان وتقدير لنساء لهن بصماتهن الواضحة في مشواره الإبداعي.
– وقفات قبل النهاية:
في بداية الأسفار قال الشايب لصادق بو حَدَب أن هذه الحكايات سوف تدخله في مشكلة، والآن أدخل سعود كل من يريد الكتابة عن سِفر العَنْفُوُز في مشكلةٍ حقيقية؛ فكيف يكتب دون أن يكشف أحداث تتلاحق مفاجآتها بين صفحةٍ وأخرى حتى السطر الأخير في السِفر؟!
الأمر مُغرٍ جدًا ومُرهِق جدًا جدًا؛ كل صفحة يمكن أن يُكتَب عنها الكثير والكثير، ولكن ماذا عن من لم يقرأوا هذا الجزء بعد؟
منذ البداية قررت ألا أكشِف شيئًا كي لا أُفسد متعة قارئ ربما تقع كلماتي بين يديه قبل قراءة الأسفار، ولكن هناك وقفات لا بُد منها مع بعض ما برع سعود في تجسيده في هذا السِفر.
لعل أولها مسألة “الهوية”، وربما لا تبدو هي الخط الرئيس في أسفار مدينة الطين، ولكنها حاضرة بقوة بتجلياتها المختلفة في شخصيات الرواية التي لا تكاد تخلو أي واحدة منها من مأزق “هويَّاتي”؛ فعاموس يتأرجح بين أصله العرقي/الديني ومحاولاته الاندماج في محيطه بالديرة، وسعدون الموصوم بكل الموبقات، والمنبوذ من مجتمع الديرة، وكل ذنبه أنه “شغَل عقله” وتساءل! انسحب إلى المَنْسَى علَّ الناس تنساه، وعَلَّه يجد نفسه المتشظية بين الإيمان كما يعرفه، وإيمان أهل ديرته، وبين عقلٍ متقِّد لا تطفئه خمر عاموس ولا النوم ولا الكتب بل تزيده اتقادًا، وبين إدراكه لأهمية “إعمال العقل” ورجاءه أن يُثمر الصوف فيزرعه في حوشه سرًا! وسند بن هولين المُمَزَق بين البادية والبحر، لا يكاد يستقر في إحداهما إلا ويَحِّن إلى الآخر، حتى انتهى أمره إلى خيالٍ يتبع محبوبة لا مرئية! وسركيس ومآساة الأرمن التي يهرب منها في المَنْسَى وينشدها على الدُودوُك، ومأزق العبودية بصوره المتباينة: بخيتة وولديها ساطور وعطا الله، وأم سرور مرضعة فضة، ومبروكة، ثم خليفوه المأزوم بهويته الجنسية، من “عاش الجزء الثاني من حياته في سبيل نسيان جزءها الأول”، فعاش ضائعًا بين زمنين: أولهما كان يُشيح الناس بوجوههم عنه، وينعتنونه بما يكره من الأوصاف، ولكنهم ما تمنوا موته أبدًا، وفي ثانيهما كان محط الأنظار ولكن مع الكثير من السخرية وعدم الاحترام والسؤال بوقاحة “متى يموت؟”!
“من نحن؟ هل ما نرى عليه أنفسنا، أم ما يرانا عليه الآخر، أم أنها صورة بين هنا وهناك؟” السؤال الذي يتردد دائمًا في لقاءات سعود منذ ظهوره الأول في برنامج “بوضوح” في يناير 2013، وعالجه في رواياته الست بأشكالٍ مختلفة. وفي سِفر العَنْفُوُز تظهر ملامح هذا السؤال في تناقضات الشخصيات، كيف ترى نفسها، وكيف ترى الآخر، وكيف تبدو في حقيقتها؟ فنجد أم حَدَب “الصاجة” ترفض أن يتزوج صبيها من واحدة من بنات حمدية! وآدم المصوقر حفيد الصاجة أم صنقور، يُنكِر ما كتبه صادق بو حَدَب في سِفر العباءة عن سحر الصاجَّات! والخطيب “عمران آل كريم عين”، يتوعد الضالين الفاسقين من فوق منبر مسجد “الجِبْلاوي”، ولا يدري ما فعله جده المُلا إبراهيم كريم العين بخليفوه في مغسل المسجد، ولا وسوسته لساطور وعطا الله! وفضة المتمسكة بإرث عادات وتقاليد أسلافها الذين ما رأتهم قط، ترفض العمل في المستشفى “كمبروكة العبدة”، وتُفَضِّل البقاء بلا عمل في مكانٍ مشبوه!
مع كل قراءة تزداد الأسئلة ليس حول حقيقة الشخصيات المكتوبة فحسب، بل يمتد السؤال عن “الحقيقة” كمعنى مُجَرَد، وهل هناك صورة حقيقية واحدة للإنسان، أم أن صوره تتعدَّد وفق منظور من يراه؟!
تطرق سِفر العَنْفُوُز أيضًا إلى العلاقة بين المكان وساكنيه؛ بدايةً من اسمه الذي يحيلنا إلى تَبة سليمان الأولى بحثًا عن اللؤلؤ، ورؤيته لسمكة العَنْفُوُز، وانبهاره بجمال ألوانها في البحر وهو ما عرفها إلا رمادية كابية كئيبة فوق مساطب سوق السمك بعيدًا عن موطنها، وتعجبه “من أين للمكان أن يورِّث جماله لأهله، فلا يصيرون هُم في غيره!”.
ثم زيارة غايب للمَنسى/ الحوطة بعد غياب سعدون وسؤاله: “كيف تنكرُ الأماكن ساكنيها بعد موتهم، وتمنح نفسها للغرباء يدخلونها مُلاَّكًا جُددًا؟” وتصديق خليفوه على كلامه بأن المكان لن يدوم بعد موت صاحبه، فالحَوْطة ما عادت نفسها “بعدما بالَ السكارى في حَوْش سعدون”.
وبين هاتين الصورتين يتركنا سعود نتساءل: هل يحتفظ المكان بجماله بعد غياب أهله؟ هل يحفظ لهم وُدًّا؟ وهل كل ساكن يستحق أن يورثه المكان جماله؟ وصولاً للسؤال الأشمل: هل الوطن المكان أم الناس؟!
وتوجد بالسِفر إشارات ذكية ودالة حول أوضاع المقيمين في الكويت 1990، من خلال عيَّاد حارس قرية يوم البحار، وكذلك مسألة البدون والمفارقة في أن يكون لصنقور، غير المنتمي لا للزمان ولا المكان بطاقة هوية، بينما يُحرَم من ذلك كثير من أهل الزمان!
– ثالث الأسفار: لماذا صار المولاف عنفوزًا؟
في لقاءٍ معه على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في 28 يناير 2019، قال سعود: “أريدُ أن أُصفِّي حسابي مع الواقع، عندي في مجتمعي كثير من الأمور العالقة، أريد أن أكتب عنها”.
ربما تكون تجربته مع الرقابة واحدةً من هذه الأمور العالقة، التي خلفت في روحه جرحًا لم يندمل بعد تمامًا، ويتجلى ذلك في الثلاثية بشكلٍ عام، سواء بشكلها وختم المنع والإتلاف على غلافها، والعبارات المُظلَلَّة بالأسود، وتدخلات محرر وزارة الإعلام في هوامش جزئيها الأول والثاني. ثم في بصقة آدم في وجه بو حَدَب، في مسودة السِفر غير المنشور، نعم يمكن للبصقة أن تُسقِط كاتبًا كبيرًا، “لو كان صغيرًا ما أسقطته” كما قال لفياصل. وفي عبارة الشايب له “ما جفت بصقة آدم في روحك”. ويكتب صادق/سعود بمنتهى الصدق والوجع أثر هذه البصقة/ المُصادرة عليه وعلى اهتزاز ثقته في جدوى ما يكتب: “أمسكت قلمي وخططت ما لم يُقنعني.. روائي معروف محل ثقة واعتزاز! تذكرت دعوة البصق التي صمتت عنها الحكومة، والتي أفضت إلى حادثة المصعد بعد خروجي من مكتبي. تذكرت المنع وإتلاف النسخ والتشهير، فمزقت الورقة في الحال بعد إعادة قراءة تلك السخافة”.
ولكن لأنه “كاتب كبير” لم يستسلم لتلك الحالة، وعاد إلى قناعته الأولى “إن الصورة الحقيقية، وإن كانت قبيحة، هي أجمل من صورةٍ جميلة.. مُزيَّفة”، كما قال في مقاله “صوت الظِّل وصمت الظلام” المنشورة بجريدة القبس في نوفمبر 2010، فحين آمن بو حَدَب بقوة قلمه وقدرته على إحداث تغيير، أوجد مَخرج لسليمان من مأزقه ولم يآبه لكلام الصاجة بأن العَنْفُوُز إن أقبلت عليه يُدبر، وفي عبارةٍ بليغة تُشبه “عودة الروح” أو عودة الكاتب لقلمه يقول بو حَدَب: “حلَّفتك بالله يا عَنْفُوُز لا تُدبِر.. ودعنا نعيدك إلى بيتك القديم مثل المولاف”.
أؤمن أن سعود بهذه الثلاثية اختتم مرحلة “تصفية الحساب” مع الأمور العالقة في مجتمعه، وحقق ما ختم به مقاله السابق الإشارة إليه “المحترم في كل مكان.. إلا!” حيث قال: “تحرَّر من كل شيء إلا إيمانه بأنه كاتب وحسب، لا ينتمي إلى شيء إلا عالم الكتابة والخيال، لا ينشد مردوداً نظير كتاباته إلا حريته في القول. أن يكون قدرك أن تعيش كاتباً في وطنك الذي لا يراك يعني أن تخلص لعملك وأن تكتب من أجلك أنت، من أجل الإنسان فيك، وهذه حظوة يتمناها أي كاتب، أن يكون حرَّ نفسه لا يُمثل غيرها.
صديقي العزيز، كُن أنت، حُرّاً، مسؤولاً عن نفسك بآرائك، عوضاً عن أن تثقل كاهلك وأنت تتنكب مسؤولية أن تكون الكاتب الكويتي، المصري، السوري أو العراقي، وقُل ما تشاء بصفتك كاتباً و.. السلام.. وليتشظى وطنك في قلوب قرائك”.
لك ما أردت سعود، فبقلمك خلقت “كويتك” التي تعرف وتحب، وخلدتها في قلوب قرائك، عبر هذه الثلاثية الآسرة، التي رحلت في كتابتها كعنفوزٍ ألفى نفسه في مكانٍ لا يُشبهه، وعُدت بها/معها مولافًا يُبطئ ولا يُخطئ.
ما بعد الأسفار:
في طفولتي كان اسم الكويت يستدعي صورة أبراجها الثلاثة الشهيرة، أما اليوم فلا يستدعي أمامي إلا صورة سعود السنعوسي: وجه الكويت الأقرب والأحب و.. الأصدق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قارئة وناقدة مصرية.