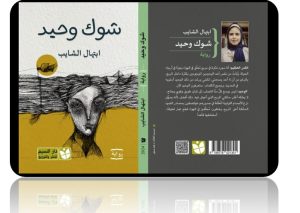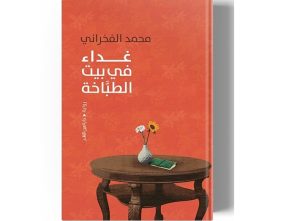د. جمال فودة
إن الإبداع الشعري لدى أي شاعر يأتي نتيجة مجموعة من الأفكار الثابتة التي يظل يدور حولها طيلة حياته، ينيرها بالكشف أو يتلمسها بالرمز، وهذه الهواجس والوساوس هي التي تهب المبدع تميزه، وتجعله نسيج وحده بين رفاق دربه.
وقد لاحظت خلال قراءة عجلى أن شعر (همام صادق عثمان) يدور ـ بشكل كبير ـ حول ظاهرة الاغتراب، تلك الفكرة التي راح ينسج حولها تجاربه؛ في محاولة مستمرة منه لفهم أعمق لذاته التي لا تكف عن الجدل والحوار والسؤال مع هذا العالم.
إن شعر (همام) يرسم صورة واضحة المعالم للإنسان المعاصر الغارق وسط الحشد، التائه في دروب الحياة، مسلوبة ذاته وضائعة روحه.
وتظل بصمته الخاصة هي التي تمنحنا أبعاد الدلالة وآفاق التجربة، من خلال التعبير عما يعانيه الإنسان من غربة كونية، وما يستشعره من زيف الحياة، وما ترصده قصائده من صور الفساد الاجتماعي التي تستشري في واقعنا المعاصر، ولعل الغربة الروحية التي يعيشها ( همام ) جاءت نتيجة لتلك التغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمع ؛ مما أدى إلى عجزه عن ملاحقة تلك التغيرات، ومن ثمّ صادفت شخصية المغترب هوى في نفسه ؛ ربما لأنه هو نفسه أصبح غريباً مغترباً حين فطن ـ رغم حداثة سنه ـ إلى عمق الهوة بين ما يراه وما يتمناه، واستشعر ضآلته حين أحس بانه ليس سوى ذرة تتحرك في إطار محدود لزمن لا محدود !!
فلا الغبراءُ أثقلهَا وجودي
ولا الخضراءُ أنقصَها غِيابي
وحين ينظر في المرآة يجد شخصاً سواه!! فقد بُدلت الملامح غير الملامح والسمات، ومن ثمَّ يخاطب مرآته / ذاته قائلاً :
لا تكوني كذَّابةً يا مرايا
ذلك الوجهُ كان شخصًا سوايا
لم أكنْ مُطفأ الملامحِ رهوًا
كنتُ دومًا مع النسائمِ نايا
كيف يا “قاهرَ” استلبتِ لساني
لم يقلْ مرحبًا ولا قالَ “هايا”
انفردْنا بقمِّة الجرحِ دهرًا
كان أوْلى إفرادُنا بالحَكايا
لا غريبًا في شيْبِ طفلٍ صغيرٍ
إذْ يرى في الوجوهِ وحشَ البلايا
شارعٌ مفترٍ يعرِّي فقيرًا
وغنيٌّ يعدُّهُ في السَّبايا
يا بلادي وما عليَّ يمينٌ
إنَّني فيكِ غُربتي في أنايا
أإذا قلتُ إنَّ فتحًا قريبٌ
جاءني الفتحُ بانتشارِ الرزايا؟!
ذكرياتي جعلتهنّ جميعًاَ
تحت رجْلي فبلَّغتْني سمايا
إن الشاعر يتحدث عن حالة التيه والضياع والإحساس بالاغتراب عن نفسه ومجتمعه، ويصف مشاعره في أغنية حزينة يسكب آهاته على أوتارها، لكن الجراح إذا ما شكونا تزيد!
إن الشاعر لا يستخدم ضمير المتكلم (الياء أو التاء أو نا) بمعناه الخاص المفرد، بل يستخدمه بالمعنى العام للدلالة، فهو عندما يقول (أنا) فإنه ينطق بلسان الجماعة، وهذا ما يدفعنا للتجاوب معه؛ إذ نراه قد استبطن أفكارنا، وجسد همومنا، وأجاد في تصويرها، ومن ثمّ فإن اغتراب الشاعر عن ذاته لا يعكس الذاتية المجردة أو الأنية الضيقة، وإنما يعبر من خلالها عن مشاعر الذات الإنسانية المغتربة، تلك الذات التي تحمل على كاهلها هموم المجتمع، بل هموم العصر!
يا بلادي وما عليَّ يمينٌ
إنَّني فيكِ غُربتي في أنايا
إن اغتراب الشاعر يتنامى نتيجة فقدان ذاته وسط زحام الحياة، فالناس تلاصقت أجساداً وتباعدت أرواحاً، وهيهات أن تعود إليه ذاته!
وأرغبُ أن تعودَ إليَّ ذاتي
وهل عادت إلى المفقودِ ذاتُ؟
لقد وصل إحساس الشاعر بالغربة عن ذاته إلى إنكار كل شيء حوله، حتى ملامحه لا يراها في نفسه، لقد طفت مرارة الغربة على وجهه، فانتقلت من روحه إلى جسده!
لا تكوني كذَّابةً يا مرايا
ذلك الوجهُ كان شخصًا سوايا
لقد بات الشاعر في خلاف جذري وأكيد مع هذا العالم، واحتدم الصراع بينهما، فلا خلاص له من هذا العالم الذي يخوض في الوحول والآثام، وحسبه أن تكون المنايا أمانيا تخلصه من رق غربته، وتفضُّ اشتباك ذاته مع ذاته!!
سيذكرُني التوجُّعُ والأنينُ
إذا جفَّتْ منَ الثَّمرِ الْغُصونُ
مِثالي في الحياةِ مثالُ كافٍ
كمِ انتظرَتْ وما في الأمرِ نونُ
كأنِّي -رغمَ جمعِ النَّاسِ حولي-
غريبٌ لمْ تصاحبْهُ السُّنونُ
صراعٌ داخلي، شَطريْ رهانٍ
أكونُ أنا أنا، أمْ لا أكونُ؟!
تَمادى الحزنُ حتَّى صرتُ حزنًا
يسمَّى باسمِهِ الشَّخصُ الحزينُ
حياتُكَ كبَّلتْكَ بِها سَجينًا
فهلْ لكَ مُنقذٌ إلا المنونُ؟
زَماني كمْ قسوْتَ على طُموحي
فما لكَ ليسَ يعرفُكَ الحنينُ؟!
يكشف لنا تصدير الشاعر للفعل المضارع بحرف (السين) عن رغبته المكبوتة في البوح، والتنفيس هنا بمعنى التوسيع وذلك لأن (السين) توسّع زمن الفعل، وذلك عن طريق الامتداد إلى المستقبل، فالمضارع بحكم مواضعته يعطي معنى التجدد الحضوري، وكأن هناك طاقات روحية إيحائية هي القادرة على جمع المتناقضات في ثنايا الصورة التي تعكس حالة من الإحساس بالضياع بين ماض أليم وحاضر أشد إيلاماً.
ولعل الشاعر يعمل على خلق نوع من التوازي بين البنية اللغوية والتجربة النفسية ، إذ يتم إنتاج الدلالة في وسط زمني ينتمي إلى المستقبل من خلال مجموعة ( المضارعات) التي تفجر بعداً زمنياً خاصاً إذ تتحرك الصياغة حركة مزدوجة، حيث تتعلق بالماضي وتشده إلى الحاضر، كما تتعلق بالحاضر وترده إلى الماضي، فتخلق بهذه الازدواجية معادلاً يوازى تجربتها خارج إطار الزمن، وهى تجربة تجمع بين الذات وموضوعها في لحظة مطلقة تختل فيها العلائق التي تربط بينهما، أما المعادل فهو الارتداد إلى واقع زمني لاستعادة علاقة مفرغة من الهموم، علاقة تشكل عالماً من النقاء والصفاء والطهر.
تَجرَّعِ المُرَّ كيْ تُسْقى حَلاوَتَهُ
كما سَقى البُرْءُ داءً بعدَ مُرَّیْنِ
…….
مهما اسودادُ الدُّجى في الأمنياتِ سجى
يحاصرُ الله عسرًا بين يسرينِ
كما وظف الشاعر بنية الاستفهام للتعبير عن الإحساس بالضياع والاغتراب وعبثية الحياة، والسعي للخلاص من أسرها، وكم كان (همام صادق) واعياً لفاعلية الاستفهام في تجسيم هذا الحوار النفسي الذي يحول دون التقاط الأنفاس.
صراعٌ داخلي، شَطريْ رهانٍ
أكونُ أنا أنا، أمْ لا أكونُ؟!
…
حياتُكَ كبَّلتْكَ بِها سَجينًا
فهلْ لكَ مُنقذٌ إلا المنونُ؟
في ضجة الذكريات يلملم الشاعر هواجسه، يحاور نفسه بعد أن أسدل الستار على حبه، وختم بالحزن على قلبه، وهذا ” المونولوج الداخلي ” الذي يستدعيه بالاستفهام يتيح له استدعاء المواقف التي استأثرت به، دون أن تجره الذكرى إلى الخوض في التفاصيل التي تستقطب طاقته التصويرية، فالاستفهام هنا أداته إلى التركيز، بالإضافة إلى كونه عنصر تنبيه في المونولوج الداخلي يجسد تلك المواقف التي تضطرم في أغوار الذات.
لقد نجح (همام) في أسر ذهن المتلقي وشد انتباهه إلى أقصى درجة؛ لما يحمله الاستفهام من ترقب يعمل على إحياء الدلالة من ناحية، ويقوى قنوات الإبلاغ من ناحية أخرى.
في ضباب هذه الأسئلة تنبت عروق الشعر الأصيل، فالشعر لا يستوطن اليقين الصامت ولا الإجابات المتوقعة، بل يعيش دائماً في هذه المنطقة المتراوحة بين الصمت والنطق، بين السؤال والإجابة.
في الحقيقة لقد بهرني شعر (همام صادق عثمان) بطابعه الفني والإنساني، وحسبي في ختام هذه القراءة العجلى أن أقول إن (همام) شاعر لا يُعرّف، وإنما يُتعرف عليه من خلال شعره، فهو لسان حاله وترجمان ذاته، لقد وجدت فيه صوتاً من أصوات الحركة الشعرية الراهنة في ثقافتنا العربية، ولا تفي هذه السطور بما يستحقه شعره من نظرات أخرى للوقوف على أسراره وسبر أغواره، وهذا ما نرجوه في المستقبل القريب.