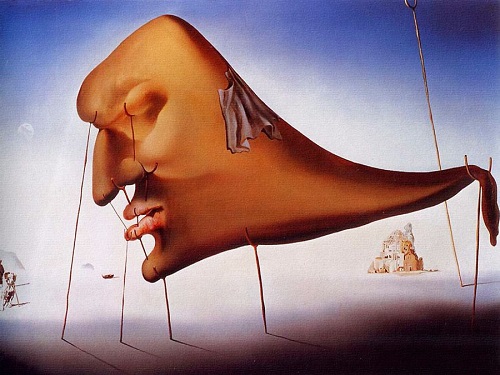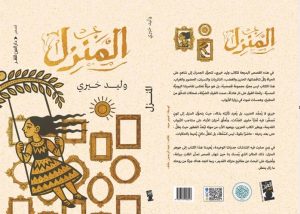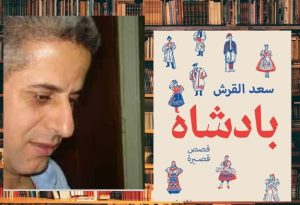محمود عبد الدايم
حالفني الحظ هذه المرة، تعطل مترو الأنفاق قبل مغادرته المحطة، توقفت الحركة تمامًا، قبل الإعلان في الإذاعة الداخلية للمحطة عن حادثة بسيطة تسببت في إعاقة حركة سير القطارات، وضغط المذيع على أحرف كلماته وهو يؤكد بجدية مصطنعة: «والسلطات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة لراحة الركاب وإعادة حركة سير القطارات إلى طبيعتها».. ليتركنا بعدها أسرى التوقف الإجباري.
السائق كان كريمًا معنا، فلم يغلق الأبواب، ولم يفتحها، تركها في المنتصف؛ مفتوحة لمن يرغب في المغادرة، ومغلقة في وجه الذين يبحثون عن أسباب للبقاء في الداخل. حدثت المعجزة الصغرى، وخرجتُ من العربة الخانقة، بعدما تلقيت ضربة موجعة من كف غليظة رفعها صاحبها وتركها معلقة في الهواء. بادرت بتقديم اعتذار، أفعل هذا دائمًا لقطع الطريق على أي أزمة عابرة يمكن لها جعل «الثلاثاء العظيم» أكثر عظمة مما اعتدت، وغادرت العربة.
على الرصيف، أُنصتُ لسيدة خمسينية أراحت مؤخرتها على واحد من المقاعد الخرسانية التي اعتمدتها الشركة المسؤولة عن إدارة المترو في حركة التطوير الأخيرة، وقالت بلغة لم تَخلُ من تشويق:«بيقولوا واحد مات.. رمى نفسه قدام المترو، بعد ما اكتشف خيانة مراته مع أخوه، مات وساب لهم الدنيا».
قطعًا، رواية المرأة الخمسينية كاذبة، فكيف استطاعت في غضون دقائق قليلة التعرُّف على التفاصيل الدقيقة هذه؟! هززت رأسي، ألقيت عليها نظرة تأنيب، تجاهلتني وأكملت واصفةً تفاصيل «لحظة الخيانة»، فما كان مني إلا أن قررت التقدُّم قليلًا. حملتني قدماي إلى العربة التالية، كان الازدحام فيها مقبولًا، أسرعت بالدخول، لم أرتطم بأي كف معلقة، ارتكنت إلى الزاوية، بعدما تنبَّهت لبائع يمسك بين يديه حافظات جلدية، يقسم إن النار لا تمسسها بسوء، كان يمرر شعلة لهب على جانب حافظة، يرفعها في الهواء، ويزعق:«صلاة النبي مكسب».
محاولًا شد الانتباه له، وضع البائع الحافظات الجلدية في كيس بلاستيكي، وسريعًا أمسك بخيط الحكاية، أخبرنا بأن «المنتحر راجل عنده ستين سنة، أول يوم النهاردة ليه على المعاش، طلع من بيته، زى ما اتعود طول السنين اللي فاتت الساعة ستة ونص، الكاميرات اللي مالية المحطة وضحت لحظة دخوله، وهو بيشتري التذكرة، وهو بيعدي من المكن، ولما وقف عند الرصيف مستنى المترو، قبل ما يرمي نفسه قدامه ويتقطع جسمه لنصين، بس الصراحة رأسه ما حصلش لها حاجة».
كبار السن كرهوا الحكاية، تبدلت وجوههم سريعًا، الأصفر كان الأكثر حضورًا على الجباه المتغضنة، دموع قليلة لمحتها تشق طريقها بين الشقوق الجلدية على وجوه ثلاثة كهول، العجائز – وعلى غير عادتهن – صمتن، إلا واحدة صاحت في البائع: «وإنت يا أخويا اللي مسكوك الكاميرات في المحطة؟! روح الله يسهلك».
أحمل على رأسي أربعين عامًا ولم أزَل أتحاشى مواجهة الدموع.مسرعًا خرجت من العربة، مجددًا وجدتني أقف على الرصيف، لاحظت أني اقتربت من العربة الأولى التي تزين مقدمتها كابينة القيادة. هناك عربتان تفصلانني عن حافة الرصيف، إلى كابينة القيادة. اتخذت قرارًا بالذهاب إلى هناك فورًا، أمتار قليلة أقطعها وأصل إلى الحقيقة، عن الرواية الواقعية لكل ما حدث. لكن، فجأة، شقَّ صوت «أم كلثوم» الهواء الثقيل، وارتفع صوت السِّت في الإذاعة:
«دوس على كل الصعب وسير..
اِدي لعملك جهد زيادة»
تسمَّرت في مكاني. الدم يغلي في عروقي، ما المناسبة الآن لإذاعة الأغنية؟! مَن العبقري الذي اختار هذه اللحظة لتقديم أغنية وطنية؟! استرجعت في رأسي تاريخ اليوم، إنه الأول من نوفمبر، لا مناسبات وطنية في هذا اليوم، هُزمنا في الخامس من يونيو، وعبرنا في السادس من أكتوبر، وقُتلنا في الخامس والعشرين من يناير، لكن الأول من نوفمبر، لا أغنية وطنية تصلح له!
حاولت الانشغال عن صوت «ثومة»، بعدما شعرت كأنها تحدثني، تقصدني وهي ترفع نبرة صوتها في كوبليه:
«اِبني وزوِّد من أمجادك..
اِبني لوطنك ولأولادك»
شققت طريقي بين الركاب الذين لم يحسموا أمرهم بالبقاء داخل العربة أو النزول، فاختاروا وضع قدم في داخلها، وتركوا الثانية تتأرجح، تلامس الرصيف بخفة تليق بسارق الهواتف الذي اشتهرت به هذه المحطة.
لم تواجهني أي متاعب في دخول العربة، كانت شبه فارغة، ركابها تجمعوا في أحد أركانها حول رجل عجوز تبيَّنت ملامحه بعدما وجدت لرأسي موضعًا خاليًا بين الأيدي المرتفعة التي تحاول التشبُّث بالحلقات المعدنية المعلقة في سقف المترو، الحلقات التي كنت أراها دائمًا «قريبة الشبه بالمشنقة»، لكنها مشنقة لـ«قطع الأيدي»، ولا تصلح لـ«الرقاب».
أصبحت في زاوية تسمح لي برؤية العجوز جيدًا، طلب جرعة ماء، رفض زجاجة مياه عادية قدمتها إحدى السيدات، اختار المياه المعدنية التي أخرجتها الفتاة الجامعية من حقيبة تحملها على ظهرها. ابتلع الماء بصعوبة، أغلق الزجاجة، وأحكم إغلاقها جيدًا، ووضعها جانبه، وقال: «كنت موجهًا لمادة التاريخ، 30 عامًا قضيتها بين الخرائط والحكايات، كنت أُروي التاريخ، أمنح المؤامرة ألف سبب وسبب لتبرير حدوثها. أعطيت محمد علي باشا 10 أسباب لذبحه المماليك، حدثتهم عن سليم الأول، وطومان باي، عن صلاح الدين، عن الجميع. وفي صباح يوم ما، أحالوني إلى الاستيداع، المعاش، وللحق مُنحت تكريمًا جيدًا؛ أعطوني خريطة للوطن العربي مرسومة بماء الذهب، وقلمًا ذهبيًّا لا يصلح للكتابة، وشهادة استثمار بـ 100 جنيه، وشيكًا مكافأة نهاية الخدمة».
قضى العجوز على ما تبقى في زجاجة المياه، ابتلع ريقه، وفشل في إخفاء دمعة سقطت من عينه اليمنى، وقال: «اتفقت مع ابني مساءً أن نذهب معًا إلى الإدارة التعليمية؛ للسؤال عن رفض البنك صرف شيك المكافأة، مشوار تعاملت معه كأنه فرصة أخيرة لأثبت لابني أن التاريخ يستحق، وأن سنوات عمري لم تسقط في الفارغ، أكدت له أن الأزمة ستنتهي بينما نحتسي معًا فنجان قهوة في مكتب مدير الإدارة، صديقي، مدرس التربية الرياضية، لكني نسيت أن حفيدتي الصغيرة ماتت منذ 10 أيام، صدمتها سيارة وهي تعبر إلى جوار أبيها الشارع، ماتت هكذا، وأنا الذي كنت أظن أن الملائكة لا تموت، واليوم مات ابني… غافلني وقفز أمام القطار، مات الملاك الأخير في حياتي، مات كما يموت الأبطال عند أبعد نقطة على خريطة الوطن».
كلُّ ما كنت أفكر فيه وقتها، زجاجة المياه، كيف فعلها الرجل، لم أُلقِ بالًا لحكايته غير المحبوكة، وإن كانت موجعة، لكن انتظامي شبه اليومي منذ 20 عامًا على ارتياد قطارات مترو الأنفاق كان كافيًا لأحظى بمناعة قوية ضد هذه النوعية من الحكايات التي تنتهي دائمًا بطلب المساعدة المالية. كنت أفكر في زجاجة المياه المعدنية، لماذا اختارها العجوز ورفض الثانية؟ ما الذي تفكر فيه البنت حاليًّا؟هل ستجلس إلى جواره تنتحب قبل أن تلتقط معه «سيلفي» لتنشرها على صفحتها الشخصية على «فيس بوك»؟ مرات كثيرة كنت أهرب من الدموع التي يتركها أصحابها تغادر أعينهم لمجرد أن حكاية حزينة رويت أمامهم، رواها أحدهم بحثًا عن «جنيه» يطلبه باسم «الله».
«ياللي بنيت الهرم..
قبل الزمان بزمان»
كررت «ثومة» الكوبليه ثلاث مرات، أحصيتها وأنا أعود للمرة الثانية إلى الرصيف. كنت بمحاذاة كابينة القيادة، لمحت السائق يتحدث في هاتفه المحمول، كان يروي لطرف خفي تفاصيل ما حدث. تناهت إلى مسامعي بضع كلمات، لكنها لا تكفي لصناعة حكاية كاملة، سمعته يقول: «زي ما باقولك كده، هو كان قاصد يرمي نفسه، لمحته من أول ما دخلت المحطة، بس ما اديتش خوانة، بس سبحان الله يا أخي، تحس إنه متدرب على الانتحار، اتقسم نصين، وكل نص سليم مفيهوش خدش، بوظ عليَّ الفطار، الله يسامحه، كنت هاخد فيها جِزا لو العسكري ما كنش قاعد مكانه وشاف الحادثة من أولها، وإنت عارفني أنا متعود أدخل المحطة سريع شوية، ربنا يرحمنا ويرحمه، شوية أهو ونتحرك».
كتمت أنفاسي محاولًا تحاشي التقيؤ على الرصيف، ركضت باتجاه لافتة تشير إلى دورة المياه، دخلت سريعًا، سقطت على ركبتي، وضعت رأسي في قاعدة الحمَّام، وتابعت انسياب سائل أصفر باهت ينزل من فمي. دقائق عدة مرت قبل أن أتمكن من السيطرة على جسدي، لا يزال صدى كلمات سائق المترو يحاصرني! غسلت وجهي ثلاث مرات، واستعذت من شيطان لا أراه، ثلاث مرات، ونظرت إلى انعكاس هيئتي في المرآة المتسخة المعلقة فوق الحنفيات الثلاث المعطوبة، قبل أن تتناهى إلى مسامعي «نهنهة» امرأة في الغرفة المجاورة، كانت تبكي بصوت مكتوم، تقول لشخص معها في الغرفة: «المنتحر جوزي،لالا… ما كنش بيعاني أي أزمات نفسية. جوزي كان… كان… كان عامل في مصنع، ملناش حد ، أيوه.. مقطوعين من شجرة، الحياة صعبة، أقنعته ننزل نبيع مناديل في المترو. عارف يا باشا، آخر فلوس معانا اشترينا بيها المناديل دي وتذكرتين المترو، بنتي في المدرسة، ما أعرفش اللي حصل. أول ما شاف المترو جري، وقال لي ربنا هياخد باله منكم. أنا مش عاوزة حاجة. أكرموه في موته، وربنا هياخد باله مننا».
ارتفع صوت «النهنهة» التي تحوَّلت إلى نحيب. ألقيت نظرة على الغرفة فور خروجي من دورة المياه، سيدة في الثلاثين من عمرها، جالسة على الأرض، تضع رأسها بين يديها، وإلى جوارها ترقد مجموعة من أكياس لمناديل ورقية. وبين لحظة وأخرى، ترفع رأسها، تنظر إلى الضابط المسؤول. ما رأيته لم يكن حزنًا في عينيها، كان خوفًا، اضطرابًا. كان شيئًا أبعد ما يكون عن الحزن!
عشر دقائق مرت، انقطع فجأة، مثلما بدأ، صوت الأغاني، كانت «شيرين» تقسم إنها «هي الصُّحبة وهي الأهل»، اختفى صوتها، وأعلن المذيع عودة حركة القطارات. تحركت سريعًا بعدما قررت ألا أركب العربة الأولى، لا أريد أن أكون قريبًا من كابينة القيادة. تشبَّثت بالجانب الأيمن من الباب الأول للعربة الثانية، قفزت إلى داخلها، شعرت بقدمي تصطدم بشيء بلاستيكي، كان زجاجة المياه المعدنية، فارغة، لمحتها قبل أن تتقاذفها أقدام الركاب الذين تجاهلوا توسلات السيدة الخمسينية بأن يعاونها أحدهم على الصعود إلى القطار.