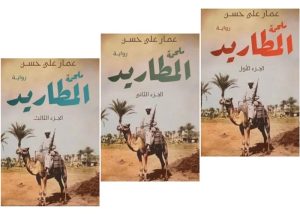سها السباعي
ستختلف قراءتك لـ«دار خولة» إذا كنت من الأبناء عنها إذا كنت أحد الوالدين. نوفيلا مركَّزة تقول الكثير وتُجْمل بين سطورها الكثير. منَّا من تعاطف مع خولة، بل تماهى معها حد البكاء، ومنَّا من تماهى مع ناصر أو يوسف أو حمد بظهوره القصير لكن المؤثر، لأنه يبدو أنه الوحيد من بين إخوته الذي ما زال يحمل لأمه بعض مشاعر الحنان والدلال لها وعليها بإيقاظه لها ليلًا لتعد له عشاء، ربما لأنه آخر العنقود الذي ما زال طفلًا رغم أعوامه السبعة عشر، لم يبلغ مبلغ الرجال بعد، بما لهم من اعتبارات أخرى وطرق مختلفة للنظر إلى الأمور، اعتبارات وطرق توفرت بغزارة لدى أخويه الأكبر منه.
تذكرتُ فور اجتماع الأم وولديها على طاولة الطعام رواية العشاء للهولندي هيرمان كوخ. إلى أي مدى تتحول جلسة طعام لذيذ بأصناف متعددة إلى نقاش متوتر بشأن قضية هامة تخص أفراد الأسرة، وجدال حول أثر مسألة ما عليهم جميعًا وكيف سيتصرفون بصددها. لكن الأدوار على طاولة عشاء خولة معكوسة عن الرواية الهولندية، فالأم هنا هي الموضوعة في قفص الاتهام، وبالطبع معروف من هم القضاة والجلادون، لتبقى خولة، طاهية العشاء والداعية إليه «مسمِّرةً عينيها في الصحن مثل طفلة تتعرض للتوبيخ».
سأحاول أن أكون محايدة فلا أنحاز لخولة تمامًا رغم تعاطفي معها في حزنها أو -دراميتها كما يصفها الأصغر سنًّا- على شبابها الذي أفنته في تربية أبنائها، ورأسي الذي أمسكته لا أراديًا بكلتا يديَّ إشفاقًا عليها كما فعلت مع رأسها المتصدع عند شهودها هول تصدع أسرتها، سأحاول أن أشعر بأزمة الهوية لدى ناصر وشعوره بالفقد ثم بالصدمة والحرمان، وأشعر بضغط المجتمع على يوسف وإحساسه بالخزي وسباحته مع التيار، وأتخيل لهو حمد والتهائه عن أي أمر جاد حوله، ثم أتساءل مع خولة عن السبب، الخاص «والعام». غياب الأب «القائد»؟ تدخل الآخرين «الأجانب»؟ الصمت وغياب المكاشفة وانعدام «الشفافية»؟ اغتراب خولة داخل حدود الوطن رغم الإغراق في تاريخه وفلكلوره، فاغتربت بالتالي عن أبنائها رغم غوصها بأفكارها وكل مشاعرها في حيواتهم وإغراقها في حبهم؟ أين تبدأ حدود الأبناء التي ينبغي احترامها وأين يحق للوالدين اختراقها؟ متى نخضع لسنة الحياة و«سِلْو البلد» ومتى نقاومها لأن ليس كل ما وجدنا عليه آباءنا مناسب لزمننا؟
قيل لخولة عن البرنامج الذي يطلبون استضافتها فيه إنهم «سيطلبون مداخلات من أشخاص في محيطها الاجتماعي، وكلمة محيط هنا مضللة، فليس لديها محيط، بل حوض أسماك بالكاد»، كلمات كافية لوصف عزلة خولة ووحدتها ومساحتها الضيقة في مطبخها العامر بمكونات إعداد الولائم وأوعية الطعام الأنيقة مع أنها «في الغالب تأكل وحيدة لأن «البيوت أضحت فندقية إلى حد كبير»»، وفي بيتها الذي تكتشف فيه «أن وراء الصمت صمتًا ثانيًا، وتحدس أن وراء الصمت الثاني صمتًا ثالثًا ورابعًا وعاشرًا ومئة وألفًا، تكتشف خولة متاهة الصمت، وهي متاهة مؤلفة من غياب اللغة المحض، لا من قصورها»، وأمومتها التي تستجديها بأطباق المشهيات والحلويات التي تضعها على طاولتها دائمًا لتكون «فخاخًا منصوبة لأمومة معطلة»، وإحساسها «بالشيخوخة» رغم سنوات عمرها الخمسة والخمسين، التي لا تُعتبر شيخوخة بأي مقياس إلا في مكان يحكم على امرأة بما حُكم به على خولة، فقررت أن «تشيخ بكرامة، رغم أن الشيخوخة في جوهرها إذلال وئيد» وتتحدى الصورة النمطية لامرأة يعتبرها المجتمع في طريقها لتوديع الحياة -بعد انتهاء المطلوب منها- حين تبدأ بشرتها بحفر الغضون التي «تتباهى بها كأنواط شجاعة»، وتتساءل «إن كانت الشيخوخة والوحدة أمرين متلازمين» لتجد راحتها الوحيدة بالتحديق في حوض أسماك فارغ، فهي «لم تحظَ بالأهلية الكافية لتحافظ على أسماكها، واكتشفت متأخرة جدا، أن بعضها قد التهم البعض الآخر، رغم أن البائع زعم أنها اختارت أنواعًا قادرة على التلاؤم»، فأبقت على الحوض الفارغ اكتفاء بما يمنحه إياها من «إحساس مهدئ وفقاقيع، رغم كل ما يوحي به من هجران».
ربما قرأ كثيرون منا كتاب النبي لجبران في بدايات قراءته، خاصة فصل الأبناء الذي ربما لا نذكر من الكتاب سواه. وصفت خولة كلماته بأنها «كلمات جبران الصداحة، «إنجيل العقوق المقدس»: أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة»، لكنها تعرف أن هذا كلام غير صحيح، فالواقع أن «أولادكم ليسوا أولادكم، أولادكم أبناء النظام»». وكي لا يسارع أحد إلى إساءة الظن، فأظن أن خولة تقصد «النظام العالمي الجديد!».
لماذا طرب بعضنا لكلمات جبران وتغنى بها؟ لأننا قرأناها حين كنا أبناء، نتوق للفكاك من سلطة الآباء. لكن، كثيرًا منا، ونحن الآن آباء، في هذه اللحظة تحديدًا من القرن الحادي والعشرين، لا نسمعها طربًا، بل عويلًا ونواحًا، ولا نعتبرها أغنية، بل مرثية.
خسرت خولة ابنها البكري، وأرجعت أسباب تلك الخسارة إلى أمريكا. عبرت خولة بصدق عن إحساسها بأمريكا، بعد دورها بتدخل ظاهره إنقاذ بلدها من عدوان “الأخ” وباطنه مآرب أخرى -وبعد سنوات عدوانها هي نفسها ثم دورها المتفرج بل والداعم لعدوان “ابن العم” على “إخوة آخرين”، لكن هذا موضوع آخر- ثم عبرت عن إحساسها ذاك باستماتتها لتطبع أبناءها بطابعها «الأبيض» المتحضر المستنير- كإحساس طفل انبهر بأمه “أو أبيه”، ثم عبرت عن تبعات انقلاب ذلك الإحساس عندما تخلت تلك الأم “أو الأب” بعد زغللة العين ببريق مزيَّف ومزيِّف للتاريخ والتعليم والحرية والعدالة والمساواة و.. القوس مفتوح، مثل «طفل اتعلق بيكي في وسط السكة وتوِّهتيه»؟ كما يقول منير في أغنيته، فعاشت أول التيه على المستوى الخاص قبل العام في انشقاق ابنها وعيْشه بـ«فردانية أمريكية مطلقة»، وعانت تبعات التحلي بالتربية الإيجابية والحب غير المشروط. لكن هل كانت الأمهات تتنتظر دورات التربية الإيجابية وكتب المساعدة النفسية التي تعلمهن الحب غير المشروط؟ ألا يمتلئن به قبل أن يرددن مع جدات الجدات «أنا أدعي على ابني وأكره اللي يقول آمين»، لأن دعائهن لا يجاوز الشفتين مهما أجرم الابن في حق أهله أو في حق نفسه أو في حق مجتمعه؟ أليس تحيز الأم لأبنائها من أفعال الغريزة؟ ولا نقول الفطرة لأن هذه الكلمة صارت عتيقة ولم تعد تعجب الجميع.
القطة التي تأكل أولادها لا تأكلهم جورًا أو جوعًا كما يتخيل البعض قائلين بسخرية إن «القطة كلت عيالها يا جدعان»، وابحثوا في هذا إن شئتم.
بعكس الابن البكري، يأتي الأوسط ليبقي على «مسافة احترازية مع خولة الأستاذة، بصفتها شخصًا لا يخصه، أو أسوأ، بصفتها عاره». ولننتبه هنا إلى لفظ «لا يخصه» الذي رغم صورته الفصحى البريئة لها دلالة أخرى في العامية المصرية! في محيطات كثيرة، المرأة، أيًّا كان موقعها أو عمرها أو مكانتها العلمية والعملية، هي في العراء، ليست تحت طبقة حماية، إلا أن «تخص» رجلًا ما له وجود، ليعلن عليها حمايته ويضعها في حِماه. وعندما تقرأ ما يدور بخلد يوسف عن أمه «وعن أبيه»، وعن الصورة المثالية التي يراها لدور الرجل في الأسرة، خاصة فيما يتعلق بفتح البرطمانات واستبدال اللمبات وتغيير الإطارات، ستجد تعريفه الدقيق لمعنى الحماية والحمى. لا يفهم يوسف لماذا لا تكتفي أمه بأن «تكون أمًّا، مجرد أمّ، «لماذا لا يكفيها ذلك؟»».
ولنكن عادلين، فيوسف، الذي لم يعرف عن أبيه الذي مات وهو صغير سوى «ما قالته أمه، ولم تكن مصدر ثقة عنده، وعليه فقد اضطر إلى التشكيك في كل شيء»، لم يعجبه أيضًا أن أباه حوَّر أبيات الشعر ليحولها إلى شيء خاص بأمه، ولم يعجبه تغنيه بالشعر و««حساسيته» التي كان يجدها منفرة»، وهو «غير مهتم بأبيه أستاذ الأدب العربي، بقدر ما هو غير مهتم بأمه أستاذة الفلكلور» و«يريد أن يعرف إن كان أبوه مثل بقية الآباء»! يوسف لا يريد للجميع إلا صورة نمطية خافتة، صورة لا تلفت الأنظار، لا تتميز عن الآخرين، صورة تشبه الجميع، لا يشير إليها أحد بأصبع الاتهام أو السخرية وربما ولا حتى ببنان الإعجاب والتقدير، فهذا أريح لرأسه: «بصراحة أنا لا أريد أمًّا مشهورة» لا بخير ولا بشر.
أما آخر العنقود، الذي تقول عنه خوله أنه «مو معبرني خير شر» فقد أحضر لها هدية ظنًا منه أنها ستعجبها، ربما تعويضًا عن عدم وجوده، بعد تجاهل موعدها على العشاء مع الأسرة عن قصد مفضلًا ألعاب الفيديو مع أصدقائه، متجاهلًا «عددًا هائلًا من الاتصالات التي لم يرد عليها عامدًا»، اعتمادًا على أنه سيجدها قد جنبت له عشاءه ليسخنه حين يعود في الجهاز الذي يستبدل أحد أدوراها، وربما يأخذ سيلفي مع «منابه» من الوجبة حين يعود للمنزل متأخرًا بعد أن تنام وينشره ويكتب عليه «تسلم إيدج يُمَّه».
اليقين من بين كل ما تحسبه خولة خذلانًا من جانب أبنائها، ومن كل ما يحسبه أبناؤها قصورًا من جانبها، أن «سوء الفهم حتمي، وعلى ما يبدو أبدي جدًّا»، ولكن كيف سنفهم والجميع يقابل الجميع بالصدود؟ كيف سنفهم والجميع يعلي الحدود أمام الجميع بجدران عازلة وأسلاك شائكة؟ ربما نتدارك شيئًا من ذلك السوء ونحسن جزءًا كبيرًا منه بالمصارحة والمكاشفة بين الجانبين، ورحابة الصدر والعفو والقبول والتسامح والرحمة، من الجانبين، وموازنة الأولويات، وتطبيق قول مأثور أكثر عقلانية وإن لم تثبت صحته النقلية، قول سابق على كلمات جبران ونظريات التربية الإيجابية: «لاعب ابنك سبعًا، وأدبه سبعًا، وصاحبه سبعًا، ثم اترك الحبل على الغارب».