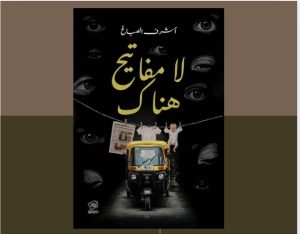ممدوح رزق
بدءًا من عنوان مجموعته الشعرية “سماء بضفيرتين” يخبرنا الشاعر المغربي عبد الجواد العوفير بأن قصائد هذه المجموعة الصادرة عن دار راية لا تعتمد “أنسنة الأشياء” بالتعبير الدارج فحسب، وإنما “أنسنة الغيبي” تحديدًا، بل و”الأنسنة الأنثوية” بتحديد أدق. الأنسنة التي لا تتماهى مع الغيبي، وإنما التي تعيّن نفسها بديلًا “صادقًا” له، الأنسنة التي تجرّد الغيبي من صورته المترفعة، ومن ثمّ تزيحه عن الحياة والموت.
“ألف الرفاق
في لفافة واحدة
وأدخنهم ببطء”.
ثمة حس “ثأري” يبدو دافعًا أساسيًا في قصائد هذه المجموعة وبالأخص في قصيدة مثل “وهمي عال”. حس يتناغم مع “الأنسنة الأنثوية” حيث “الموسيقى” هي الجسر الأكثر ملاءمة لإنزال الغيب من عليائه. هنا تبرز الغاية من استبدال الغيبي بالأنثوي. يتحوّل الغيب إلى هدف شبقي للشاعر. هدف يكمن وراء “تخيلاته الثأرية” ويقودها. يتحوّل “الوهم” إلى “ممارسة” مشحونة بالعنف اللائق.
“الموسيقى تهبط الأدراج
مثل امرأة غنوج
لكن بيتي سفلي
فكيف تخيلتُ أن الموسيقى
تهبط الأدراج الداخلية”.
لكن هذا العنف لا يكشف عن احتدامه بصورة مباشرة، وإنما يتقمص سكون الغيب وغموضه، يكثّف العنف لغته إلى أقصى حد، بما يعادل الصمت الخبيث لذلك الغيب، يرد “الرعب” بالحدة الخفية نفسها. حتى أننا قد نشعر بـ “العتمة” المنزلية التي تواري هذا العنف، بعد أن حلت موضع العتمة السماوية بكل ما تضمره لانهائيتها. هذا ما يجعل “الثأر” تهكميًا بشكل جوهري.
“أنا وكافكا وحيدين في غابة
ندفع باب بيت قديم
نجد امرأة مخنوقة بالبكاء
نضاجعها الليل كله”.
لنفكر في “المرأة” من خلال قصيدة “وحيدان في غابة” باعتبارها الحياة ذاتها، لا كما عاشتها “الأنا” في وحدتها المشتركة مع “كافكا”، وإنما كما قُدّر لها أن تكون رغمًا عنها. كما أُجبرت أن تكون إشارة للسر “الكوني” الذي لا يمكن تفسير “كابوسيته”. الحياة هنا لا تقدم نفسها كشيء منطقي، وإنما ككيان موصوم بهوية قهرية، تطبق على أنفاسه، ومن ثمّ يكافح للتبروء من ثقلها. كقناع يقاوم الوجه المستتر للمطلق. يقاوم أن يكون ملامح ناجمة عن هذا الوجه. وكأن مضاجعة القناع هي مضاجعة الوجه المستتر. كأنها طمس متعمّد للوجه المستتر. وحيدان يخوضان متاهة الألم، نحو “فكرة” الحياة العالقة في الأزل، يخلقان من تعاستها أبديتهما الهازئة كما في قصيدة “نرفع أنخابنا لذكريات عالية”:
“نخبئ ذكرياتنا في الجيوب
كمحاربين قدامى
ونقدمها للعاهرات كأجر
من يريد سماواتنا الصغيرة
من يريد هذه الأبدية
التي تنمو في قلوبنا كشجيرات عليق”.
هذا خطاب “إلهي”، ولكنه خطاب “مضاد”، أي أنه يدرك مناوئة “السماوات الصغيرة” لـ “السماء”، يُشكّل أبدية خاصة تناقض “الأبدية” الكونية. الذكريات إذن هي سيرة المجابهة بين البشري والغيبي. تاريخ امتلاك البشري لغيبية ذاتية، تستعمل الفناء لكي تكتسب خلودًا “ينمو كشجيرات عليق”.
“السحب التي أحببناها كنساء بعيدات
نرفع أنخابنا نحوها
…
فلتأت أيها الموت بملاكك الصغير
وأقتل هاته الأبدية
التي تتجمل مثل امرأة خجول”.
يُنظر للسحب أحيانًا خارج طبيعتها الأصلية، شعريًا بالأخص، أي ككائنات حية تنتمي للمطلق لا إلى العالم، واتساقًا مع “الأنسنة الأنثوية” للغيبي التي تعتمدها المجموعة، وتحويل تفاصيله إلى أهداف شبقية؛ تصبح السحب نساءً تستجيب للأنخاب المرفوعة، وبما أن “الموت”، كناتج عن الأنسنة السابقة للغيبي، قد صار خاضعًا لـ “المحارب القديم”؛ فإنه من الممكن توجيه هذا الموت إلى المسار العكسي، نحو الأبدية التي طالما ظلت محصنة من بداهته، لكنها الآن لم تعد كذلك؛ أصبحت “تتجمل مثل امرأة خجول”. ذلك ما يوطد “الثأر” كدافع أساسي. يوسّع تعريف “الشبق” ليصبح أكثر شمولية في استهدافه للغيب.
“امرأة بوشاح أخضر
تلقي ابتسامة
وجهانا كإلهين هاربين
من سماء ضيقة”.
تتضح الأنسنة الأنثوية المعتادة بدرجة ناصعة في قصيدة “في صحة الغائب”. اكتسبت الألوهة سمة امرأة، لا تتسع لها “سماء المطلق”. تصبح ابتسامتها عناقًا مع “وجه” لإله يُدار المشهد بمشيئته. الغائب ـ الذي كانت تتسع له السماء من قبل ـ تحوّل لامرأة بوشاح أخضر “هدف شبقي” فصارت سماؤه ضيقة، لذا كان عليه الاستجابة لإرادة الإله الذي خلق هذا التحوّل ـ هروبًا من السماء نفسها ـ بواسطة الابتسامة التي تعلن حيازة سماء أكثر اتساعًا. سماء جديرة بالمطلق الذي جرى استبداله.
“معلّمة الانشاء كانت ترتجف بين يديها الشمس
تنورتها الصغيرة علمتنا اللغة
وأنا الآن أنظر للشمس
تغيب اللغة”.
اللغة ليست “تفصيلة غيبية” وحسب، ولكنها في قصيدة “لغة” هي “جوهر الغيب”. الجوهر الذي يتحوّل بفعل “الأنسنة الأنثوية” إلى “إزاحة للغة”. يجعلها موضع غياب. معلمة الإنشاء هي الإله الذي أصبح ينتج اللغة بدلًا من مصدرها الغائم. تحوّل “الغيم” إلى “ضوء” مشبعًا بشهوانيته / شمس مرتجفة. ذلك ما يجعل الضوء مجردًا من لغة المطلق. يصير خارج اللغة التي يستقر الغيب في أغوارها.
“المرأة التي تجلس وحيدة في البار
وترتدي شالا أحمر
تشبه الله الذي تركناه في المنزل
ألم نغلق الباب جيدا؟!”.
كأن عنوان هذه القصيدة “ربما تشابه” يمثل إمعانًا في السخرية التي تدعم الاستبدال المعهود للغيبي بالأنسنة الأنثوية. لا يبدو هذا تشابهًا وإنما وجودًا يأخذ محل وجود آخر. مكانُا بديلًا للامكان. زمنًا بديلًا للازمن. هنا إعادة تسمية “الوحدة”. لم تعد وحدة “إلهية”، وإنما وحدة “امرأة ترتدي شالًا أحمر”. وحدة تناسب تحويل الغيب إلى هدف شبقي. تناسب الثأر الذي يقوم عليه هذا التحوّل.
هذه الأنثى التي تعيّن نفسها بديلًا للغيبي يمكنها أن تحمل روح “فرجينيا وولف” أو “مدام بوفاري”، لذلك فاكتسابها سمة الألوهة لا يجعلها “مخلّصة” بالمعنى “الديني” وإنما على العكس تجعلها منتهكة للخلاص، تكمن “أبديتها” في تقويض “النجاة”، في الانفصال عن “الحكمة”، أي خلخلة اللغة التي كان الغيب يستعملها في ترسيخ إكراهاته. لذا نجد عبد الجواد العوفير يستخدم ما يُعرف بـ “قلب المنطق اللغوي” حين يتحدث عن تلك المرأة التي أصبحت بديلًا للغيب “حين أضاجعك / أصعد إلى أسفل”؛ فالألوهة هنا لم تعد “ترفعًا” وإنما انغماسًا في المسار العكسي، المفكك لذلك التعالي المجهول الذي يتسم به المطلق. وكأن أثر هذا الاستبدال يمتد بالضرورة إلى حركة الموجودات امتثالًا للتحوّل الشبقي، فنصبح إزاء “عالم بديل” يستند إلى هذا التخيّل الثأري الذي يستخدمه الشعر تجاه الغيب؛ فنجد مثلًا في قصيدة “في بيتي مدام بوفاري” هذا التلازم بين “الفعل الشهواني” تجاه مدام بوفاري وأداء كائن آخر:
“ها أنت تدخلين بيتي
الذي لم يدخله الأنبياء
منذ أن علقت وردة في روحك العالية،
إذا انحنيت لتقبيل يديك الصغيرتين
ينقر عصفور نافذتي”.
نلاحظ هنا التناغم الذي يلخص الاستبدال: البيت الفارغ من “الخلاص” والمرأة التي أصبحت بديلًا لذلك الخلاص. مدام بوفاري التي أزاحت “الحكمة” والممارسة التي يخلق بها الشاعر أبديته المناقضة. تقبيل يدي مدام بوفاري ونقر العصفور للنافذة. هذا التناغم هو إعادة اختراع ضدية للعالم. إعادة تفسير لعلاقة فرجينيا وولف بالنهر كما في قصيدة “سماء بضفيرتين”:
“أيكون لي شكل الله الآن؟
تقول المرأة وقد غادرها الجسد القديم.
النهر يحب فرجينيا وولف
وقد أحست بذلك
وهي تطوي أوراقها في مكتبها الوحيد”.
كأن الشاعر يبعث فرجينيا وولف مجددًا إلى الحياة وفقًا للألوهة الكامنة في انتحارها. كأنه يسبق لحظة انتحارها بخطوة ليجعلها تكشف العلاقة الحميمية بينها والنهر، والذي حين انتزع منها “جسدها القديم” فإنه قد قام بتطهيرها من “سطوة المطلق”. هذا ما يجعل انتحارها تدميرًا لما أرغمها الغيب أن تكونه، يجعله حصولًا على ولادة جديدة، إلهية، يقتنصها الشاعر؛ فيحوّل فرجينيا وولف إلى “أنسنة أنثوية للموت” تقوم على أشلاء الموت نفسه.
“المرأة التي تكلّم جدارها كل ليلة
هي ذاتها التي تعرف أسرار الغيمة وأحوال النجوم
لكن الجدار لا يعرف شيئًا عن الحنين
الحنين الذي ينبت كعشب سيء”.
هل تمثل هذه الأنسنة الأنثوية توطؤًا مراوغًا من الشاعر مع الجانب الأنثوي المضمر في ذاته؟ التواطؤ الذي يمارس من خلاله تلك الشبقية الانتقامية مع الغيب الذي يكوّن هذه الذات؟ الذكوري يستبدل المطلق بأنثويته المتوارية والتي تجسدها نساء القصائد، ليتمكن من قتله / امتلاكه خياليًا. ربما تلك الكيفية الوحيدة لإدراك “الروح”، لبلوغ التجانس العسير بين الجسد وفنائه.