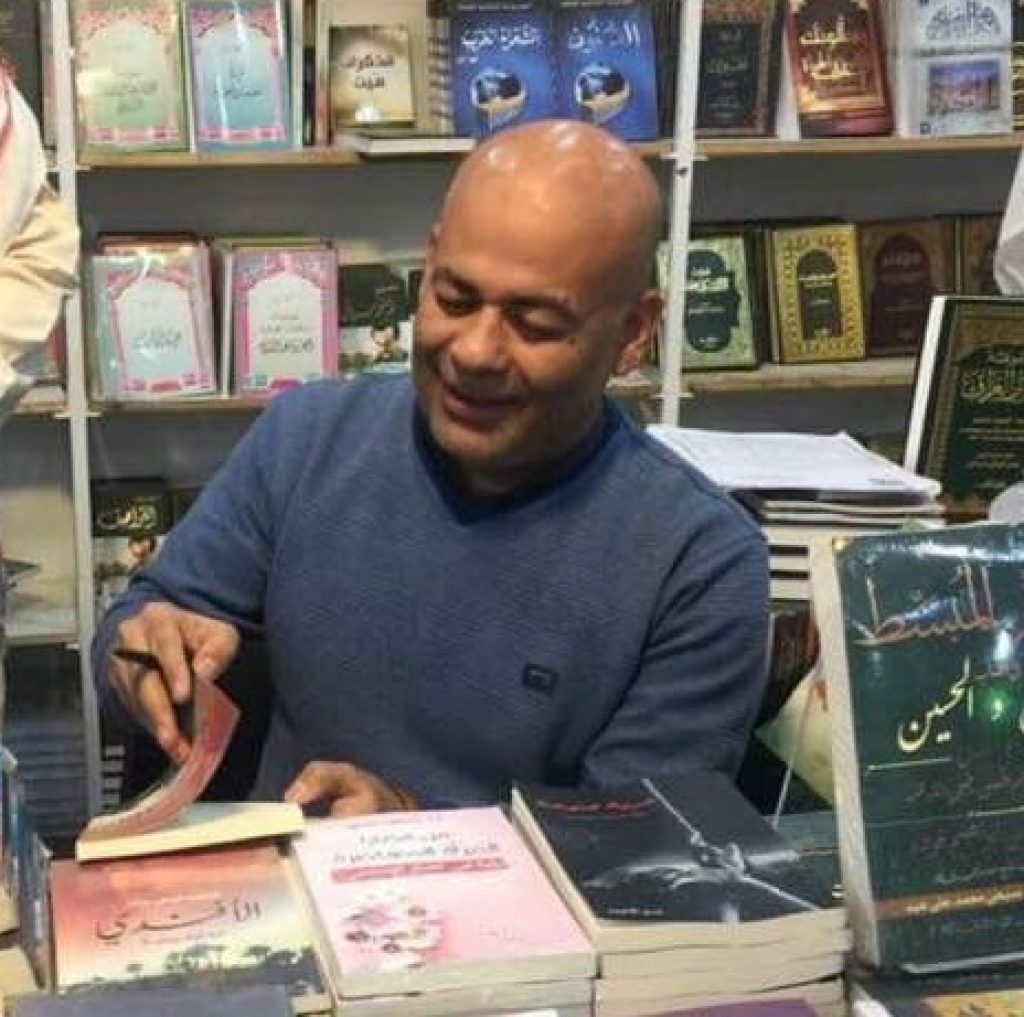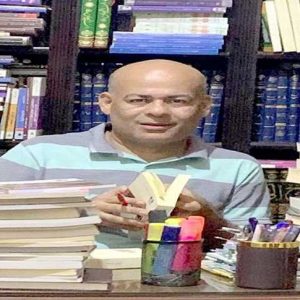محمد فيض خالد
الفواعلي
أخيرا انقضت الامتحانات، وانتهت المُهلة التي اعطيتها نفسي لاستر عَافيتي، والتي كَلفت أمي زوجين من الأرانب، وأربعَ دجاجاتٍ انقطعن عن البيَضِ، عاجلتهن السِّكين قَبل أن يألفن التَّسكع فوقَ أسطحِ الجيران.
ألقيتُ ملابسي ببطنِ حَقيبة يدٍ صغيرة، احتلت على توفيرِ جُنيهاتٍ قلائل استدنتهم من جدتي لأمي لزوم الطريق، لم يتبقى إلا أن يُحدِّد صديقي ربيع موعد السفر، هذه المرة الأولى التي أُغادر فيها قريتي، لوجهٍة جديدة ولحياةٍ مختلفة أجهلها بالمرة، فلطالما تصفَّحت أوراقا من دفترٍ أحوالِ الغُربة، رواها أبناء قريتنا، ولطالما انجذبتُ لما فيها من الحزنِ والفرح الضَّيق والفرج المرض والصحة، حتى معاركهم وبطولات البعض المُلفّقة التي مرحت بحقولِ الخَيالِ انشغلتُ بها.
وجدتُ في تلك العوالم اللَّذة والانجذاب، وجدت فيها بَراحا مُمتدا، وتَحرُّرا من قيودٍ صَارمة، وفِكاكا من مَـألوف، تَحدَّد صباحَ يومٍ صَائف فاتر ملتهب، أحمرّت شمسه موعدا للرَّحَيلِ، مَرَّ ربيع في جِلبابهِ الأزرق وحذائه اللَّميع، انسللت خِلسةً قبل أن يراني أحدٌ، فهذه الرحلة على غيرِ مُرادِ الأهل، خاصةً الوالدة التي تَخشى على صغيرها قسوة الأيام، تقول متُألمة: كسرة الخبز في بيتك أبرك من خروفٍ في بلاد الناس، الغربة تُربة ، ما أشقى الغريب وما أشقى لياليه، في حُجرةٍ متواضعةٍ رُصَّت الفُرش إلى جوارِ الجُدرانِ، امتلأت بأواني الطَّبخ وقناني المياه، ووجوه لوَّحتها الشَّمس، واجهدها التَّعب فنفرت عظامها، وتشعَّثت لحِاها. التهمتُ عشائي الأول في ابتهاجٍ وأنس، ومن بعدهِ دارت كؤوس الشاي معبقة وسط أجواءٍ السَّمرِ والتَّسليِة، انهمك الأصدقاء في لعبهم وكَأنَّ دنياهم خَلت من قسوتها، فلم تعرف غير المرحِ والضَّحكِ الصَّافي.
تَخيَّرت مكانا للرّقادِ اتخذته إلى جوارِ ربيع، اطفئ المصباح الوحيد لتَغوص من بَعدهِ الغُرفة في ظَلامٍ دامس، اختلطت فيه تأوهات الأحلام بأنينِ الآلام، بتصريفِ البطون هكذا حتى انفلق بطن الصباح وصَرخَ جنينه، توسلت للنُّعاسِ فلم يستجب، لكَّنه عَاجلني بغتةً، استغرقت في هدأتهِ زمنا، لم أدر بنفسي إلا ويد ربيع تَهزَّني برفق، تناولنا فطورنا على عَجلٍ وانطلق ثلاثتنا أنا وربيع وابن خالته، قال ربيع مُتهلل الوجه: أنت وجه السعد، لقد تقاولنا على شغل جديد للتشوين ، هَززت رأسي مُؤمِّنا على كلامهِ، وقفنا أمام بناءٍ حديث، صَفقَ صاحبنا فَرِحا وهو يشير ناحية جَبلٍ هائلٍ من الرمال، بادرني بالصِّياح: البوسطا.. البوسطا ، لم افهم معناها، لكننَّي انهمكت معهما في تعَبئِة الأكياس بالرمل وحملها، انتابت ربيع حالة من الهياج، جعل أثنائها يَصرخُ بصوتٍ عالٍ وهو يهرول فوق الدرج: بوسطا..بوسطا ، ظللت على حالتي من الثَّباتِ، إلى أن فسَّر مقصوده، يتوجَّب على ثلاثتنا الانتظام سريعا فوق الدَّرجِ في تَسلسلٍ، يتناول أحدنا الحِِمل عن أخيه حتى يفرغه الأخير وهكذا، لم يكن يومي الأول كأجملِ ما يكون، بلَغَ مني الإعياء مبَلغه وأنا الذي حمل الفأس صبيا، جعلت أنظر من أعلى ألعن جبل الرمل الراسي في استفزاز، انقضي يومي وعدت أجر جسدي المنهك، تناولت العشاء وارتميت على فراشي لا ألوى على شيء، وعند الصباح ايقظني ربيع مُبتسما وهو يقول: لقد ازعجتنا طوال الليل، ظللت تطلق عقيرته بكلمة بوسطا حتى مطلع الفجر، فرَكتُ عينيَّ، اقتربتُ منه هامسا في أذنه: بوسطا ، وغِبنا في ضحكٍة طويلة.
***
حُبٌّ بلا أطراف
ظَلَّ عمره يُكابر، لا يَعترف بَفارقِ السِّنِ بينهما، هو شابٌ يَافعٌ على أعتابِ الجَامعِة، وهي فتاةٌ غَضَّةٌ لم تُوِّدع سنواتها العشر، ابنة عمه ذلَك الرجل الصَّامت الذي قالَ يوما في حَسم ٍعلى مَلأٍ من الأقاربِ: هي له وهو لها لن يُفرقهما إلا الموت، لا يقبل الرجل رأيا ولا يتراجع عن قَرارٍ، يرى ابن أخيه أجدرَ بابنته، لم تجد زوجته العنيدة من حيلةٍ غير الصَّبر، بعد إذ فشلت في التماسِ كُلّ ذريعة تثنيه عن عَزمهِ، كانت تمَطّ بوزها حِينَ رؤيته، ترميه بنَظرةِ تأنيب من عَينٍ حَمئة، مع الأيام صَارت المرأة عقدته الكَؤود، تناوبَ على إرضائها بكلِّ وسيلة، تمنَّى لو يحظى عندها بقبولٍ، بيد أن سَعيه خَابَ وذهبت أمانيه أدراج الرياح، فهي لا تتورع أن تُعلِن رغبتها وتذيعها عن عَمٍد بينَ نساءِ العائلة، أن ابنتها لن تتزوجَ سوى وجيٍها من أبناء عمومتها أصحاب الأفدنة والمال، فمُحال أن تُلقي بهذه الزَّهرة البَّرية لتَحترق مثلها في أفرانِ الفقر.
لم يفقد الأمل ولم يخيب رجائه، أن يجدَ مَأمنه يَوما عند المرأِة العنيدة، أما ابنة عمه فكانت فتاة غريرة لا تَعرفُ من إشاراتِ الُحب شيء، حَتَّى وإن بدت في هيكلِ الجمال النَّاضج، لا يدورُ بخُلدها غيرَ كَلماتِ والدها ترغبها فيه، لحَظتها تَحمرّ وجنتيها، لكن سُرعان ما ينطفئ لهيبهما وهي تَصطدمُ بتعَنيفِ أمها، وترهيبها حَال اقتربت منه، لا يستنكف صاحبنا عن مُلاطفِة فتاته بَينَ حِينٍ وآخر، اقترحَ على عمه أن يستذكرا دروسها سَويا، انفقَ أغلبَ وقته معها، لازمها كظلَّها، شعرت أثنائها بشيءٍ من الانجذابِ وسُرَّت لحديثهِ، لكن رقابة الأم التي فرضتها عليهما، وأختها الصُّغرى التي تُسجِّلُ كمُنكرٍ ونكير تعد عليهما أنفاسهما، قتلت هذه المشاعر وأخمدت جذوتها.
أمَّلَ عمه في الأيام خيرا، أن تُغيِّر الواقع المَشحون، وأن التَّعودَ سيزحزحُ من عِِناد الزوجة، ويُسلمها لأن تَرضخَ، في هَاتهِ الأثناء كَانَ قلب المرأة بركان يَغلي يُوشك أن يَنفجر، مارست معه صنوف الضَّغطِ، تُذكِّرهُ في لحَظاتِ صفوهما ميراثه المَنسي عند أخوتِه، يُلجِمُ حِيلتها بابتسامٍة باردة، يعَقبها بردٍ حَازم: نحنُ لا ينقصنا شيء، هؤلاء فقراء أولى بالإحسان ، مَرَّت الأيامُ كأقسى ما يكون على الفتى، الذي لاَم والده فيه إصراره على المَذلةِ، انقضت سنوات دراسته الجامعية، كانت فتاته قد فارت فورتها، بعدما تَلبَّست بجسِد أثنى مُكتملة الأنوثة، مُستوفية الغواية، انجذبَ لحسنها كلّ خَاطبٍ يُقدِّرُ الحسن ويهوى الجمال.
واظَبَ على مَضضٍ الحُضور لبيتِ عمهِ، استماتَ لأجلِ حُبِه، قَاومَ غطرسة المرأة واستفزازها بَصمتٍ مطبق، كانت تطمينات عمه تبَعث بداخلهِ السَّكينةِ، وانجذابُ الفتاة احيانا التي بدأت تلقاه بَوجهٍ بَاسمٍ وصوت دافئ، لكنَّها حتى الآن لم تُعلن مشاعرها، تراوغه مع سؤاله المُتكرّر: هل تحبينني؟!.
مضت فترة تجنيده، تَغيَّرت المرأة تجاهه، تَودَّدت إليهِ على غَيرِ العَادةِ، كَانَ عمه يَعلم خبيئتها، فكَّرت أن تَستخدمه ليُطالِب بميراثِ عمه، لم تُفلح خطتها، فعادت تنسج مكائدها، مُؤخَّرا تَدهورت صحة عمه انتكست هيئته، وبينَ عَشيةٍ وضُحاها باغته هَازمُ اللَّذات فغيَّبه للأبِد، انتهت أيام الحِداد في ترَقُبٍ، بعدها وجد الأبواب وقد أوصدت دونه، أُذيع أنّ الفتاة خُطِبت لغَريمِ الأمس، تَصدَّع قلبه، استبَد بهِ الشَّوق فَقرَّر زيارتهم ذاتَ عيد، اشترى لها هدية، ساعة ثمينة تلقته بوجٍَه عَابس، بالغت في إهانتِه، قالت مُتعجرفة: لا احتاجها، رُبَّما تَليق بأخرى ، امتَقعَ وجهه وفَارَ دمه، قذَفَ بَهديتِه فتَحطَّمت، انتهت الحكاية مع حطامها المتناثر يملأ المكان، قَرَّر الرَّحيل للأبدِ، بعد عامين اقترنَ بأجملِ فتاة عرفتها القرية، لكنَّ ذَلك الجَمال لم ينسه حُبَّ الأمس واختيار القَدر.
***
ابن النيل
في كَاملِ وجَاهتِه يَفترشُ الرَّصيف، يَعرضُ بضاعته، تُعجبني هَيئته المُرّتبة، بدلة سوداء وقميص ناصع البياض مُنشَّى ياقته، ورابطة عنق حمراء، وفوق جبهته تَصلَّبت نظارته الشمسية، يتَمخطرُ في حذاٍء أسود لامع كمرآةٍ مجلوة، وابتسامة عريضةٍ تَتبدَّى منها أسنانه البيض، تَشعُّ بالفرحِ والثقة، تتَوزَّع نظراته المُشرقة على زبائنِه من طلبةِ المدارس، الذين تَحلَّقوا حول بضاعته ينيشونها، تتَكرر عشرات الأسئلة والطلبات جميعها تسأل عن الحزام الجلد الطبيعي، وعن زجاجةِ المسك الأصلي، و علبة الورنيش البني ، يُغالِبُ في كَمدٍ استفزاز الشباب من حَولهِ بنظرةٍ طويلة، لكنَّها دافئة وحميمية، وعبارة موجزة يختصرُ فيها حديثه: تشتري إيه يا شيخ ، كانت طيبته كافية لأن تُغري به الفلاحين، فتدفعهم دفعا للشراء، بمرورِ الوقت صنعت منهم أصدقاء َفي غاَيةِ اللُّطفِ، وهؤلاء لا يأتون في الغَالبِ إلا أيامَ الخميس حين يُنصب السُّوق، كَان إدريس السوداني يعرف طلباتهم المَخصوصة، يُخرٍج من حقيبةِ جلدٍ صغيرة زجاجات وعلب في أشكالٍ مُريبة، تتَهلّل الوجوه الشَّاحبة بالفرحِ، وتغيم في نشوةٍ وهي تُقلِّبُ الِعلب، نشط هؤلاء فجلبوا غيرهم ليمتلئ الرَّصيف بهم، فأدوية الفحولة ودهانات المفاصل الأكثر رواجا بين هذه الفئة، يشعر إدريس بهؤلاء ويُرحِّبُ بهم في بشاشةٍ، رُبَّما يُذكِّرونه بوالده الَّسبعيني المُتصابي الذي عاَد يُحبُ الحياة من جديدٍ و يراوغها ثانية، يَغيبُ في نجوى معهم، أحاديث مُلفّقة مضحكة، يميل إدريس دائما للغُموضِ، رُبَّما عَلَّمته التَّجارب، و لقَّنته الأسفار والاغتراب عن الديارِ، أن يكون حَذرا بما فيه الكفاية، هي طَبائع أبناء الرَّصيف وضَحايا التّجوال، والرجل َبرَمَ مدن مصر وقراها شمالا وجنوبا، في شَهوةٍ مُبكِرة اندفعتُ مع المشترين، هذا عامي الأول في هذه المدينة الكئيبة، وقروشي لا تَكفي غيرَ أكياسٍ صغيرة من البَخور، أعجبتني خلتطها الغريبة، سألت إدريس عناه قفال بلكنة سودانية: هي من المستكة ولبنان الدكر وعين العفريت انفلتت ضحكة طفولية وأنا اسمع عين العفريت ، توقفتُ سريعا حين بدت جهامته وتَصلَّبَ وجهه، سُرّت أمي لها بعد أن وجدتُ مفعولها الطيب، هَدأت بقرتنا الصفراء التي كانت تُنكِرُ ذكرها ساعة الحَلبِ، انجذبتُ في ارتياحٍ للحَالةِ الناشئة على الرصيف، تُؤنسني حكايات الزبائن الغريبة، وحركة الرواج التي أحدثها في المكان، قبيل انتهاء العام كانت بضاعته مصدر ابتهاج، تَجرأت شئيا فشيئا فمددت يدي بين الأيدي، اقلِّبُ وأفاصل، اظهر ما يُظهره الزبون المُراوغ من تَمكيس أحيانا، مرت سنوات الدراسة الثلاث، انتظره عِند كُلِّ خميسٍ في تَلهُفٍ، لا أجد تفسيرا لوجاهته وأناقة هندامه التي لا تتغيّر، تستفزني طريقته التي حَفظ بها رزانته، وتملكه أعصابه مع بعض المنُفلتين، لم يفكّ شِفرته سوى عمي صالح فراش مدرسة الصَّنايع، يقترب منه في تودد ليذوبا في رطنة طويلة، يُعِّدلُ بعدها إدريس ياقته المُنشَّاة، يَتحسّس بطرفِ أصابعه عُنقه الرفيع، جاء صاحبنا من جنوب السودان إلى مصر، كما جَاء ملايين غيره، قال في حَمأةِ حديثه ذات مرة، إنَّه يسكن قرية فقيرة على أطرافِ الوادي مع أبوين كبيرين، وزوجة مطيعة وأبناء ثلاثة، قَدِم منذ أربعَ سنواتٍ بالتَّمامِ وراء لقُمة العَيشِ، يُرسل بقروشهِ للأسرة تعيش منها، وتدفع أقساط قطعة أرض يزرعونها، يقولُ في اطمئنانٍ بأنَّه مُستريح ٌهنا بين أهله.
خلا الرصيف يوما من إدريس فوجئنا بوافدٍ جديد يشبهه، أسمر البشرة، في نفس مظهره، يتكلم لكنته طيبةٍ معروفة، لم يسأل الناس عن سَببِ رحيل إدريس بقدر انشغالهم بالبضاعةِ الجديدة، وهذا حَال أهل مدينتنا..
***
الكبارة
تدسُّ عمتي وجهي في حجرها عنوة، رويدا رويدا تهدأ أعصابي، يفوح حجر جلبابها الفلاحي الرخيص برائحة محببة، ارفع عقيرتي شاكيا لحظة تحرك أصابعها الخشنة تفرك فروة رأسي، تدمي شعري وتلهب جلدي، فجأة يتسلمني نعاس عميق لا أعرف كم متى من الوقت، أشعر وكأنني اسبح وسط بركة بلا حواف، مملوءة بمزيج لاذع من صنف الرائحة التي تفوح منها، خليط لطيف يدغدغ أعصابي، تضاعف عمتي من فركها، مفزوعا أهب من رقدتي، وقد تناوبت دقات قلبي في سباق محموم، أطالع باب الحجرة المظلمة، اتسمع هدوئها المقلق، لعلها الكبارة ، يتأتى في خاطري كلام عمي الأكبر ليضاعف من مخاوفي: لقد اختطفت صبيا في قرية قريبة ومصت دمه .
ضقت ذرعا بالمكان، وكرهت ذلك الوعاء النحاسي اللعين، تحاشيت النظر إليه حتى بعد مغيب الشمس واختفاء خيوطها، ربما يشتعل مائه في لحظة ما وعندها تحل الكارثة، استسلمت لهذا الوهم السخيف سنين طوال، كثيرا ما اخفت عمتي ضحكاتها، حين تغيب وجهها الأبيض الحنون تحت حرامها القطني الأسود، تتظاهر في استخفاف أنها تتحاشى دخان الكانون، لم يكن أحد ليجرؤ على إخافتي في حضرتها، هي الوحيدة التي تستحضر الكبارة، وهي من تملك صرفها عني حال امتثالي للأمر.
لم أسأل نفسي يوما، لماذا تترصدني الكبارة دون البقية، ألا تجرؤ على تأديب أولئك الذين ملأوا الدرب بالسباب في شجار لا ينتهي، أم تراها أضعف من أن تواجههم؟!، كبرت وكبرت مع وساوسي، حتى وإن تشاغلت بأمور المدرسة، ومشاركتي في أعمال الحقل، أو السباحة في الترعة أغلب ساعات النهار، إلى كان اليوم الموعود، طلبت عمتي أن احمل إليها الوعاء النحاسي بعينه، كان فارغا قد اسند إلى الجدار، مددت يدي في تخاذل، مررت أصابعي ببطء حول حافته، تلاحقت أنفاسي، وتسارعت دقات قلبي، تراجعت قليلا للوراء، ثم هجمت سريعا فأطبقت يدي عليه في استماتة، ملأته بالماء ثم أعدته إلى موضعه، دقائق وتساقط شعاع الشمس من طاقة في الجدار، اهتز وجه الماء، ليرتعش الضوء في دوائر متلاحقة متوهجة ملأت المكان، مددت يدي ناحيتها لتمر بسلام دون أذى، كررت المحاولة مرات كثيرة، في عفوية تعالت ضحكاتي، ومن خلفي ضحكت عمتي وهي تلكزني في كتفي قائلة: ألا تخشى الكبارة يا صغيري؟! لم انطق بكلمة، غادرت مسرعا، ونفسي ممتلئة بنشوة الانتصار.