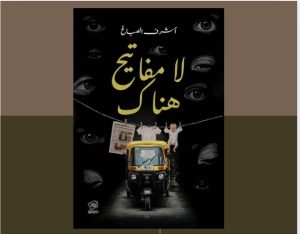أبو اليزيد الشرقاوي
- مدخــل: تمثل الكتابة عن شعراء السبعينيات تحديًّا نقديًّا بسبب اختلاف التجارب وتطورها وعدم ثباتها، وبالتالي يبدو الإمساك بمنطق هذه الكتابات مستعصيًا؛ لأنها “نصوص انطلقت من حرية شاسعة بلا حواجز ولا تابوهات ولا محرمات.. وقد ساعد على ذلك عدم تصميم نماذج ذهنية أو أيديولوجية أو عمومية، وعدم رمي التجارب في حدائق مسيجة، أو وراء قضبان فكرية ونقدية[1]. وقد دفع هذا بعدد من الباحثين لاستجلاء هذه الإشكالية، فجاءت نتائجهم تؤكد المقولة نفسها، وأرجع محمد عبد المطلب هذا لكون تجربتهم الشعرية تقوم على مفاهيم الموقف والأحوال والمقامات ثم اللحظة. ورد محمود أمين العالم ذلك إلى تأثرهم بالفكر الأوروبي، مثل كانط في القول بلا غائية الأدب والفن، وأنهم يشاركون كروتشه في القول بخلو الأدب والفن من أية دلالة اجتماعية أو أخلاقية، ويذهبون – شأن المتشددين من أصحاب الاتجاهات البنيوية- إلى أن العمل الأدبي والفني ليس له من دلالة غير أقنوميته التكوينية الخالقة[2], ووصف عبد السلام المسدي المنتج الشعري السبعيني- مقارنةً بالمنتج الشعري التقليدي – قائلًا: “القصيدة الخليلية بيت مؤثث تام المرافق، جاهز كليًّا لإقامة الزائرين فيه، أما القصيدة الجديدة (قصيدة السبعينيات) فبيت مجهز إلى النصف، على الزائر أن يستكمل بحسب ذوقه ومزاجه، وما يألفه من الحياة، ما تبقى من ضرورات الإقامة ومرافق الاستجمام”[3].
أرجع الباحثون كل ذلك إلى اعتماد الشعراء السبعينيين على مفهوم التجريب، وإحلاله محل التجربة. وفي ورقة بحثية ميز محمد عبد المطلب الفروق بين التجربة والتجريب، لينتهي إلى أن هذا الشعر “تجريب”، ولأن “التجريب الحداثي فعل غائي إجرائي يستهدف التعامل الحر مع مفردات اللغة وإنتاج أبنية إبداعية مغايرة أو ضدية للأبنية السائدة الدالة، والقطيعة معها”[4]، فسيكون ذلك مغايرًا لمفهوم التجربة التي تصدر عن معاناة وخبرة وجدانية باطنية. واعترف شعراء السبعينيات بذلك، فقرر حلمي سالم – على سبيل المثال – أن “التجريب يعني، ضمن ما يعني، ألا شيء مقدس، أو أعلى من متناول الخبرة الشعرية”. وأضاف إن “بعض شعراء الحركة التجريبية المعاصرة يزاول هذا المعنى مزاولة مفرطة”[5].
ومن هنا، تبدو صعوبة الإمساك بخيوط عامة لهذه التجربة الشعرية، التي غيرت وجه الخريطة الشعرية العربية. وثمة ما يشبه الاتفاق – لا أقول الإجماع – على أن غالب شعراء السبعينيات “يصطنع.. تجارب باطنية اصطناعًا كمنطلق لمغامرة اكتشافية لرؤى ومشاعر غير عادية”[6]؛ بقصد الابتكار، الذي رأى فرانسوا ليوتار أنه يتولد دائمًا من الخلاف، و”كلما زادت قوة الحركة زاد ألَّا تلقى الحد الأدنى من الإجماع، وذلك على وجه التحديد؛ لأنها تغير قواعد اللعبة التي استند إليها الإجماع”[7]، وإذا قلنا إن شعراء السبعينيات لديهم “الجرأة على النبش والاقتحام الجمالي لكل مجهول ومحرم ومغلق”[8]، سندرك مدى الصعوبة التي تواجه دارس شعر السبعينيات، حينما يطمح إلى كتابة تاريخ هذه الحقبة الشعرية الأكثر أهمية في تاريخنا الثقافي الحديث.
ورغبة في التحديد والإيجاز، سيكون مدخل دراستي معتمدًا على نقطة وحيدة وهي (الموضوع الشعري)، باعتباره أحد أهم التطورات التي أحدثها شعر السبعينيات، ومنه تفرعت قضايا عدة سنطرق أهمها في حدود المساحة المتاحة لنا، على ضيقها.
- الموضوع الشعري: قديمًا، سار الشعراء وفق قالب بنائي يستوعب كلامهم، استخلصه ابن قتيبة في بيانه الشهير (ليس لمتأخر الشعراء أن يخرج على مذهب المتقدمين، فيقف على منزل عامر…؛ لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافي، وليس له أن يرحل على حمار أو بغل ويصفهما؛ لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير، … كما لا يجوز له أن يقيس على اشتقاقهم فيطلق ما لم يطلقوا… الخ). وظل الشعراء يعيدون صب معانيهم في هذا القالب حتى القرن العشرين، لتبدأ التساؤلات عن جدوى هذه القولبة، لتنتهي بتدميرها والخروج عليها في جدل ثقافي لا يعنينا. والآن يمكن القول – باطمئنان – إن قصيدة رفعت سلَّام (باعتباره نموذجًا على شعراء السبعينيات) لا تسير وفق هذا القالب، ولا تقترب منه، إطلاقًا، ويمكن تلمس أبوتها الشعرية في التراث الأوروبي المعاصر، وبالتحديد في “القصيدة اللغوية التي برزت في الستينيات والسبعينيات في فرنسا.. التي تدفع اللغة كطاقة مجردة ومستقلة إلى الواجهة الأمامية من الاهتمام”[9].
أعتقد أن “غياب الموضوع الشعري” بحسب الالتزام القديم، فيما عرف باسم أغراض الشعر، مثل المديح والهجاء والغزل… الخ، هو أهم ملمح يمكن التماس شعرية سلام من خلاله.
يمكن تخيل شاعر مكتظ بالتجربة الشعرية، ويكتب دون أن تدفعه أفكار سابقة إلى الكتابة عن “موضوعٍ ما”، يكتب هذا الشاعر و”الأغراض” كامنة في لا وعيه، وتظهر في أثناء الكتابة فقط. هذا أهم ملمح أضافه شعراء السبعينيات، ومثَّل خروجًا جادًّا على تجربة شعراء الستينيات، الذين كان “الموضوع” هو الذي يدفعهم للكتابة، فيكتب الشاعر “عنه”، ويمكن استكشاف ذلك من خلال رصد “الموضوع الجوهري” في شعر أمل دنقل أو أبو سنة أو حجازي أو مطر مثلًا، وهذا ما لا يمكن التماسه في شعر سلام؛ فيستحيل الزعم أن الهم السياسي كان محركه للكتابة، كأمل دنقل، أو العاطفية الرومانسية كأبو سنة، أو اغتراب الإنسان المعاصر كحجازي. فمثل هذا التحديد مستحيل إذا مارسناه على تجربة سلام؛ لأنه بكل بساطة “بلا موضوع” شعري مسبق؛ بل كتب الشاعر “خيالات موضوعية” كامنة في لاوعي الشاعر، لم يكن مدركًا لها وقت الكتابة، وبالتأكيد ولا قبل وقت الكتابة. ان القصيدة “خلقت” نفسها هكذا. وقد أشار حلمي سالم بذكاء إلى ذلك في شهادته، فوصف هذا الشعر بأنه يهدف إلى “الدخول إلى الموضوع (إن صح تعبير الموضوع) ليس من أهم ملامحه ولا من جوهره الرئيسي، ولا من أعمق سماته، مثلما كان يحدث من قبل. على العكس: فإن التجربة الجديدة هي ولوج الموضوعات عبر النقاط الثانوية فيها، ومن خلال ملامحها الجانبية، أو ما يسميه البعض: النقاط العمياء”[10]. ويصف ذلك بقوله: يلتقط الشاعر، إذن، موضوعاته من خلال الوقوع على خيط من خيوط النسيج الكبير، ثم هو يتتبعه ويتغور فيه حتى ينجز به نصه. وحينما ينجز نصه المكتمل، سنجد أن الشاعر قد وصل من خلال التفصيلة المعمقة المغورة إلى معنى يتخطى أصل التفصيلة نفسها. هذا المعنى الأعم الأغلب الذي كان يصل إليه الشاعر السابق من خلال “اللوحة الكاملة”. وفي تفصيل رائع لكيف يحدث ذلك، يواصل حلمي سالم مسميًا ذلك بـ”التفصيلية”. وهكذا يتبين- في حركة التجريب- أن مقاربة الموضوع من أطرافه، أو من حوافه (أو قُل من مؤخرته)- والكلام لحلمي سالم – وليس من قلبه أو متنه أو بؤرته، تسمح بالإحاطة الأعم، وبه يتحقق مصداق أعمق له.
يمكن ملاحقة ذلك في ديوان سلام “كأنها نهاية الأرض” الذي تقع نصوصه في مئة صفحة بالضبط. وهي ثلاثة نصوص، فقط: (عراء- فضاء- سؤال). يقع النص الأول في اثنتين وثلاثين صفحة (161 – 193) مقسم على “مقاطع” (يصعب تصديق ذلك، ولكن إن اعتبرنا هذا تقسيمًا إلى مقاطع)، أو فقرات (أو نصوص جزئية تكوِّن نصًّا كبيرًا)، لا يجد قارئ الديوان – إذا فرغ من هذا النص (والديوان كله) – إجابة للسؤال” ما الموضوع؟ “؛ والإجابة: لا موضوع.
هنا يكمن التحدي الأكبر: كيف تكتب شعرًا حول “لا موضوع”، ويظل، بالفعل، شعرًا جيدًا، إن لم نقل ممتازًا؟ والديوان كله لا يمكن القول إلا أنه شعر جيد، قدم “تجربة” شعرية مميزة ورائعة، فكيف يكون ذلك؟
هنا استخدام “جديد” للغة، يستخدم الشاعر لغته كأنها تخلق “عوالم ممكنة”. وكما وصف عبد المقصود عبد الكريم – أحد أقطاب شعراء السبعينيات – هذه الحالة بقوله: “تكمن الشعرية في النص، وليس في المفردة أو الجملة أو الموضوع”[11]. وبعيدًا عن الإحساس بالذات المتضخم، في كلام سلام عن تجربته وجيله، الذين رآهم “ليسوا معنيين بتقديم إجابات على السؤال الذي يطرحه الموضوع، فقد وضعوا أنفسهم فوق السؤال والإجابة معًا، خارج الموضوع كله، وداخل الذات. هكذا يصبح الموضوع مناسبة لتجلي الذات، وإثبات حضورها المتعالي. بعيدًا عن المغالاة، فإن الكلام يمثل وجهًا من وجوه الحقيقة، وهو أن هذا الديوان بلا موضوع، ولكنه لا يكشف عن: لماذا ظل الكلام شعرًا، مع غياب موضوعه؟ كيف ينقذ تجلي الذات، وإثبات حضورها المتعالي، الكلامَ من هوة السقوط في فخ النثرية؟
تبدو المهارة في صياغة النص من خلال التداخل بين النثري والشعري. ففي القصيدة نص شعري من شعر التفعيلة، مكتوب بخط أغمق، وموزع كتابيًّا على الهيئة الطباعية للشعر، وعليه تعليقات كثيرة تتخلل الصفحة من “قصيدة النثر”؛ وبالتالي يمكن الحديث عن “نصين”: قصيدة تفعيلية وقصيدة نثر معًا داخل النص الواحد. يمكن قراءة كل نص على حدة، والمعنى يكتمل (إن كان هناك معنى)، أو يمكن القول إن تواصل المتلقي مع النص يستمر في حال عزل كل نص على حدة، والتعامل معه على أنه نص مستقل، وكذلك في حال قراءتهما معًا. وعلى سبيل المثال المقطع الأول بعنوان تأتي:
تَأتِـي:
مُدَجَّجَةً بِالمَرَاثِي وَالمَوَارِيثِ وَالأُمُومَةِ وَالبَربَرِيِّ الأخِير.
تُرَبِّيهِم فِي الذَّاكِرَةِ، تَرعَى خُطَاهُم فِي جَسَدِهَا أَطرَافَ النَّهَار، تُهَدهِدُ أحلاَمَهُم الوَثَنِيَّةَ آنَاءَ الليلِ، يَنَامُونَ فِيهَا، لاَ تَنَامُ الصَّرخَاتُ وَالمَجَانِيقُ وَالسَّنَابِكُ، الأَسوَارُ مَلغُومَةٌ بِالحُرَّاسِ الشَّاهِرين، نَفِيرٌ ضَالٌّ أم نَفخَةُ صُور، مَن القَادِمُ المُرِيب؟ تُرُوسٌ مَنثُورَةٌ، مَركَبَاتٌ مَكسُورَةٌ، والخُيُولُ- نَافِقَةً- تَعلِكُ الوَقتَ وَالرَّمَاد، أيُّهَا الليلُ اللئِيمُ، مَا حِيلَتِي؟ مِن أينَ يَأتِي الهَدِيل، دُخَانٌ سَامٌّ، أشيَاءٌ مَبقُورَةٌ، مَتَى كَانَت اليَقَظَة؟ أم النُّعَاسُ مَملَكَتِي الشَّاغِرَة؟ نَامُوا إلَى أن يَشبَعَ النَّومُ، سَاهِرَةٌ عَلَى أحلاَمِكُم، أرعَى الطَّعنَاتِ البَائِرَةَ، تَصحُو وَتَغفُو طَوِيلًا،
وَأُغَنِّي غُنوَةً عَتِيقَة
أنَا المَرأةُ الغَرِيقَة
أنَامُ دَهرًا مِن خَرِيـف
وَأصحُو غَابَةً طَلِيقَـة
مُتخَمَةً بِالعَوِيلِ وَالنِّسيَان، مِن أينَ جَاءُوا، مَتَى؟ وَذَلِكَ الزَّوجُ الجَهَنَّمِيُّ، أيُّهَا الغَرِيبُ، مَا أتَى بِكَ بَينَ ثَديَىَّ، فِيَّ، أيُّهَا الغَرِيمُ، جَسَدِي مَملَكَةٌ عَلَى هَاوِيَةٍ، تَدخُلُنِي فَلاَ تَدخُلُنِي، فَمِن أينَ ابتِلاَلِىَ المَوقُوت، كَأنِّي سَرَابُكَ السُّرِّيُّ لاَ تَبلُغُنِي، فَأنحَنِي عَلَى الوَقتِ طِفلِي اليَتِيمِ، يَقطُرُ فِي فَمِي العَزَاءَ وَالسُّدَى
قَطرَةً مِن رَمَـاد
وَ
قَطرَةً غَــدا[*]
يمكن أن نقرأه نصًّا واحدًا، أو نصين، ويمكن اعتبار قصيدة التفعيلة المتن وقصيدة النثر هامشًا عليها، أو تعليقًا، أو تعارضًا، وبذلك يمكن إثراء القراءة. ومهما يكن فإن السؤال المعتمد هو: ما موضوع قصيدة (عراء؟ ).
من الصعوبات التي تواجه قارئ سلام أنه إذا كان قارئًا تقليديًّا يهتم بمعرفة “موضوع” قصيدته، فلن يجد لها “موضوعًا”، وسيجد الشاعر يلجأ إلى التعويض عن الموضوع بصور، وبرغم أنها ليست صورًا موحية دائمًا، وليست واضحة غالبًا، إلا أن القارئ سيجد سلسلة من صور بدل الموضوع، ولأن هذه الصور تبدو غير مترابطة، ومفككة، سيبدو معها أنها مقصودة لذاتها، سيبدو أنها هي “الموضوع” الذي تتخفي وراءه ملكة خيال الشاعر. وهنا فإن “قراءة الصور المجازية في كل من مستوى الجملة ومستوى النص برمته، وفي المجازات الخاصة، وكذلك العامة، ما هي إلا عملية تجريب في العلاقات بين الأجزاء والكليات”[12].
على سبيل المثال، سنقرأ هذا الجزء الطويل نسبيًّا من المقطع الثاني بعنوان:
أنا البربَريُّ الرَّحِيـم
أحمِلُ فِي جُعبَتِي سُلاَلَتِي البَائِــدَة
أحمِلُ فِي سَرِيرَتِي وَردَةً رَاكِــدَة
أحمِلُ فِي دَمِي النُّطفَـةَ الكَاسِـدَة
أُدِيرُ ظَهرِي لِلنَّوَاعِيـرِ النَّاعِقَةِ وَالفُصُـولِ الفَارِقَة، سِهامٌ كَلِيلَـةٌ وَبَصِيرَةٌ قَلِيلَة، أمضِي إلَى مَدَائِنِ اللهِ الصَّاخِبَـة، أُصَلِّي رَكعَتَين استِخَـارَةً، إِلَى الشَّمَالِ الشَّمَـال، أنَا البِدَائِيُّ الجَهُـولُ أقتَرِفُ اللُّغَةَ الصَّعبَةَ، أخطُو عَلَى شَظَايَا جَارِحَـةٍ، أغرِسُ الحُرُوفَ المَسـنُونَةَ فِي لَحمِي، تَشبُّ بَيتًـا وَمَرأةً وَبَنِيـن، زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّنيَـا، سَيَأتُونَ سَيَأتُون بَعدَ ألفِ شَـظِيَّةٍ أُخرَى، وَعُمرٍ مِنَ الرَّمـلِ وَالحُرُوبِ، انتِصَارِي القَادِمُ قَـادِمٌ، أنتِ أنتِ، أيَّتُهَا المُهرَةُ الرَّاكِضَـةُ فِي المُرَاهَقَةِ،
كَامِنٌ مُستَتِرٌ وَرَاءَ البَـالِ، وَرَاءً وَرَاءً،
سَاعَتِي آتِيَـةٌ لاَ رَيبَ حَتَّى مَكمَنِي،
فَاركُضِـي، بَينَنَا حَبـلٌ سُرِّيٌّ وَدَمُ السُّلاَلَةِ البَائِـدَةِ، سَهَوتُ عَنكِ كَي تَكتَمِلِي لِي، تَركُضِيـنَ عَلَى مَاءٍ مُطِيعٍ لاَ يَنثَنِي، عَلَى الحَافَّةِ وَاقِفٌ مَخفُـورًا بِمَا سيجيء، أمُدُّ الحَبلَ، أُرخِيه، لاَ أُفلِتُـه، كَأنِّي غَائِبٌ أو غَيمَةٌ خَارِجَ الدَّائِـرَةِ، مَن يُبصِر الأُنشُوطَةَ وَاللِّجَـامَ، لا سَرجَ، مَن يَرَى مَا سَيَجِـيءُ فِي لَحظَتِي المُبَاغِتَة؟
عَلَى سِنَامِ زَمَـنٍ مُنتَصِبٌ، أرَى مَا أرَى، رِهَـانِي العَشوَائِيُّ زَمَـنٌ دَاجِنٌ يَلقُطَ الحَبَّ مِن يَدِي، فَيَأوِي لِي، أقُولُ: كُن صَهـوَتِي إِلَى صَبوَتِي، كُن رَفِيقِـي فِي طَرِيقِي، فَيَكُون، وَئِيدًا وَئِيـدًا، يَدُسُّ فِي يَدِي خَاتمَه، يُقَلِّدُنِي الصَّولَجَـان
وَردَةٌ سَـودَاء وَعَظمَتَان؛
كُلُّ عَظمَةٍ: بُرهَــان؛
كُلُّ بُرهَان: ضِحكَةٌ آفِلـةٌ
وَامتِحَــان؛
يصعب استكشاف علاقة المقطع الأول وهذا المقطع، إلا بتدخل المتلقي و”اختراع” علاقة مجازية ما. كما أن هذا المقطع، بعنوانه، يمكن قراءة قصيدة التفعيلة، فتعطي معنى ما، مجئ كائن هذه صفته التي توحي بها أبيات القصيدة؛ ولكن هذا المعنى يتفكك بضمه إلى قصيدة النثر التي تتخلل قصيدة التفعيلة. ففي قصيدة النثر جملٌ مستقلة، تم ضمها هكذا: “أدير ظهري للنواعير الناعقة الغارقة(1) / سهام كليلة وبصيرة(2) / أمضي إلى مدائن الله الصاخبة، أصلي ركعتين استخارة(3) / إلى الشمال الشمال(4) / أنا البدائي الجهول أقترف اللغة الصعبة، أخطو على شظايا جارحة(5) / أغرس الحروف المسنونة في لحمي، تشب مرأة وبنين، زينة الحياة الدنيا(6) / سيأتون سيأتون بعد ألف شظية أخرى، وعمر من الرمل والحروب(7) / انتصاري القادم قادم(8) / أنت أنت(9) / أيتها المهرة الراكضة في المراهقة(10) / كامن مستتر وراء البال(12) / ساعتي آتية لا ريب حتى مكمني(13).
معنا (13) جملة شعرية، والترقيم من عندي، تشير كل جملة إلى معنى معجمي، تفقده بانضمامها إلى باقي الجمل؛ لأن هذا المعنى المعجمي يفسد المرجع، وبالتالي يتنازل عنه القارئ بغية البحث عن ارتباط دلالي من نوع آخر؛ وهو الدلالة الإيحائية (وليس المرجعية) للجمل الشعرية. وكأننا أمام موقف فيه “يتحول الوسيط (اللغة) إلى طرف أصيل، وهنا يصبح المستهدف توصيل اللغة ذاتها، فالذي يتكلم في الخطاب الشعري الجمل والتراكيب التي تقدم نفسها مباشرة”[13]. لذلك يغيب الارتباط المعنوي والدلالي بين الجمل، كما في (1و2). والجملة (3) مكونة من جملتين نحويتين بينهما رابط، وهو أن الفاعل واحد (أنا)، لكن ربط (3) بما سبق وما يلي يستحيل وفق القيم الدلالية التي يبثها المعجم في هذه الألفاظ. والجملة (4) تبدو نافرة؛ لأن صلاة الاستخارة لا تتحقق ضرورةً بالاتجاه إلى الشمال الشمال، ولا معنًى لحشر الاتجاه هنا، إذا ربطناه بما سبقه (وهو صلاة الاستخارة). كما أن (4) لا ترتبط مطلقًا بـ(5)، التي يبدو أنها تتحدث عن كتابة قصيدة، وربما تشاركها في ذلك (6)؛ فهاتان هما الجملتان الوحيدتان اللتان يمكن تخيل علاقة منطقية بينهما؛ ولكن سرعان ما تنتهي هذه العلاقة مع (7)، وستبدو لا علاقة لها مع (8و9و10و11و12و13).
باختصار هذه “ألعاب لغوية” قيمتها إشباع متعة خاصة باستخدام اللغة، بعيدًا عن أغراضها النفعية، وهذا هو الذي أشارت إليه سوزان برنار في كتابها الرائج “قصيدة النثر” إذ قالت “سوف يعيد الشعراء تركيب عالم غريب مختلف، سنشعر فيه بالغربة كما لو كنا مسافرين على كوكب آخر، باستخدام المواد الاعتيادية جدًّا، والحقائق اليومية، وكلمات الأيام العادية والأشياء المبتذلة”[14]. وهنا يتحول “الموضوع” إلى ما أصبح يعرف باسم “الرؤى الشعرية”، وكما وصفها حلمي سالم بأن يلج الشاعر معناه من خلال العلاقات غير الملتفت إليها، وليس من خلال العلاقات المعلن عنها والمتفق عليها، أو التي تمثل “جوهر” الموضوع، وبؤرته الأم، كأن هذا الشعر يباشر موضوعاته من الأبواب الخلفية لها، لا من الأبواب الأمامية. وهذه الأبواب الخلفية هي التي تجسد التَّماس الخاص للشاعر، بعيدًا عن التماس العام الذي يشترك فيه الجميع: جميع الناس وجميع الشعراء.
هنا، أيضًا، لا يكون ثمة “موضوع” بل “تشكيل فني”، بعيدًا عن نمطية الشعر القديم القائم على “المحاكاة”، فيستحيل أن تكون هذه القصيدة “انعكاسًا” لواقع، أو حتى إعادة تكوين “لواقع”؛ لأنها ببساطة، هي واقع نفسها؛ إن موضوع قصيدة (عراء) هو قصيدة عراء. ان هذا هو “الخروج الكبير” على الشعرية التقليدية، إذ كان “الغرض” يسبق القصيدة. فأي نص قديم قاله صاحبه في مدح فلان أو هجائه كان هذا الشاعر قد اتخذ قرارًا بالكتابة في “موضوع”، قبل أن يبدأ. وهذا ما استحال إلى ما يمكن أن نطلق عليه أن قصيدة شعر السبعينيات تخلق موضوعها. ان قصيدة “عراء” موضوعها لا يزيد عن استدعاءات لا واعية أملاها العقل الباطن على الشاعر لحظة الكتابة لا قبلها. ومن هنا، تشيع في قصيدة (عراء)- شأن كل شعر السبعينيات، إلماعات صوفية- ميتافيزيقة، بسبب غياب الفكرة المسبقة. وهذه الميتافيزيقية لا تعكس أي موقف ديني مع / أو ضد، ولا تعبر عن ميل صوفي، لكنها تجليات اللاوعي، التي داهمت الشاعر، إذ يكتب قصيدته. كما في هذا المقطع الثاني:
فَانثُر عَلَى سَطحِ المِيَـاهِ طُيُورَكَ الرَّقطَاءَ تَرعَى الزَّبَـدَ الصَّافِي، تَسُوقُ السَّرَاطِينَ إِلَى سِردَابِكَ السِّـرِّيِّ سَاعَةَ الخُسـرِ، رَسُولٌ سَائِغٌ سَاغِبٌ لَه السُّـؤَالُ المُستَحِيلُ وَسَـورَةُ الجَسَدِ الحَسِيرِ، اغْرِس سِهَـامَكَ فِي السَّدِيمِ السَّهلِ سَيسَـبَانًا وَبَانًا يَسلُبُ السَّبِيلَ مِن السَّائِرِين سِـر إِلَى السِّرِّ سَـرِيعًا سَافِرًا لاَ بَأسَ مُستَوفِزًا سَـرَابٌ سَابِغٌ سُؤَالٌ عَسِيرٌ لا تَستَدِر وَاسحَب مِن الأَسفَـارِ سَيفَكَ السَّـامِرِيَّ وَاستَلِبِ السَّـرَابَ إِلَى سِـربٍ مِن النُّسُورِ السَّائِمَةِ تَغسِلُ السَّـرِيرَةَ فِي السَّعِير المَرِيـرِ المُر
(الديوان / ص172)
أن هذا الجزء من القصيدة لايمكن فهمه بعيدًا عن الإلماعات الميتافيزيقة. ان شعرية هذه الأبيات لا تنبع من جمال التعبير، بل من تدفق الرؤية، من خلال انغماس يصل حد اللذة في موسيقا حرف السين، والوصول باللغة إلى أقصى درجات تفجير الدلالة، وعزلها عن محمولاتها المعجمية المتعارف عليها- مؤقتًا- والاستمتاع بها كلغة، في حد ذاتها. ان جمالها كائن في لفظيتها، حروفيتها، صوتيتها (رَسُولٌ سَائِغٌ سَاغِبٌ لَه السُّؤَالُ المُستَحِيلُ وَسَـورَةُ الجَسَدِ الحَسِيرِ، اغْرِس سِهَامَكَ فِي السَّدِيمِ السَّهلِ سَيسَـبَانًا وَبَانًا يَسلُبُ السَّبِيلَ مِن السَّائِرِين سِـر إِلَى السِّرِّ سَرِيعًا سَافِرًا لاَ بَأسَ مُستَوفِزًا سَرَابٌ سَابِغٌ سُؤَالٌ عَسِيرٌ… ) هذه شعرية لا تعتمد على ما تعنيه هذه اللغة، إن جمالها في لغتها، في جرسها، ولأجل ذلك تغيب تمامًا علامات الترقيم، فتستحيل كلها جملةً واحدةً، ليس لها مرجع خارج سياقها. ومن الحكمة ألا يكون لها مرجع؛ إنها تعبر عن تجربة شخصية وذاتية بحتة؛ “ولكن مثل هذه التجربة لا بد أنها كانت من الشدة الإيجابية الكبيرة لتكون الصور مترابطة لا تتطاير شططًا، فلا نرى أجزاء مهشمة في أيدينا، بل قصيدة كاملة”[15].
3 – غياب الذات والموضوع: وباستدعاء المقولات التي تؤسس تاريخ الشعرية العربية، مثل: جدل الذات والموضوع، وكيف أن غلبة الموضوع أفرزت الحقبة الكلاسيكية، وغلبة الذات أفرزت الحقبة الحديثة، مثل الرمزية والرومانسية، فهل تصلح مثل هذه المقولات للكشف عن عالم سلام الشعري؟
إذا نظرنا في القصيدة الثانية في الديوان (فضاء)، التي تقع في (12) صفحة موزعة بطريقة شكلية خاصة، إذ يتم توزيع النص الشعري على أربعة مواقع في الصفحة الواحدة، واحد في أعلى الصفحة يمينًا، ثم يليه واحد في جهة اليسار، وبعده واحد في جهة اليمين، ثم واحد في جهة اليسار؛ وفي هذه الحال ليس هناك ما يجبر القارئ على القراءة العمودية أو الأفقية، فالقراءتان واردتان، كما يمكن اعتبار كل (موقع) نصًّا مستقلًّا، وبذلك يكون لدينا أربعة نصوص أخرى تتوالى في نفس القصيدة، أو يمكن قراءة الصفحة كوحدة واحدة، دون اهتمام بهذا التوزيع، أو يمكن قراءة الأعلى متنًا والأسفل هامشًا. ويمكن بالإبدال استخراج عدة قصائد من النص تتجاور معًا، تنتظر مخيال القارئ ومقدرته على ذلك.
هل هذا زخرف؟ هل هو امتداد لعصر الركود؟ هل يعكس هذا إفلاسًا فنيًّا؟ هذه أسئلة تطرأ على ذهن الباحث، وهو يقلب هذه الاحتمالات التي لا تنتهي. ولكن هذا الإجراء، وفق الشعريات الحديثة، يعكس نمطًا من التحرر (أو الحرية) التي تجعل شعرية النص مفتوحة على احتمالات لا تنتهي. ومن المؤكد أن هذا ليس إفلاسًا قدر ما هو “ابتداع”. ان الزخرف- على عهد الركود- كان يعكس إفلاسًا في أصل الشعرية، جعل المبدع ينصرف إلى الشكل، إلى المظهر؛ أما هنا، فإن هذا الشعر (وهذه رغبة كل شعراء السبعينيات) يؤسس تغييرًا فيما يتعلق بالتفرقة العتيدة: الشكل والمضمون.
إن غياب الموضوع (أو الكتابة بعيدًا عن استباق موضوع مسبق وفكرة جاهزة) معناه غياب الرسالة. ان هذه القصيدة تؤسس شعريتها بعيدًا عن صخب إرسال (مرسلة)، وهذه المرسلة ما هي إلا (المرسلة الشعرية)، المرسلة التي هي الهدف.
أطلق محمد عبد المطلب على مثل هذا الإجراء مصطلح (التأجيلية). فالقصيدة لا توحي ولا تعلن ولا تصرح ولا تبوح، بل تصدر عن عمد إلى ما هو ضد ذلك؛ لأن ذلك هو “جوهر الخطاب الشعري الحداثي الذي يقوم على التأجيلية؛ ذلك أن طبيعته الإبداعية تتنافى مع الوضوح النثري، ومن ثم يعمد إلى التصدي لأي إضاءة وإخضاعها لمنطق العتمة بالتشويش على مجموعة العلاقات الداخلية لتظل في إطار المجهول”[16].
إن عدم “الاتفاق” على “ملامح” القصيدة المكتوبة، وهل هي العمودية أو الأفقية أو المتوالية أو المتداخلة، أكبر عقبة ضد التنوير، وهذا يحتجز القصيدة ضمن (التأجيلية)، فلا تبوح بشعريتها. وعلى سبيل المثال:
1- وَالكَائِنَاتِ الحَامِضَة.
تَغسِلُنِي
مِن نَفسِي.
2- يَدَاهَا
تَكشِفَانِ عَنِّي الغِطَاء،
فَقَلبِي
حَدِيـد.
3- جَسَدِي: تَارِيخ.
وَأعضَائِي: حُقُول.
لاَ مَاءَ يُروِيهَا،
وَلاَ نِسيَـان.
4- جَسَدُهَا حَقلٌ مِن الفِخَاخِ المَنصُوبَة.
أفتَعِلُ النِّسيَان.
أُغمِضُ عَينِي.
أقفِـز.
5- أيُّهَا العُمرُ الذِي مَضَى،
أنتَ غَرِيمِي.
سَرَقتَنِي مِنِّي.
6- أنَا صَبِيُّ الفُصُولِ الأربَعَة.
أكبُرُ فِي جَمِيعِ الاتِّجَاهَات
نَحوَ
جَسَدِك.
7- أعضَائِي: غُصُونٌ مُثقَلَةٌ بِالنُّوَاح.
لاَ غَفوَ يَعرِفُهَا،
وَلاَ صَبَاح.
8- سَيِّدُ اللحَظَات الآفِلَة.
لاَ أُفُولَ لِي.
أعتَلِيـه
إِلَى اللحظَةِ الصَّاهِلَة.
هذا المقتطف يمكن توزيعه على هذا الشكل، مع ملاحظة أن (1و2و3و4) في الصفحة اليمنى، و(5و6و7و8) في الصفحة المقابلة لها يسارًا، وهذه الأرقام من عندي للدراسة:
لنخرج باحتمالات قرائية منه على هذا النحو: (1+5) (2+7) (3+6) (4+8) (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7) (1 – 3 – 5 – 6) (2 – 4 – 7 – 8).
والآن: هل يمكن قراءة ذلك في ضوء (الذات والموضوع)؟ اعترف شعراء السبعينيات باستحالة ذلك. فاقترح حلمي سالم أن شعرية الحركة التجريبية لا تكمن في الشيء المرئي، كما كان يذهب الواقعيون أو الطبيعيون أو التقليديون من دعاة محاكاة الطبيعة أو محاكاة الواقع الخارجي (الموضوع). ولا تكمن في (العين الرائية)، كما كان يذهب الرومانتيكيون، أو دعاة محاكاة الذات أو الداخل. انها تكمن بالضبط في (المسافة) بين العين الرائية والشيء المرئي، أي في (المنظور) الذي يقترحه أو يجترحه الشاعر لكشف موضوعه ومكاشفته”[17]. وهذا الذي حدده حلمي سالم بأنه (المسافة) أو (المنظور)، صاغه سلام بصورة حادة فرأى فيه “تجاهل الموضوع ذاته، وعدم السماح باقترابه من الذات، أو طرح أسئلة عليها، حيث السؤال اجتراء واقتحام، لا يعد إلا بالقلق والتوتر، وانكشاف اليقين المطمئن عن شبكة متواطئة من الأفكار الهشة”[18]. ورآه النقاد حيث “إن طبيعة الذات في شعر الحداثة ذات مراوغة، تستعلي أحيانًا، وتتدنى أحيانًا أخرى، وتميل إلى الانغلاق أحيانًا، والانفتاح أحيانًا أخرى، وتسعى للخلاص أحيانًا، وتستسلم أحيانًا أخرى”، كما يرى محمد عبد المطلب. وإذا كان حضور الذات لا يتحقق إلا بحضور (الموضوع) الشعري بوصفه (محمولها) الذي يحتقب رؤاها، فإن “الموضوع في شعر الحداثة قد أخذ طابعًا معتمًا نتيجة لإظلام المصدر بكل محتوياته المركبة”[19].
لقد غاب اعتقادان شكَّلا جوهر الشعرية القديمة، الأول (مطابقة الكلام لمقتضى الحال)، والقواعد العقلية الصارمة (للموضوع)، والثاني أن الشاعر “إنسان غارق في ذاته، عاجز عن الرؤية الخارجية، قادر على النظر فقط إلى داخل نفسه”[20]. ولا يمكن بحال- أن يكون المقتطف السابق إلا ما هو عليه، دون أن يكون انعكاسًا (لموضوع) أو (ذات)؛ وبذا يمكن الحديث عن “عالم مغلق، كامل عضويًّا”، هو القصيدة. وستبدو تأويلاته بعيدًا عن هذا الوعي مغالطات كما في قراءة محمود أمين العالم الذي بحث عن (الذات والموضوع) بإصرار في هذا الشعر، فرأى فيه “مرحلة جديدة أو انعاطفة جديدة أو تطورًا جديدًا في بنية الشعر البلاغية المجازية والدلالية. وهو في مجمله- رغم اختلاف تجلياته- رفض للسلطة التعبيرية والاجتماعية السائدة وسعي لتجاوزها”[21]. وهذه قراءة مغلوطة لإصرار محمود أمين العالم على البحث عن (الموضوع). وأي قراءة لهذا الشعر لا تؤمن بأنه (بلا موضوع) تنتهي إلى استنتاجات مجحفة. وقد وعى ذلك سلام، فقال: “أية قراءة في قصائد السبعينيين لن تكون بمقدورها الخروج بقوانين وحقائق من أي نوع. ذلك، تحديدًا، ما يحول هذه القصائد إلى “جدار صلب” لا “يثير” كنتيجة لـ”اختراع” دور للقصيدة ليس لها، والتفتيش فيها عما لا تقدمه”[22].
4 – شعرية اللامعنى: ذهب تودوروف في تحليله لديوان الإشراقات لرامبو إلى أن هذه القصائد تهدف إلى اللامعنى. واللامعنى في الواقع هو تحد للعقل والمنطق. لذلك يرى تودوروف أننا لا بد ان نقرأ ديوان الإشراقات على هذا الأساس؛ إنها قصائد لا معنى لها. وقد حرَّر رامبو الشعر من قيود الدلالة، بحيث إنه أفسح الطريق للشعر من بعده أن ينطلق في طَرْق المجهول، ونحن نخشى المجهول في جميع صوره، بما فيها المجهول اللغوي المتمثل في اللامعنى، ونسعى دائمًا إلى إيجاد معنى لكل شيء بل نوغل في هذه العملية التأويلية، ولا نستطيع أن نتقبل اللامحدود واللامحدد[23].
إن تحرير الشعر من قيود الدلالة أصبح مطمح الشعراء، ويمكن الإعجاب بنصوص بلا معنى، وقد توقف أرشيبالد ماكليش في تحليله لقصيدة “إلى النرجس الجبلي” للشاعر “هيريك”، وأعلن صراحة أن “مشكلة القصيدة ليست مشكلة تعقيد في المعنى، بل فراغ ظاهر من المعنى. فإنك إن فصلت أقوال القصيدة عن تلك القصيدة، فلن يكون لديك أكثر من تفاهة الملاحظة بأن الحياة قصيرة”[24]. لكن هذا المعنى (التافه) تتم صياغته في قصيدة جادة، وصف ماكليش هذه الإجراء “باللامعنى الراسخ في المعنى”. ولننظر في هذا المقتطف:
سَكِينَةٌ رَيبٌ فَارِعٍ يَتَسَلَّقُ الفَرَاغَ مُرَاوِدًا مُرَاوِغًا، يَحتَلُّ السَّهوَ وَالنِّسيَانَ فِي السِّرِّ، يَرِثُ الذِّكرَيَاتِ العَتِيقَةَ، تَبلَى، تَتَآكَلُهَا العِثَّةُ فِيالذَّاكِرَةِ المَهجُورَةِ، حَتَّى يَنتَصِبَ عَمُودًا مَاءً يَقسِمُ صَفوَ الأسَن السَّاجِي نِصفَين ألِيفَين، بَينَهُمَا يَمرُقُ سِربُ الأسئِلَةِ السَّائِلَةِ، كَزَيتٍ مَنسِيٍّ فِي رُك نٍمَهجُورٍ، صَوبَ النِّسيَان
كُلُّ سُـؤَال بُهتَان
يَسعَى فِي الأروِقَةِ المُعتِمَةِ عَلَى وَجَلٍ، هَل يَأخُذُ شَكلَ القُنفُذِ، أم أشوَاك ِالسَّنطِ، وَئِيدًا سِرِّيًّا، يَخِزُ الغِفلَةَ، يُوقِظُ مِن نَومٍ، تَنفَجِر ُ الصَّحوَ ةُصَارِخَةً، صَاخِبَةً، دُونَ شَظَايَا أَو بُرهَانٍ، نَحوَ خَوَاءٍ مُلتَصِقٍ بِالأطرَافِ المُرتَخِيَةِ كَالذِّكرَى العَشوَائِيَّةِ، وَقتًا أَو مَقتًا، فَيَنجَلِي عَن هَبَاء
أعيد اقتباس إشارة ماكليش باستبعاد تعقيد المعنى، وأن المشكل في فراغ ظاهر من المعنى. يمكن الجدل حول كيف تمكن الشاعر من ذلك؟ هذه شعرية قصدية تعمد إلى غياب المرجع، وتحرير الدوال من مدلولاتها، مؤقتًا، “وهو ما يشير بدايةً إلى أن الإبداع يريد أن يقول أكثر من الذي قاله أو كتبه؛ لأن هناك صدامًا دائمًا بين حركة الذهن الداخلية، وحركة الصياغة الخارجية، وهو ما يؤدي إلى فقد التوافق والانتظام بينهما. فإذا كان المتلقي يستطيع بلوغ المستوى الذهني الداخلي عن طريق استيعاب المستوى السطحي للصياغة، فإن المستوى الأخير لم يعد كافيًا في تحقيق ذلك، مما يترك المتلقي في منطقة (التخمين) الذي قد يصيب مرةً، ولكنه قد يبتعد عن الصواب مرات. وأعتقد أن تضليل المتلقي على هذا النحو شيء مستهدف من الحداثيين، يمارسونه عن اقتناع كامل؛ لأنهم يكفرون بمبدأ (التوصيل)، ولا يطرحونه كمستهدف شعري بحال من الأحوال”[25].
كيف نتفهم المقتطف السابق؟ ما الذي يقف عليه المتلقي من “سَكِينَةٌ رَيبٌ فَارِعٍ يَتَسَلَّقُ الفَرَاغَ مُرَاوِدًا مُرَاوِغًا، يَحتَلُّ السَّهوَ وَالنِّسيَانَ فِي السِّرِّ، يَرِثُ الذِّكرَيَاتِ العَتِيقَةَ”؟
تعجز كل آليات التلقي التقليدية عن الإمساك (بموضوع أو معنى أو مرجع) لهذه العبارة. تم إلغاء السياق تمامًا، وأصبحت الألفاظ “مرصوفة” وفق رؤى شعرية جمالية، تولد إعتامًا دلاليًّا، يُلجئ المتلقي إلى التأجيل، والبحث عن “عالم ممكن” (عالم النص). وجادل جادامر بأن هذه هي مهمة المؤوِّل الذي لا يتهرب منها. و”يمكن النظر إلى أي عمل أدبي بوصفه إجابة على سؤال ضمني يقع على المؤول أن يفيض في شرحه لكي يحصل على معنى النص”[26]. لكن الإشكالية الكبرى أن الخطاب فرَّغ الألفاظ من دلالاتها، وبالتالي فإن البحث عن مرجع أو إحالة أمر مشكوك فيه. ويمكن الاتكاء على فكرة أن هذا مجاز يعكس عواطف من نوعٍ ما، دون أن نكون قادرين على تحديد هذه العواطف؛ لأن النص مفتوح على عدة احتمالات لا ترقى لليقين.
تُنتِجُ هذه الحالة صراعًا هرمينوطيقيًّا، غير قابل للتوافق؛ وسيكون الدفع بالقارئ حلًّا حتميًّا لإنقاذ النص الشعري، مع الأخذ في الاعتبار بأن التشويش في الشعر يفسده، و”أن بناء المعاني في الشعر قد لا يكون فقط بناءً مشوشًا تنظِّمه العواطف لتجعله حقيقيًّا صادقًا”[27].
في الجملة السابقة، الألفاظ لها معان مرجعية (سكينة – ريب – فارع – الفراغ – السهو – النسيان – السر) … الخ. لا يمكن أن تتخلص من معناها تمامًا، ونحن نقرأ الجملة. ان الذي يحدث أننا نضع هذه المعاني جانبًا، (نؤجلها)، لكن لا ننفيها. ولأن “وجود النصوص يعتمد كليًّا على ما نصنع منها”[28]؛ أي أن وجودها لا يتحقق إلا من خلال القارئ، وهذا الذي انتهى إليه المختصون في جماليات التلقي، إذ ميزوا في النص نصين: النص ببعده الأنطولوجي، وهو النص في ذاته؛ والنص الجمالي عندما يتفاعل مع ذات قارئه، ويتحول إلى نص فردي خاص. ونحن باستمرار نتحدث عن “النص الجمالي”، وليس الأنطولوجي. فالواقع أني “عندما أؤول نصًّا فأنا لا أخرج من جلدي، أو أترك عالمي الخاص خلفي تمامًا. انا بالأحرى أعبِّر عن جوانب في نفسي لكي أفتح عالم الآخر. اي أنني أُسقط فرضيات تعكس افتراضاتي المسبقة، وتجاربي السابقة، والتقاليد التي تعلَّمتها. لكن بينما أنا أطبق فرضيات تجسِّد جوانب من عالمي الخاص، يظهر عالم آخر أمامي، عالم أُدرك آخريته؛ لأن إجراءاتي للفهم لم يسبق لها أن استخدمت بهذه الطريقة قط، ولأني بحاجة دائمًا إلى مراجعتها، بينما أنا أواصل عملي لكي أُبقي تأويلي متحركًا”[29].
ولكي ينجح تأويل هذا المقتطف فنحن بحاجة إلى غرسه في سياقه، وسنجد أن الشاعر يمارس اللعبة المفضلة لديه، وهي جدل قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، حيث تتكون القصيدة (سؤال) من قصيدتين: تفعيلة ونثر؛ بيت أو بيتان (في الغالب) من قصيدة التفعيلة وتعليقات (حواش) عليها. وتظل قصيدة التفعيلة هي المرجع الذي تدور حوله الحواشي. من ثم فلا يمكن إغفال المعنى العام لها، وبالتالي فنحن في اضطرار إلى عزل الجزء الخاص بها حتى هذا المقتطف، وهو:
كُل خُطوة ذُهول
كُل عُضو بَلَـد
زَبَدًا أو بَدَدًا
كُل قَضمة زَلزَلَة
كُل زَلزَلَة قَافِلَة
كُل غُنوة نَشِيج
لَاسلام أو كَلَام
كُل سُؤَال بُهتَان
هذه جمل تم حشدها، وتظل كل جملة منفصلة. تخلو الأبيات من الفعل، أو المتعلقات، كشبه الجملة والمفاعيل أو الصفات… الخ. ويمكن الزعم بأن الفكرة التي تدور حولها الأبيات هي الفوضى، أو تفاهة الحياة مثلًا. ان الدوال هنا ليست إحلالًا لشيء معين، كما هو العادة للاستخدام الطبيعي لها. ان الدوال هنا تُؤخَذ كما هي، في شكلها ووضعها النحوي والصرفي والمعجمي، لا غير. هذا خطاب يشير إلى نفسه. ومن ثم تأتي التعليقات (من قصيدة النثر) تدور في نفس المدار وتكرس نفس الفكرة، فكرة فوضى العالم وفراغه من القيمة. ولا أقدر على ذلك من نص مفرغ من المعنى، نص يدور حول نفسه، لا يقدم إلا ألفاظه، نص (فارغ من المعنى) يعبر عن عالم (فارغ من المعنى). وبالتالي، فإذا قلنا ما معني العبارة التي سبق اقتصاصها من سياقها (سكينة ريب… الخ)، فمعناها هو ألفاظها وأصواتها، وكما نراها. وسيكون الاحتراز الحتمي، كما قال بول ارمسترونج “لا تستطيع أن تشير قراءة واحدة باعتبارها هي الصحيحة، وهو ما يوجب السماح بصراع هرمنيوطيقي أصيل وغير قابل للتوافق”[30].
5 – شعريَّـة الفوضى: رأى كمال أبو ديب أن (التوتر) هو أساس إنتاج الشعرية الجديدة، و”أن قصيدة النثر تخلق مسافة توتر بين عناصرها المختلفة مؤسسة بذلك شعريتها”[31]، وأطلق على هذه الإستراتيجية (بنية التوتر)؛ وهو ما يتقاطع مع ألفاظ أثيرة يتم سردها في الحديث عن هذه الشعرية مثل: التشظي والغياب والاغتراب والجنون والسلطة والعبث والتمرد والتفكيك والتناقض والفوضى. وإذا كانت (الفوضى) مستغربة، يتساءل بوول شاؤول: “الفوضى لم لا؟ ! فنصوص عظيمة انطلقت في فوضاها وفي فوضى العالم والكون والتاريخ، … ، ونظن أن.. التشوش الحسي أو الذهني أو الشعوري، ومن ثم اللغوي، يحمل بنيته الخاصة معه. لكل شيء بنية. حتى اللابنية هي بنية.. فخلف الفوضى حالاتٌ ما، أو أفكارٌ ما، أو مناخاتٌ ما، وبالطبع لغةٌ ما؛ وهذه عوامل كافية كي يكون للفوضى ما يؤازرها من عناصر”[32].
هذا اعتراف بشعرية تكمن خلف هذه “الفوضى”، كما صاغها سلام في الشواهد السابقة. وهذه الشعرية لها “بنية” و”منطق”؛ ولكن بريق الأمل في استنطاق هذه البنية وهذا المنطق مشروطٌ بأن يكون ذلك ضمن القصيدة، التي لا تحيل إلى مرجع، ولا تعكس عالمًا، بل تبني عالمها داخل حدودها. وكل ما سوف نعرفه ونتحصل عليه إنما يكون في القصيدة، وهذه الخبرة التي تمنحنا إياها القصيدة – حتى لو كانت “التوتر أو العبث أو الفوضى”… الخ- فإنها “خبرة” لا يمكن عزلها عن القصيدة، ثم فرزها جانبًا، والحديث عنها مستقلة. “إنها شيء تعنيه القصيدة، شيء يتلاشى عندما تنتهي القصيدة، ولا يمكن استرجاعه إلا بالعودة إلى كلمات الشاعر، لا إلى كلمات الشاعر مستقلة، بل كلماته ضمن القصيدة”[33].
بالعودة إلى “الفكرة” المحتقبة من المقطع، وقد قلنا إنها “فكرة فوضي العالم وفراغه من القيمة”، وهذه “فكرة” سيارة مستهلكة يعرفها القاصي والداني، وهذا ما لا يطعن فيها أو يستهجنها؛ فأنت “في الشعر تحاول حقًّا أن تقول ما كان الجميع يعرفونه من قبل، بحيث “لا يفهمه” أحد. وإذ تنجح في ذلك يصبح ما تقوله مهمًّا.. ولكن تقوله بطريقة لا تجعل الآخرين لا يكتفون بمجرد “فهمه” ووضعه في سجل الذاكرة ليُنسى. بل إنهم في القصيدة يجب أن يشعروا به، وأن يواجهوه ويعيشوه… وذلك بتكثيف العاطفة”[34]. ان “فوضى العالم وفراغه من القيمة” فكرة قديمة متداولة في جميع الثقافات، وصاغها الفكر الديني في قوالب مبدعة، ولكن ذلك لا يطعن في القصيدة. فكما قال مالارميه، فإن الشعر لا يصنع من الأفكار، بل من الكلمات؛ وهو عين ما أكده الجاحظ من قبل بأن “الشعر صياغة، وضربٌ من التصوير”، والمعاني مطروحة في الطريق. هذا معناه أن القصيدة تتكون من إقامة علاقات بين الكلمات كأصوات، وبناء الكلمات كأصوات مقدم على بناء الكلمات كمعان. ونحن لا نلتفت في الشعر- بالدرجة الأولى – إلى ما يتولد عن بناء الكلمات كمعانٍ؛ ولو فعلنا لرفضنا الشعر لأنه “لا يقدم معلومات”.
ينجح سلام في هذا المقتطف، والمقتطفات السابقة؛ لأنه يقدر على أن يحتفظ بما أطلق عليه كيتس: “القدرة السلبية”. ومن خلال هذه الحالة الشعورية، يظل سلام في “حيرة وغموض وشك” عن قصد، ويقيم في هذه المنطقة. انه لا يبحث عن حقائق علمية، ومن ثم يقدم ذلك الوعي المضطرب، وكلما استطاع التعايش مع هذه “القدرة السلبية” نجح في ذلك التكثيف الذي نشعر به في قصائده، معتمدًا في ذلك على بناء الكلمات كأصوات في المقام الأول. ومن ثم نعيد قراءة الجملة “سَكِينَةٌ رَيبٌ فَارِعٍ يَتَسَلَّقُ الفَرَاغَ مُرَاوِدًا مُرَاوِغًا، يَحتَلُّ السَّهوَ وَالنِّسيَانَ فِي السِّرِّ، يَرِثُ الذِّكرَيَاتِ العَتِيقَةَ، تَبلَى، تَتَآكَلُهَا العِثَّةُ فِيالذَّاكِرَةِ المَهجُورَةِ، حَتَّى يَنتَصِبَ عَمُودًا مَاءً يَقسِمُ صَفوَ الأسَن السَّاجِي نِصفَين ألِيفَين، بَينَهُمَا يَمرُقُ سِربُ الأسئِلَةِ السَّائِلَةِ، كَزَيتٍ مَنسِيٍّ فِي رُكنٍمَهجُورٍ، صَوبَ النِّسيَان”، لنقف أمام هذه الألفاظ كأصوات، وسنجد أنها قادرة على نقل “قدرة سلبية” توحي بالعجز والخواء والضعف وفوضى عالم فارغ من معناه. اما إن سألنا عن “بناء الكلمات كمعان”، وانتظرنا معنى (سَكِينَةٌ رَيبٌ فَارِعٍ يَتَسَلَّقُ الفَرَاغَ مُرَاوِدًا مُرَاوِغًا) فسوف تسقط القصيدة بكل تأكيد. ان ما يضم هذه “الفوضى”، ويحافظ على شعريتها، ويمنحها لقب “قصيدة”، هو البناء الشكلي؛ ففيها بداية ووسط ونهاية، وإلا فلن تكون شيئًا كاملًا؛ كما أن لها إيقاعًا، وهو “مجموعة من التعبيرات الصوتية التي لا يلي بعضها بعضًا، بل يؤدي بعضها إلى بعض ويسببه”[35]. كما أن هذه القصيدة محشوة بصور استمدها الشاعر من عالم المكان والزمان، وهذه الصور تطور “موضوع القصيدة” (في الحقيقة تطور لا موضوع القصيدة)، وتجعله يتطور بنسق معين وترابط معين، حيث تتوالد هذه الصور من بعضها، ويشعر القارئ أن الصور تتطور. وإذا أعدنا كتابة نفس الجملة: (سَكِينَةٌ رَيبٌ فَارِعٍ يَتَسَلَّقُ الفَرَاغَ مُرَاوِدًا مُرَاوِغًا)، سيجد القارئ أن الصور “تتكاثر” ذاتيًّا، ولا يعلم بداية الصورة ونهايتها؛ فهل السكينة هي الريب؟ والذي يتسلق الفراغ، مَن؟ أهو السكينة أو الريب؟ وأين تبدأ الصورة (مراودًا) أو تنتهي صورة (يحتل السَّهو)؟ ومَن هذا الذي “ينتصب عمودًا ماءً” ومَن الذي سوف ” يَقسِمُ صَفوَ الأسَن السَّاجِي نِصفَين ألِيفَين”؟ هكذا يشعر القارئ بأن الصور “متوالدة” من ذاتها؛ إنها “موضوع” واحد، وكأن هذه القصيدة سلسلة من التجارب تتداخل حلقاتها. بهذا يمكن الإمساك بالفوضى والتفاعل معها والإحساس بها. وبهذا أيضًا، تتحول الفكرة “التافهة” عن “فوضى العالم وفراغه من القيمة” إلى “موقف”؛ صحيح أنه موقف “غائم”، وينبع من الاستسلام “للقدرة السلبية” التي تفضي إلى “الفوضى”. وهنا “يجادل نورمان هولاند أن كل واحد منا سيجد في العمل الأدبي تلك الأشياء التي يرغب فيها، أو يخشاها، على نحو خاص”[36]. وسوف يؤدي ذلك إلى التناقض، بلا شك، في تقدير هذه “الفوضى السلبية”. وللتدليل سأذكر موقفين متناقضين. رأى حلمي سالم في ذلك إبداعًا، فقال “إنما يخلق الشعراء- والتجريبيون منهم بخاصة- شعرهم لاجتلاء هذا الكون الغني المبهم، وللقبض على هذا التصور في حالة تلبس بين الاكتشاف والهروب”[37]. ورأى فيه أمين العالم، وقد وصفه بطريقة واعية، أنه “عبث”، فقال: “وهكذا يقوم شاعرنا الحداثي بتشكيل عالمه الشعري بغير أية شروط موضوعية. وهكذا يتم التجريب الإبداعي، أو المغامرة الإبداعية، في تشكيلاتها المتحررة من كل سلطة مسبقة، أو أية غاية مستهدفة، أو دلالة محددة، غير الإبداع ذاته. وبهذا يصبح مفهوم الإبداع مرادفًا لمفهوم القطيعة المطلقة لكل ما هو سائد قائم. ولهذا قد نتبين- في كثير من الظواهر الإبداعية الحديثة- ازدواجًا في البنية الإبداعية نفسها، بين تخطيطها العقلاني ولا عقلانية أو انعدام هذه الدلالة. ومن هنا، في تقديري، يبدو الإبداع الحداثي أحيانًا، على درجة عالية من الغموض، ليس الغموض الذي هو طبيعة كل إبداع أدبي أو فني، وإنما الغموض الذي يصل حد الإبهام والعتامة. وقد يبدو أحيانًا أخرى على درجة مبتذلة من النسج العادي لبنيته اللغوية. فالمهم المغامرة المتمردة على ما هو سائد مسيطر، ولكنها أحيانًا، المغامرة العبثية أو العدمية أو اللعب اللفظي الذي لا يكاد يفضي إلى دلالة. وما أكثر الأمثلة”[38]. ويعيدنا هذا التناقض- مرةً أخرى- إلى فكرة الوجود الأنطولوجي للنص والوجود الجمالي له. وفي التأويل نتحدث عن “النص الجمالي”، النص كما رآه القارئ. وسيدعم ذلك أن هذا توجه عالمي في “الشعرية العالمية؛ فلقد تغيرت قواعد اللعبة، وأصبح المنطق غير المقبول هو الأسلوب المقبول اليوم، وأصبح الرديء جيدًا. ولكننا يجب ألا ندين هذا النوع من عدم التنسيق والمنطق غير المقبول دون مقاومة. فقد يكون الشاعر محقًّا في رفضه مجابهة القارئ المثقف في ساحته نفسها، وأن يكرهه إلى دخول ساحة غير المعقول، حيث تنعدم القواعد المتمدنة لتقوي من مقاومته”[1][39]. في هذا السياق الثقافي (الجديد – الحداثي)، فإن التفاعل مع “اللامعنى الراسخ في المعنى” – بتعبير ماكليش – يحتاج إلى “قرَّاء القصيدة الصحيحين”، على حد تعبير فروست.
6 – التكثيف: إيجاز الإيجاز: اعتبرت سوزان برنار الكثافة أحد أهم ثلاثة معالم تقوم عليها قصيدة النثر (التكثيف والمجانية والتوهج). واختلفت ترجمات التكثيف بين الكثافة والإيجاز والتكثيف، لكن ثمة إجماعًا على المعنى، بما يتقاطع مع المصطلح التراثي للإيجاز؛ وإن شئنا المبالغة يمكن الحديث عن “إيجاز الإيجاز”.
سبق أن الديوان يتكون من ثلاث قصائد ويقع في مئة صفحة. وهذا معناه أنها نصوص طويلة، وهي كذلك بلا شك. فمن حيث الشكل، يتشكك الباحث في تحقق الكثافة، إن أخذنا حجم النص معيارًا للكثافة. ولكن: هل الكثافة في الفكرة، أو في التعبير عنها؟ إن كانت الإجابة في التعبير عنها، فهذا ديوان يفتقد الكثافة. وإن كانت في الفكرة، “فيمكن أن نفرق بجلاء بين الإيجاز بوصفه مادة شعورية أو ذهنية وبين الإيجاز بوصفه جزءًا من العملية الشعرية، أي جزءًا من القصد الشعري. اذ يمكن أن نجد عند شاعرٍ ما مادة شعرية مكثفة، ولكن على مدى لغوي متسع، إن لم يكن مفلتًا أو متدفقًا؛ إذ إن ما يطرح: لمن الأولوية في هذه العملية، للمادة أو لمصوغاتها، للحالة أو للغة؟ [40]. ويميل الباحث إلى اعتبار الكثافة في الفكرة لا اللغة.
يتوفّر الديوان[41]على كثافة دلالية على مستوى التركيب والدلالة والإيقاع الناشئ عن الإزاحة، مما يحقق للغة أدبيتها، ويمنحها هويتها الشعرية، وخصائصها الجمالية والتعبيرية، من خلال توسيع الفضاء النصي بواسطة نمط تأليفي نظمي، ينجح في نقل الإحالة من مستوى البنية السطحية إلى مستوى البنية العميقة، بانتهاك المستوى المعياري للغة، وتكثيف بنية دلالية تخلق للنصوص فاعليتها، من خلال توسيع مدى الإحالة المنوطة بالتراكيب، فتنزاح الدلالة المعجمية، تاركةً المجال لدلالة مولَّدة تهدف إلى امتلاك رؤية جديدة، وتحقيق تلاحم نصي وفق منظور جمالي قائم بذاته، غير معتمد على المقولات القديمة. ويتحقق ذلك لغويًّا من خلال انخفاض درجات النحوية والتكثيف المعجمي.
أ- درجات النحوية: يظهر هذا المفهوم منذ 1957، بفضل شومسكي. ورغم مرور كل هذه الأعوام، فالمصطلح ملتبس ومحل خلاف، “لم يتم تحديده، ولو بطريقة جزئية”، وعليه انتقادات كثيرة. والنحوية هي خاصية ما يولده النحو. ويكون الحكم على الكلام بالنحوية أو عدم النحوية متوقفًا على استجابته لحدس المتكلم. ويركز شومسكي على الطابع التقني لمفهوم النحوية، إذ لا يتعلق الأمر هنا بتحريم استعمال الجمل المنحرفة. فالنحوية ليست مفهومًا معياريًّا، بل إنها مفهوم تقني. فالمبادئ التي تسمح بإنتاج اللغة هي نفسها التي تتيح فهمها وتأويلها. فما يعطينا إنتاجًا يعطينا فهمًا؛ لأن ما لا يُفهم لا يمكن أن يُنتَج، والعكس صحيح.
وبفضل جهود كاتز وتطويره لمفهوم شومسكي “درجات النحوية”، استقر الرأي على أن الجمل التي لا تحترم قواعد الإسقاط (إسقاط المعلومات المعجمية في كل من الدلالة والتركيب)، تعتبر جملًا غير نحوية بالمعنى الواسع، بتعبير شومسكي، أو تعد “شبه جملة”، بحسب تعبير كاتز. وهذا النوع من الجمل (أو الملغمات) تمنعها قيود الانتقاء التي تشكل عنصرًا فعالًا في عمل قواعد الإسقاط.
في ضوء مقولات الخطاب النقدي المعاصر، فإن وجود الجمل غير النحوية في القصيدة ليس احتمالًا أو ترفًا، بل هو أمر حتمي. فما يؤسس الشعرية هو عدم نحوية الكلام. ففي اللحظة التي تبرز فيها الوظيفة الشعرية، تلتبس الوظيفة المرجعية للغة. فما يحقق الوظيفة الشعرية هو انتهاك قواعد اللغة، كما ذهب إلى ذلك موكاروفسكي بقوله: “ومن هنا يتضح أن إمكان تحطيم قانون اللغة المعيارية أمرٌ لازم للشعر، وبدونه لن يكون هناك شعر.. وعلى هذا لا ينبغي أن يُعدَّ انحراف اللغة الشعرية عن قانون اللغة المعيارية من قبيل الأخطاء؛ لأن ذلك يعني رفض الشعر”، وهذه هي الوظيفة الشعرية عند جاكوبسون، و”التوصيل الشعري” عند هنريش بليت.
وديوان “كأنها نهاية الأرض” نموذج على عدم النحوية، وهذا جزء من القصيدة الثالثة (سؤال):
مَا الَّذِي يَزحَمُنِي فِي أُنُوثَتِهَا الغَافِلَـة؟
وَردَةٌ
أم
قُنبُلَـة؟
أذَانُ العَصرِ أمِ الفَجرِ؟ لاَ أطرُقُ البَابَ، أرمِي بِكِلمَةِ السِّرِّ يَنفَرِجْ عَن المَملَكَةِ العَادِيَّةِ، فِي الحَمَّامِ: المَلِكَةُ تَصنَعُ شَيئًا مَا لأُنُوثَتِهَا، تَتَخَفَّفُ مِن شَيءٍ مَا، كَي تَفرَغَ لِي، وَرَعِيَّتُهَا تَتَشَبَّثُ بِالنِّسيَانِ وَتَغفُو فِي الأرفُفِ، مِن خِشَبٍ يَتَوَاطَأ: تَارَاس بُولبَا بَيتٌ مِن لَحمٍ النَّاسُ فِي بِلاَدِي وَلِيمَةٌ لأعشَابِ البَحرِ الأبلَه الشَّيطَانُ السَّيِّدُ الرَّئِيسُ المُومِسُ العَميَاءُ وَردَةُ الفَوضَى الجَمِيلَة أزهَارُ الشَّرِّ أعرَاسٌ غَيمَةٌ فِي بَنطَلُون عَشِيقَةُ الضَّابِطِ الفِرِنسِي جُورنِيكَا شَرَف المَجُوسُ وَالسَّحَرَةُ رَغبَةٌ تَحت الدَّردَارِ اللَّذَّةُ الأُولَى مَرثِيَّةُ العُمرِ الجَمِيلِ تَعلِيقٌ عَلَى مَا حَدَثَ فِي الشِّعرِ الجَاهِلِي الفَرقُ بَينَ الفِرَقِ قَنطَرَةُ الَّذِي كَفَر عبد الهادي الجَزَّار مَالِكُ الحَزِين الفَرَاشَةُ ثَورَةُ الشِّعرِ الحَدِيثِ أُنشُودَةُ الشَّبَحِ الفَارِسُ البُرُونزِي كَالِيجُولا أرضٌ لاَ تُنبِتُ الزُّهُور مُدُنُ المِلحِ المِلَلُ وَالنِّحَلُ بِنيَةُ الاستِلاَب مِئَةُ عَامٍ مِنَ العُزلَةِ الشَّمَندُورَة طَرِيقُ الحَرِيرِ شَكَاوَى الفَلاَّحِ الفَصِيحِ الخُبزُ الحَافِي، مَن الهَاتِفُ الدَّاعِي؟ المُقَامِرُ دُونَ شَهَادَة
فَالصَّمتُ أوَّلُ العِبَــادَة
وَالغُبَارُ أوَّلُ الشَّهَــادَة
هذا جزء من جملة شعرية طويلة، ظاهره أنه سؤال وجواب. السؤال (مَا الَّذِي يَزحَمُنِي فِي أُنُوثَتِهَا الغَافِلَة؟ ) وباقي الجزء إجابة على هذا السؤال. لا يمكن- بحال- أن تكون هذه إجابة. كما أن الجمل مفككة بلا رابط معنوي بينها. ومن قوله: “تاراس بولبا” إلى قوله “المقامر دون شهادة”، هذه أسماء كتب تم حشدها هكذا دون رابط معنوي، إلا أن يكون هذا ردًّا على السؤال. قد يكون هذا واردًا، إن كان باقي قصيدة التفعيلة يتحدث عن “امرأة” فاتنة ينقذها من غوايته احتماؤها بالثقافة. لكن هذا ما لا تقوله القصيدة، وتظل بذلك “الجمل” معلقة بلا إسناد، مؤسسةً التشتت المقصود. وهذا هو الذي يوحي بالكثافة. وبرغم أن النص طويل بصورة مفرطة، فالمتلقي يعجز عن تخيل ما تحيل إليه هذه الكتابة؛ لأنها ببساطة تتعمد تغييب المرجع بهذه الصور المهشمة، مما يضفي على الجملة الشعرية مسحة من عدم الوضوح. اطلق محمد عبد المطلب على حالة مماثلة لفظ الإعتام، وقال: “يبدأ الإعتام في هذه الدفقة بتغييب مراجع الضمائر أولًا، ثم عبثية الأفعال ثانيًا، ثم لا معقولية ردود الأفعال ثالثًا”[42]. وهذا موجود في هذا الجزء، فما الذي تحيل إليه الجمل؟ ما المرجع؟ مَن الذي يقوم بهذه الأحداث؟ إن كانت ثمة أحداث، وما العلاقة التي تجعل هذه الجمل في هذا الترتيب؟ كل هذه أسئلة بلا إجابة؟ بما يدفع درجات الكثافة الفنية إلى الارتفاع، وزيادة معدلات الإبهام والغموض الدلالي الناتج عن التشتت. وإذا أضفنا إلى ذلك “الكثافة المعجمية” أمكن الحديث عن:
ب– الكثافة المعجميةLexical Density: في قولنا: “القلم على يمين الكتاب” قسَّم فتجنشتين مفردات العبارة إلى (أ) مفردات شيئية مثل (القلم الكتاب)؛ لأنها تشير إلى شيء في الواقع؛ (ب) ألفاظ علائقية مثل (على يمين)؛ لأنها “ليس لها في الواقع الخارجي شيء تصدق عليه أو تشير إليه، وإنما هي تعبر عن العلاقة التي تربط بين الأشياء”. ويمكن ضم قطاعات عدة من اللغة مثل حروف الجر والمعاني والنواسخ وظروف المكان، وكل الألفاظ المفتقرة إلى المعنى في ذاتها، والتي لا يتضح معناها إلا بوضعها في سياق مع غيرها من الألفاظ الشيئية.
طوَّر السلوكيون فكرة مماثلة ليتوصلوا إلى الكثافة المعجمية، و”المراد بكثافة الجملة المعجمية نسبة الكلمات المعجمية Lexical words إلى الكلمات النحوية Grammatical Words في الجملة؛ وهو مقياس قام على فارق مميز، مقبول بشكل عام، بين الطائفة المفتوحة Open words التي تضم معظم الكلمات في اللغة، والطائفة المغلقة Closed Words التي تضم الكلمات التي لها وظيفة نحوية من جهة، والتي هي محدودة العدد من جهة أخرى، مثل أداة التعريف (الـ)، والأسماء الموصولة (الذي التي اللذان اللتان… الخ). وأجرى بيرفتي Perfetti 1969 تجربة عالج فيها هذا المتغير، أظهرت نتائجها تأثيره في عملية الاستدعاء، حيث تبين أن الجمل الأكثر كثافة (أي الأكثر احتواء على الكلمات المعجمية، وهي التي تعد من الطائفة المفتوحة) أكثر صعوبة؛ ويرجع ذلك إلى أن الكلمات المعجمية أقل، من حيث إمكانية التنبؤ بها من الكلمات النحوية (الطائفة الثانية).
وهذا يعني أن غياب الألفاظ العلائقية (بحسب فتجنشتين) يقلل من استدعاء مرجعية الكلام، وبالتالي يزيد من درجة تكثيف الدلالة وإغماضها. وبقراءة الشاهد الذي معنا، في ضوء هذه المعلومات، يمكن حصر التالي: يحتوي هذا الجزء على (5) حروف عطف، و(15) حرف جر، وأداة استفهام واحد، ولا النافية مرة واحدة، و(13) فعلًا، و(111) اسمًا. وتختفي أسماء الإشارة والنداء وأسماء الزمان والمكان، إلا لفظ (تحت) فقط، الذي يرد مرةً واحدة، وأدوات النصب والنواسخ، مما يجعل التردد العالي لألفاظ (الطائفة المفتوحة)، فيزيد من كثافة الجملة، بتقليل توجيه المعاني إلى متعلقات لها، وبتغييب الجمل أحيانًا في الجزء الخاص بالعناوين. ان غياب (الطائفة المغلقة) هو الذي ولَّد هذه الفجوات التي تعمل على توليد الكثافة المعجمية. وكما قال بول شاؤول إن كثافة القصائد الطويلة “تكمن في سرية العلاقات الداخلية في المتون الشعرية، وفي سرية التواصل، وفي القدرة على الاختزال التفصيلي”[43]، وذلك عن طريق صهر الشعوري فيما هو متخيل، وتعمد الإزاحة، بما يخلخل العلاقات الدلالية المتعارف عليها للجمل، والاعتماد على الجمل غير النحوية.
7 – كتابة الكتابـة: قصائد تحتفي باللا موضوع، وتصنع منه “موضوعًا”، وتدور حول “الفراغ”، وتمتدح الفوضى وتجسدها، معتمدة على التكثيف اللغوي والدلالي معًا، مفككةً عن قصد؛فلا يوجد ما يجبر القارئ على البدء من نقطة محددة في القصيدة، أو حتى الاتفاق على نص واحد، كما في القصيدة الثانية من الديوان، تعيد الكثير من مقولات اللاوعي والوعي السريالي. ومن المؤكد أن شعرية كهذه تستفز قراءها؛ لأنها تبدو دائرة في “كتابة الكتابة”، الكتابة لأجل الكتابة، كتابة “النص”، النص في ذاته ولذاته، عودة إلى “الفن للفن”؛ لكن بصياغات حداثية. لقد أصبحنا “مع الانفجار المجازي الذي أمسى يسود القصيدة الجديدة؛ لأنه حنين إلى الشعرية المفارقة، فتخلخلت الأعراف في تداول اللغة، وانفرج اللحام بين قواعد النظم وتجليات لغة النص؛ فانفسحت الشقة بين الدلالة والتأويل، وانفرط العقد النحوي الذي كان يمسك بأطراف البنية السطحية في الكلام وبنيته العميقة”[44].
أنتج هذا الوضع شعرية مغايرة، لا بد معها من ناقد يؤمن بأن “الفوضى تخلق الشعر”، وهذا الناقد سيرى “أن امتلاك الشعرية لأدواتها الفضائية والتأجيلية والحيادية يعني- بالضرورة- أنها تتجه إلى الأعماق أكثر مما تتجه إلى السطوح، وأنها تعمل على تجاوز النظر إلى المنظور، والبصر إلى المبصر، والعقل إلى الحدس، والنطق إلى القلب”[45]. فإن لم يكن بذلك مؤمنًا، قال: “إن وراء التجريب الحداثي منهجية تغلب الدال على المدلول، في تحديد الإبداع الشعري، وتجعل الأولية له؛ بل تقول أحيانًا على لسان بعض النقاد بأحاديته المطلقة. ويتبعهم في هذا الشعراء الحداثيون. فالشغل- في الدال اللغوي، أو بتعبير آخر، في التشكيل الخارجي أساسًا – هو منطلق الإبداع الحداثي، أو ما بعد الحداثي، تجنبًا للمعاني الكلية والمضامين والأيديولوجيات، والإسقاطات الذاتية. وبهذا تفقد المفردات اللغوية معانيها، وما وراءها من خبرات ثقافية وتاريخية، وتصبح مجرد عناصر في بنية متعددة الإمكانات التشكيلية، وربما خالية تمامًا من المعنى، بل حريصة على اللامعنى أحيانًا، عند البعض”[46].
…………………………….
[1] بول شاؤول، “مقدمة في قصيدة النثر العربية”، 161، مجلة فصول، المجلد السادس عشر، العدد الأول: صيف 1997.
[2]محمود أمين العالم، “أزمة الشعر وأزمة الحضارة”، 24، إبداع، السنة التاسعة، العدد الثالث: مارس 1991.
[3] عبد السلام المسدي، “شعرنا العربي المعاصر والزمن المضاد”، 21، فصول، مج16، ع1: 1997.
[4] حلمي سالم، “التجريب قوس قزح”، 273، فصول، مج16، ع1: 1997.
[5] حلمي سالم، 322.
[6] محمود أمين العالم، “مفهوم التجريب الشعري”، 272، فصول، مج16، ع1: 1997.
[7] بول. ب. أرمسترونج، القراءات المتصارعة: التنوع والمصداقية في التأويل، 228و229، ترجمة وتقديم فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة, 2009.
[8]حلمي سالم، 317.
[9] بول شاؤول، 156.
[10] حلمي سالم، 318.
[11] عبد المقصود عبد الكريم، “الشاعر التجريبي والثقافة”، 145، مجلة ألف، ع11، 1991؛ مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة الأمريكية، القاهرة.
[*]نلتزم، في جميع الاقتباسات المستمدة من الديوان، بتمايز الخطوط والشكل الإخراجي للنصوص، كما ورد في الأصل. [المحرر].
[12]سي دي لويس، الصورة الشعرية، 201، ترجمة أحمد نصيف الجنابي، وآخرين، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 1982.
[13]محمد عبد المطلب، مناورات الشعرية، 89، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1996.
[14] سوزان برنار، قصيدة النثر، 19، ترجمة: زهير مجيد مغامس، هيئة قصورالثقافة، القاهرة، 1996.
[15]سي دي لويس، 149.
[16] محمد عبد المطلب، 23.
[17]حلمي سالم، 320.
[18] رفعت سلام، ببليوجرافيا شعراء السبعينيات في مصر، مع تعليق” 176، مجلة ألف، ع11، 1991.
[19]محمد عبد المطلب، 33.
[20] أرشيبالد ماكليش، الشعر والتجربة، 14، ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي، مراجعة: توفيق صايغ، دار اليقظة العربية، بيروت, 1963.
[21] محمود أمين العالم، “معلقات عفيفي مطر”، 17، إبداع، العدد السادس: يونيو 1991، السنة التاسعة.
[22]رفعت سلام، 179.
[23] فريال جبوري غزول، “شعرية الخبر”، 134، فصول، مج16، ع1: 1997.
[24]أرشيبالد ماكليش، 47.
[26] بول أرمسترونج، 54.
[27] أرشيبالد ماكليش، 45.
[29] السابق، 56.
[30]السابق، 123.
[31] كمال أبوديب، في الشعرية، 172، دار العودة. د. ت.
[32]بول شاؤول، 161.
[33]أرشيبالد ماكليس، 20.
[34]السابق، 48.
[35]سي دي لويس، 39.
[36]بول أرمسترونج، 54.
[37]حلمي سالم، 315.
[38] محمود أمين العالم، “مفهوم التجريب الشعري”، 273، فصول.
[40]بول شاؤول، 154.
[41] ناقشت هذه الفكرة في كتابي:”شعرية غياب المرجع – تفجير اللغة”. وأنا هنا أعتمد على ما قلته هناك، ويمكن مراجعة الفكرة بمراجعها لمن شاء، في صفحة، “92 إلى 98 وما بعدها؛ مطبعة دار غريب، 2015.
[43] بول شاؤول، 155.
[44] عبدالسلام المسدي، 27.
[45] محمد عبدالمطلب، 17.
[46] محمود أمين العالم، “مفهوم التجريب الشعري”، 273، فصول.