ممدوح فرّاج النّابي
يعدُّ المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد ( 1935- 2003)، نموذجًا باذخًا للمثقف العضوي لو استعرنا مفهوم جرامشي، إذْ قدم تمثُّلاً حقيقيًّا للمثقف غير المتعالي والمتشابك مع قضايا الجماهير، دون التقليل من إسهاماته المُتعدِّدة في كافة المجالات؛ النقديّة (وتحديدًا النظرية) وتحليل الخطابات المعرفية التي تناهض الذات؛ لذا تعدُّ سيرته حافلة بصور شتى عن الأنا في تشكلاتها من أجل اكتشاف هويتها ووجودها، فصارت سيرته المترعة مجالاً رحبًا (من قبل الباحثين والتلاميذ والمريدين) لاستحضار شخصيته للوقوف على هذه الأنوات المتعدِّدة المتصارعة.
ومن جانب ثانٍ كانت سيرته نموذجًا خصبًا لما يمكن أن نطلق عليه دراسة “التكوين الفكري لحيوات المفكرين والكتاب”، وهو ما أسهم في تشكيل بني هذه العقليّة، وما صاحبها من تحولات منهجية وفكرية، ولم يبخل علينا إدوارد بكتابة سيرته التي كانت أشبه برواية تجاوزت حدود التصنيف الموضوع على غلافها “مذكرات”، فقدّم واحدة من أروع السير الذاتية التي سعت إلى فضّ تشابكات الأنا مع الآخر، بدءًا من حلّ صراع وتوتر ازدواجية ثنائية اللغة (العربية ا[لأم] – الإنجليزية [لغة الدراسة والاستعمال]) في سبيل البحث عن الهُوية المضطربة (أو المنشطرة) التي عاشها بإحساس اثنينْ داخل شخص واحد، وهو ما تبلُّور في صورة غُربة مزدوجة كان يعيشها، وهي السيرة التي عرفت بـ”خارج المكان” (2000)، والتي كان حريصًا في كتابتها على تجسير “الهوة التي تفصل بين عالمينْ نقيضين؛ عالم البيئة الأصلية (الماضي) والتربية (حاضره)، أو حيرة الأنا – الأنا، فسعيد لازمه إحساس قديم منذ “أنْ رُحّل قسريًّا من بلدته فلسطين، وأقام في مصر بأنّه كان يعد غريبًا في القاهرة لأنه أمريكي، أما بلده الأمريكي فلم يعده أصيلاً فيه”، هذه هي المحنة التي أرقته، وهي ما تجسّدت بشكل عملي عندما رُفض صعوده على رحلة الطائرة في البرتغال، فشعر بالإهانة مع إنه أشهر هويته الأمريكية.
فليس الهدف هنا – كما يُخايل للبعض – هو إعلان القطيعة أو العداء بين ما كان وما هو كائن، أو ما أراده ولم يكن، وإنما الهدف هو إبراز التفاعل الثقافي الذي لمسه الكاتب في هويته التي لم تتشكّل، كما يرى، في صيغة أكثر تناغمًا بين الذاتين المتقاطعتين؛ العربيّة والأمريكيّة. وكان لثراء الشخصية، وعطائها الفكري اللامحدود، أن تعدّدت السّير (الغيريّة) التي كتبها مُقرَّبون منه، أو زملاء عاصروه، لكن تبقى السيرة التي أصدرها تلميذه تُمثي برنن “أماكن الفكر” (الصادرة عن سلسلة عالم المعرفة (عدد 492)، مارس- 2022)، بترجمة محمد عصفور؛ تبقى واحدة من أكثر السير التصاقًا بإدوارد سعيد، بل تكاد تكون بمثابة قراءة غير مباشرة لفكر سعيد، وكذلك تأويل جديد لمذكراته “خارج المكان“، حيث تعامل تمثي معها وكأنّه يعيد قراءة خارج المكان، ولكن عبر مصادرها الأساسية وليس حسب راويها الأصلي، فأهم ما في كتاب تمثي هو أنه يرصد السياقات المختلفة التي تمت فيها كتابات إدوارد سعيد المتعددة، فهو يضعنا في أجواء ثقافيّة حماسيّة وصراعات سياسيّة وفكريّة كانت الخلفية الأساسيّة لانبثاق الأفكار الرئيسيّة لهذه الأطروحات.
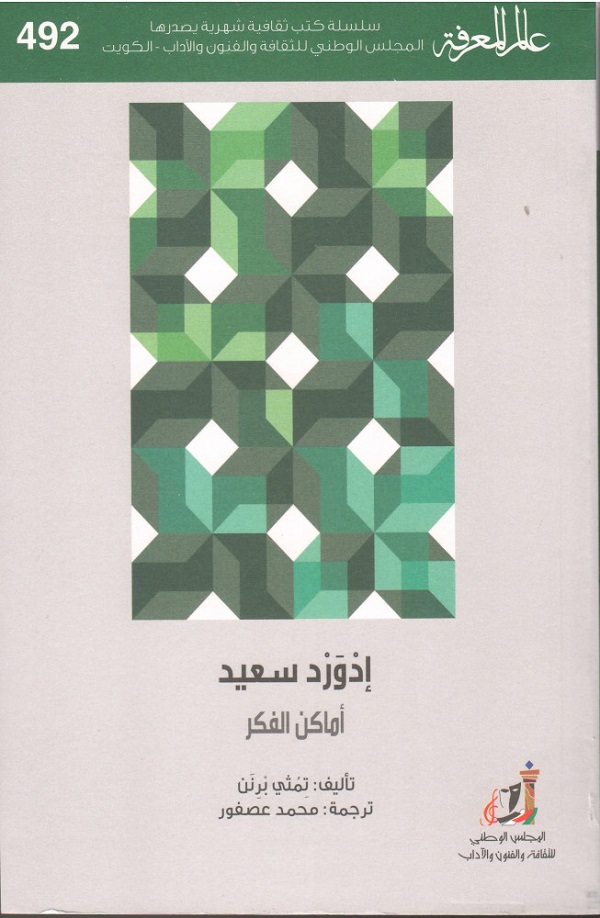
السيرة الدنيويّة
لا جدال أن إدْوَرْد سعيد (حسب الهجاء الجديد الذي ابتغاه مترجم الكتاب) يُعدُّ واحدًا من أهم المفكرين الذين غيّروا نمط التفكير في نص القرن الأخير، وهذا على أكثر من مستوى، أولا على مستوى التنظير النقدي، برقشه النظرية وتتبع ارتحالاتها، وهو ما أسفر عن استحداثه النظرية الطباقيّة في قراءة الأعمال الأدبيّة، أو النقد الدنيويّ، وقبلها بتسليط الضوء على الاستشراق، وتقديم جهد لافت في قراءة المشروعات الاستشراقية وكَشْف أَغْراضِها، وسعيه لتصحيح الصورة المغلوطة التي رسمتها المخيّلة الاستشراقيّةعن الشرق، وثانيًّا بما فعله للقضية الفلسطينيّة، ودفاعه المستميت عنها، سواء بالكتابة عنها أو بشروعه في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينيّة من الاندثار بعمل أرشيف يحتوي على الألاف من الصور الفلسطينية منذ عام 1948، وكذلك بالدفاع عنها في الصحافة الغربية والمحافل الدولية، والتخطيط السياسي وتحمُّله لسهام النقد والهدم التي وجهت إليه من قبل الأصدقاء قبل الأعداء، فظل متمسكًا بالدفاع ضاربًا أروع الأمثلة بنموذج المثقف الفاعل لا المنعزل في برجه العاجي، بصفته -كما يقول تُمثي – “الضمير الاجتماعي في المجتمع، ومشخّص أمراضه، وواضع أجندته”، فأسهم بشكل غير مباشر إلى نقل العلوم الإنسانية من الجامعة إلى مركز الخريطة السياسيّة.
كما تعدّدت الأعمال التي قام بها، والتي جعلت منه نموذجًا للشخصية الكوزوموبوليتانية في رحابتها وتعدّدها وانفتاحها، على نحو ما كانت هويته الحقيقيّة مُتعدِّدة بين ثقافات وعرقيات مختلفة، وإحساس المنفِيّ الذي طارده منذ طفولته، كلّ هذا جعل شخصية سعيد المترعة، ذات تركيبة معقدة بعض الشيء، وفي الوقت ذاته ثرية، إلا أنها صعبة القولبة أو التدجين ووضعها تحت إطار عنوان واحد؛ فهو المناضل المحارب، وهو الناقد الحصيف، وهو صاحب النظرية، وهو الإنساني وهو الموسيقي ، ولك أن تضع ما تشاء من الألقاب التي تتسم مع الشخصية التي هي نتاج عوامل كثيرة، ليس أهمها المنفَى أو الارتحال الذي عبر عنها مرارًا وتكرارًا بمشهد الحقيبة الجاهزة للسفر، في مذكرات خارج المكان.
ثمة جانب غفل عنه كل من قرأوا سعيد عبر كتاباته، فكما يقول تلميذه وكاتب سيرته “تُمثي برنن” لم يروا كلَّ ما فيه: “لم يروا صبيانيته بلا شك مثلما لم يروا ولاءه العميق لأصدقائه وتسامح هؤلاء مع قدر من السلوك السيء: الاعتداد بالنفس، والنزق الذي يظهر أحيانًا، والحاجة المستمرة إلى الحب والدعم المعنوي”، هذه الصورة المـُقرّبة التي يقدّمها كاتب السيرة الغيرية، تكاد تكون مُبْعَدة أو مقصاة أثناء كتابة السيرة الذاتيّة، فصاحب السيرة الذاتية مهما ادّعى قول الصدق وفقًا للميثاق السيري، إلا أنّ ثمة عوامل عديدة تحول دون تحقيق الصدق الخالص، وأهمها عامل الاختيار والانتقاء، فمثلاً إدوارد سعيد لن يُحدِّثنا عن نزق طفولته في خارج المكان، أو عن أنانيته بأن يذهب إلى حفل موسيقي ويترك ابنه المريض، بل كل ما يركز عليه هو التكوين الاجتماعي وكيف تشكّل فكره وصراعه بين الهوية (المضطربة على حد وصفه) والانتماء إلى الوطن خاصة في ظلّ التمييز الذي لاحقه وهو في المدرسة، كان جهد إدوارد سعيد في مذكراته هو الوصول إلى هدنة بالذات المرتحلة مكانيًا وثقافيًّا وعرقيًّا، ووضعية هذه الذات في خضم صراعات مُتعدّدة، لا تقف عند الصراع الكبير: صراع الشرق الغرب، أو صراع المركز الهامش، وإنما صراع اللغة العربية الإنجليزية.
فلئن كانت سيرة إدوارد التي كتبها بنفسه “خارج المكان“، هي سيرة – في مجملها – توفيقيّة بين الهويات المتصارعة على مستوى الأنوات والأمكنة والثقافات واللّغات؛ فإن السيرة الغيريّة (إذا استعملنا المصطلح العلمي الدقيق) “أماكن الفكر” التي كتبها تلميذه “تمثي برنن” هي السيرة الذاتيّة الكاملة، أو الأقرب إلي الكمال؛ فهي سيرة عن إدوارد سعيد الإنسان والمفكّر والمناضل، صورة جامعة وشاملة لنواحٍ عديدة من حياته الشخصيّة، وطفولته وعلاقاته بأفراد أسرته المتوتّرة، وعلاقاته بأصدقائه، في غضبه ومزاحه، حياته البوهيميّة وهو يتسكع لمشاهدة الأفلام السينمائية، وعن إخفاقات الزواج، وعن العمل وأصدقاء العمل، عن المنهج والبحث عنه؛ عن سعيد في طبيعته وهو يلحٌّ على أصدقائه لشراء ملابسه وأحذيته، وعن طعامه، وهواياته، بالأحرى هي سيرة عن سعيد الإنسان الأرضي، بعيدًا عن حيل التفاوض التي استخدمها سعيد ليصل إلى هذا الإنسان المزيج بين أناتيْن متناقضتين؛ الأنا العربيّة والأنا الأمريكيّة، أو العائش بين عالميْن غير مريحيْن – بتعبير زوجته (الأولى) مايرة – في رحلة استعادة الطفولة وأماكن النشأة والتكوين؛ أي صورته التي جعلته أيقونة بالمعنى الحرفي للكلمة، وأن يبقى دائمًا في عالم الأفكار وعلى استمراريته بعد التغيرات التي تَحْدُث مع تعاقب الأجيال، كما شهد له أعداؤه من أمثال “جواشوا مورافجك”.
كتاب أماكن الفكر، يرسم صورة لإدوارد سعيد الدنيوي إن استعرنا مصطلحه عن النقد الدنيوي، حيث يرسم “صورة كاملة لشخصيته العربية والأمريكية وهما تتحدان”، بل هو كتاب تأويلي، على أكثر من مستوى؛ فهو تفسير لصراعات الهويات والشخصيّة المضطربة في “خارج المكان”، وتفسير لحيرة الأنا (العربية) – الأنا (الأمريكية)، وأيضًا يمكن اعتباره –من جهة ثالثة – تفسيرًا لـ”كتابات سعيد عن فلسطين والموسيقى، ومفكري المجتمع، والأدب، ووسائل الإعلام”، والأهم تفسير الدور الذي لعبته الأم في تشكيل وعي الطفل، باعتبارها الحاضنة التي نهل منها من كل شيء بما فيها انتماءاتها السياسية، وهي تتحدث عن القومية العربية، أو حتى باعتبارها قاعدة بيانات للذاكرة الفلسطينية، وحفظها لبيانات ضخمة عمن غادر فلسطين ومتى في حرب 1948.
تحضر سيرة خارج المكان (إلى جانب كتابات سعيد النقدية والفكرية) داخل المتن هنا. فالراوي السارد يحكي عن انزعاج إخوة إدوارد من الصورة التي رسمها سعيد لأبيهم في سيرته. فعلى عكس الصورة التي رسمها سعيد للأب وصوّره بأنّه أب قاس متصلِّبٌ وجاهل في الأمور العاطفيّة، بدا لهن الأب “هادئًا رقيقًا عاملهن بالحب والعطف، وأنّه حمل “جين” (أخت سعيد) في حضنه طول الليل عندما أصيبت بالمرض، وغنّى لها، ولا عبها بالحيل السّحرية”. الصورة النقيضة التي رسمتها الأخوات للأب(في أماكن الفكر) تكشف حالة الذات المتوترة التي كان عليها إدوارد في كتابته لسيرته، وبمعنى أدق تكشف عن الهُوّة التي كانت بين الأب والابن، لا على مستوى المكان، فالابن أرسله الأب إلى مدارس داخليّة، ثم أرسله إلى أمريكا، وإنما على مستوى العلاقات العاطفية، وتحديدًا علاقته المؤلمة مع الأب المتسلّط؛ فقد نشأ بينهما جدار عاطفي، لم يكسر حواجزه إلا مرض أبيه، على عكس البنات اللاتي حكين صورة تكشف عن القُرب العاطفي، فالحضن في حدّ ذاته أكبر دليل على الدعم المعنوي، وهو ما كان يفتقده إدوارد، وهو ما رسخ عنده حب العزلة، والهروب من أصدقائه في كلية فكتوريا.
ومن ثمّ من الضروري قراءة الكتابين في مواجهة معًا لمن يُريد أنْ يفكَّ الاشتباك بين ذات سعيد المضطربة في “خارج المكان“، وذات سعيد المطمئنة الهادئة في “أماكن الفكر“، ففي الكتاب الثاني “أماكن الفكر” تحليلات لما كان مرّ عليه سعيد في مذكراته دون تبرير أو تعليل؛ فيردُّ العزلة إلى الالتصاق الشديد بالبيانو، وإن كان خلق عزلة على مستوى سعيد، فإنه -في المقابل – كان وسيلة انتماء لأفراد العائلة، فالأطفال الخمسة كانوا يعزفون لمدة طويلة، وأيضًا كانت الموسيقى إلى جانب القراءة هي المصدر الرئيسي لانضباطه الفكري والخيالي. وأول نظرية يستقصيها قبل أن تهيمن عليه الفلسفة.
أهمية قراءة تمثي لسيرة إدوارد سعيد (الذاتيّة والفكريّة) إذا اعتبرنا أنه ما كتبه هو قراءة طباقيّة بالمعنى الذي قصده إدوارد سعيد (والتي استوحاها من التوزيع الموسيقي الهارموني)؛ أي قراءة النص وفي الوقت نفسه قراءة النصوص الأخرى التي تتداخل معه؛ إننا يمكننا قراءة ما كتب في ضوء التاريخانية الجديدة، أي الجمع بين السيرة الذاتيّة الشخصيّة لإدوارد سعيد في ضوء الوثائق والمقابلات التي قام بها “تمثي برنن”، والسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي نشأ فيه” سعيد”، وبالتالي قراءة واقعينْ بكل تمظهراتهما الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، يتمحوران بين هُنا وهناك، وما كشفه من تفاعل مؤثّر بين الذاتي والعام، فسيرة إدوارد (الذاتية والفكرية والعملية) هي نتاج لسياقات عصره بكل تحولاته وتمظهراته.
يتتبع تمثي برنن في كتابته للسيرة زمنًا كرونولجيًّا، يبدأ بتتبُع مسيرة هذه السيرة منذ الطفولة، مرورًا بالمراحل المختلفة، بما فيها الحياة الجنسيّة بعيدًا عن مراقبة الأم، وفي تتبعه لهذه الآلية، يتوقف عند المواقف التي تكشف شخصية سعيد، فنراه يقف عند علاقاته الشخصية بأفراد أسرته، ونظرة أخواته البنات له، وتعامله هو داخل البيت، في الفصل الأول الذي جاء بعنوان “الشرنقة” يتحدث عن طفولة سعيدة والحادثة التي تعرضت لها الأم بفقدانها ابنها الأكبر من إدوارد، وخشية الأسرة أن تتكرّر مأساة فقد الطفل، فقرّرتْ أن تعود إلى فلسطين، وبدلاً من الاعتماد على دكتور تمّ الاعتماد على قابلة في تناقض للحالة الأولى، وتناقض لوضعية الأسرة الاجتماعي والاقتصادي، التي كان الأب عمودها الأساسي في عيد الشكران يتناول ديك رومي. فيسهب السارد في توضيح النمط الحياتي الذي عاشته أسرة سعيد، وانعكاسات ذلك عليه، بما فيها من محاولات الأسرة إبعاده عن السياسة، إلا أن تأثيرات أفراد العائلة تسربت إلى عالمه المثالي، ومهّدت ليقظة سياسية، كحب العمل التطوعي مثلاً .
الخروج من الشرنقة
الشيء المهم في سرده لهذه الرحلة الطفولية التي كانت بمثابة الخروج من الشرنقة، لما اقتضته من عوامل بيداغوجية أسهمت في صقل وعيه وتشكيله؛ أنها توقفت عند مفاصل أساسيّة في تكوينه، وكانتْ فِعلاً بمثابة الضوء أو البصيرة للكثير من التحولات في شخصية إدوارد سعيد، فسيرة أماكن الفكر، يمكن اعتبارها بصورة أخرى سيرة الإجابة عن سؤال لماذا في حياة سعيد وتركيبته، ومواقفه النقدية والسياسية وأيضًا مواقفه الأخلاقية التي حتّمها وضعه كمنظّر نقدي سعى إلى توسعة النقد إلى ما بعد الأدب الإبداعي، وموقفه من الدين، الذي لا يتعارض مع كونه علمانيًّا؟ فالدين في رأيه “مسألة اختيار وإيمان“.
وأيضًا إجابة عن: لماذا (كمفكر) اهتمّ بقضايا الإنسان المهمَّش، والهجنة والجندر، والتابع والمستعمِر، وغيرها من قضايا طرحتها الدراسات الكولونياليّة؟ ومن هنا أبرزت السيرة إجابات عن تحولاته النقدية واشتغالاته الفكرية، وتبلور علاقته بالسياسة التي جاءت على استحياء في بادئ الأمر، ثمّ تطورت بعد أحداث الأعوام الشداد الخمسة بأن انخرط فيها بقوة محطمًا الخيط الحذر الذي رسمته العائلة له في هذا الشأن، ثم علاقاته بإقبال أحمد وإعجاز أحمد الهنديين، وفانون وغيرهم من رجال فكر كانوا يناضلون من أجل أوطانهم؟ وكيف تبدلت نظرته للواقع في خطابه وأولويات اهتماماته؟ وكأننا أمام صحوة أدخلته في معترك الأنا الجمعيّة، ومن ثم لم يتوانَ عن جلد ذاته، وهو ما صاغه في مقالة “صورة العربي”.
حالة الاضطراب أو عدم الانضباط (بتعبير أبيه) التي كان عليها إدوارد وهو في القاهرة، لازمته وهو في أمريكا، وصارت توصف بعدم الاستقرار، على الرغم من حصوله على الجنسيّة الأمريكيّة، فالصراع بين الأنا (هنا)، والأنا (هناك) بدأ يزيد، وهو ما تبلوّر بصورة جليّة في “خارج المكان” رغم إن سعيدًا في بعض الأحيان كان يشير إلى الانتماء إلى الهُناك / أمريكا، في تأكيد لحالة الانغماس والاندماج مع الذات الجديدة.
ومع هذا فتكشف السيرة في أحد جوانبها عن توتر نظرة سعيد للآخر – أمريكا، بوصفه مواطنًا عربيًّا تارة، ومواطنًا أمريكيًّا تارّة ثانيّة، وهذه النظرة تتصل برؤيته للاستشراق كما في كتابه المهم. فسعيد طيلة تواجده في أمريكا، كان في رحلة بحث عن هذا الآخر المندمج معه بحكم الهُوية وبحكم الثقافة وبحكم اللغة التي صارت هي المهيمنة على كتاباته، فعلاقة عدم الاستقرار التي وسمت مرحلته الأولى أثناء الدراسة، كانت تعكس صورة النظرة العدائية ضده، بوصفه مواطنًا من الشرق، وقد تجلّى هذا في عدم حصوله على ترقيات داخل المدرسة وكذلك تخطيه في تمثيل المدرسة في أدوار مهمة، كأنْ يُلقي كلمة الخريجين وهو الحاصل على تقديرات تؤهله لهذا. أيضًا عبر علاقته بأصدقائه الذين درسوا معه في المدرسة أو مَن التحقوا معه بجامعة برنستن. ثم جاءت مرحلة المناضل في دفاعه عن القضية الفلسطينيّة من إحساسه مع امتلاكه الجنسيّة الأمريكية، وأنّ ذاته هي ذاتهم، إلا أن ثمة إبعادًا أخرى وفوقيّة، ونظرة دونيّة، جعلته أكثر إصرارًا على الدفاع عن القضية.
لم يكتب تُمثي سيرة غيرية لإدوارد سعيد، بل على العكس تمامًا كتب سيرة أشبه بالذاتيّة، معتمدًا على الوثائق التي خصته بها أسرة سعيد، إضافة إلى شهادات المقربين منه، وما يُقرّب السيرة الجديدة من السيرة الذاتية لا الغيرية (حسب ظني الذي قد يخالفني فيه الكثيرون) أن تمثي لم يكن خارجًا عن السيرة أي مجرد راوٍ أو منظم للوقائع، وإنما كان محللاً لشخصية إدوارد من جانب ومن جانب ثان قدّم قراءة موزاية لأفكار سعيد ومشاريعه الفكرية، لكنها ليست قراءة منفصلة، وإنما قراءة مرتبة ومنظمة في ظل سياقات إنتاجها وما لازمها في صخب وجدل معرفيين، ولأول مرة نكتشف أن كتاب الاستشراق أولاً كان استجابة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973ـ كما أنه كان مشروعًا ثنائيًا بينه وبين تشومسكي لأنه انتهى الحال ليكتبه سعيد وحده.
تُمثي وهو يستعيد سيرة إدوارد سعيد يتبع منهجًا مختلفًا في كتابة السيرة الغيرية أو الذاتية، فهو لا يتوقف فقط عند المعلومات الشخصية، ومصادرها الأساسيّة التي تكون في الغالب من الأقارب من الدرجة الأولى، أو حتى الأصدقاء (يضع قائمة بأسماء من قابلهم وتاريخ المقابلة ومكانها في نهاية الكتاب)، وإنما يلجأ إلى نصوص سعيد النقدية وكتاباته المختلفة، فنراه دائم المراوحة بين ما يُقال عن سعيد وما رواه سعيد بنفسه في خارج المكان، وما عبر عنه نقديًّا في كتاباته (النقديّة والفكريّة والذاتيّة)، كما يلجأ لتحليل هذه المعلومات بمقاربتها بمصادر أخرى تتمثّل في كتابات ومرويات أدبيّة مختلفة، فتترد أفكار ألبرت حوراني وصادق جلال العظمة وشارل مالك، وعبد الله العروي، ومقدمة ابن خلدون، وشتراوس ولوسيان جولد مان، وفوكو، وتشومسكي وغيرهم.
كما يلجأ إلى الأعمال الروائية، فمثلا في حديثه عن الطابع الذي تميّزت به القاهرة باعتبارها مدينة حديثة، كان لها بالغ التأثير في تكوين سعيد الفكريّ، يلجأ إلى روايتي “بين القصرين وزقاق المدق” لنجيب محفوظ، للتأكيد على حداثة المدينة وما تتمتُّع به من طابع علماني، حيث “الخليط المربك من الأقليات الدينية” وما يعكسه من تقسيم جذري للقضاء القاهري، بل لا يكتفي بما هو تمثيل ظاهر في مرويتي محفوظ، فيذهب إلى التدليل من سيرة محفوظ نفسه، ورواياته، فيقول” فإنه صوّر بصدق مسارًا جسّده هو نفسه، فتنقل في رواياته (وفي حياته) بين القسم المزدحم المأهول بالطبقة العاملة المسلمة من مدينة الجمالية، القديمة إلى ضاحية العباسية الداخلية ذات الطراز الأوروبي”. وإن كان يعود سعيد لنجيب محفوظ ويقارنه بالجيل الأحدث، الذي يعتبرهم الأفضل، في رأي مخالف لكتاباته الرسمية.
فالسارد وهو يصوغ السيرة من منظور غيري، لا يأخذ كلام سعيد وكأنه مسلّم به، بل يعمد إلى مطابقته بالواقع، فمثلاً عندما يتحدث سعيد عن مدرسة “ماونت هيرمن” التي ألحقه بها أبوه كي تعيد له الانضباط الديني، يصفها سعيد بأنها “تكتم الأنفاس“، ولكن تُمثي يُعقّب بناءً على مشاهدة أو معاينة للمدرسة بأن “الأدلة المتوفرة لا تؤيد ذلك الوصف”، يتكرّر هذا عندما يسرد إدوارد أنه طُرد من كلية فكتوريا، فيصحح ثمتي المعلومة ويقول: “إن الأمر ليس صحيحًا من الناحية الإجرائية، وإنما هو فصل لمدة أسبوعين بسبب مجادلة مع مُعلّم”. وأحيانًا تبدو السيرة أشبه بمراجعة لأقوال سعيد، وانتقادات التلميذ لأستاذه في بعض مواقفه، ومن هذا موقفه من مؤتمر باندونج الذي تجاهله سعيد في مقالته عن عبد الناصر وأزمة السويس. وأحيانًا يأخذ السارد دورَ المفسر لما كتبه في مذكراته (خارج المكان)، فيبرّر مثلاً سخريته من شارل مالك أحد المؤثرين الفكريين في تكوين وعي سعيد. ونراه يستنكر من تصريح سعيد بما صرّح به في مذكراته عن علاقته بهايدجر، وقال من الممكن قبول ما ذكره عن كونراد وفوكو، فالاستشهادات في كل مكان في كتاباته، “لكن هايدجر فلا يذكر إلا عابرًا”.
السيرة النقدية
السيرة في أحد جوانبها هي بحث عن الروافد التي شكّلت الوعي والفكر النقدييْن لسعيد، فالاستشراق الذي عمل عليه هو من تأثير شارل مالك أحد أهم الشخصيات الأربعة تأثيرًا في وعي سعيد، وتحديدًا مقالته عن “الشرق الأدنى”، والتي رسم فيها حدود المعرفة الأساسية التي ينبغي استقصاؤها إن أريد فهم ثقافي لظاهرة المستشرق، وفيها حدّد مالك مقدار الخير الذي سببه الاستشراق، كما أن المنهج الدنيوي الذي كان نتاجًا لكتاباته الأولى البدايات والنص والعالم والناقد، هو من تأثير الناقد بلاكمر، خاصّةً ما استمدّه من الرؤية الدينية عند هوبكنز لجعل النقد رسالة دنيويّة، أما المفردة نفسها فهي من كتاب أورباخ “دانتي شاعر العالم الدنيوي”، ومصطلح البيان الذي استخدمه أعقاب الانتفاضة الأولى، ودعا إلى مؤتمر دولي تحت عنوان بيان، هو مستعار من مقدمة ابن خلدون، والذي يعني عنده “القدرة على استخدام المفردات للتعبير عن الأفكار التي يرغب المرء في التعبير عنها،…”
الشيء المهم الذي ركّز عليه تُمثي هو أنه ردّ الأفكار التي طرحها إدوارد سعيد في كتاباته المختلفة إلى مظانها الرئيسية، ولم يكتف بهذا، بل قدم ما يشبه الصياغات الأولى للأطروحات التي شكّلت أساس كتب إدوارد سعيد، وموقف المتلقين من أصدقائه وأساتذته من هذه الأطروحات، ومحاولات سعيد لإعادة الصياغة والتجريب حتى اهتدى إلى الصوت الذي يريده، وسط حالة من الجدل والصراعات بين الأفكار المتضادة، فهو يفضل كونراد السوداوي مع أنه يعشق أشعار بليك المعادي للاستعمار وصاحب الأشعار الرؤيوية، وكذلك كان قلبه ميالاً لسارتر إلا أنه أحب دروس ميشيل فوكو المناهض لسارتر، ويدعو تلاميذ لقراءة دولوز رغم أن كل هدف من أهداف دولوز كانت تتعارض مع آرائه، وكأن السيرة كشف لديالكتيك سعيد نفسه.
قوة تأثير الأفكار التي صاغها أساتذته كان لها دور كبير في تشكيل وعيه، على الرغم من اختلافات سعيد مع بعض أفكارهم على نحو اختلافه مع أفكار شارل مالك الدينيّة المتشدّدة، لكن يبقى تأثير هؤلاء واضحًا عليه فكريًّا وعلى مسيرته النقديّة، وهو درس من دروس سعيد، فسعيد نِتاج أفكار متعدّدة الثقافات أيضًا، بدءًا من أيديولوجيا أمه المنحازة للقوميّة العربيّة، وعمل عمته الخيري الذي أسهم في شدّة إيمانه بالقضية الفلسطينية ودفاعه عنها، فقد كان مصدره للأعمال الخيرية، تردده مع عمته على الجمعيات التي تشرف عليها. وبالمثل بلاكمر هو الذي علّمه وأثره فيه بقوله “تقريب الأدب إلى الأداء” وهو الشكل الذي لجأ إليه سعيد للاستفادة من المهنة التي تخلّى عنها، وهي مهنة عازف البيانو، فصار الناقد موسيقيا يؤدي دوره أمام المستمعين، وبأن يتخيله خطيبًا يدافع عن قضية في محكمة.
كشفت السيرة عن عقلية إدوارد سعيد القلقة، ومطاردته للأفكار، من خلال مشروعيْن الأول؛ مشروعه عن كونراد وهو رسالة الدكتوراه، ثم مشروعه عن سوفت، وهو الذي لم يتم، وإن كان قطع شوطًا بعيدًا في دراسته، والسبب هو حالة القلق وعدم الرضا عن النتائج. وقد يتضح بصورة أخرى في إعادة تقييمه للإله الخفي لجولد مان في ضوء تصوّر جديد بعد قراءته ” فرانز بوركناو” أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت.
يدخل تُمثي مع سعيد في نقاش فكري مباشر وغير مباشر، إذْ يضارعه الحجّة بالحجّة في الكثير من الأفكار التي طرحها في كتاباته المختلفة، وهو يستعرض لكتابات سعيد، وكما سبق وأن ذكرت عاليًّا، بأنه يرد النصوص إلى مظانها (الأصول الأولى) التي استقى منها سعيد لبنات أفكاره، وأحيانًا يعيد قراءة كتب سعيد في ضوء كتب مماثلة لها في الفكر والرؤية، وربما كانت أسبق منها، على نحو ما عرض من قراءات موازية لكتاب الاستشراق، بأنْ استعرض جملة من الكتابات التي لعبت على ذات التيمة التي جعلها سعيد محورًا لكتابه، كما في كتاب فيليب حتى “الإسلام والغرب” (1962)، وميخائيل رستم صاحب كتابي” الغريب في الغرب” (1895) الذي يفكك الأكاذيب الغربية وتمثلاتهم عن الشرق كما في كتابي هنري جسب “الحياة البيتية السورية” (1874)، و”نساء العرب” (1873)، ثم التماثلات بين كتاب الاستشراق وما جاء عند عبد الله العروي “أزمة المثقفين العرب” (1973).
ومن جهة ثانية كان يضع كتابات سعيد في مواجهة مع الكتابات التي تنتقدها، وأبرز مثال لذلك إبرازه لمقالة جلال العظمة عن كتاب الاستشراق والمآخذ التي أخذها على كتابه، وعبر هذه النقاشات التي كانت تصل إلى جدال وخصام، كان يسعى لأن يعكس – لا أدري بقصد أو دون قصد- الجانب العدائي عند سعيد في ردوده، والتي تبدو في صورة مغلّفة بالسُّخرية، وإن كانتْ كُتبتْ بلهجة لاذعة شديدة الحدّة، بل كان تمثي ذكيًّا لانتقاد أستاذه بأن أظهر التباينات في تلقّي كتاب سعيد، والتي وصلت إلى الهجوم على سعيد والتقليل من منجزه.
في الأخير إذا كان إدوارد سعيد وخاصة كتابه الاستشراق المؤسس لدراسات ما بعد الاستعمار، قد ساهم في انتشار مصطلحات مثل الآخر والهجنة والاختلاف والهوية، والمركزية الأوربية إلخ..، فإن سعيد نفسه نستيطع أن نقول عبر هذه السيرة الغيرية، كان التمثيل الحقيقي لمثل هذه الأطروحات، فاستطاع [بأناه الأحادية المضطربة والمطاردة بالمنفِيّ] تفكيك المركزية الأوروبيّة، وكشف البنيات المضمرة للآخر المختلِف الهُويّة والهجنة، في تأكيد لمقولة “التابع ينهض“، ومع ما حققته هذه الأنا من حالة الانصهار والاندماج مع الآخر، إلّا أنه لم ينسَ البدايات، فمع معرفته بإصابته باللوكيميا(يونيو 1992)، إلى جانب شعوره بالعزلة السياسية، بدأ يفكر بـ “العودة إلى البدايات “.
ملحوظة: التزمتُ في كتابة أسماء الأعلام الأجنبية بالصورة المتعارف عليها، ولم أكتبها كما انتهجها مترجم الكتاب داخل المتن، كأن يصير إدوارد إِدْورْد، وتشومسكي “جومسكي” ، وفريدريك جيمسون “فردرك جيمسن”، وتشارلز ديكنز “جارلز دكنز”، و(ت. س. إليوت) يصير (ت. س. إليُت)، وجائزة البُكر بدلاً من جائزة البوكر إلخ….هذا للتوضيح، وإن كان أبدى أسباب انتهاج هذا الشكل الكتابي في المقدمة.








