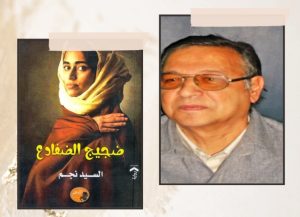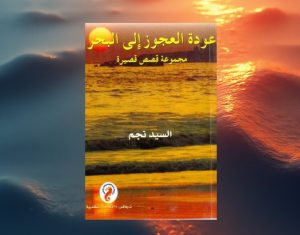صبحي موسى
شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة تطورا مذهلا في التقنيات المستخدمة في الريف المصري على وجه التحديد، حيث اختفت العديد من الآلات والأدوات التي ربما يعود تاريخها إلى العصر الفرعوني القديم، وظلت مستخدمة حتى سنوات قليلة، لكنها اختفت بظهور أدوات أحدث أو توقف المهنة الداعية إلى وجودها، هذا ما رصده الكاتب الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي د. عمار على حسن في عمله الأخير “عجائز القرية” الصادر مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية.
توقف الكاتب أمام 65 آلة أو أداة كانت تستخدم في الريف المصري، لكنها نظرا لتطورات التي طرأت على العالم ومن ثم المجتمع المصري ككل فقد توقف الجميع عن استخدامها، وإن بقيت في البيوت كنوع من آثار الزمن القديم التي تثير دهشة السؤال لدى الأطفال والغرباء كي يعرفوا، فيجلس الآباء والعجائز ليحكوا لهم عن الزمن الذي كانت فيه هذه الأدوات عصب الحياة وصاحبة البطولة فيها، من هذه الأدوات “الحصير” الذي كان يصنع من سمر “الدبس” أو “الحلفا” التي تنبت على حواف الترع، وهو الذي اختفى بظهور مصانع الحصير البلاستيك، ومصانع السجاد التي غزت بمنتجاتها بيوت الريف، و”النورج” الذي ظل صاحب البطولة في أجران القمح، حيث يجلس الفلاح على دكة خشبية ثقيلة يجرها اثنان من الثيران في عز شمس الصيف، وهي تدور بعجلتين كبيرتين من الحديد على الرمية الكبيرة في الجرن، فتحيلها إلى عصف مأكول، بينما فلاح أخر يرفع ذلك العصف “بمذراة” في وجه الريح كي تفصل بين القمح والتبن، و”المذراة” في حد ذاتها أداة توقفت الحياة عن استخدامها بعدما ظهرت ماكينات عملاقة تقوم بدرس القمح، وفصل “تبنه” عن حبوبه في حركة واحدة، وهناك “الزير” الذي ما كان بيت ريفي يخلو منه، وهو إناء عظيم من فخار يوضع به الماء، فيضربه النسيم العليل فيجعله رطبا منعشاً في حر الصيف، لكنه اختفى بغزو الثلاجات للبيوت، وهناك “المحراث” الذي اختفى بظهور جرارات الحرث العملاقة التي ملأت الحقول، ووفرت العديد من عمليات الكدح والكد التي عاشها الفلاح لسنوات طويلة.
لا يقدم عمار على حسن أدواته هنا بنوع من الأسى لاختفائها ولا حتى الفرح به، ولكنها يرصدها كصرخة في وجه الذاكرة التي باتت تفتقدها، معتمدا في ذلك على حكايات ورثها عن الأهل والأجداد، وربما شهد جانبا منها بنفسه، هذه الأدوات التي قد نعتبر أنه كان لابد لبعضها أن يختفى، لأنه مثل شقاء عظيماً للعاملين به، كـآلة “الشادوف” التي كانت تسقى بها الحقول، فتنقل الماء من الترع إلى المساقي عبر حركة آلية من أذر الرجال وظهورهم، بينما مثلت آلات أخرى لحظات رومانسية لا تنسى، لحظات صنعتها السينما العربية في أفلامها الخالدة، كمشهد الساقية الذي جمع بين سعاد حسني ومحرم فؤاد في فيلم “حسن ونعيمة”، أو مشهد سقوط البقرية في بئر الساقية كما في فيلم “الأرض” ليوسف شاهين، وهناك آلات اختفت بحكم التطور الطبيعي مثل “الكانون” الذي حل محله البوتاجاز، و”الخص” الذي كان بناء من غاب أو أعواد ذرة قديمة، وحلت محله أبنية الحديد والأسمنت، و”الماجور” الذي كان بمثابة العجانة الكبيرة لأي بيت ريفي، والذي انهى دوره بغزو الأفران الألية للقرى، وبطبيعة الحال اختفى “الفرن البلدي” نفسه باختفاء أعواد الحطب القديم، كما اختفت “الطاقية” الصوف بتحول الريفيين إلى عمال في المدينة، لكن هناك أدوات مازالت تعاند الزمن، مثل “الطبلية” تلك التي كانت بطلا لمشهد الطعام والمذاكرة في كل بيت، لكنها تراجعت لصالح ما غرف “السفرة” التي أصبحت فرض عين في كل جهاز لعروس، إلا أن الكثيرين مازالوا رغم امتلاكهم لمنضدة السفرة في بيوتهم يحتفظون بالطبلية معها، حتى وإن كانت على شكل بلاستيكي حديث أو خشبي قديم، ربما لأن غالبية المصريين يعيشون في شقق صغيرة، أو أنهم لم يتقبلوا بعد فكرة غرفة كاملة للطعام فقط.
حرص عمار على أن ينسج لكل آلة حكاية وكأنه يخلق لها نوعا من الحياة، أو أنه يؤكد وجودها من خلال ما سمعه وما وعاه وما شارك فيه، لكنه لم ينس أنه أمام مقال وليس قصة قصيرة، فالبطولة هي للمعلومة والوصف، وليس للدراما أو الحبكة الفنية، ومن ثم حرص على أن يصف الآلة وطريقة استخدامها، وأسباب انقراضها، مما جعل الكتاب في مجمله هو مجموعة من المقالات الثرية والمهمة عن مفردات من التاريخ الاجتماعي المصري، إلا أن الكاتب لم يكن معنياً كثيرا بالبحث التاريخي عن هذه الآلات ولا معرفة العصور التي بدأت بها، فآلة “الرتينية” التي توضع في الكلوب (وهو في مجمله آلة صارت منقرضة)، لتضيء مساحات واسعة، كانت أسبق في وجودها من الكهرباء، وتعتمد على الجاز أو السبرتو، حيث يتبخر على ثناياها الرقيقة فينتج ضوء أبيض مبهر كأضواء النيون، كانت تعمل به كل المحلات قديما، وتاريخها يحتاج إلى نوع من البحث، ففي اعتقادنا أنها أحد منتجات الحضارة العربية في عصورها المتأخرة.
لا نتفق مع دار النشر في تصنيف الكتاب إلى قصص عربية، لأنه كتابة ما بين المقال والسرد، وهو أقرب للأولى منه للثانية، ويعضد فنون كتابة المقال أكثر من تعضيده لطرائق السرد القصصي، حتى وإن اشتمل على إطار فني، أو بعض الحكايات الحقيقية، كتلك التي ساقها الكاتب عن “العصيدة”، وهي نوع من الأكلات الريفية البسيطة التي لا تحتاج جهدا في تحضيرها، وحين أعدته سيدة ريفية لأبنائها ووضعتها على الطبلية سمعوا صراخاً، وعلموا أن أبناء عمومتهم يتشاجرون مع آخرين، فذهبوا جميعاً لنصرتهم، إلا واحدا تكاسل، ثم ضعف أما الرائحة ووطأة الجوع، فأكل الصينية كاملة، وما أن عاد اخوته من مناصرة أبناء عمومتهم لم يجدوا ما يأكلوه، فتشاجروا مع بعضهم، حتى ظن أبناء عمومتهم أن أعداءهم اشتبكوا معهم، فأتوا مسرعين لنصرتهم أيضاً. فهذه الحكايات الطريقة تأتي لتعضيد الفكرة وتخفيف المعرفية التي في النص.
تأتي أهمية الكتاب في أنه يوثق مبدئياً هذه المفردات، ويؤكد على مصريتها قبل أن يقوم آخرون بتوثيقها لصالحهم في التراث الشفاهي أو المادي، فقد تبدو اليوم عادية وبلا قيمة، لكنها في الغد قد تصبح ذات أهمية كبيرة، وقد يحدث صراع دولي حولها، على نحو ما حدث في “الأراجوز” ، “الكشري”، “الفلافل” ، وغيرها، فضلاً أنها تعد مداخل لإعادة قراءة تطور المجتمع المصري والعربي، ورؤية الأسس التي كان الريف المصري يقوم عليها، وما الذي حدث له من تغيرات، وفي النهاية يعد هذا الكتاب وقوفا في وجه محو الذاكرة المصرية أمام منتجات الحداثة، تلك التي لم يعد يسيطر عليها الغرب وخده، فقد صارت المجتمعات العربية سواقا رائجة لكل ما هو تركي وصيني، وصرنا نستورد سجادة الصلاة وسبحة الأذكار من الهند والصين وكشمير.