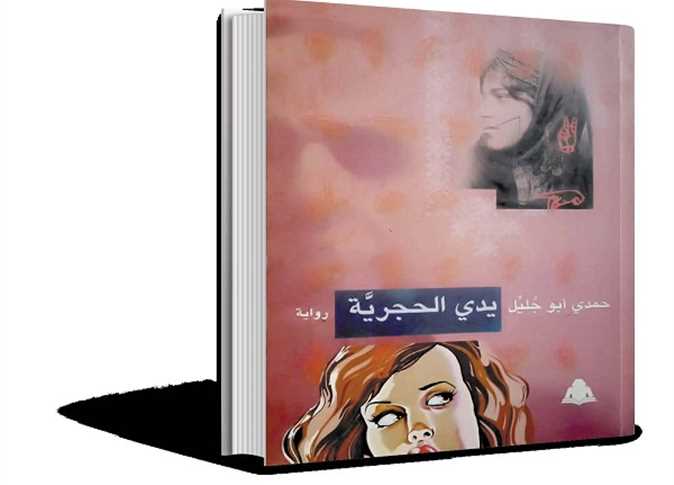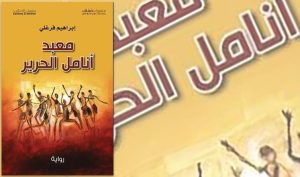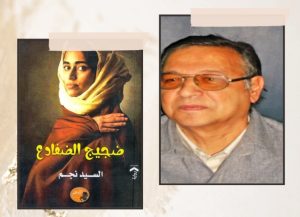شوقي عبد الحميد يحيي
وستظل ثورة 1919 هى الثورة الأم، فى مسيرة الثورات العربية، حيث كانت هى الثورة الحقيقية، التى جمعت كل فصائل الأمة، مسلمين ومسيحيين (عاش الهلال مع الصليب)، رجال ونساء. وهى التى كانت بداية لحركة ثقافية، نشرت ظلالها لسنوات عديدة فيما بعدها، وبداية نهضة اقتصادية (إنشاء بنك مصر)، وإنهاء الحماية البريطانية على مصر والتى كان قد تم فرضها عقب انتصارها فى الحرب العالمية الأولى، كما شهدت إنشاء دستور 1923 الذى يعد أحد أهم الدساتير المصرية عبر تاريخها. وإذا كانت الثورة قد شملت البلاد بطولها وعرضها، فإن الفيوم لم تكن بعيدة عن أحداثها ليس فقط من خلال أحد أبرز زعماء الثورة حمد باشا الباسل والذي كان اعتقاله، مع سعد زغلول ورفاقه، الشرارة التي أطلقت المظاهرات ضد الاحتلال في كل ربوع ونجوع وقري الفيوم، حيث تصدت لهم قوات الاحتلال فسقط العشرات منهم سيدات ورجال يوم الخامس عشر من مارس وهو اليوم الذي تتخذه الفيوم عيدا قوميا لها حتى اليوم، وما يقول عنه علام عبد الغفار {مشاركة الباسل البارزة في ثورة 1919م، والتي انطلقت من الفيوم، عندما علم أهل حمد باشا الباسل، بإلقاء القبض عليه من قبل الإنجليز وأنه يتم نفيه خارج البلاد، توجه عدد كبير من أبناء عائلته إلى مركز شرطة إطسا، التابعة له قريتهم، وحاصروه وتحفظوا على المأمور الإنجليزي وأفراد القوة، ثم توجهوا إلى مديرية أمن الفيوم بالخيول، مع أفراد من عائلة أبو جليل، وحاصروا المديرية ولكن الإنجليز أطلقوا عليهم النيران من الأسلحة النارية، وتوفي في هذه المعركة 40 فردا من العائلتين، وكانت هذه الواقعة هي الشرارة الأولى في ثورة 1919م، والتي انتقلت الاحتجاجات فيها من الفيوم إلى باقي المحافظات}.
وحيث ينحدر “حمد الباسل” بن محمود باشا الباسل من قبيلة “الرماح” التى بدأ ظهورها عقب الاشتراك بدور مهم فى الثورة العرابية، وبعد ما قامت به عائلة الباسل، تم تسمية القرية باسم “قصر الباسل” فى 1905.[1] ومن هنا تبدأ انطلاقة حمدى أبو جليل فى روايته “يدى الحديدية”[2] التى يسير فيها برفقة الأجداد، والثورة، وكأنه يعيد كتابة تاريخ البلاد والعباد، الذى يعودون إلى الصحراء، والبداوة، كما لو أنه يعود إلى أصل الحياة البدوية، والتى ينحدر منها حمدى أبو جليل. فمثلما خلد نجيب محفوظ حى الجمالية فى القاهرة، وخلد محمد مستجاب ديروط فى الصعيد، وخلد خيرى عبد الجواد بولاق الدكرور فى الجيزة. يحاول حمدى أبو جليل، أن يخلد “دانيال مركز أطسا” فى الفيوم، بان يخلق لها تاريخا، ترجع أصوله إلى منابع النهضة المصرية، التى عاصرت، ثورتها الحقيقية، ثورة 1919. حيث يخلق منها نموذج لمصر عامة، وكأنه يتحدث عن الجزء، المُشكل فى النهاية للكل {ويُروى أن العرب لما جاءوا مصر بالإسلام ظلوا فترة لا يعرفون الفيوم بسبب بعدها عن النيل، والفيوم ماكيت لمصر، بحيرة قارون في الشمال تعادل البحر الأبيض المتوسط، وبحر يوسف في الشرق يعادل البحر الأحمر، والدلتا في الوسط والصحراء محيطة من كل جانب، والناس نفس الناس، بنفس التركيبة الأصلية الآسرة، فيهم السواد الأفريقي وفيهم البياض الأوروبي.}. {ونحن الفيومية نؤمن ونعتز بأن ثورة 1919 بدأت من أحراشنا وانتشرت من الإسكندرية حتى أسوان.}[3]. وحيث يضع أبو جليل ثورة 19 فى مواجهة الثورة الأم –فى العالم- الثورة الفرنسية، والتى كان من أهم مبادئها، الحرية، وحقوق الإنسان، وكأن الكاتب يضع الوجهين المتقابلين لصورة المجتمعات، العربية من جانب –بصفة خاصة- والأوروبية فى الجانب الآخر-بصفة عامة-. وكانت المواجهة الأكبر، والتى اتخذ منها الروائى السودانى الطيب صالح فى روايته “موسم الهجرة إلى الشمال” متكأً يُعَبِر به عن انتقام العربى من المستعمر الإنجليزى، وفقا لرؤية العربي لذلك الفعل –الجنس- والذى رأى معه أن مجرد ركوب الرجل العربى للمرأة الفرنسية، هو تعويض عن ركوب المستعمر للأرض العربية. فاستخدم أبو جليل الجنس –أيضا- غير أنه استخدمه، كأحد رموز الحرية عند الغرب. فضلا عن النظرة –العامة- إلى الجنس يإعتباره البداية للحياة، ومناداة الفرنسية بحرية الجنس، بما قد يعنى فى النهاية “الحياة”. وهو ما يأتى من وضع ذلك التصور فى مواجهة الموت، الى يكاد العربى يعشي من أجله، بل أصبح هو المسيطر والمتسلط على فكره. فنرى السرد فى روايته عن االبيت {وسكَّانه، أسرة جدي عيسى، كانوا يستعدون للموت في استسلام تام، وخضوع أتمَم لقضاء الله وقدره. جدي عيسى مات وهو فى الأربعين من عمره ولحقته عمتي حميدة وهي في الخامسة عشرة ثم عمي حامد وهو دون العشرين. وعندما وصلت أمي في ثوب عرسها كانت” حَنِّي”
طامية ممدَّدة على فراش الموت}ص8. و{فما إن يعلُ أحد أبنائها ويذيع صيته في أي مجال حتى يختطفه الموت فجأة وهو في عزِّ الشباب، يونس بيه أول مستشار وياسين بيه أول نائب وعبد الواحد بيه أول ثائر ومعوض بيه أول ضباط ماتوا جميعًا في الأربعين من أعمارهم}ص51. ثم ننتقل إلى البر الآخر، حيث نرى الحرية حتى فى إختيار ساعة الموت حيث تحكى “مراية” {وصديقي دخل مستشفى تولوز في جرح عادي، قطع طولي بالساق اليمنى، ومنذ ثلاثة شهور وهو ينهار، ومنذ أيام طلب أن يموت، ووافقت المستشفى واتفقت مع الأهل والأصدقاء على أن يتم التنفيذ اليوم الاثنين 30 سبتمبر في الحادية عشرة صباحًا.}ص205.
فإذا كان قد ساد الجنس فى كتابات الروائيات و الروائيين العرب فى نهايات القرن العشرين، وبدايات القرن الواحد والعشرين، ما سمى بأدب الجسد، حيث كان الجنس هو أحد ظواهر تلك المرحلة، نظر إليه الكثيرون بأنه محاولة للفت الأنظار، والسعى نحو الانتشار وجاذبية القراءة، متغافلين عن أنه نوع من الثورة على المكبوت، أو غير المسموح به فى الأدب العربى، فكان نوعا من الثورة على الأوضاع السياسية فى بلادنا، الثورة على كل ما هو ممنوع، ومطالبة بالحرية، ليس فى الجنس وحده، وإنما فى كل شئون الحياة، وأخذت الروائية السعودية “رجاء الصانع” ضربة البداية بروايتها، “بنات الرياض” على إعتبار السعودية، أكثر البلاد العربية إنغلاقا(يناير 2007)، خاصة فيما يخص الجنس. فالجنس، هو أحد التابوهات المحرم الاقتراب منها فى الحياة العربية، رغم كونه أساس الحياة، وسر وجودها. وهو أحد الاختلافات الجذرية بين الشرق و الغرب، فبينما قامت الثورة الفرنسية للمناداة بالحرية فى كل شئ، خاصة الحياة الجنسية، فكانت الفرنسية “مراية” إبنة هذه الثورة {إنها ابنة حقيقية لثورة الطلبة، الثورة الفرنسية العظيمة، وخرجت وهي تلميذة في الإعدادي تهتف للحياة المشتركة والجنس الحر المشترك}ص114. بينما كان على الطرف الآخر، السارد، يحلم، نائما ويقظانا بتلك الحاجة المُلحة، ولا يستطيعها {من قبيل الحيرة والألم وقلة الحيلة أمام تلك النار، ذلك الوهج المرعش والمُرجُّ رجًّا والمضني إضناءً لأي بارقة أنثوية، ما إن تخطف عيناي الواحدة حتى لو كانت مارقة في الشوارع والطرقات حتى أحس بنخصة، غزّة، انتفاضة من رأسي لأخمص قدمي وأحيانًا أزوم كأي ذئب}ص32. وبكمل السارد رغبته فى الخروج من قمقم الكبت بتلك العلاقة مع الفرنسية “مراية”{الإنسان داعر، شخص داعر، إنما مقموع، وأنا قررت أن أطلقه في هذه البرهة الفرنسية الحرة}ص114.
فصمم الكاتب روايته على ضفتى التجربة، تحمل إحداهما حياة البدو -أبناء ثورة 19 -فى جانب، والتى يمثلها السارد وبيئته، والحياة الفرنسية –أبناء الثورة الفرنسية، أبناء ثورة الطلبة في1968، والتى أعادت تجديد الإصرار على الحرية، على الجانب الآخر، والتى يمثلها “مراية” وبيئتها، التى عبرت هى نفسها عنها فى {وأيام الثورة كنت في السنة النهائية في مدرسة اللاتيني، وآمنت بها بكل كياني، وهتفت مع الهاتفين بأسماء”ماو تسي تونج وماركس وكاسترو وجيفارا” باعتبارهم أنبياء الحرية والانعتاق الأبدي، ولكني لم أومن لم أصدق أساسًا إلا أشعار رامبو والتغيير والحرية وتحطيم القيود، وطبعًا حلم الجنس الحُر المشترك والإنجاب المشترك والحياة الحرة المشتركة، بدت لي الحياة، جنة التجرُّد والإيثار والحب والتفاني والنهم للحياة}ص212.
ويؤكد السارد تلك المعلومة، من واقع التجربة الفعلي معها{مراية قوية حقًّا، حينما تريد شيئًا تقتنصه في التو واللحظة، ابنة الثورة الفرنسية فعلاً، ثورة البنات المارقات اللاتي خرجن في الشوارع يهتفن للجنس الحر المشترك، واقطفوا الحياة}ص31. وهو ما اتفق مع رغبة السارد المكبوتة، والمزمجرة، بحثا عن تلك الحرية، وذلك الانطلاق، وهو ما عبر عنه فى {ومراية كانت على قد خيالي بالضبط، هي كانت تقول إنه على قدها بالضبط وهي كانت على قد خيالي بالضبط}ص21. فكبت وخيال هنا {جنة الحياة المشتركة والجنس الحر المشترك – كنت أؤسسها مع نفسي في قرية دانيال مركز أطسا محافظة الفيوم}. وحرية يشتهيها السارد هناك. وقد بدأ السارد، بما هو مألوف، من إبداء الحياء – ظاهريا- بينما تموج أعماقه بالتوق، والرغبة {طبعًا أخجل، “أختشي على دمي”، أقاوم، وأحاول طوال الوقت أن أبدو مثالاً للإنسان المؤدب الخلوق “اللي عينه متترفعش عن الأرض”، وتخطيت الثلاثين وأنا لم ألمس واحدة، وكبت مستمر بدون أي اقتناع. حبي الأول كان حبين، الحقيقة ثلاثة، أربعة، لو أضفنا حبي الموءود للأبلة وحبي المهدر لبنت شريكنا في الغيط وحبي الفاشل للبنت التي كانت تجاورنا في الجرن، هذا فضلاً عن اللاتي تواردن على خيالي في النوم واليقظة.}ص32.
فنثر الكاتب العديد من المواجهات بين هنا وهناك، بشكل مبعثر، وترك القارئ لينظر ويتأمل، ويعقد هو المقارنة بنفسه.
فعلى الجانب البدوى، الفيومى، نقرأ، حيث يستخدم الكاتب السخرية المُرْة، التى تستحضر روح مستجاب فى كل أعماله، ليسخرا من الأهل، الخاضعين للتقاليد والموروث، الذى لافكاك منه. فيروى أبو جليل عن كيف ساهم البدو فى ثورة 19، بلسان الأم، أو مركز الانطلاق، التى منها البداية، والتى ستأتى منها النهاية. فيقول السارد عن الأم {دعت لنا كوكبة من كبار المتكلِّمين في العائلة، وتباروا جميعًا في تسميع مراية المواقف الزاهية في تاريخنا التليد من أول الحملة الفرنسية لمحمد علي وسعيد وأم حليجة وثورة 19 حتى الضابط البطل معوض الذي استشهد على حدودنا الشرقية في التسعينيات برصاص المقاومة الفلسطينية}ص9. لتكشف بذلك عن وضع الأم فى تلك البيئة، وكيف أنها الحكاءة، أو راوية التاريخ، وكيف أنها تسعى فيه إلى (فتح الصدر) أو (الفشخرة)، فضلا عن إعتماد البطولة (الكلامية) على الأشعار والخطابة. وفض –أيضا- عن الإشارة الأخيرة {برصاص المقاومة الفلسطينية} تلك المقاومة التى تكبدت مصر بسببها الكثير، وخاصة 1967، التى سيأتى الإشارة إليها.
و يتكشف الواقع المعيش، لتلك البطولات (الكلامية) فى معرفة دور الجدود في تلك الثورة {وفيها خدوا النجارين، ومنهم دانيال بو إبراهيم النصراني جد ثابت اللي عايش اليوم وبكرة، وقلّعوا خشب التلفونات وقضبان السكة الحديد وقطعوا السلوك وقاموا على النقطة وولعوا فيها،وقاموا م النقطة ع المركز}ص150. حيث كان {جدي عولة يعتبر قاطع طريق نهَّاب كان ينقب البيوت ويطلع البهايم، تقولي بدوي تقولي فارس هو في النهاية كان ينهب الناس أو يُنهبوا له}ص12. وعن الجد عيسى، الذى كان طيارًا، حمامة،, شابًّا أبيض وسيمً بعيون زرقاء وثروة من الأراضي ممتدة في ثلاث عزب، وحافظًا كتاب الله، وإمامًا وخطيبًا في الجامع {وفجأة وقعت ثورة 19 فصار من أبطالها المجهولين، أرى أصدقائي يبتسمون، أنا شخصيًّا أبتسم.. لنقُل: كان أحد ضحاياها المخفيين. وهو كان ضحية لا مراء فيها، ومن حقنا أن نطلب تعويضًا فيه. وسُجن في أحداث ثورة 19 وقضى في السجن ثلاث سنوات، وخرج من السجن شبه مجنون، وظل يهذِي ويطفلف ويهيم على وجهه في حمارينا الشاسعة حتى مات}ص13. وكأن أبو جليل ينسف تلك المزاعم من البداية، أو كأنه يضعنا أمام أحد عيوبنا (الكذب، والفشخرة، والخطب والأشعار).
ويمعن الكاتب فى السخرية من الماضى، الممثل فى الجدود، وكيف أنهم عاشوا عالة، خاملين عن العمل {عمي كرومة ثالث الإخوة المنكوبين، جلولة وعزوزة وكرومة، والدهم جدي بهيج بو سلطان باع أرضه ومات وهم أطفال، وأمهم “حَنِّي رسم” بنت محمود تزوجت عمهم جدي شعيشع وتركتهم يتلطَّمون لا عائل ولا مصدر للرزق.
عمي جلولة الكبير تزوج “حَنِّي عيشة” بنت عمه عبد القوي وعاش بالفدادين الأربعة التي ورثتها، وعمي عزوزة سحب بلطة وعاش على السرقة والنهب حتى تزوج عمتي شربات بنت عمه باغي وعاشابالأفدنة الأحد عشر التي ورثتها.
وكرومة نظرًا لأنه من يومه قليل الحيلة ظل هاملً، يرتدي جلابية فردة مقيّحة ومرصوص بالقمل، ويتلطَّع على الحيطان، ويشبع يوم ويجوع عشرة وينام في أي مكان}ص109.
هكذا كانت الصورة فى الماضى، ثم يبدأ الاحتكاك مع الغرب، فكان بداية الاحتكاك (الثقافى) حضور “مراية” العاشقة للترحال والاستكشاف إلى مصر،حيث عملت بتدريس اللغة الفرنسية، فى أكثر من مدرسة فى الأسكندرية، فعشقتها، وهامت بها، ولذلك {عادت مراية ملبوسة بمصر، ليست مفتونة أو معجبة وإنما ملبوسة بشيء أو إحساس أو مصيبة سوداء اخترقت القلب واستقرت في الأعماق، ليس فقط مصر الأهرامات والفراعنة والأقصر، وإنما مصر التراب والهواء والناس والشمس المشرقة من الإسكندرية حتى أسوان}ص119. وكأن الغرب ما رأى إلا الطبيعة التى وهبها الله لمصر، أما البشر، فذاك موضوع آخر.
يصحبها السارد فى جولة يطوف بها مصر، من أقصاها إلى أقصاها، ليتعرفا على الكنوز البيزنطية التى ترجع إلى القرن الأول الميلادى، وربما لأسباب دينية، حيث ينتمى الفن البيزنطى إلى الديانة المسيحية، وربما بسبب الإهمال، أو عدم معرفة القيمة الحقيقىة، وهذا هو الغالب، فى ظل روح الرواية، وظل السخرية التى يسوق بها الكاتب، تلك الرؤية، التى تعبر عن الإهمال هنا، والاهتمام والرعاية هناك {ولكن إذا كانت حمير جدي المسكين بعَّرت فوق الكنوز البيزنطية فهناك من أكرمها ونعَّمها في أوروبا، ونُزحت أم البريقات، التي كانت عبارة عن قرية أو قُل مدينة كاملة، على المتاحف وحتى البيوت الأوروبية، ولم يبقَ منها إلا أسوار مهدَّمة وصف أسود مبتوري الرأس، ومراية زهدتها بل كرهتها سريعًا، وعادت مسرعة للمرسيدس}ص11.
وتأتى المفارقة، حينما يصنع يحيى، ابن عم السارد يدا جديدة له من الحجر، يوضح السارد دورها فى تلك المفارقة {يحيى ضحك وبرَّر نقلته الفنية بأن يد مراية يد الفاعل اللي لسه بيشتغل في الفاعل إنما دي يد الكاتب اللي مبيكتبش} ثم يكمل بعدها ما يكشف عن طبيعة الإنسان العربى عامة، والصانع منه خاصة، الذى لا يعمل إلا إذا كان له رغبة، أو حاجة للعمل، وما دون ذلك، فهو لا يعمل {يحيى ابن أختى ينحت أحيانًا أو ينحت عندما يروق.. نادرًا} ص19.
وعندما سافر –السارد- إلى فرنسا، كان كأى عربى، منبهرا بالظاهر الذى يراه، وحتما ستقوم المقارنة التى يعبر عنها لما رآه هناك {الطريق سريع ومزدوج، وعلى الجانبين والخلف والأمام والأفق الممتد مروج خضراء، جبال شاهقة بنفس التلال والهضاب والسهول لكن على هيئة شلالات من الخضرة، وبدلً من أن أركز فيها ضحكت، أي والله قهقهت، وانهمرت عليَّ عزبتنا دانيال مركز أطسا الفيوم، واسمها الشعبي “أبو طاحون”، وتهيأت أمامي بترعتها الصغيرة وبيوتها الحجرية الجرداء ومنظرها العام، وتلوت على مراية نشيدها الوطني “حمراية بو طاحون حمراية جبال/ طبع صخور ما تعرف محال”}ص98.
ولم تكن سخرية الكاتب من تاريخ الأجداد، لمجرد السخرية، تحميسا للقراءة، أو أنها طبع أصيل فى شخصيته، وإنما كانت تعبيرا عن رؤية، وموقف لديه،إزاء فقدان الحرية، وسيطرة الكبت من جانب، ومن جانب آخر رؤية فلسفة التفكير السلفية، وتقديس الماضى، وفقدان الثقة فى الحاضر، والذى يعبر عنه ذلك الحلم (الكلامى)، حين العودة للستينيات التى إعتبرها السارد فارقة فى مسيرة الحياة المصرية{ هذا النوع من العربيات انقرض على يدينا احنا المصريين، جت في حموة التصنيع الناصرية، ووهبتها الحكومة الإيطالية إلى مصر كما وهبت أختها العربية الآر للهند، ولكن الهند فرضت الآر على مسئوليها من أول رئيس الوزراء، واحنا قعدنا، طنطنَّا كتير على العربية المصرية مئة في المئة ومعملناش حاجة، فذهبت ال 1300 في مصير سَرِيَة استكشافية أرسلها جيش إلى جهة واتجه إلى أخرى}ص208.
ويلتقى –السارد- برفقة “مراية” ببعض العرب هناك، وربما للرؤية عن بُعد، والتى بالضرورة تكون أوضح، وربما بفعل رؤية الغرب للعرب، وربما بواقع الانبهار والمقارنة. ففى ذلك الاجتماع {تملكتنا حماسة جماعية في الهجوم على العرب، وتبارينا في ذكر المواقف والمفارقات والنكات التي تظهر مدى بؤسهم وتخلفهم وخيبتهم الثقيلة، وتكلمنا جميعًا في نفس الوقت وعلت أصواتنا وضحكنا، وقامت مراية وعادت بالشاي الأخضر. ووجدتها فرصة لإطلاعهم على دعوتي للاستسلام التي نشرتها مؤخرًا عندما دكت الطائرات الإسرائيلية بيروت الحبيبة بينما المقاومة الإسلامية اللبنانية تعلن الانتصار}ص199. حيث تنضاف تلك الهزائم، بلا أى انتصار أما العدو الإسرائيلى، إلى مرحلة اليأس، فكانت دعوة الاستسلام، والتى لا يقول بها البدوى الصحراوى النشأة، إلا إن كان قد وصل للفقدان التام للحاضر، والذى لا ينبئ بمستقبل به بصيص من الأمل. وقد أدى لذلك الموقف وتلك الرؤية ما ساقه الكاتب مع بدايات الرواية، عندما حدد الوضع أيام أمه أو فى عهد الأم:{أكتبُ الآن في بيت أُمي، البيت الذي أحيته أمي، زارته مراية أيام كان ينغش بخلق الله، من كل زوجين اثنين ثلاثة أربعة، كل الطيور وكل الحيوانات وحتى الزواحف والحشرات المتعارف على شغيها في البيوت كانت تشغي في بيت أمي}.حيث كان الخير يملأ البيوت. بينما التاريخ يقول أنها كانت فترة إستثنائية، فما قبلها، وما بعدها، يوضحه السارد {والآن، في عهدي المبارك يعود حثيثًا إلى فترة أو قُل مأساة أو قُل”مُجرة” ما قبل أمي. كان ينهار، يندثر اندثارًا، هو أساسًا ليس بيتًا، بضع أوض أي حجرات متَّسعة.. متسعة جدًّا}. الأمر الذى يشير إلى دور الأم، الحياتى، والرمزى، الذى سيستغله الكاتب فى نهاية الرواية، عندما يتوجه إليها ببؤرة الخطاب الروائى.
كما يشير الحاضر-أيضا- إلى هدم الماضى، والاستهانة به، وهو الأمر الذى يشير إلى خاصية مصرية عربية، قد لا نجدها فى أى مكان آخر، وهى أن التاريخ يبدأ بنا فقط. فهكذا تم طمس معالم التاريخ، والاستهانة به {وزرنا خرابة أم البريقات، وهي بقايا بائسة من قرية كاملة من العصر اليوناني أو البيزنطي، صفٌّ من الأسود المرمرية البيضاء مقصوفة الرأس، وأسوار متهدِّمة وكتل حجرية منحوتة وصف من الأعمدة الغائرة في قلب الصحراء، وقديمً، حتى نهاية الستينيات، كان جدي عولة الله يرحمه يكمن فيها البهايم المسروقة، وكان يربط الحمير بالذات -الحمير اللي متسواش نكلة- في رقاب الأسود الأثرية التي لا تقدَّر بثمن}ص11.
وقد استغل الكاتب ذكاءه الإبداعى فى تمرير (نهاية الستينيات) وكأنها جملة عابرة. غير أن إشارة أخرى تشير –وكأنها أيضا جملة عابرة- قد توضح لماذا تخير هذه الفترة تحديدا (نهاية الستينيات) حين الإشارة إلى ذات الفترة، والكشف عن مآساتها المتمثلة فى صراع القمة، التى أعقبت أكبر هزيمة نالها العرب أمام إسرائيل {ليست حربًا كبرى كحربنا الأزلية مع إسرائيل، ولكن حربًا صغرى بيننا. عم حلمي كان يعمل ضمن حملة أسطول سيارات المشير عبد الحكيم عامر يوم م قتله جمال عبد الناصر، أو يوم م هو انتحر خوفًا من بطش عبد الناصر، محدش عارف بالضبط، ولكن عم حلمي عرف أن أسطول المشير القتيل الرابض حول قصوره واستراحاته في القاهرة سيوزع على الأقاليم، ولقي نفسه مكانيكي على جرار وحيد في قرية نائية من قرى الدلتا، وكان من رأيه أن المشير “قتلة منتحرش” وأنه كان السبب الأساسي للهزيمة، وأنه كان عقلية عمدة ولقي مصر كلها في حجره فاتجن، وكان سيبانه خطر، بل أن قتله كان ضرورة لاستقرار البلد في عز هزيمتها.}ص208. وحيث سنلاحظ الإشارة إلى (حربًا كبرى كحربنا الأزلية مع إسرائيل).وهى المقدمة التى بررت للسارد أن يطلب الاستسلام، حيث الوصول لمرحلة اليأس.
إلا أن الأصل البدوى الصحراوى، والمعتز بكرامته، ينفر عندما بدأت “مراية” تتحفظ على بعض تصرفاته، خوفا منه كعربى، وكإفريقى، والذى تتصور أنه يمكن أن يفعل أى شئ مجنون –فى رؤيتها-أى يمكن أن يتصرف بعيدا عن العقل، الذى يفتقده- وفق رؤيتها أيضا- {فتأكدت من حقيقة أنها تتوقع أن أفعل أي شيء وأنه حتى لو انبثق لي ذيل في مؤخرتي أو قرنان في رأسي لن تستغرب أبدًا، هم هكذا الأوروبيون في الغالب الأعم يظنوننا كائنات أسطورية يتوقَّع منها حتى الجنان الرسمي}ص198.
وينفر العرق البدوى، ويتكهرب السارد عندما يبدأ يعتريه الإحساس بالمساس بالكرامة، حينها يمكن أن يضحى بأى شئ، حتى لو كان ضياع حلم الحرية، أو مغادرة “مراية” ومغادرة فرنسا كلها، فبعد موقف، شعر بإشمئزازها منه، قرر وضع نقطة النهاية {عرفت مراية من عامين بالضبط، وكانا أجمل عامين في حياتي، وقضينا أيامًا تاريخية في الإسكندرية والأقصر وتولوز الحبيبة، ولكني استرحت فعلاً، استرحت لأني استرحت. والمريح أكثر أنها استراحت، مراية الحبيبة استراحت، وجاءت النهاية سريعة وغير مفهومة وغير مبرَّرة ومناسبة لاثنين مثلنا، أنا خرجت باندفاع وهي أغلقت الباب بعنف. فجأة اكتشفنا أننا على غير هدي أو إطار، مقطورة انفصلت عن قطار، خرجت عن قضبان الزواج والحب والتبنِّي ولا حتى الاستغلال}ص241.
وبهذه النهاية، لا نهاية الرحلة، ونهاية المقارنة، بل نهاية الرواية التى يبحث لها عن نهاية، طال البحث عنها، وتوقف القلم طويلا، وهو هو يبدأ النهاية، مع ملاحظة (ولففت فى شوارع وسطت البلد)، التى تعيد السارد إلأى أرض مصر، وكأنه كان فى حلم،، قام منه أخيرا. حلم الحرية، وحلم فرنس، و.. “مراية” {وأحسستُ بغمة انزاحت عن صدري، وانشرحت لرغبة المشي في الشوارع وخلاص إلى أن يشاء الله، ولففت شوارع وسط البلد وأنا في منتهى الطرب والسعادة، وفكرت في الكتاب، كنت أبحث عن نهاية وها هي النهاية المناسبة، وقلت بصوتٍ عالٍ “آن الأوان لفعل شيء حقيقي “، من زمن لم أفعل شيئًا حقيقيًّا}ص247.
فإذا كانت تلك هى نهاية الرواية الباحث عنها، فإنها -أيضا- نهاية رواية “يدى الحجرية”. والتى تُسفر عن رفص الاستسلام للماضى، والاستسلام للإستيراد من الخارج.. فيدى الحديدة قادرة على العمل، وبيدى الحديدية سأصنع حياتى.
التقنية الروائية
على الرغم من أن فى كل الأعمال الإبداعية، نستطيع أن نتعرف على المبدع فيها، إلا أننا فى “يدى الحديدية” سنرى حمدى أبو جليل، بشخصه، حتى أنه يمكن أن نعتبر الرواية ترتكن إلى السيرة الذاتية، فى الوقت الذى نراها تجنح إلى الرواية الوثائقية، حتى لو لم تكن تعتمد المصادر، إلا أن تاريخ البدو الذى عرضته الرواية، يمكن التحقق منه عبر البحث عن المصادر.
فنجد اللهجة البدوية بادية، وكأن أبو جليل يتحدث إلينا بلغته، وبشخصه. وهو ما يوضحه بنفسه فى الرواية، بذات السخرية الضاحكة {ولهجة الفيومي في واقع الأمر هجين من لهجتين، يعتبر واقعًا عمليًّا تحت سلطتهما، لهجة القاهرة حيث السلطة المركزية في الشمال، ولهجة البدو حيث السلطة المحلية في القرى، القاهري مثلاً لما يشير إلى شيء يقول “ده “، والبدوي يقول”هضا “، والفيومي يقول” ديدا”، والقاهري لما يسأل عن مكان يقول”فين” والبدوي يقول “وين” والفيومي يمدها هكذا «فاااااا ».. واحنا صغيرين حوَّرنا أغنية شهيرة لعبد الحليم حافظ واعتبرناها نشيدًا وطنيًّا للفيوم يقول مطلعه:”كنت فا وأنا فا جيتني منا والأيام دي كانت غايبة عني فااا}ص122.
وإذا كان الكاتب يعلم ذلك الحاجز بين المتكلم والسامع-القارئ- والذى يوضحه بنفسه {وكل ذلك بلهجتي أنا، المزيج الأهوج بين البدوية والقاهرية والفيومية، والتي عادة ما تغمض على المصريين أنفسهم. لغتي أنا، لغة البدو المخلطين التي ليس لها أي علاقة باللغة العربية!}ص40. فما كان من الضرورى الإكثار من الأشعار والأغانى التى خلقت فاصلا بين العمل وقارئه، لفقدان التواصل معها.
كما يمكن أن نُجَمِعَ أشلاء التاريخ من بين الصفحات، حتى وإن بدا الكثير منها مكررا، أو غير مؤثر حذفه، بما لايُخِل بمسيرة الرواية، فسنصل إلى، ليس تاريخ الفيوم، أو البدو فقط، وإنما إلى تاريخ مصر. حيث سنجد البداية فى {الفيوم الجغرافيا هي آخر نقطة في سرسوب مصر العظيمة، مصر الفرعونية العظيمة، ولو حدقت فيها جيدًا ستجد آخر نقطة في سرسوب آخر، سرسوب إنساني، أنا تقريبًا متأكد أن الإنسان الفيومي العايش في الفيوم اليوم هو خلاصة قديمة، ليس قدم الفراعنة طبعًا، ولكن قدم الاحتلال، الاحتلالات المتعاقبة التي مرت على مصر}ص122.
ثم يبدأ تاريخ البدو {وأم حليجة كانت زعيمة عربان المرابطين الذين ينسبون إلى دولة المرابطين بالمغرب وهاجروا إلى مصر وكفُّوا عن الترحال واستقروا جنوب الفيوم وسكنوا في البيوت الحجرية منذ العهد العثماني}ص51.
ولم يكن البدو كلهم من الرُحل، بل كانت قبيلة {الرماح هي القبيلة البدوية الوحيدة التي تعتبر مصرية وأعلنت كقبيلة في مصر، وهي صنيعة حية لإصلاحات محمد علي التي نقلتهم فعليًّا من طور البداوة إلى طور الاستقرار وفلاحة الأرض والخوف الأزلي من أي شكل من أشكال الحكومة}ص62. ويستمر مسلسل الإندثار، وضياع التاريخ {ومررنا على أثرنا الحقيقي، أثرنا المندثر مندثر، أطلال سراية أم حليجة التي صُفِّي فيها شيوخ قبيلة الرماح الأربعين في عهد الوالي سعيد باشا، ومن يومها استقروا، كفُّوا عن الترحال والنهب وتحوَّلوا إلى فلاحين امتلكوا الأرض وزرعوها وعبدوها عبادة}ص11.
وهو ما يدخل بنا إلى الرواية الوثاقية، حيث قراءة التاريخ المُكوِن للسارد، والذى وصل به فى النهاية، إلى موقفه السلبى السابق الإشارة إليه.
ثم يلقى أبو جليل بالقارئ فى بحر المعلوماتية، دون أن يقدم المعلومة مباشرة، وإنما يسوقه للبحث والدراسة، والبحث عن تلك الإشارة إلى تلك المجموعة، الغير شائعة لدى القارئ العربي، والتى تدل على تعدد الجماعات اليهودية المتطرفة، والتى إتخذت لها من الأرض الفلسطينية، مقرا ووطنا. وهو بؤرة فكر الجماعة المسماة ب”الكيبوتسية” تلك المجموعة التى آمنت بها “مارشال” صديقة “مراية” والتى أحبت يهوديا وذهبت إلى إسرائيل، وأدمنت حب إسرائيل والكيبوتسية. ورغم أن “مارشال عادت خائبة من تجربة الزواج اليهودى، بابن يهودى، وقناعة بإسرائيل، ليبدأ الشقاق بين الصديقتين، وكأنه الشقاق بين الغرب عامة، حيث منهم من يؤمن بالقضية الفلسطينية، ومنهم من يؤمن بحق إسرائيل فى فلسطين {وما أثار استغراب وحنق مراية أكثر ونسف علاقتهما في النهاية أنها صارت أكثر حبًّا لإسرائيل، وصار شغلها الشاغل التبشير بالجنة الموعودة في “الكيبوتس” الإسرائيلي، والتيه فخرًا بابنها اليهودي والإلحاح بمناسبة وبدون مناسبة «انظر إليه، نعم، هذا الطفل الذي أمامك: إنه يهودي، والده يعيش الآن في إسرائيل}ص106.
وتقول المراجع أن{الحركة الكيبوتسية هى ظاهرة اجتماعية فريدة. وكان إسحاق طيبنكين الذى تولى رئاسة حركة “الكيبوتسين الموحد” (كيبوتسين: قرية تعاونية) بضع عشرات من السنين، يحمل مفهوما مبلورا ومتكاملا بشأن دورها وأهميتها. وكان يعتقد أن الكيبوتس هو جسم إستيطانى.. وعرف طبنكين ماهية الاستيطان بأنها “الاستيلاء على مساحة من الطبيعة بغية العيش فيها. ولم يكن الاستيطان فى نظره حالة سكونية ثابتة جامدة، بل سيرورة دائمة ومتواصلة}[4].
ونظرا للعلاقة الكاملة بين كل من مارشال، ومراية، لم تستطع مراية أن تستمر فى خصامها مع مراية، وفضلت متعتها، وضعتها فى الدرجة الأولى، ولكنها آثرت الصمت {وانتظمت مراية في تلقي دروس الرقص والحب والتلامس في شقة مارشال طوال خمسة عشر عامًا. وأثناء علاقتهما سافرت مراية إلى مصر وإلى فلسطين نفسها واطلعت على ما أوصلها إلى قناعة تامة بأن إسرائيل دولة مغتصِبة تبيد شعبًا بأكمله، ولكنها كأي إنسان حصيف قررت منذ البداية ألا يقف رأيها السياسي في مأساة لا تعرف في النهاية ضحاياها حائلً بينها وبين مارشال الحبيبة}ص107.
ومن هنا بدأ التغير فى رؤية السارد، أكملها بإزدواجية “مراية” {مراية كانت مزدوجة، ولكنها، أثناء الممارسة، طبيعية تمامًا، امرأة كاملة الأنوثة مع الرجل، ورجل كامل الرجولة مع المرأة، مع فيلسوف التلامس امرأة ومع مارشال صديقة فيلسوف التلامس…. رجل}ص231. ثم المقولة الصادمة-وللأسف الحقيقية- التى تنطق بها “مراية” والتى تضع السارد أمام نفسه، ليرى حياته معها {العرب لا يرون في الغرب إلا مبولة جنسية }. ص115. وليتذكر كيف تخلصت منه بكل هذه السهولة، ليرى أنه لم يكن بالنسبة لها سوى {شاب بدوي سيناوي قالت إنه يشبهني، وقضت معه العامين المحدَّدين لأي رجل مر في حياتها}ص120.
ورغم أن الهدف الأسمى بين كل من السارد و”مراية” هو العمل الثقافى المشترك، بعمل مسح وتعريف بالمدن، المصرية، والذى تخلله ذلك السؤال الحامل للدهشة والحيرة وإن جاء فى ضوء الحوار الثقافى والمعرفى بين مصر وفرنسا: عندما سألت “مراية : لماذا ظهرت الأديان السماوية في منطقة الشرق الأوسط؟ فأجابها :
{أنا أتوقع -وهذا توقُّع يخصني وحدي ولم يرد في أي كتاب سماوي أو أرضي- أن الأديان ظهرت في منطقتنا لأنها رعوية، الأدق بدوية صحراوية، فما يخيف البدو غالبًا قوى غامضة لا يستطيع فهمها أو مواجهتها، كالريح مثلاً القادرة على كنس خيمته في ثانية، أو لدغة العقرب أو الحية التي لا يعرف من أين أتت أو إلى أين تذهب، أو غياب البئر ومواجهة الموت نفسه في قلب الصحراء، أو السطو المسلح في الغفلة.. باختصار قوى ومخاوف لا يستطيع مواجهتها إلا قوة أشد غموضًا وفتكًا، ومن هنا ظهر الأنبياء برسالاتهم التي تدعو إلى إلهٍ قادر وقاهر ومسيطر على كل شيء.}ص83. إلا ان تساؤلات بدأت تظهر فى أعماق السارد، وبدأ الإحساس بأن الغرب ليس هو جنة الله على الأرض. وليتضافر ذلك مع رؤية الداخل وما به من كبت للحرية. يصل السارد إلى قناعته التى تنتهى إليها الرواية.
وهو أن “يدى الحديدية” رغم ما تحمله من سخرية، وإبتسامة مريرة، فإنها تضع “المراية” أمام أعيننا، كى نرى أنفسنا، ونرى تاريخنا، كما أنها “المراية” التى نرى الغرب من خلالها. ومن هنا كان ذكاء الكاتب فى إختيار اسم المرأة الفرنسية، التى استعار لها أسم “مراية” عوضا عن اسم صعب عليه- بنوع من الحيلة الروائية – أن ينطقه.
العنوان
نستطيع القول بأن العنوان كان العتبة الأساسية فى الدخول إلى النص، رغم أنه يعتبر مبتدأ بلا خبر، فجاء النص بكامله هو الخبر. وعلى الرغم من أن الكاتب فجأة وبعد عدد من فصول الرواية يكتب عنوان فصل “يدى الحجرية الجديدة”. دون أن يوضح فيما قبلها ما تعنيه اليد الحجرية. إلا أننا بالتأمل سنلحظ أنه قبلها، كان الحديث عن الجدود، وأفعالهم فى السرقة والنهب، ثم انتقل فيما بعدها إلى الحديث عن “مراية” التى إنتهت بانتهاء العلاقة، عندما أحس السارد بالإهانة {وبدأت أحلق، لا أحلق وإنما أغيب عن الوعي، ومددت أصبعي وتحسَّستها، كانت ناشفة، وبلَّلت إصبعي فقالت فجأة «اغسل إيدك، نعم؟ ! آه اغسل إيدك، فانهرت. انهرت فعلاً وأحسست بصفعة حقيقية على وجهي، ولم أعرف ماذا أفعل، وظللتُ فترة مشدوهًا وهممتُ بمغادرة الشقة عريانًا كما أنا. المشكلة مش في الكلمة، المشكلة في نبرة الكلمة، في احتقارها الذي لا لبس فيه، كانت تقول لي بزهو”أنا فرنسية”، وكانت تقول ع الأفارقة “بلاك”، وكانت تعتقد أن الفرق بين الأفارقة والعرب اللي في فرنسا أن العربي هيحط السلاح في دماغك عشان يخوِّفك وينفَّضك والأفريقي هيحط السلاح في راسك عشان يصورك ويضحك عليك وأنت خايف}246. ومن هنا كانت نهاية البدوىالذى فشلت علاقته بالفرنسية، وتيقن من ذلك عندما فشل العلاقة، التى لم تبتغ غيرها منه، وكأنها تؤكد عكس مقولتها عن العربى الذى لا يرى فة الغرب سوى مبولة جنسية، وكأنها لا ترى فى الرجل العربى سوى (..) يُفرغ حمولته {هي حاولت، وعندما لم تجد بارقة أمل اعتمدت على نفسها، نامت على ظهرها وضغطت وجهها في عنقي وواصلت بيديها بكل قوة وعنفوان، حتى جاءت الحشرجة، الحشرجة الناعمة، الأشبه بتهشيم عيدان القش تحت قدم بطيئة خفيفة وحانية، الحشرجة الحقيقية التي لم أسمعها أبدًا، وأطلقت صرخة مدوية لا بد أن الجيران سمعوها.. ثم همدت.}ص59.
ومن هنا كانت إنطلاقته لحياة جديدة، بعيدة عن ميراث الجدود، الذى جعل منه فاشلا ليصرخ فى وجه (الأم) {النجاح المايع ميعجبنيش. أنا لازم الذروة، الحاجة اللي معملهاش حد والحتة اللي موصلهاش إنسان، ومن هذا المنطلق ومن هذا المنظور ومن هذا المقياس أنا فاشل فاشل فاااااااااااااااشللللل…}ص248. وكان التوفيق فى توجيه التحذير إلى الأم، أى إلى الأصل، والتنبيه بأنه سيغادر كل ذلك الميراث، وأنه {آن الأوان أن أنجح وأنطلق} ولتصبح “اليد الحديدية، هى اليد التى تعمل، وتكتب دون أن يُخضعها موروث غير مشرف، أو استيراد ينظر بعين الاحتقار، أو الخوف.. لذا فسأكون..أنا.. وفقط.
استطاع أبو جليل أن بنثر المقدمات فى صحراء الفيوم، بين خيام البدو، التى استحضر فيها فرنسا بثورتها الأم، والداعية إلى الحرية، فخرج منها بأن تلك الحرية الحاملة لآحتقار الآخر، لا تتناسب ولا تتمشى مع تقاليد ذلك الصحراوى البدوى، بما يحمله من شموخ وإعتزاز بالنفس.. فقرر أن يبدأ بيده الحديدة.. فى بناء نفسه، ومجده. مصداقا لمقولة {الإنسان قادر على كل شيء، و لو أراد شيئًا بإخلاص لتكاتف الكون لتحقيقه}ص32.
………………………………
[1] – د أيمن عبد العظيم رحيم – حمد باسا الباسل وصفحات خالدة من كفاح عائلة عربية- يسطرون للطباعة والنشر – 2020.
[2] – حمدى أبو جليل – يدى الحجرية – الهيئة المصرية العامة للكتاب ط1 2021.
[3] – الرواية ص 123، 124.
[4] – دانيئيل دى ملاخ – الكيبوتسات وصراع السيطرة اليهودية على الأرض- دورية “مدارات التاريخية الربع سنوية” عدد 64.