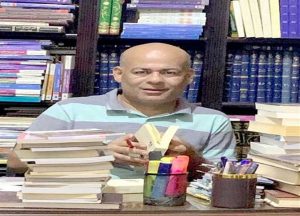غادة أحمد
قابلته للمرة الأولى في الإسكندرية، سافرت إليه كمن يحج إلى قِبلته. بمجرد وصولها كتبت له عبر واتساب: أريد الاتصال بك. أثناء انتظارها لرده كانت قد وصلت إلى الفندق، نامت قليلًا، استيقظت ونظرت في الهاتف لترى إن كان أجابها، فلم تجد ردًّا. شردت قليلًا، على وجهها طيف انفعالات مختلفة، تنهدت، ثم أخيرًا قررت أن تتحلى بالصبر.
قامت لتأخذ دُشًّا دافئًا، وعادت لتفقُّد الهاتف ثانية. لا رسائل منه.
بالبُرنس جلست على حافة السرير لتمنح جلدها تدليلًا وترطيبًا بالبدي لوشن، حين سمعت صوت الرسالة. اهتز قلبها كمن مسته كهرباء خفيفة؛ عرفت أنه هو، قرأت رسالته: أكلمك دلوقت؟ فردت على الفور: أوكي، مستنية.
– مساء الفل يا روحي.
– مساء الجمال والشوق يا حبيبي. عامل إيه؟
– أنا كويس. وحشاني.
– وانت واحشني ونفسي جدًّا أشوفك.
– وانا كمان نفسي جدًّا أشوفك.
– فعلًا؟!
– أيوه طبعًا فعلًا.
– طب أنا في إسكندرية دلوقت.
صمت خفيف شعرت فيه بابتسامته، وبأثر المفاجأة عليه. سألته:
– بتبتسم؟
– بابتسم. فرحان. إنتِ فين؟ عاوز أشوفك حالًا.
– أنا في الكريون، تحب نتقابل فين؟
– في الكريون؟! عشر دقايق وابقى عندك.
– طب أنا لسه ما لبستش حتى، نص ساعة وأنزلك؟
– وليه تلبسي أو تنزلي، أطلعلك انا!
– يا سلام!
ضحكا.
– هاستناكِ في ديليس. ما تتأخريش.
أنهيا المكالمة على وعد بلقاء بعدها بدقائق معدودة. وقفت أمام المرآة بجسد مفرود وواثق من جماله الخاص، رغم ندوبه ورغم آثار إهمالها وكرهها له لسنوات. هو من منحها هذا الإيمان بنفسها والتقبل لجسدها، وأحبها كما هي ناقصة، تكتمل بالحب في عينيه.
لحظة التقت أعينهما فرت كل المخاوف والشكوك والارتباك. ونزلت ستارة شفافة على الكون كله، حجبت كل ما عداهما. ساد السكون وانبثقت، مثلما يحدث في كل لقاء تشعر فيه بوجوده حاضرًا ناطقًا حيًّا، موسيقى يتراقص على إيقاعها قلبها، وتتحول كلماته، حتى تلك الأشد عادية، إلى لمسات تعيد خلقها وتشكيل روحها من جديد. مد يده لا ليسلم، بل ليحيط خصرها، ويشدها إليه ويضمها، فغابا للحظات. حينما أفلتها لينظر مجددًا في عينيها لمح تلك الحمرة التي وصفتها له مرارًا تُلهب خديها فضحك وشدها من يدها إلى حيث سيجلسان.
عرفته افتراضيًّا قبل لقائهما الأول بفترة طويلة، بعد تعليق له في فيس بوك أثار انتباهها رغم أنها عادة ما تتابع السوشيال ميديا بنصف تركيز ونصف لا مبالاة يميزانها. لكن أنَّى لها تجاهل رجل لم يمنح العالم نظرته ولا انتباهه، وأدار وجهه عمدًا!
شعرت أن صورته تنبئ عن شيء مشترك بينهما. حدسها لم يخِب. مرت إلى صفحته مرورًا خفيفًا لأنها لم تكن تنوي التورط ولو بمجرد إعجاب بعد إنهائها القريب لعلاقة دامت سنتين، واستنزفتها بالكامل. في البدء تمعنت في صوره، ورغمًا عنها وجدت نفسها تستنطق ملامحه التي أسرتها، تسلل وجهه إلى داخلها، ولإبعاده بدأت تصفح منشوراته أملًا في ألا تجد فيها ما يستوقفها فتفر. فرغم ميلها إلى سمات خارجية محددة في الرجل، لم تسمح لنفسها بالإعجاب بغبي أو مدعٍ لثقافة أو مزيف مهما كان وسيمًا. لكنها وجدت في صفحته كتابة تحبها، وتأملات تقترب من أشد مناطقها خصوصية، ومساحة إلى الداخل/ داخلهما تعرف حدود بوحها، وخفة وسخرية عند الاقتراب من عبث الواقع ومساوئه التي ما زالت تتعامل هي معها تعامُل مراهقة لم يُنضِجها الألم ويُحول ضعفها إلى جَلَد.
كانت لا تزال تنزف آثار علاقة مسمومة لتطهر دمها من أثر خيانتها لنفسها. واحتملت العيش تحت وطأة ضغوط ثقيلة سلبت أمانها وزعزعت استقرارها لسنوات. كانت في أشد أوقاتها قتامة، تدير وجهها للحياة كلها، حينما بدأت يد اهتمامها تمتد نحوه. أدمنت المرور إلى صفحته عشرات المرات يوميًّا، من دون أن ترغب في الإعلان عن نفسها ولو بتفاعل واحد. منحتها كلماته ومشاركاته بذرة حياة تمنت من أعماق قلبها ألا يُنبتها أحد سواه ولا هي حتى. ففي كلماته عرى جزءًا من روحها وبإنسانية محب لا يعرف كيف يصدر حكمًا أخلاقيًّا على أحد، منحها ابتسامة طَمْأنة. رغبت في وجوده في حياتها، ليس كفارس يحمل خلاصها، بل كإنسان يمنحها بعض الإيمان والثقة والتقبل والحب، وفي المقابل كانت مستعدة لتمنحه كل شيء؛ حياتها وعشقها وروحها وكل كيانها.
بعد تفاصيل عديدة لا تهم سواهما، تفاصيل عادية ومربكة في بساطتها عشناها في قصصنا العاطفية المتفردة، صارا قريبين، لا يهمنا كثيرًا أيهما مد يده بالسلام أولًا، لكن مشاعر حزن وارتباك وخوف بدأت تشوب علاقتهما. هذه المشاعر التي ظهرت لتوِّها كانت مختبئة في ركن قصي من روحيهما المتعبتين، ركن كانا يعرفانه جيدًا.
وإذا بها لم تعد تعرف هل تتقدم أم تتراجع، هي التي كرهت دائمًا الخطوات الواقفة وأنصاف الحياة، واندفعت واقفة مفتحة العينين إلى الحياة، كان لزامًا عليها أن تكبح هذا كله خشية إيذائه أو استدرار عطفه واقترابه. كانت هشة وغير واثقة في كونها صارت محبوبة حقًّا لرجل مثله. لا نعرف كيف تسرب هذا التحول إليها ومتى بدأ، ولا نعرف ما يخفيه هو من جراح وآلام سرية، نعرف فقط أن عينها لم تتحول عنه قَط وظلت تنتظره بصبر عاشقة لا يتسلل إليها الضجر. مكررة على نفسها قواعد عشقه بصرامة؛ أن تعطي، أن تتقبل، أن تتفهم، ألا تنتظر، ألا تتوقع، ألا تأخذ سوى ما يمنحه برغبة وحب، أن تفهمه، أن تحبه بلا قيد أو شرط. أن تكون له كل ما أراده ورغب فيه ولم يجده، مهما كلفها هذا من عذاب صده ونأيه، وكَتْم حاجتها إليه.
دندنت: وان كان أمل العشاق القرب، أنا أملي في حبك هو الحب.
لم تفكر قَط في أن تصير قديسة، وهجرت فكرتها الساذجة عن المثالية بعد أن أدركت كم كلَّفتها. لكنها الآن تحاول اختبار حب شعرت به حقيقيًّا، لذا حاولت أن تمنحه نفسها بالكامل، ليس فقط لأنه الشيء الوحيد الذي يستحق أن تحيا من أجله كطوق نجاة من كل الشرور التي أحاطت بها، إنما لتحاول أيضًا اختبار ما رددته كثيرًا من دون فهم واعٍ: الحب من أجل الحب.
كان يتحدث عن الفيلم الذي شاهده مؤخرًا، وعن تلك اللقطة التي تمنى أن يعيشها مع من تبادله الحب نفسه، حينما لاحظ كيف تنظر إليه، فتوقف مرتبكًا وخجلًا للحظة وضم يدها. كانت هائمة في عمق عينيه، تشرب كلماته وتتنفس الهواء الذي يزفره، محاوِلةً قراءة رسائله التي لم يقُلها.
قالت:
– هل تعرف أنك الرجل الذي تمنيته طويلًا، بكل ما فيك، الرجل المثال، المناسب تمامًا لامرأة مثلي؟ أردت دائمًا لقاء كهذا، لأنني شعرت أن التواصل الافتراضي غير كافٍ، وأن لقاءنا يجب أن يكون حقيقيًّا. كنت أرغب في النظر إلى عينيك، لأبحث فيهما عني، عما أُمثله لك، أن أسمعك بلا توقف، أن أعرفك، أن تتحدث إليَّ كما تتحدث إلى نفسك.
وكعادتها، انكمشت روحها، وخشيت أن تكون تعدت حدًّا وضعه لها. فاستدركت:
– لم أقصد أن أطالبك بأن تُدخِلني إلى غرف ترى أنه ليس من حقي ولوجها بعد.
تمنت في هذه اللحظة أن يضمها فقط، لتخبئ ارتباكها، عرضت عليه أن يتمشيا معًا. سألها لماذا يداهمها الخوف. أخبرته لأنها لم تحب هكذا من قبل. ضم يدها وأكملا سيرهما.
كانت تدور في دوامات من الخوف والحب، لكنه كان خوفًا آمنًا، مشاعر جديدة لم تختبرها من قبل. وفكرت طوال الوقت فيه أكثر مما فكرت في نفسها. لهذا أيضًا كانت تريد أن تسمعه، ربما حينها يمنحها حق تشكيل روحه من جديد مبرأة من كل خيبة ووجع، كانت تشعر أن الماضي يقف بينهما، كانت ترى هذا في صمته ونأيه، كما تمنت أن تُعلِّمه كيف أن الحب قادر على رأب صدوع الروح وتجديدها، وله من الاتساع ما يحتوي كل تناقضاتنا وتقلباتنا النفسية والمزاجية.
أمام البحر أوقفته، رفعت يده وفتحتها، وعبر خطوطها كتبت، من دون أن ترفع عينيها إلى عينيه: أحبك، وأشتهيك.
مس ذقنها ورفع وجهها إليه وقبَّلها بنهم، قُبلة عرفت منها كم يحبها، وكم يتعذب مثلها.
في سيرهما المحموم إلى الفندق، تشكلت في رأسها غيمة من كلمات وأسئلة، دارت حولهما وحول وضعهما الملتبس، بعضها وجَّه إليها اتهامًا بالأنانية، وبعضها شكَّكها في وعود قد لا تفي بها، وبعضها سألها عن وجهتها واتهمها بإغوائه.
وقفت، مشتتة وضائعة، استغرب واستفهم منها، كانت تلك الغيمة تبتلعها في داخلها وتخنقها. وجدت في نفسها حساسية تمنعها من التدفق ناحيته بحرية، لم تفهم السبب، فبحثت لديه عن تفسير. كان متحفظًا خائفًا من الدخول في شِباك الحب، وكانت خائفة، تذكرت اتفاقهما على القفز معًا، تذكرت وعده لها بتعليمها العوم والحب، تذكرت اتفاقهما على ألا يفلت يدها. كان في ضعفه قويًّا وراسخًا، وكانت مرتعشة، ارتمت في حضنه وتقبَّلها، امتزجا كما تمنت، ارتقيا كما تمنى، وارتعشا معًا، فتساقطت الغيمة مطرًا يطهر روحيهما، ويمنحهما سلامًا، فكرت أنه حتى لو لم يَدُم فلن يكون جارحًا أبدًا. لأنهما تعلما جيدًا حب الحرية والتحليق، وتعلما كيف يحبان من دون أن يمحوا حدودهما.
لو كنت معي الآن، نُحلِّق فوق الميناء الشرقي، لرأيناهما عبر نافذة غرفة الفندق عاريين، يتبادلان تدخين سيجارة واحدة، وشعاع ضوء خافت يتمايل ظله مع الستارة الشفافة ينعكس على جسدها. هو يتأمل عُريها الفاتن والدخان حول رأسها، وتدندن هي: خد عمري كله، بس النهارده خليني أعيش.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتبة مصرية