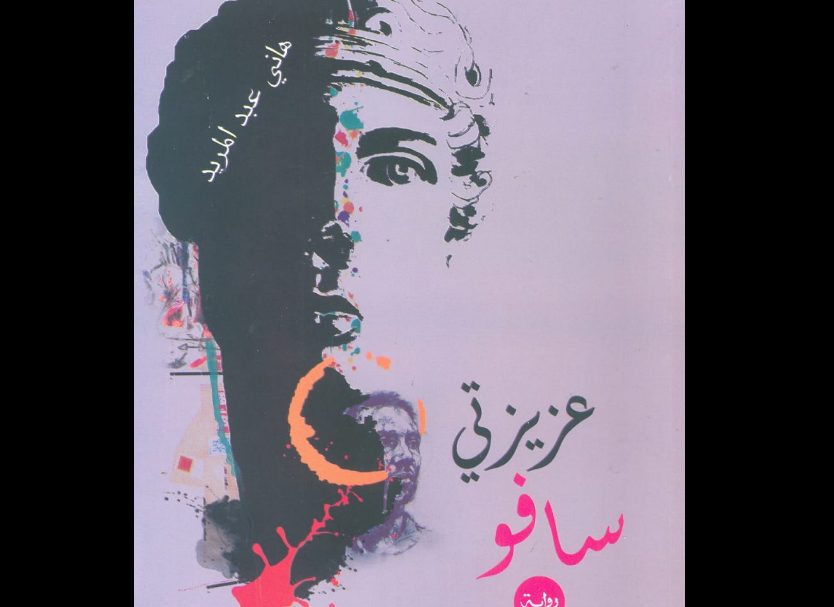صارت أشجان تتردَّد بحُرِّيَّةٍ على بيت خالد، بعدما تعرَّفَت على إحدى الجارات، حكت كذبًا عن زواجها من بولا -الذي لم تُسمِّه بولا- ابن خال خالد، أتت معه من أسيوط حتى يتعالجا من العُقم عند طبيبٍ كبير هنا في وسط المدينة، دعت لها الجارة بأن يراضيها الله ويرزقها الخلف الصالح، بينما تنهَّدَت أشجان وردَّدَت من كل قلبها بصدق:
“آمين، يا رب يا خالة والنبي”.
صار بولا يجلس في براح الروف بعباءته النصف كم الفضفاضة، بينما تأتيه أشجان بكوب شاي بالنعناع، أو بقطعة بسبوسة من التي أتت بها بالأمس بعد انتهائها من عملها، بينما رفض كُلٌّ من خالد وبولا تَذَوُّقَها، حينها دمعت عيناها، أقسمت أنها لم تشترها من فلوس عملها، بل من حوالة بريدية ترسلها جَدَّتُها كُلَّ فترة لتشتري ما تشتهي، أشجان لم تكن راضيةً عَمَّا تفعل، هي لم تلجأ لهذا الطريق إلَّا مُجبَرَةً، الجميع لم يرحمها، الجَدَّة التي ترسل لها نقودًا من حين لآخر، تحاول أن تُكفِّر عن ذنب هَجرِها وتخلِّيها عنها، هكذا تقول بينما جسدها يرتعد، وهي تحاول منع دموعها، ومسح سيلان أنفها، كانت مضطربة منكسرة وهي تبدأ بسؤال:
“عمركم فكَّرتم وانتوبتقروا الحوادث، عن مصير الناس دي إيه؟”.
أسرة سعيدة، أب وأم لديهما أجمل ولد في الدنيا، فعلًا كان الأجملَ على الإطلاق، وبنت أصغر قليلًا مُبتَسِمَة دومًا لا تعرف شيئًا عن غدر الزمان، تجلس بجوار أخيها الذي يلعب بسيارته الصغيرة، مُحدِثًا صوتًا يزعج الأب، ينبِّهه مرَّةً، وفي الثانية يضرب الصغير، يدفعه، يصطدم بالحائط، يسقط والدماء فوق وجهه، وقبل أن يروح ينظر للجميع كمَن يودِّعهم وهو لا يفهم ماذا حدث، ينظر للأب كأنه يتساءل: هل ما يحدث حقيقي، هل هذا هو الموت؟ كان بالفعل كابوسًا، لكن لم ينته، مات الولد الجميل، لم يتحمَّل قلبُ الأُمِّ المشهد، سقطت في الحال لتُفارِقَ الحياة بأزمة قلبية، وفي الصباح كتبت الجرائد عن رَجُلٍ تَوتَّر لسقوط أسهم البورصة فدمَّر أسرته…
حين تقرأ مثل هذا الخبر، فتتندَّر، أو تبتئس، هل فكَّرتَ كيف ستكبر هذه الطفلة، كيف تكون حالتها النفسية حين تعرف أن أباها قتل أخاها وتَسبَّب في موت أمها من أجل هبوط البورصة.
تصمت باكِيَةً، بينما خالد يكمل:
“متهيَّأ لي كده كنت سمعت مرَّة إنُّه مَوِّتهُم عشان حِتِّة لحمة”…
تبتسم أشجان وتؤكِّد:
“هو أنا مُخِّي دفتر!”.
يضحك خالد ويشاركهما الضحك بولا دون أن يفهم بالضبط السَّببَ…
لو كانت لدى بولا فضيلة واحدة فهي القدرة على الاستماع، قدرة لا تَكِلُّ ولا تَمَلُّ، كانت أشجان تحكي وبولا يستمع، يستمع ويتعاطف ويُحلِّل ويربط، ويقول رأيه الناصح بكل أمانة، بولا لا يهمُّه التَّحقُّق إن كان ما تقوله حقيقة أم كذبًا، هو فقط يسمعها، ويقول رأيه بكل جدية…
جلسات الرسم تعدَّدَت، انتهى سريعًا من خمس لوحات لأشجان، لم يبدُ لها فقط كرسَّامٍ، كان يعيد تشكيلها مع كل لوحة، ساعدها لترى نفسها من زوايا أخرى، تلمس ملامح وتفاصيل، بل وقدرات مختبئة داخلها لم تكن تراها، لم يكن أَحدٌ يراها غير بولا الذي كان ينظر لها كعَطيَّة، أنها كَنزُه الذي صنع نَقلَةً فيما كان يقوم به، كان يرسم ويستمع لها، يرسم وتحكي، كأنه يرسم ما يسمع لا ما يرى، باع بلا تَرَدُّدٍ الكثيرَ من لوحاته السابقة، لوحة فلوحةً؛ حتى يستطيع العيش، مَرَّ بمرحلة كان يحتفظ بهم من أجل معرضه الأول الذي يأمله، لكنه قرَّر أن تكون لوحات أشجان هي معرضه الأول، خاصة وأنه وصل أخيرًا لجاليري يقبل شراء لوحاته القديمة.
كان خالد يبدو لهما كطَيفٍ، يعيش معهما لكنه لم يَكُن معهما فعليًّا، يستمع لما يقولان، يبتسم، يجيب على تساؤلاتهما حول أمرٍ ما، لكنه كجهاز مضبوط على تردُّدٍ غير تردُّدِهما، كأنه يعيش على أرض ويتعامل مع أناس مختلفين عنه في كل شيء…
مرَّ وقت طويل لم تظهر خلاله سافو في أحلامه، في البدء صبر وانتظر، مع طول غيابها، رفض فِكرَةَ أن أَمرَها انتهى، أنه لن يستمع لها مرة أخرى، لن يقام حوارٌ آخر بينهما، كان يشتاق إليها، يخاف أن تكون النهاية بالفعل، مع كل يوم يزداد توتره، يزداد أمرُه سوءًا، حتى إنه في انتظار سافو خسر كل شيء دون أن يعي ذلك، لم يوقِف رغبته المحمومة في رؤيتها أيُّ شيء، في المكتبة جعل سميرة تبكي، وهو لا يدرك ماذا قال وماذا فعل، في التليفون تشاجر مع ميليسا التي أنهت المكالمة مُنفَعِلَةً قائلة إن التليفون غير مُجدٍ، وأنها تنتظر أن يمرَّ عليها بشكل ضروري.
في البيت كان وحيدًا بعدما نزل بولا مع أشجان لزيارة مسجد السلطان حسن، كان المَمرُّ بين مسجِدَي السلطان حسن والرفاعي من أكثر الأماكن التي يعشقها بولا، اصطحب أشجان لتستشعر ما حكاه لها عن مكان لم تلتفت له من قبل، قرَّر أن يبدأ لوحةً جديدة لها بإيشارب غير مُحكَم، تمدُّ يديها بشمعة مضاءة بينما تنظر للضريح بتبتُّلٍ…
استغلَّ خالد وحدته بالشَّقَّة، قرَّر أن يستحضر سافو بنفسه هذه المرة، لماذا تأتي بإرادتها فقط وقتما تحب؟
جرَّب طريقة السَّلَّة التي قرأ عنها من قبل، حتى يستحضر روحها، لكنها لم تنجح، جرَّب إظلام الحجرة واستخدام طريقة “نعم.. ولا”، جرَّب كل الطرق التي استطاع الوصول إليها، لكنها لم تأتِ، ومع كل محاولة وكل إخفاق كان يزداد يأسُه وتَوَتُّرُه، كان يشعر بالأزمات تحيطه من كل جانب، ميليسا تهدِّد مستقبله، الكتابة عَصيَّة، سافو هَجَرَته بلا سبب واضح، حياته مُتعطِّلة، لا يملك غير سِتِّين جنيهًا، ويعلم أن ميليسا لن تمدَّه بمزيد من المال حتى يخضع لما تريد.
بينما يجلس حزينًا مُتدلِّيَ الكتفين كرجل عجوز، دخلت أشجان بضحكتها العالية، من خلفها بولا يحمل لوحته الجديدة التي لم تكتمل.
كانت مليئةً بالحياة، كمن تتلمَّس طريق السعادة الحقيقية لأوَّل مَرَّة.
كذلك بدا بولا كمن يكتشف نفسه من جديد، يكتشف علاقاتٍ جديدةً وروابِطَ بينه وبين الحياة عامَّةً، وبينه وبين لوحاته وألوانه، كأنه وصل لطريق للتعبير الفني أو لأسلوب كان يعمل طوال السنوات السابقة من أجل الوصول إليه.
دخلا للبيت بدبيب الحياة، يتحدَّثان بانطلاق عمَّا دار طوال اليوم، يخبران خالد أنهما تَمنَّيا وجوده معهما اليوم، يعطيانه نصيبه من السندوتشات، حيث أكلا بالخارج، بدا خالد كمن يُقْدِم على حالة من الاكتئاب، لم يستطع التفاعُلَ مع ما يشعران به من سعادة، كان عنيفًا، رفض أن يمدَّ يده لتناوُل السندوتشات من يد بولا، رفض الإحسان كما قال، تطوَّر الأمر سريعًا، أهان أشجان، جرح بولا، كان يفعل ما يفعل ببساطة، كأنه ينطق بقناعاته الشخصية الراسخة، قال الكثير عن حياته المُهَلهَلَة، حياته التي اختُرِقَت وصارت مُستباحَة، تحدَّث منفعلًا عن عجزه عن الكتابة والتركيز، أرجع ذلك بسبب وجودهما بحياته، أرجع كل فشله وضعفه لوجودهما…
خرج بولا مُسرِعًا بعدما لملم أشياءه، ولأنه كان يعلم بإفلاس خالد؛ فقد ترك له دون أن يُلحِظَه خمسمئة جنيه فوق سريره، فوقهم ترك لوحة كوربيه “الرجل الذي جُنَّ من الخوف”، خرج بوجهٍ مُحمرّ وعيون تلمع بالدموع، تبعته أشجان شاعرة بالأسف، بعدما نظرت لخالد لائِمَةً، رحلت وكأن لسان حالها يعاتب الزمن الذي بخل عليها ببضعة أيام أخرى تشعر فيها بالأمان.
في ذلك اليوم ظلَّ بولا وأشجان يلفَّان في الشوارع حتى خفتت الأرجل، فرغت الشوارع من المارة، اصطحبته سرًّا لحجرتها، التي بَدَت معها رفاهية شقة خالد…
في تلك الليلة لم ينم خالد، ظَلَّ مستيقظًا فوق فراشه على الأرض، ترك السرير كأنه ما زال لأشجان، ظل مُحَملِقًا في السقف، دمعت عيناه، عنَّفَ نفسه، لكم الحائط بقبضته كعادته عندما ينفعل، مع أول ضوء نهض، لمح اللوحة، ابتسم لها ولبولا، قال له صباح الخير كأنه يراه، خرج للروف، كانت الشمس في بداية الإشراق، مجرَّد ظهوره حفَّز كلب الجيران بالروف المقابل، نبح معلنًا عن وجوده، اقترب من السور، شبَّ بقدميه، كرَّر نباحه بصوتٍ أعلى، اقترب خالد من السور أيضًا، نظر في عينيه، قال له بثقة “اخسأ”، سكت الكلب على الفور، طأطأ رأسه مُذعِنًا، ثم عاد ليجلس في مكانه بهدوء، ابتسم خالد، قال في نفسه، لو تقابلنا في الوقت المناسب، لَتغيَّر في حياتي الكثير، في هذه اللحظة اكتشف أن كل منظومة قِيَمِه لم تأت من تعليماتِ أبيه وأمه بالبيت، ولا من المُدرِّسين والمُدرِّسات بالمدرسة، ولا من الشيوخ بالمساجد، بل جاءت جميعها من قصص الأطفال، التي حَوَتها المكتبة، ونطقت بها برامج الصغار بالتليفزيون، وسمعها من قبل في حِجر جَدَّته، تلك القصص التي ينتصر فيها الخير على الشر مهما طال الأمد، ويُتلِفُ فيها الطَّمَعُ كُلَّ ما جُمِع، قصص استشفَّ منها قيمة الأمانة وقَولَ الحَقِّ ونُصرَةَ الضعيف…
حينها تذكَّر سؤال بولا حول العلاقات خارج الزواج، قال مبتسمًا كأنه يسمعه:
“لأن مفيش ولا قصة أطفال قابلتها اتكلِّمِت عن التظبيط يا عم بولا”…
هذا التفكير جعله يشعر برهبة ومسؤولية أن يكون كاتبًا، شعر بنفس الرهبة وهو يقف أمام مقبرة “كاجمني”، أحد وزراء الملك “تيتي” بمنطقة سقارة، كان منشغلًا ومبهورًا بالنقوش المُلوَّنَة، بينما بدأ الدليل يردِّد على مسامعه بعض أقوال الرجل، كانت تشبه ما يُقال الآن بكتب التنمية البشرية، لكن جملة واحدة عَلِقَت بذهن خالد:
“فرِحٌ هو قَلبُ الكاتب؛ يزداد شبابًا كل يوم بما يعطي للناس؛ فغذاء العقل الذي تُقدِّمه للناس باقٍ”.
استشعرت الجملة؛ ما جعلني أرهب الكتابة، هل شعور المسؤولية يأتي معي بأثرٍ عَكسيٍّ، هل يمكن أن يكون ما بيني وبين الكتابة نوع من الرهبة، رهبة تمنعني أن أُتِمَّ عملي، لكن قد يكون هذا منطقي مع الكتاب الأول أو الثاني، أنا كتبت من قبل روايتين ومجموعةً كبيرة من القصص المُتفرِّقة، أيَّة رهبة لعينة تلك التي تأتي لكاتِبٍ قطع شوطًا في الكتابة…
هل يمكن أن تكون الرهبةُ قَرينةَ المعرفة لا الجهل؟
لو كان الأمر بالفعل كذلك، فهو بلا شك يُقبِل على حياة يزداد جحيمها يومًا بعد يوم، عليه أن يستعدَّ لذلك ويتفهَّمه…
عاد لسبب خروجه للروف، اعتلى السور، أغمض عينيه، سار بسرعة أكبر من المعتاد، قفز عند النهاية على أرض الروف بثقة، بدا على وجهه كأنه يمقت مروره سالمًا هذه المرة، يَمقُت بقاءه ليوم جديد.
دخل بعدما ألقى نظرة سريعة على الكلب الذي ما زال مُذعِنًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرواية صادرة مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب