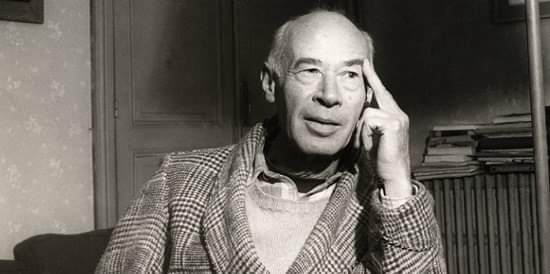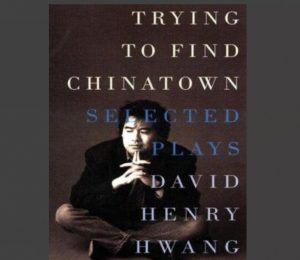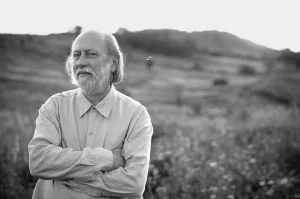هنري ميلر
ترجمة: محمد عبد النبي
رَدًا على سؤال في استبيان صحفي، قالَ كنوت هامسون إنه يكتب ليقتل الوقت. وأعتقد أنه حتَّى إن كان صادقًا في قوله ذلك فإنه كان يخدع نفسه. الكتابة شأنها شأن الحياة ذاتها، رحلة استكشاف. للمغامرة طابعٌ ميتافيزقي، إنها طريقة لمقاربة الحياة على نحوٍ غير مُباشِر، ولاكتساب رؤية كُلية للعالَم بدلًا مِن النظرة الجزئية القاصرة. يعيش الكاتب بين العالَمين، العالَم الأعلى والعالَم الأدنى، ويسلك الطريق بهدف أن يصير هو نفسه الطريق في نهاية المطاف.
أمَّا أنا فقد بدأت مِن فوضى تامة وظلامٍ دامس، في بِركة راكدة أو مُستنقَع للأفكار والعواطف والتجارب. وفي الوقت الراهن حتَّى لا أعتبرُ نفسي كاتبًا، بالمعنى المعتاد والشائع لهذه الكلمة. لستُ سوى رجل يروي قصةَ حياته، وهي العملية التي تبدو كأنها لا تنضب ويتأكَّد هذا الإحساس أكثر فأكثر كلّما واصلت العمل. إنها عملية لا نهائية، مثلها مثل تطوُّر الكون. إنها انقلاب وانكشاف، ارتحالٌ عبرَ أبعادٍ مجهولة، وثمرة ذلك كله أن يكتشف المرء عند نقطةٍ ما على الطريق أنَّ ما يحكيه ليس هو المهم بالمرة بقدر ما هو فِعل الحَكي في ذاته. وهذه سمة ضِمنية في كل فن، وهي نفسها ما يًضفي على الفن صِبغة ميتافيزيقية، بحيث تحمله وترتفع به خارج الزمان والمكان وتضع في مركز العملية الكونية أو تدمجه بها. وهذا ما يمنح الفن قدرته (العِلاجية): ما يمنحه شأنه وأهميته، ولا غَرضيته، وطابعه الخالد.
مِن البداية الأولى تقريبًا كنتُ أدركُ إدراكًا عميقًا أنه ما مِن هدفٍ ولا غَرض. لم أتمنَ قَط أن أحيطَ بالكُلي الشامل، بل أن أمنحَ كلَّ جُزئية منفصلة، وكلَّ عَمل، إحساسَ الكلي الشامِل بينما أواصل وأمضي قدمًا، لأنني أواصل الحَفر أعمق ثم أعمق في الحياة، أواصل الحفر أعمق ثم أعمق في الماضي والمستقبل. بالتنقيب الذي لا ينقطع، ينمو يقينٌ هو أعظم مِن الإيمان أو العقيدة، فقد كنتُ أزدادُ لامبالاة بشأن حَظي، ككاتبٍ، بينما أزدادُ انشغالًا واهتمامًا بمصيري، كإنسان.
بدأتُ بالمثابرة على فحص أسلوب وتقنية أولئك الكُتَّاب الذين كنتُ ذات مرَّة أُعجَب بهم وأتعبَّدهم: نيتشه، دوستويفسكي، هامسون، بل وحتَّى توماس مان الذي أستبعده اليوم لكونه مُصطَنعًا بارعًا، صانعَ قوالب طوب، حِمار شُغل لكنه مُلهم. وأخذتُ أقلّد كل أسلوبٍ برجاء أن أعثر على مفتاح ذلك السِر الممض وهو كيف نكتب. في نهاية الأمر وصلتُ إلى طريقٍ مسدود، إلى درجةٍ مِن الإحباط والقنوط لم يعرفها إلَّا قليل مِن الناس، وذلك لأنه لم يكن ثمّة انفصال بيني أنا الكاتب وبيني أنا الإنسان: وإذا فشلتُ ككاتب فقد فشلتُ أيضًا كإنسان. وقد فشلتُ، وأدركتُ أنني لم أكن شيئًا يُذكَر – أقل مِن لا شيء – كمية بالسالب. وحدثَ عند هذه النقطة تحديدًا، أي بينما كنتُ ضائعًا وسط المحيط كأني في بحر سارجاسو، أنني قد بدأت أكتب حقًا. بدأت من لاشيء، وتخلصت مِن كل شيء على متن سفينتي بأن رميته في مياه المحيط، حتَّى أولئك [الكُتَّاب] الذين أحببتُهم أكثر مِن سواهم. وعلى الفور سمعتُ صوتي وأنا مفتون: الحق أنه كان صوتًا مستقلًا، واضحًا يسهل تمييزه، وفريدًا لا يشبه سواه، وهذه الحقيقة وحدها شدَّت مِن أزري. لم يكن مهمًا عندي إن كان ما أكتب لا بد أن يُعدّ ردئ، فقد استبعدتُ الجيد والردئ من قاموس مفرداتي. قفزتُ بقدميَّ الاثنتين في مملكة الجماليات، في مملكة الفن التي لا وجود فيها لأحكام أخلاقية أو نَفعية. أصبحت حياتي ذاتها عملًا فنيًا. عثرتُ على صوت، وعدتُ كُلًا واحدًا مِن جديد. كانت التجربة شديدة الشَبه بما نقرأه بخصوص قصص حياة المريدين المبتدئين في عقيدة الِزن البوذية. كان إخفاقي الهائل مِثل تلخيص لكامل تجربة النوع الإنساني: كان عليَّ أن أتشبَّع بالمعرفة حد التلوث بها، ثم كان عليَّ أن أدرك بُطلان كل شيء، وأن أحطم كل شيء، وأن أصاب باليأس، ثم أتواضع، ثم أمسح كل كتابة من على سبورة نفسي، من أجل أن أسترد صحتي وأستعيد أصالتي. كان عليَّ أن أصل إلى الحافة ومِن ثمّ أن أقفز في قلب الظلام.
إنني أتحدّث الآن عن الواقع، لكنني أعلم أنه ليس من الممكن القبض عليه، على الأقل عبرَ الكتابة. أتعلّم أقل، وأدركُ أكثر. أتعلم بطريقةٍ مختلفة، طريقة باطنية أكثر. وبوتيرة مطردة أكتسب موهبة الحَدس والبداهة. أكتسب القدرة على أن ألحظ، وأعقل، وأحلل، وأركّب، وأصنّف، وأشي، وأُفصح – كل ذلك معًا في الآن نفسه. بمزيدٍ من السرعة والطواعية تتكشف أمامَ عينيَّ العناصر الأوَّلية التي تتألّف منها الأشياء. وأُعرضُ عن جميع التأويلات الواضحة كالشمس: فَمع التبسيط المتزايد يحتدم اللُغز ويتعاظم. ما أعرفه ينزع لأن يصير أكثرَ فأكثر غير قابلٍ للتعبير عنه. أعيشُ في يقين، وهو يقين لا يعتمدُ على براهين أو إيمان. أعيشُ لنفسي تمامًا، إنما بلا أهون قدرٍ مِن أثرة أو أنانية. أعيشُ محققًا حصتي من الحياة وهكذا أسهمُ في دَفع المخطط الكبير للأمور، وهكذا، ففي كل يوم وبكل طريقة ممكنة، أعزز مِن حركة ارتقاء هذا الكَون ومِن ثرائه وتقدمه. أعطي كل ما يتوجَّب علي أن أعطيه، طوعًا عن طيب خاطر، وآخذُ بقدر ما يمكن لي أن أحتمل وأهضم. إنني أميرٌ وقُرصان في نفس الوقت. أنا عَلامة (يُساوي) في الرياضة، وهي النظير الروحي لبُرج الميزان ذلك الذي حُشرَ قسرًا كالإسفين في المخطط الأصلي للأبراج الفلكية عن طريق إبعاد العذراء عن العقرب. أجدُ أنَّ ثمَّة متسع في العالم لكل إنسان – أعماق هائلة بين كل حيز وآخَر، عوالِم هائلة بداخل كل ذات، جُزرٌ هائلة للتجديد والإصلاح، لكل إنسان يظفر بفرديته الخاصة. على السطح، حيث تحتدم المعارك التاريخية، وحيث يُترجَم كلُ شيء بلغة المال والسُلطة، قد يوجد ازدحام واحتشاد، غير أنَّ الحياة تبدأ فقط عندما ينزل المرء تحت السَطح، عندما يُقلع عن الصراع، ويغوص ويختفي عن الأنظار. أستطيعُ الآن أن أكتب أو ألَّا أكتب بمنتهى السهولة في الحالتين. وأيًا كان ما أفعله فإنه نتاج البهجة الخالصة: أطرحُ ثماري مثل شجرة طابَ قطافُها. ولا يشغلني على الإطلاق ما يراه القارئ العام أو النقاد في تلك الثمار. أنا لا أكرسُ قِيمًا: إنني أتغذَّى وأتغوَّط. المسألة بهذه البساطة.
هذه الحالة من اللامبالاة السامية تطورٌ طبيعي لحياةٍ الذاتُ مركزها ومدارها. أمَّا المشكلة الاجتماعية فقد نجوتُ بحياتي في مقابل موتها: فالمشكلة الحقَّة ليست كيف للمرء أن يتوافق مع جيرانه أو كيف له أن يسهم في تطوُّر بلده، لكن أن يكتشف مصيره الشخصي، أن يصنع حياة متناغمة مع الإيقاع العميق للكون. أن يكون قادرًا على أن يستعمل كلمة كَون في جراءة، وأن يستعمل كلمة روح، وأن يتعامل مع الأمور “الروحية” – وأن يُعرض عن التحديدات والذرائع والبراهين والواجبات. الفردوس موجودٌ في كل مكان، ويقود كلُّ طريقٍ إليه، فقط إذا واصل المرء سعيه عليه بما فيه الكفاية. لا يمكن للمرء أن يمضي إلى الأمام قُدمًا إلَّا بالسير للوراء قليلًا ثم بالسير جانبيًا ثم صعودًا ثم نزولًا. ما مِن تقدُّم: ثمة حركةٌ أزلية، تزيح وتبدّل، وهي حركة دائرية وحلزونية، ولا نهاية لها. لكل إنسانٍ مصيره الشخصي، وواجبه الأوحد هو أن يقبله، وأن يتبعه أينما يقوده.
ليس لديَّ أدنى فِكرة عمَّا ستكون عليه كتبي التالية، ولا حتَّى عن الكتاب القادم مُباشرةً. ولا أسترشدُ بمخططاتي الأولية إلَّا بقدرٍ زهيدٍ للغاية: وأمزّقها متخلصًا منها عندما أشاء، فأبتكر، أحرّف، أشوّه، أكذب، أضخّم، أبالغ، أحيّر وأُربك وفقًا للمزاج. أطيعُ فقط ما يمليه عليَّ غرائزي وحدسي. لا أعلمُ شيئًا مُسبقًا. وكثيرًا ما أكتب أشياء أنا نفسي لا أفهمها، مطمئنًا إلى معرفتي بأنها سوف تتضح مِن بعد وستكون ذات مغزى بالنسبة لي. لدي إيمان بالرجل الذي يكتب، والذي هو أنا، الكاتب. لا أؤمن بالكلمات، ولو أحسنَ تنضيدها معًا أبرع الأشخاص: بل أؤمن باللغة، وهي شيءٌ يتجاوز الكلمات، شيءٌ لا تنال منه الكلمات إلَّا وهمًا هزيلًا. لا تُوجدُ الكلمات منفردة ومنفصلة، إلَّا في عقول الباحثين وعلماء الاشتقاق وأصول الكلمات وفقة اللغة، إلى آخِره. الكلمات المنبتة عن اللغة هي كائنات ميتة، ولا تُسفرُ عن أي أسرار. والمرء يتكشَّف في أسلوبه، اللغة التي خلقها لنفسه. وفي اعتقادي أنه حينما يكون المرء نقي الفؤاد يصير كل شيءٍ صافيًا مثل ناقوس، حتَّى أشد الكتابات إلغازًا وغموضًا. وثمَّة لغزٌ على الدوام بالنسبة لهذا الشخص، غير أن اللغز ليس مُعمَّى ولا مستترًا، إنما هو منطقي، طبيعي، مُحتَّم، ومقبول ضمنًا. ليس الفهمُ اختراقًا للغز، بل قبول به، والعيش معه في حبور، معه وفيه، وعبره وبه. أودّ لكلماتي أن تتدفق كما يتدفق العالَمُ تمامًا، حركةٌ أفعوانيةٌ عبر ما لا يُحصى مِن أبعاد ومحاور ومجالات ومناخات وظروف. إنني أتقبَّل مُسبقًا عَجزي عن بلوغ ذلك المِثال. ولا يضايقني هذا ولو بأهون قدر. في المجمل النهائي، فالعالَم نفسه مُتخمٌ بالإخفاق، وهو التجلّي الأكمل للنَقص، والوعي بالإخفاق. وفي إدراك هذا، الإخفاق نفسه ينمحي ويتلاشى. مِثل الروح البدائية للعالَم، مِثل المُطلَق الراسخ، الواحِد، الكل، الخالِق، أي بتعبيرٍ آخَر؛ الفنَّان، يعبّر عن نفسه بالنَقص وعبره. هذا النقص هو مادة الحياة، والأمارة الدالّة على حياة كل كائن. يصير المرءُ أدنى إلى قلب الحقيقة، وهي الغاية القصوى للكاتب على ما أحسب، بمقدار ما يتوقَّف عن الصِراع، بمقدار ما يُسلم الإرادة. والكاتب العظيم رمزُ الحياة، رمزٌ للنقص وعَدم الكمال. يتحرَّك في يُسرٍ مِن غير أدنى جهد، نابذًا وهمَ الكمال، منطلقًا مِن مركزٍ مجهول وهو ليس مركز العقل قطعًا، غير أنه مركز بلا أي شك، مركز موصولٌ بإيقاع الكون كله، وعلى هذا فهو مِثل مِثل الكون نفسه سليمٌ، مكين، راسخ، ومِثل الكون باقٍ، جَسور، فوضوي، ومُنزَّه عن الأغراض والأهداف. لا يُعلمنا الفن شيئًا، عدا ما للحياة مِن أهمية وقيمة. ولا بدَّ للعمل العظيم مِن أن يكون غامضًا، إلّا على قلة قليلة، إلَّا على هؤلاء الذين فعلوا كما فعلَ الكاتب نفسه، خاضوا غمارَ الغوامض والألغاز. وعلى هذا يكون الوصول للجمهور مسألة ثانوية: المهم هو بقاءُ العمل نفسه، ومِن أجل هذا لا ضرورة إلَّا لقارئ جيد واحد فقط.
إن كنتُ ثوريًا، كَما يُقال عني، فعلى مستوى لاشعوري. أنا لستُ ثائرًا ضدّ نظام العالَم. “إنني أثوّر”، كما قال بلاز سندرار* ذات مرَّة عن نفسه، وثمَّة فرق بين مَن يَثور ومَن يُثوّر. كما أنني أستطيعُ العيش على الجانب الأقل حظًا مِن السياج بنفس سهولة العيش على الجانب الأوفر حظًا. والواقع أنني أعتبر نفسي فوق تينك العلامتين، موفرًا منطقة وَسط بينهما، وهو ما يعربُ عن نفسه بمنتهى المرونة في الكتابة وعلى نحوٍ غير أخلاقي. أعتقدُ بأنَّ على المرء أن يعبرَ لما وراء مضمار الفن وتأثيره، فما الفن إلَّا وسيلة لبلوغ الحياة، لحياةٍ أغزر وأوفر، وهو ليس تلك الحياة الثرية في حد ذاته، إنما فقط يشيرُ إلى الطريق، وهو الأمر الذي غفل عنه عامة الناس، ليس هُم فقط بل كثيرًا جدًا ما غفل عنه الفنان نفسه. حينَ يصير الفن هو الغاية القصوى فإنه يهزم نفسه بنفسه، وأغلب الفنانين يهزمون الحياة تحديدًا بمحاولتهم الإمساك بتلابيبها والتشاجر معها، فكأنهم أخفقوا في الأمرين. في اعتقادي الراسخ، الفن بكامله سوف يختفي يومًا ما، غير أن الفنان سوف يبقى، والحياة نفسها لن تصبح “فنًا مِن الفنون”، بل هي “الفن”، أي أنها بكل تأكيد وفي كل وقت سوف تستولي على المضمار نفسه. بأي معنى صحيح فإننا يقينًا لسنا أحياءً بَعد. لم نعد حيوانات، غير أننا يقينًا لسنا بشرًا بَعد. منذ بزوغ فَجر الفن ظلَّ كل فنانٍ عظيم يذكّرنا بذلك مرارًا، لكنّ قلة فقط استوعبته. ما أن يصيرُ الفن موضع قبولٍ حقًا سيتوقّف عن الوجود، فهو ليس إلَّا بديلًا، لغةً ترمز وتؤمي، لشيءٍ مِن الممكن الإمساك به مباشرةً. ولكن لكي يصيرُ هذا أمرًا ممكنًا على الإنسان أن يكون دينيًا بالتمام والكمال، دينيًا وليس متدينًا أو مؤمنًا، أي أن يصير هو العِلة الأولى ومُسبب الأسباب، إلهًا بالقول والفعل. وهكذا سيصير حتمًا. ومِن بين جميع المسارات على هذا السبيل، الفن أكثرها مجدًا وألقًا، أكثرها خصوبة وتنويرًا للبشر. وحين يبلغ الفنان درجة تامة من الإدراك فإنه بالتبعية يتوقف عن كونه فنانًا. والنزوع يتجّه صوب الإدراك، صوبَ ذلك الوعي الذي يبهر الأعين ويغشى الأبصار، ذلك الوعي الذي لا يمكن لأي شكلٍ راهن مِن أشكال الحي أن ينمو ويزدهر، ولا حتَّى الفن.
بالنسبة للبعض سيبدو كلامي هذا تَعميةً وإلغازًا، غير أنه تعبير صادق عن قناعاتي الراهنة. ولا بدَّ لنا مِن أن نتذكّر، بالتأكيد، أنَّ ثمة فارق حتمي بين حقيقة الأمر وبين ما يعتقده المرء؛ حتّى ما يعتقده بشأن نفسه، ولكن لا بدَّ أن نتذكَّر أيضًا أنَّ ثمة فارق مساوٍ بين حُكم شخصٍ آخَر وبين هذه الحقيقة ذاتها. ما مِن اختلافٍ جوهري بين الذاتي والموضوعي. كل شيءٍ مُراوغ وشفَّاف بدرجةٍ أو أخرى. وجميع الظواهر، بما في ذلك الإنسان وأفكاره حول نفسه، ليست أكثر مِن حروف أبجدية تتحرَّك وتتبدَّل. ما مِن حقائق صلبة يُمكن الإمساك بها. وبناءً على هذا، فحتّى إن كان ما أعمدُ إليه مِن تشويه وتحريف، في عملية الكتابة، قصديًا فلا يعني هذا بالضرورة أنه أشد نأيًا عن حقيقة الأمور. يستطيع المرء أن يكون كاملَ الصِدق والنزاهة حتَّى وإن كذب كذبًا فاضحًا لا سبيل لإنكاره. الخيال والاختلاق هما نسيج الحياة ذاته. أمَّا الحقيقة فمِن المستحيل أن تُعكّرها الارتباكاتُ الحادّة للروح.
بناءً على ذلك، فأيًا كانت التأثيرات التي أحققها عبرَ الأدوات التكنيكية فهي ليست محض نتائج للفنيات التقنية، بل هي تسجيلٌ بالِغ الدقة لحركة مؤشِر جهاز قياس شدة زلازلي، جهاز قياس شدة تجاربي الموَّارة المضطربة، المتشعبة، المُلغزة والعصية على الفَهم، تلك التجارب خضتُها، وعبرَ عملية الكتابة، أخوضها مرة أخرى، وإن على نحوٍ مختلفة، ربما على نحوٍ أشد اضطرابًا وإلغازًا وعصيانًا على الفَهم. ما يُسمَّى بجوهر الحقيقة الصلبة، والذي يشكّل نقطة الانطلاق ونقطة التجديد والإصلاح أيضًا، هو شيءٌ مغروز عميقًا في داخلي: ليس ممكنًا لي مهما حاولت أو اجهتدتُ أن أفقده، أو أن أبدّله، أو أن أخفيه بطرق التنكُّر. ومع ذلك فإنه بالفِعل يتبدَّل، تمامًا كَما يتبدَّل وجهُ العالَم، مع كل لحظةٍ نعيشها ونتنفّسها. وحتَّى يستطيع المرءُ أن يسجّل تلك الحقيقة الصلبة، ينبغي عليه أن يقدّم وهمًا مزدوجًا – وهمَ القبضِ على الحقيقة في ثبات ووهمَ التدفق معها باندفاع. هذا ما يصنعُ وهمَ الزيف المتقن، إنها هذه الخدعة ذات الوجهين، إن صحَّ التعبير: إنها هذه الكذبة، هذا التملُّص الخاطف، القِناع المجازي، كل ذلك مِن صميم وجوهر الفن. أن يكون المرء ثابتًا في التدفّق: أي أن يضعَ القناعَ الكاذب من أجل أن يكشف عن الحقيقة.
كثيرًا ما خطرَ لي أنني لا بدَّ ذات يوم سوف يروق لي أن أكتبَ كتابًا لأشرح فيه كيف كتبتُ قِطعًا محدَّدة في كتبي، أو ربما كيف كتبتُ قِطعة واحدة فقط. أعتقد أنَّ بوسعي إنجاز كتاب بحجمٍ معقول يدور حول فقرة صغيرة لا أكثر بعد أن أختارها عشوائيًا مِن عملي. كتابٌ عن نشوء تلك الفقرة، ومَرحلة تكوينها، ومراحل تحوّلاتها، ثم مخاضها وولادتها، عن الوقت المُنقضي بين مولِد الفكرة وتسجيلها، والوقت اللازم لكتابتها، وعن خواطري خلال أوقات التوقُّف في أثناء كتابتها، وعن أي يومٍ مِن أيام الأسبوع كان يوم كتابتها، وعن حالتي الصحية آنذاك، ووضعي العَصبي، وعن الأحداث المقاطعة مسارَ الكتابة، سواء تلك النابعة مِن إرادتي أو المفروضة عليَّ رغمًا عني، وعن التعبيرات العديدة شديدة التنوع التي خطرت لي في أثناء عملية الكتابة، التبديلات، النقطة التي توقَّفت عندها ولدى عودتي مرةً أخرى غيَّرتُ الاتجاه الأصلي تمامًا، أو النقطة التي توقَّفت عندها بِمهارة، مِثل جرَّاحٍ يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه مِن عمليةٍ سيئة، وفي نيته أن يعود ويستأنف العَمل في وقتٍ ما بعد ذلك، لكني لا أعود ولا أستأنف أبدًا، أو بخلاف بذلك أعود وأواصل المضي في الاتجاه المتروك نفسه، مِن غير وعيٍ من جانبي، في كتابٍ آخَر تمامًا بعد إنجاز بضعة كتب، حينما تكون ذكرى ذلك الاتجاه المتروك قد تبددت كأن لم تكن. أو لَعلَّني أتناول فقرتين لأضاهي إحداهما في مقابل الأخرى، فقرتين ربما تكون الأعين الباردة للنقَّاد قد رأت فيهما نموذجًا على كذا وكذا، فأعمد إلى إرباكهم كليةً، أولئك النقّاد ذوي العقول التحليلية، بأن أُظهرَ كيف أنَّ قطعة من الكتابة تبدو في الظاهر مكتوبة بسلاسة ودونما أدنى جهد قد كُتبت تحت قدرٍ هائل مِن الضغط والإرغام، في حين أنَّ قطعة أخرى تبدو مثل متاهةٍ مُعقّدة قد كُتبت مثل نسمة عليلة، مثل نبعٍ متدفّق للماء الحار. أو يمكنني أن أظهرَ لهم كيفَ أنَّ قطعةً تشكَّلت ابتداءً وأنا راقدٌ في الفراش، كيف تحوَّلت إلى شيءٍ آخَر مع نهوضي مِن الفراش، ثم مِن جديد تحوَّلت إلى شيءٍ آخَر عند جلوسي لتدوينها. وربما يمكنني أن أستدعي دفترَ ملاحظاتي السريعة لكي أظهرَ كيف يمكن لأبعد المحفزات الأولية وأشدها افتعالًا واصطناعًا أن تُسفرَ في نهاية الأمر عن زهرةٍ إنسانية دافئة لها شكل الحياة الحقَّة. كما يمكنني أن أستدعي كلماتٍ محددة اكتشفتُها بمحض المصادفة بينما أتصفح كتابًا ما، وكيف حفزتني تلك الكلمات ودفعتني للانطلاق – لكن مَن ذا الذي مخلوقٍ يمكن له أن يخمّن حتَّى كيف جرى هذا، وبأي طريقة تحديدًا؟ كل ما يكتبه النقَّاد عن عملٍ فني ما، حتّى في أفضل المقاربات وأشدها سَدادًا وإقناعًا ووجاهة، وحتَّى عندما يكتبون من منطلق الحب وما أندرَ هذا، لا يُعدّ شيئًا إذا ما قورنَ بآليات العَمل الفِعلية، تلك الجينات الوراثية الحقيقية لأي عمل فني. إنني أتذكَّر عَملي، ليس كلمةً كلمة بكل تأكيد، ولكن على نحوٍ أدق وأجدر بالثقة؛ فقد أضحى عملي بكامله أقرب إلى أرضٍ مطروقة، إقليم جغرافي أعددتُ له تخطيطًا ومسحًا جيوديسيًا شاملًا، ولم أفعل هذا مِن مجلسي إلى المكتب، بالقَلم والمَسطرة، لكني فعلتُه باللمس، بالنزول على أطرافي الأربعة، والانبطاح على بطني، وبالزحف فوق سطح تلك الأرضًا شِبرًا شبرًا ومترًا مترًا، وهذا على مدى زمنٍ غير محدود وفي جميع الأحوال الجوية. وإجمالًا، فإنني الآن قريبٌ إلى العَمل كما كنتُ تمامًا في أثناء تنفيذه – بل ربما أقرب. ولم أعتبرُ خاتمة كتابٍ لي أكثر مِن بدنٍ يتقلّب فيتخذُ وضعًا مختلفًا، إذ كان مِن الممكن له أن ينتهي بألف طريقة مختلفة. كما أنه لا يُوجد جزء واحد فيه منتهٍ وموصَد تمامًا: بوسعي أن ألتقط خيطَ السرد مِن أي نقطة، وأبدأ مِن هناك، وأشق القنوات، وأحفر الأنفاق، وأمد الجسور، وأشيد المنازل والمصانع، مرصعًا هذا كله بسكّانٍ آخرين مِن البشر، وسكّانٍ آخرين مِن النبات والحيوان، وكله ذلك صحيح ومطابق للواقع بنفس القَدر. وحقيقة الأمر أنني ليس لديَّ نقطة بداية ولا نقطة نهاية. بالضبط كما تبدأ الحياة عند أي لحظة، عبر فِعل التحقق والإدراك، هكذا يكون العمل الفني. غيرَ أنَّ كل بداية، سواء صفحة من كتاب، أو فقرة، أو جملة أو عبارة، تشيرُ لوشيجةٍ حيوية، وهي لكذلك بقدر حيوية الأفكار والأحداث التي أغطس فيها مجددًا كل مرة، حيويتها وأيضًا دوامها وقدرتها على الصمود أمامَ الزمن والتبدُّل. كل سطر وكلمة تربطه بحياتي وشائجٌ حيوية، حياتي فقط لا غير، سواء أكانت في صيغة فِعلٍ أو حدثٍ أو حقيقة أو فكرة أو عاطفة أو رغبة أو تَملُّص أو إحباط أو حُلم أو تخيّل أو نزوة، بل حتَّى تلك التوافه والسفاسف المبتسرة التي تطفو على سطح العقل بفتور وبلادة مثل خيوط شبكة عنكبوت متآكلة. فَلا شيء مِن هذا قد يوصف حقًا بالغموض والهشاشة – حتَّى التوافه حادة خشنة وراسخة مستقرة. ومَثلي مَثل العنكبوت، أعود مرارًا وتكرارًا لإنجاز المَهمة، واعيًا بأنَّ الشبكة التي أغزلها مصنوعة من مادة نفسي، تلك المادة التي لن تخذلني أبدًا، ولن ينضب معينها أبدًا.
راودتني أحلامٌ في البدايات أن أطاولَ قامة دوستويفسكي، وتمنيتُ أن أقدّم للعالَم صراعات روحية ضخمة، يضيعُ فيها المرء كالمَتاهة، صراعاتٍ مِن شأنها أن تُقوض بُنيان العالَم. لكني سرعان ما أدركت، وقبل أن أمضي بعيدًا في هذا الصوب، أننا قد تطوَّرنا فوصلنا إلى نقطةٍ بعيدةٍ في ما وراء دوستويفسكي، بمعنى التراجع والانحطاط. فقد اختفت مُعضلة الروح في زماننا، أو بالأحرى تكشف عن نفسها في هيئة كيماوية ما، هيئة مشوّهة حدّ الغَرابة. إننا نتعامل مع عناصر بلورية للروح، تلك العناصر المتباينة والمبعثرة هنا وهناك. ولعلّ الرسامين المعاصرين قد عبّروا عن هذه الحالة أو الوَضع بقوةٍ وعنفوان أشد ممَّا لدى الكتَّاب: وبكاسو مثالٌ ممتاز على مقصدي. وكان من المستحيل بالنسبة لي، بناءً على هذا، أن أفكر في كتابة الروايات، كما كان مُستَبعدًا بالقدر نفسه أن أتبع تلك الدورب العقيمة والتي كانت تُمثلها الحركات الأدبية المتنوعة في إنجلترا وفرنسا وأمريكا. بمنتهى الصدق، شعرتُ بأنني مساقٌ رغمًا عني إلى أن ألتقطَ تلك العناصر المتباينة والمبعثرة لحياتنا – لحياتنا الروحية، وليس لحياتنا الثقافية – ثم أتلاعب بها عبرَ مزاجي الشخصي، مُستخدمًا ذاتي المحطّمة المبعثرة، كما أستخدمُ بنفس القدر مِن القسوة والطيش كلَّ ما يطرحه أمامي عالَم الظواهر المحيط بي مِن حطامٍ وسقط متاع الدنيا. لم تروادني قبل ذلك قَط مشاعرُ البُغض والعدواة والقلق تجاه الفوضوية التي تعبّر عنها الأشكال الفنية السائدة؛ بل على النقيض مِن ذلك، لَطالما رحبتُ بتأثيرات التذويب. في عصرٍ سِمته التحلُّل والتَفكك، أرى إذابة الجوامِد من بين الفضائل، بل هي واجب أخلاقي. ليس الأمر فقط أنني لم أشعر قَط بأدنى رغبة في استبقاء أي شيءٍ وحِفظه من الزوال والتفسُّخ، ولا بأدنى رغبة في تعزيز وتمتين أي شيء، بل قد أقول إنني طالما نظرتُ إلى التَحلُّل بوصفه تعبيرًا عن الحياة؛ تعبيرًا بنفس رَوعة وثراء النمو.
أعتقدُ أنَّ عليَّ أن أعترف أيضًا بأني كنتُ مدفوعًا إلى الكتابة لأنها كانت المُتنَفس الوحيد الذي وجدتُه مفتوحًا أمامي، والمَهمة الوحيدة التي وجدتُها جديرة بقدراتي. فقد جرَّبت بإخلاص جميعَ الطرق الأخرى نحو الحرية. وقد فشلتُ باستماتة وعناد في ما يسمَّى عالَم الواقع، ولم أفشل بسبب افتقاري للقدرة. لم تكن الكتابة “مَهربًا”، أو وسيلة للتملّص مِن الواقع اليومي: بل على النقيض، كانت تعني القفز وإلى تلك البركة الآسنة والغطس تحت سطحها، غطسًا هادئًا نحو العُمق، نحو المنبع حيث كانت المياه تتجدد باستمرار، وحيث حركة موَّارة لا تنقطع. حين أنظر للوراء نحو مسيرتي المهنية، أرى نفسي شخصًا قادرًا على الاضطلاع بأي مهمة تقريبًا، وبأي عمل تقريبًا. لكنَّ المُتنفسات الأخرى كانت كلها رتيبة وعقيمة وجرتني إلى حالة من القنوط. كنتُ راغبًا في مجالٍ يفرضُ عليَّ أن أكون سيّدًا وعبدًا معًا في الوقت ذاته: ولم أجد مِثل ذلك المجال إلَّا في عالَم الفن. دَخلتُ إليه بلا أي موهبة ظاهرة، مُبتدئ حتَّى النُخاع، عديم القُدرة، مُفتقر للبراعة والمرونة، معقود اللسان، مقيدُ الحركة بأغلال الخوف والوَجل. وكان عليَّ أن أضعَ طوبةً على أخرى، وأن أدفعَ ملايين الكلمات للظهور قبل أن أكتب كلمة واحدةً حقيقية أصيلة مُنتزعة مِن داخل أحشائي. زلاقة حديثي وبراعتي فيه كانت هي إعاقتي؛ اجتمعت فيَّ جميع شرور الشخص المتعلّم المثقف. كان عليَّ أتعلَّم كيف أفكر، وأشعر، وأرى، على نحوٍ جديد تمامًا، بطريقة غير مثقفة، بطريقتي الخاصة، وهو أصعب شيء في العالَم. كان عليَّ أن ألقي نفسي في التيَّار، مع معرفتي بأنني على الأرجح سوف أغرق. النسبة الأكبر من الفنانين يقفزون وحول أعناقهم أطواق النجاة، وفي أغلب المرات يكون طوق النجاة هو نفسه سبب غرقهم. إذا ما أسلمَ المرءُ نفسَه طوعًا للتجربة دون مقاومة فلا يُمكن أن يغرق ويبتلعه محيطُ الواقِع. إن كان هناك أي تقدم في الحياة فهو لا يتأتَّى عبر التأقلم والمسايرة بل عبر الإقدام والمجازفة، عبر إطاعة الحافز الأعمى. قالَ رينيه كريفيل* عبارة لن أنساها ما حييت: “لا مجازفة هلاك، الهلاك ألَّا نجازف”. المنطق الكُلي للكون مشتَملٌ في المجازفة، أي في الخلق استنادًا على أضعف الركائز وأضألها. في البداية قد نظن أنَّ هذه المجازفة إرادة، لكن مع الوقت نُسقط الإرادة وتحل محلها عملية عفوية تلقائية، ومن جديد ينبغي هي أيضًا أن تكسَر أو تُسقَط ويتأسس راسخًا يقينٌ جديد لا شيء يربطه بالمعرفة أو المهارة أو التقنية أو الإيمان. بالإقدام يصل المرء إلى هذا المقام الغامض للفنان، وإنَّ هذا المرفأ لا يمكن لأحد أن يصفه بالكلمات، ومع ذلك فإنه يغذي كل سطرٍ يُكتَب، وينضح مِن كل سطرٍ يُكتَب.
……………………
*نشر هذا المقال ضمن كتاب (حكمة القلب) وهو مختارات قصص ومقالات أدبية للكاتب الأمريكي هنري ميلر (1891-1980)، وسبق أن نشرت ترجمته العربية في مجلة عالَم الكتاب المصرية خلال سنة 2020.