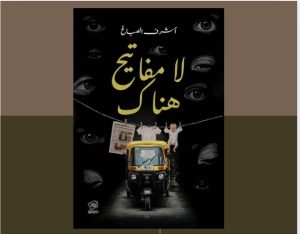البهاء حسين
يلتقط محمود خيرالله، أولاً بأول، ما يُخلّفه اليوم على روحه، ثم يخزّنه فى سرداب، كأنه يعتق تجاربه، كأنه ينقيها من شوائب العابر، لتصبح قرينة الأبد، هكذا يجعل من اليوم نفسه قصيدة ومن الأيام ديواناً. إنه يتلمظ فى انتظار اليوم، ويتأهَّب له باعتباره قصيدة محتملة. كأن له، هو وأيامه، هدفاً واحداً ..أن يعبروا مكتوبين لا خائفين.
إذن يحاول خيرالله، فى ديوانه الجديد “الأيام حين تعبر خائفة”، الصادر عن سلسلة ” الإبداع الشعرى”..هيئة الكتاب، أن يجعل الأيام حين تمر تمر بثمن هو القصيدة فهى حيلتنا فى توثيق مواجعنا إزاء التلاشى .
يوم خيرالله أشبه، كما يقول فى الديوان، بـ” طلقة، مصوبة منذ أعوام ، لكنها لم تصل بعد” والقصيدة هى إعلان وصول الطلقة إلى هدفها.. ” سويداء القلب”، لأن الشعر عنده طريقة للعيش ..به يحيا ويحب ويكره ويقف، هو والشعر، كذاكرة واحدة فى مواجهة الماضي.
والبرج الذى يراقب منه الأيام، وهى تمر مرّ السحاب، هو النافذة. يقول : ” أنا لا أملك من حطام الدنيا سوى عينين ونافذة “. إن النافذة ، بالنسبة له، ليست أداة ، بل آلة يرى بها الأيام وهى تجرى ويرى نفسه وهو واقف يتفرج على جريانها المحموم الذى لا يوقفه شىء ولا يبقى منه سوى دخان توثقه مخيلة خيرالله لا على سبيل المحاكاة ولا الـتأريخ، بل بتأكيد ما كان قبل أن يتسرب تمامًا من الذاكرة . إنه يخلق حياة موازية تتفوق على الواقع وتسبقه بخطوات فى المستقبل قبل أن يأتى. مستقبل خيرالله، كأنه يرثى نفسه مسبقاً على فوات كل شىء، ولا سبيل أمام فجيعته فى التفلت، حاضرًا ومستقبلاً، سوى بإقامة بيت من كلمات.. قصيدة نعيش معها حياة أخرى بدلاً من التى كانت تهمهم للتو تحت نافذته . إنه ذلك الرجل الذى “يخوض فى الخمسين” ويقف كل يوم “أمام نفسه، عاريا، لا يتغطى سوى بنافذة “.
لكن آية أشياء أو لحظات يريد خيرالله أن يستنقذها. هو يريد، مستقبلاً بعد أن يموت “وتصير العظام ترابًا”، أن يتحول “إلى شجرة، ينام الناس تحتها، يبتسمون ويأكلون كلما شاءوا، وحين تجف الحياة فى بدني، وتصير القامة يابسة، تمامًا، من كثرة الحنين إلى الثمار، أصير جسرًا ميتًا بين ضفتين، لا يمكننى أن أصحو، إلا كلما مرت أحذية الفقراء على رأسي”.
وماضيه، بدوره، مسكون بالفقراء أيضًا، هو “آخر ما تبقى من دموع أجدادنا، الذين ماتوا فى سالف الأزمان ببطون خاوية”. بقى أن يعامل الحاضر على أنه شرفة يتلفت منها خيرالله، مرة على الماضي، ليحصي الأيام التى أصبحت وراء ظهره، ومرة على الغد، ليخمن ما قد يجيىء به من أيام أخر. اتسعت النافذة، بتقدم العمر، وأصبحت شرفة تتوسط زمنين، أصبحت بالأحرى قصيدة تمد قدماً فى الحنين وأخرى فى المستقبل الذى سيصبح، عما قريب، تحت الكتابة أو موضع تذكر. كأن الشاعر قد عوّد ذاكرته أو لقنها أن كل شىء حدث أو سيحدث هو شىء ينتمي بالضرورة للماضي، ليكون هناك مبرر ناضج لكتابته. هكذا يصنع خميرة القصيدة. إن عواطفه وحواسه وذاكرته فى حالة تلمظ دائم كأنها مساحات مفروشة يؤجرها للشعر ولا شىء غير الشعر .
سأذكر لك شاهدًا يضع يدك على الآلية التى ينتشل بها خيرالله القصيدة من سلة الماضي. كانت لى خطيبة جميلة فى مرسى مطروح والدها حالة وحده بين الناس، إذا لا حد لغرابة أطواره . نمط بسيط ، مفرط فى بساطته وطيّب، لكنه يضع نفسه ومن حوله دائماً فى الدرجات الخطرة من الإحراج. وقد حكيت لصديقى خيرالله كثيرًا عن والد خطيبتى هذا، حكيت له اللقطة الفريدة التى مات بها واختصرت شخصيته الكاريكاتورية..إذ وقف فى الشرفة وراح ينحنى، ليجمع الغسيل، لكن ذراعه لم ترتد إليه ومات بينما أصابعه عالقة بالمشابك. علقت هذه اللقطة بذاكرة محمود مدة 15 عاماً وإذا بالرجل وميتته المدهشة مكتوبان تحت عنوان هو الأنسب إذا أردنا أن نعرّض بالموت حين يقابل الأرواح المرتجلة بطريقة كهذه. يقول خيرالله فى قصيدة ” علق ابتسامته فى الشرفة ومات ” :
لم يمت “مفتش الآثار ” التعيس ،
أبدًا،
بهذه الطريقة العجيبة ،
لأن روحه المرحة ،
لا تزال تلوّح لليمام فى السماء،
رغم أنهم كفنوه
قبل خمسة عشر عامًا
فى تلك المدينة القديمة ،
التى تدفن رأسها فى البحر،
بينما كان وجهه يبتسم
تحت “فيونكة” الكفن ،
كما لو كان
وجه رجل سعيد،
يبتسم بخبث للدود
الذى يأكل ابتسامته،
كرجل يناكف خطاياه
إلى الأبد .
يبتسم ” المفتش ” مضطرًا،
لأن الموت يأتي
حين لا يكون المرء جاهزًا،
لقد خرج السر الإلهي،
بينما كان العجوز يجمع الغسيل ،
ساعة العصارى
فى ” بالكونة ” عرجاء،
مرتديًا ملابسه الداخلية
مادًا يديه الطويلتين
فوق الحبل
ضاحكا من كل قلبه
على هذا العالم
الذى جففته الأيام بين يديه !
خيرالله، فى مطاردته للقصيدة، يعنيه الجمال أولاً، لأن الجمال بالنسبة له هو الحقيقة التى نقرؤها على الورق فنتبناها باعتبارها شيئاً قد حصل بالفعل. لقد شعرت وأنا أقرأ هذه القصيدة أننى بإزاء رجل آخر غير الذى عرفته وخبرته عن قرب.. رجل لا يمكن لابنته أن تخجل منه وهو يواصل الضراط فى حضور خطيبها، ولا يمكنك إلا أن تنصفه من نفسك وتتساهل مع حماقاته التى سردتها على خيرالله وخزنها هو حتى جاء وقت كتابتها فجعل من ابتسامة الرجل لافتة نسخر بها من الموت.
الجميل أن ما يصيده من تجاربك ومن تجارب غيرك يخرج بصوته، بحيث لا تملك إلا أن تحب صيده وتحمد له أن مد يديه على سلتك وأنقذ حواديتك من الكسل. عن نفسي لم أفكر فى كتابة الرجل، لا أدري لماذا، لكن اعتبرت، حين قرأته، أن خيرالله كفانى مؤونة إخراجه حيًا من ذاكرتى .
إن خيرالله ” ذاكرة أيامه”، بمعنى أنه قايض الأيام على أن يمنحها ذاكرته وتمنحه هى القصيدة. وفى هذا الديوان أفلح أن يجعل من أيامه التى تعبر خائفة أيامنا جميعاً..فنحن نقاسمه، بحبور، لحظاته كلها من أول الشهد الذى تمنحه له شجرة التوت إلى الأبواب التى نغلقها معه بهدوء كأننا نودعها، ذلك لأن محمود خيرالله حين يكتب يتوسل بكل شىء يمكنه أن يورطك معه ويجعلك شريكه فى النص، بداية من شعورك أنك مررت بهذه التجربة من قبل، مروراً بالبساطة الآسرة التى يكتب بها هذه العوالم، البساطة التى تمكّن، مع ابن المقفع، لمفهوم عن الأدب العظيم ..أنه ذلك “الأدب الذى إذا قرأه الجاهل ظن أنه يحسن مثله”. تلك هى الطريقة التى تجعلك تتمزز الشعر.. ” الماضى الذى يندلع فجأة فى قلوبنا “.