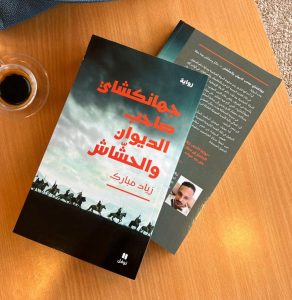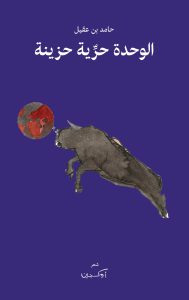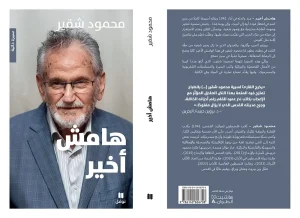عبد الرحمن أقريش
زاكورة، 1989.
الأصيل، تميل الشمس نحو المغيب، تفقد حرارتها، تتوارى، ومن خلف غابة النخيل الممتدة، تتسلل خيوطها الذهبية وترسم أفقا لغسق جميل وهادئ.
هناك في قلب واحات (وادي درعة) ينتصب قصر (الحاج اليعلاوي)، يختفي، يغرق وسط جنان من النخيل فلا تظهر منه إلا مناراته المتوجة بالبياض، يبدو المكان باذخا ومريحا، صالة فسيحة بسقف خشبي منقوش وعال، ستائر حريرية ونوافذ كبيرة مشرعة بسخاء، أواني فضية ونحاسية، زرابي مبثوثة، تحف، لوحات وقطع فنية نفيسة، سيوف وبنادق قديمة ونادرة، في الخارج تهب بين الحين والآخر نسمات خفيفة وباردة، تتسرب إلى الداخل، تحمل معها عبقا لروائح قوية ومتنافرة، رائحة الشاي، نعناع، ورود وياسمين، رائحة القطران، ودخان بخور يضفي على المكان هالة تكاد تكون سحرية.
امتد الأمر لسنوات طويلة، طويلة جدا.
مساء كل خميس، ينظم (الحاج اليعلاوي) طقوس حفلات خرافية على شرف ضيوفه وأصدقاءه، حفلات مخزنية غارقة في البذخ والبهرجة والاستعراض، يجلس هو في قلب الصالة، ويجلس ضيوفه على شكل جماعات صغيرة، ينظر إليهم بفرح، يأكلون، يشربون، يحتسون الشاي، يدخنون، يثرثرون، ويستمتعون بقطع الحلوى وأصناف التمور والفواكه الجافة، أما هو فيكتفي عادة بسيجارة وكأس شاي مسوس.
ينزع (الحاج اليعلاوي) نظارته الطبية، ينفخ عليها، ويمسحها بمنديل قطني في حركة رفيقة وهادئة، فتكف الجماعة عن الثرثرة ويسود الصمت، فقد كانت تلك الحركة إشارة إلى أنه يود الكلام وينتظر السكوت، يجيب عن سؤال، يسمع مديحا، أو يرد على مجاملة…
ثم في نقطة ما، في لحظة ما، يبدأ الهاتف بالرنين، رنين ملح، متردد ومنتظم، يعود الصمت ثانية، يرفع السماعة ويرد.
– أهلا سيدي العامل…كنا نود لو كنت معنا، ولكننا نعرف أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقك لا يسمح، ونحن نقدر ذلك…إنهم هنا، الجميع هنا، الحاج، الحاج الآخر، القاضي ديالنا، وسعادة القايد والسيد الرئيس، صاحبنا…أنت تعرفه، آه نعم، هو، إنه غني عن التعريف…
يرن الهاتف مرة ثانية، وثالثة…
وفي كل مرة يجيب على مكالمات لا تنتهي، مكالمات يصفها بأنها مهمة، ويصر دوما على التأكيد بأنها (من لهيه)، من هناك، يقصد (الرباط) العاصمة، لا يتعلق الأمر بالادعاء أو البهرجة الفارغة، أبدا، فهاتف الرجل كان دوما مهما وخطيرا بالفعل، إنه أحد الحبال التي يستعصم بها الوصوليون والطماعون الباحثون عن الجاه والسلطة والمال السهل.
…
(الحاج اليعلاوي) هو أحد أعيان القبيلة، رجل ميسور الحال ينحدر من عائلة توارثت الثروة والجاه والسلطة، عائلة ساهمت في دعم سلطة دولة المخزن وبسط نفوذها بين قبائل الجنوب ما قبل وما بعد الاستقلال، جاه وسلطة لم يبق منهما إلا القليل، فالزمن غير الزمن، ودوام الحال من المحال، فمنذ سنوات لم يتقدم (الحاج اليعلاوي) للانتخابات بعدما تخلى عنه المخزن، واختار حزب الأعيان مرشحا آخر، شخص من نفس العجينة ولكنه متعلم، متخرج من الجامعة وأكثر ثراء…
يعرف (الحاج اليعلاوي) أن الحياة تتغير، وأن الزمن يدور ولا يدوم على حال، ولكل زمن رجاله، يعرف ذلك في قرارة نفسه، يقبله، يتقبله على مضض، ولكنه في النهاية يقبله، ومع ذلك يحرص بقوة على المظاهر والشكليات وجلسات الضيافة المنتظمة، خدم وحشم، أتباع، متزلفون، أصحاب الحاجات، خماسون وعبيد…أشياء كانت في الماضي عنوانا لقوة المال والجاه والسلطة، ولكنها اليوم مجرد بقايا، أشياء تصلح للذكرى، للعزاء، لترميم الكبرياء، للتعويض النفسي ربما، ولكنها لم تعد تعني شيئا كثيرا.
منذ مدة، ما عاد هناك ضيوف ولا أصدقاء ولا حفلات، فقد انفض من حوله الجميع، أما هو فلم يتغير، بقي عنيدا ومكابرا رغم الهزائم والانكسارات، بقي وفيا لنفسه، لتاريخه، لأمجاده، لذكرياته، لكل الأشياء التي كانت غالية وعزيزة على قلبه، يجلس هناك كل مساء في قلب الغرفة الفسيحة وحيدا، ينظر، يجول ببصره، يتأمل التفاصيل التي تؤثث المكان، لوحات فنية بإطارات منقوشة ومذهبة، صور عائلية من زمن الأبيض والأسود، خزانة الكتب، وثائق، مراسلات، ظهائر مخزنية، أوسمة، سروج فخمة، أسلحة، سيوف، بنادق ومسدسات من زمن مضى…
أشياء كثيرة وضعت هناك لمتعة العين، للذكرى، لتحنيط الزمن، وأشياء أخرى خفية ومحفوظة بعناية.
يتوقف (الحاج اليعلاوي) ببصره عند الهاتف، الهاتف الذي لم يتغير، ولم يغير مكانه أبدا، ينظر إلى السماعة السوداء اللامعة بتصميمها الكلاسيكي الأنيق، يبتسم، يقدر أنها تحفة غالية، وأن هذا النوع من التصاميم لم يعد موجودا إلا في المتاحف، تتسع ابتسامته، يتذكر أنه أول من أدخل خط الهاتف إلى بيته في المنطقة كلها، هاتف يختزل تاريخا يعج بالأحداث الخطيرة والحاسمة، انتفاضات، عصيان، سيبة، صراعات قبلية، حروب طاحنة على الأرض والماء والكلأ، وحركات مخزنية لتأديب القبائل المتمردة والمارقة، نزاهات، مواسم، واحتفالات لتنصيب رجال المخزن والتخلي عن آخرين، إمغارن، قواد وباشوات…
في تلك اللحظة، يشعر (الحاج اليعلاوي) بالألم، مغص مؤلم ورهيب يعود ويزوره بشكل منتظم منذ مدة، يخترقه، يعتصره، يمزقه من الداخل، ترتسم على وجهه الخطوط الأولى لتعبير غريب وغامض، تعبير يمتزج فيه الألم بالحزن والأسف، يتذكر كيف كان طرفا في فظاعات حركتها نوازع النفس الشريرة الأمارة بالسوء، أنانية، طمع، جشع، حسد، ورغبة عنيفة في القوة والتملك، رغبة مدمرة تلامس حدود الجنون والهذيان…
يتذكر كيف كان ذلك الهاتف شاهدا على شرور وفظاعات الماضي، مؤامرات، خيانات، مظالم واغتيالات، ذلك الهاتف لم يكن شاهدا فقط، كان أيضا أداة، كان كأسا مترعة بالسموم والوضاعة والحقد الأعمى.
ثم في نوع العزاء، يخاطب نفسه بصوت مسموع وكأنه يكلم شخصا آخر.
– لا باس، ينبغي ألا تشعر بالانزعاج إزاء الأشياء التي لا تستطيع تغييرها…إنها أحابيل السياسة والسلطة ولا شيء بدون ثمن، لست وحدك، الكثيرون شربوا من نفس الكأس، شربوا أنخاب الانتصار، وتجرعوا أنخاب الهزيمة…
…
في الطابق العلوي للقصر، دخل (الحاج اليعلاوي) غرفته الخاصة، تمدد على الفراش الوثير، يقاوم أرقه ويستعد للنوم، أشعل سيجارته، أطلق العنان لهواجسه وراح يدخن، ثم في حركة لا شعورية، امتدت يده إلى سماعة الهاتف الموضوعة بجانب السرير الفخم وراح يدير أرقاما يحفظها عن ظهر قلب، فهي أرقام هاتفه المنزلي.
ينتظر، تمر لحظات، يصيخ السمع، ينتبه، ثم يسمع صوت الهاتف يرن في قاعة الضيوف في الأسفل.
يضع السماعة جانبا دون أن يغلق الخط، يغادر الفراش، ينتصب، يلبس رداء قطنيا دافئا، وينزل الدرج في حركات هادئة ومحسوبة، يسمع وقع خطواته ووقع عكازته على الدرجات الرخامية، يعود لقاعة الضيوف، يتوقف امام الهاتف، ينظر إليه، يبتسم، يتركه يرن للحظات، ثم يلتقط السماعة، يستلقي على أريكة هناك، ثم تدريجيا تنمحي ابتسامته ويحل محلها تعبير قاس وجامد.
– ألو، نعم سيدي العامل…أنا والقبيلة كلها في الخدمة نعم أس…حنا خدام المخزن نعم أس…إن شاء الله، موعدنا في مكتبك غدا فالصباح نعم أس…
ينتظر قليلا، ثم يغلق الخط.
…
يعود إلى غرفته، ينظر إلى الفراش، ثم ينظر إلى السماعة، يعيدها إلى مكانها ويتجه صوب النافذة، يفتحها، يقف هناك متكئا على دعامة البالكون، يحب هذه الشرفة، أحبها دوما، فهي في نظره أجمل مكان في القصر، مكان مريح، مفتوح، عال ويهيمن على الأفق، يشعل سيجارة أخرى، يمتص منها نفسا عميقا، يمسك الدخان للحظات، ثم يحرره، يطرده، يرسله على شكل أعمدة منتظمة، قوية ومستقيمة، ينظر جهة جناح الحريم، يقدر أن النساء والجواري قد آوين إلى مخادعهن، فلا أثر للضوء والجناح يغرق في صمت رهيب.
في الأفق تتردد أصوات بعيدة، تمزق سكون الليل، كلاب تنبح، ذئاب تعوي، وأصوات أخرى لطيور غريبة تغدو وتروح على ضفتي (وادي درعة)، تبحث عن مكان تبيت فيه، أصوات رهيبة، تتعالى، تسافر، تتلاشى، ثم تعود رجعا بعيدا، تستيقظ هواجسه، تنتصب الأسئلة بداخله، أسئلة الموت والحياة، والخير والشر، والعدالة هنا وهناك…تلك الأسئلة التي يبدو أنه أجلها لسنوات، ولكنها تعود كل مرة في لحظات الضعف والمرض والانكسار، فهو في النهاية رجل مؤمن، وتلك الأسئلة لا معنى لها إلا بالنسبة لرجل مؤمن، وهو رجل مؤمن وشجاع لا يزعجه كثيرا الاعتراف بضعفه وذنوبه، الاعتراف لنفسه أمام نفسه بكل الشرور التي اقترفت يداه.
في كل مرة يقف (الحاج اليعلاوي) في تلك الشرفة، ينصت لصمت الليل، يقف أمام ذاته، يتعالى بداخله ضجيج هواجسه، في كل مرة يقف هناك يستحضر موت والده فتجتاحه كآبة قاسية، يفكر في موته هو، يفكر في ثروته، يحز في نفسه أنه سيتركها وراءه، وأنها لن تغني عنه شيئا عندما يحين أجله، أحيانا كثيرة يتساءل إن كان سيمتد به العمر ليقف هنا ثانية وثالثة؟ ويعترف في قرارة نفسه أنه لم ينجح في أن يكون سعيدا، يعترف أمام نفسه أن الأيام غيرته نحو الأسوأ، تملكته جرثومة الجشع ونخرت روحه من الداخل فبنى ثروته بعيدا عن الله، يشعر بالحزن، ويتألم أكثر عندما يستحضر كيف انتقلت تلك الجرثومة في غفلة منه إلى أبناءه فلوثت أرواحهم، وحولتهم إلى ذئاب في ثياب بشر بسبب الصراع على الأرض والمال، وطبعا يتألم أكثر ويشعر بالمرارة، عندما يتخيل أنهم يستعجلون موته طمعا في الميراث.
يفكر (الحاج اليعلاوي)، يستعيد صورة والده، ما تبقى منها بفعل المسافة والزمن، يستحضره، يراه، يتخيل أنه يخاطبه، يسمعه، ويستعيد بقوة نبرة العتاب والتحذير في صوته.
– احترس يا بني، فبذور الخير عادة عصية، صعبة المراس، ولا تنبت إلا بصعوبة، ولكن بذور الشر ملعونة، خصبة، وتزهر بسهولة!
ولكن (الحاج اليعلاوي) ينجح دوما في التغلب على هواجسه، ينتصر عليها فيستعيد هدوءه تدريجيا، يغمره إحساس مريح، ويشعر ببعض العزاء عندما يستحضر أفضاله على القبيلة وأبناءها، فإليه يعود الفضل في افتتاح أول مدرسة ابتدائية، إليه يعود الفضل في بناء الكثير من القناطر والمعابر على (وادي درعة)، هو من شق الطرق والمسالك في الجبال…
ثم يفكر في زوجته، الممرضة الفرنسية التي تعرف عليها ذات حملة طبية، يبتسم، يفكر أنها إحدى الأشياء الجميلة التي حدثت في حياته، يستحضرها بكثير من الامتنان، يشعر أنه مدين لها، ثم يفكر بصوت مرتفع.
– لست وحدي، الجميع هنا مدين لها، لولاها ما وصلت الحملات الطبية إلى أقاصي الجبال، لولاها ما لقح الأطفال والمواليد الجدد، لولاها ما تمدرست الفتيات، أفضالها على نساء القبيلة لا تعد ولا تحصى، فهي من علمهن مبادئ النظافة والوقاية والعناية بالأطفال وتدبير المنازل…
…
يترك الشرفة مفتوحة، يعود إلى فراشه، ينظر إلى الأشياء التي تؤثث المنضدة أمامه، يتأملها، الكتب، السبحة الفيروزية التي تنام بشكل أنيق على صفحات المصحف المفتوح، يطفئ سيجارته، يسحقها في حركات بطيئة في المنفضة، يلتقط السبحة، يحركها، تنزلق حباتها بشكل آلي، ترتعش شفتاه في تناغم مع حركة أنامله الطرية، ينظر جهة النافذة وفي عينيه هدوء غامض.
لسنوات كان (الحاج اليعلاوي) ضحية لفصام واغتراب حاد، تركيبة نفسية غريبة تجمع بين ورع عابر، تدين شكلي، ونزعة دنيوية لا تقيم وزنا للعالم الآخر، وفي كل مرة يفكر في الموت، يستحضر نهايته، يتمنى لو يعود الزمن الذي ولى، لو يتأخر الموت قليلا، لو أمكنه أن يصحح الأخطاء والخطايا، لو يكفر عن ذنوبه، أحيانا كثيرة يحزن، يتألم، ولكنه لا يشعر أبدا بالندم.
يخاطب ذاته.
– ما الجدوى، فات الأوان!