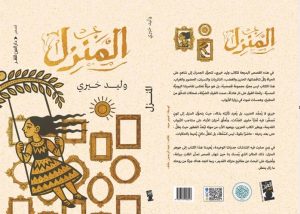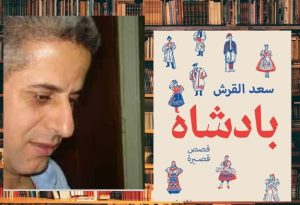عبد الهادي المهادي
تفاصيل كثيرة مُفجعة صاحبتْ علاقتنا بوالدنا، يصعب عليّ جدا الآن البوح بها، ربما أسجّلُها في كنّاشة أوصي بنشرها بعد مماتي، ولكن نتيجتها الطبيعية أن والدي انفصل عنّا. هجرنا وذهب ليسكن في قرية بعيدة، حيث تَعُودُ أصوله الجبلية، تارِكا زوجةً وخمسة أطفالٍ بدون أدنى مُعيل. تفاقم الأمر بيننا إلى ما يشبه القطيعة، وعندما قررتُ الزواج، وكنت قد اقتربتُ من الأربعين، لم أخبرْه، بل وفعلتُ المستحيل كي لا يصل الأمر إليه من أية طريق محتملة، كانت الخصومة عميقة بيننا، وهو الأمر الذي كان يشكل في صدري جُرحا غائرا كنتُ أعرف استحالة اندماله.
كان شخصية غريبة جدا؛ فبقدر عنفه وانغماسه ـ حينها ـ في عالم الكحول والدّخان ـ كان عسكريا ـ بقدر إيمانه بعوالم الأولياء وكراماتهم؛ كان ـ مثلا ـ يتقطّع فؤاده لزيارة ضريح المولى عبد السلام بن مشيش، ولكنه لم يزُرْهُ أبدا، ولم يكن يستطيع الذهاب إليه، كان يردد دائما وهو مؤمن تماما بما يقول: “مولاي عبد السلام مَـكَـيْـقْـبْـلْـنِـشِي” (لا يَقْبَلُني). من أجل ذلك كان يرسل مع بعض أصدقائه صدقات وهدايا يوزعها على فقراء الضريح و”طُلْبَته”.
وقائع كثيرة في هذا الباب يصعب تصديقها، و كثيرا ما نقرأ شبيها لها في كتب مناقب الصوفية؛ فذات ظهيرة من صيف حار، سمعنا دقات سريعة على بابنا، دقات تُعلنُ أن صاحبَها في عجلة من أمره، كان شيخا من عائلتنا البعيدة، سنوات طويلة جدا لم نره فيها، أدخلناه إلى غرفة الضيوف، وما لبث أن بدأ يشهق بالبكاء، ظننا في البداية أن عزيزا قد فقدناه، ولكن الأمر كان غير ذلك بالمرّة. بعد أن طلب من أمِّنا تَغْييبَنا في غرفة أخرى ـ كنا بالكاد تَعدّيْنا مرحلة الطفولة ـ بدأ تبليغ ما اعتبره “رسالة من عالم الغيب”، هكذا سمعناه يقول، لقد تنصّتنا عليه، أحسسنا أن الأمرَ جللٌ ويستحق المغامرة؛ سمعناه يقول: جاءني اليوم جدّنا الأكبر السِّي العياشي في المنام، كان غاضبا جدا، ولابسا السوّاد وكأنه في حِداد، قال لي سريعا وبقوة: “مْشي عَـنْـدْ ابْني سْلّامْ وْقُـلُـو يْـعْـمْـلْ عَـقْـلُـو، وْلَّا غَـدي يْـجِـيـبَا فْ رَاسُـو”. فيما بعد رَوَتْ لنا والدتنا كيف أن والدنا، في سلوكه، لم يهتم مطلقا بهذه الرسالة التي تحمل وعيدا واضحا، رغم أنه في أعماقه كان بالفعل يهابه.
ليلة عرسي، وكانت حفلة بسيطة، جمعتُ فيها أقرب المقربين من العائلة دون أي أحد من الأصدقاء، كان المطر خيطا واحدا من السماء، يومها صدقت نبوءة جدّتي؛ كانت تقول لي مبتسمة عندما تراني أمسح بقايا الطعام من الطجين بلساني: “غَدي يْكُون عرسك فْ الشّْـتـا”. أتذكر أن المؤذن كان ينادي لصلاة العشاء عندما دخل علينا بجلباب صوفية، وعمامة صفراء، كان كمن اُخْرِجَ لتوّه من بئر ماء. وبصمتٍ قبوري بَحْلَقَ فيه الجميع؛ آخر مَنْ كنا نتوقعه بيننا. كانت إحدى أخواتي أول من استفاق من دهشتنا، سلّمنا عليه ببرودة، وقادته إلى إحدى الغرف لكي يغيّر ملابسه، بينما غادرت والدتي إلى غرفة أخرى، كانت ترفض بشكل قاطع البقاء في مكان يوجد فيه. أتذكر أنها ذات عشية صيفية جمعت كلّ صوره، أكثر من خمسمائة صورة، وأشعلت فيها النار في حزن جنائزي؛ لقد تخلّصت من آخر ذكرياتها معه، ومن يومها أصبحت لا تطيق مجرد ذكر اسمه أمامها.
الجميع أكد أن لا أحد أخبره، وليس هناك مِن أحد يمكن أن يكون قد أوصل له النّبأ، لأنه اعتزل الجميع، وقطع علاقته بالجميع، ولم يبق في حياته ـ تقريبا ـ سوى بدويّة تزوجها هناك. رحبنا به ـ على أية حال ـ ولم يكن من المناسب أن نستفسره عن الوسيلة التي عرف بها فرحتنا.
سنوات طويلة بعد ذلك، أصبح يزورنا مرّة كل عام قصد متابعة العلاج من مرض ألمَّ به، وكنا نحسُّ أنه يريد التقرب إلينا، ولو بشكل محتشم، بعدما توفيت والدتنا.
يا ألله كم كانت أحاسيسه جامدة؛ فطول هذه المدة لم يأت أبدا على ذكرها، وكأنها لم تقض معه عشرين سنة من الزواج !
قَدْرَ استطاعتني كنت أحاول تجاذب أطراف الحديث معه حول أمور لم يكن “تاريخ أسرتنا” من بينها؛ كنتُ أحادثه في السياسة وتاريخ المغرب، خاصة ما تعلق بالفترة الأخيرة من الاستعمار والمقاومة، لأنه كان عنصرا من عناصر “جيش التحرير في الشمال”. ومن خلال هذه الدردشات بدا لي، ولأول مرة، أن “رَاسُـو عَااااامَرْ بْـزّافْ”، ولكنه كان كتوما جدا، ويبدو وكأنه خائفٌ من أحد أو شيء ما. لقد مات ـ رحمه الله ـ دون أن أستطيع تحديد ماهيته. مات هنّا، ودفناه هنا، بعد هروب دام أكثر من ثلاثين عاما.
مرة، وبينما كنتُ أتصفح مجلة “جون أفريك”، صادفتُ صورة شيخي عبد الصمد العطّار (لم أكن أريد أن أخبركم بالأمر، ولكن سياق السّرد يحتّم عليّ الآن فعل ذلك؛ منذ شبابي الأول، تعرّفت على هذا الشيخ وصاحبته وأخذتُ عنه الأوراد) أرَيْتُه الصورة قائلا: “وَاشْ كَـتْـعْـرَفْ هادْ الشيخ؟”. نظر إليّ مَليّا، وبنبرة المصدوم قال لي سريعا وكأنه يريد التخلص من سرّ قديم أثقل كاهله: طبعا كَـنْـعـرْفُـو… عْـلاشْ شْـكُـون عْـرْضْنـي للعرس دْيالك !” ثم بدا كمن أحس بالندم، ولكنه من الذّهول الذي ارتسم على وجهي عرف أن لا جدوى من التراجع أو المراوغة. قال حينها، وهو يعدّل من جلسته:
كنتُ نائما عندما جاءني، كان في هيئة من انتهى لِحِينِه من وضوء، فقطرات الماء كانت ما تزال تنزل من لحيته الشّيباء، و”المْقْرَاجْ” في يده. هزّني من كتفي برفق، وخاطبني وهو ينظر في عينيّ مباشرة: “نُـوضْ مْـشي للعرس دْ بْنْـكْ”.