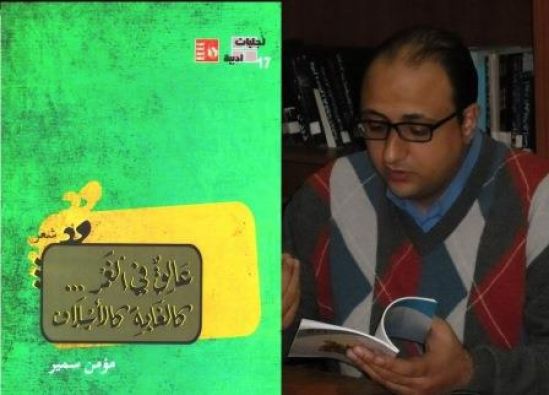مع كل قطعة تسقط من علي جسدها تشتعل تخيلاتهم لما هو آت أكثر من اهتمامهم بما هو ظاهر أمامهم، أنا لست مهووسة بالكتابة الإيرو تيكية الجنسية، لكن مهووسة بتلك الإيروتيكيه التي تعرى النفس البشريه وتحاول فك لوغارتماتها.
لم أجد افضل من مشكلتي التي تؤرقنى فى بعض الأوقات لأتحدث عنها.
وجهي متناسق جداً مع عينى العسليتين اللاتى تظهران لامعتين أغلب الوقت، ليس بفعل الإقبال علي الحياة لكن بفعل الدموع المتأرجحة فيهم دائماً.
أملك شفتين كبيرتين حمراوتين أغلب الوقت دون أى أدوات تجميل أو ملمعات، أعلم أنهما ممتعتان جداً في القبل.
ربما زاد وزنى مؤخراً، لكن ليس بالشكل الذي يدعونى لاتباع حمية غذائية مرهقة لنفسى المتلهفه للشيكولاتة دائماً.
الحياة بها الكثير من الممنوعات لا نستحق أعباء أخري نضيفها لأنفسنا، انتزعت فكرة الحمية من رأسى نهائياً مؤخراً عندما تأكدت أني مازلت محط الأنظار، وأن هناك أكثر من أحمق يعاكسونني معاكسات مبتذلة، في شوارع وسط البلد بعد أن حشرت نفسى داخل البنطلون السكينى والبوت الأسود قصير الرقبه والجاكت الجينز المهترئ.
مع ربطة ايشاربى الهندى الصنع الذي يحمل كل الألوان الفاقعة، برغم أن زوجى وأمى دائماً ما يقارنوني بـ”خدامات مصر الجديدة” مع ربطة حجابى الخلفية التى لا أكترث إلا لكونها الأكثر راحة بالنسبة لى دونما طبقات من الإيشاربات والبندانات كما تفعل اغلب المحجبات.
سعيدة جداً بمظهري الوحشى الغير مبالى، ولا ينغص سعادتي الا هذا الأنف الكبير نوعاً ما والذي يحمر بشدة ويتضاعف حجمه عند بكائى، لا أستطيع ان أجد حلاً مناسباً لخلق مواءمة ما بين شكل عينى الذي يزداد لمعة وجمالاً عند بكائي وأنفى الذى يتضاعف حجمه فى ذات الوقت.
ــــــــــــــــــــــــــ
لقراءة تكملة النص.. اقرأ ما كتبته غادة