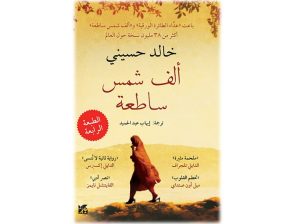لا ينشغل السرد داخل المجموعة ببناء أحداث متنامية بقدر ما ينشغل بالانفتاح على الماضي بتفاصيله. فالسرد_ داخل كل القصص تقريباً_ لا يهتم بالحدث المركزي الذي تنبني عليه القصة. فهذا الحدث_ الذي يخايل بمركزيته_ يصبح محض مفجر للقلق والتوتر الذي تنغلق عليه النفس البشرية، هذا التوتر الذي يحتل بدوره مركز السرد وصدارته ويعيد الحدث الأول_ المفجر للنص_ إلى الخلفية في حالة واضحة من التلاعب بخيوط السرد بحيث يظل القارئ غير متيقن أين يقع مركز الثقل داخل النص، مثل قصة “خروج إنسان” والتي تحكي عن خروج إنسان لشراء هدية كما تعلن في أول سطر”من ساعة،وهذا الإنسان يبحث عن هدية لحبيبته” (ص 6).
صحيح أن هذا الشخص أعجبته إحدى الهدايا عند “أول محل وقف أمامه” بما يعني أن الحدث الأساسي الذي تنبني عليه القصة قد انتهى منذ أول صفحة، ولكننا سنجد أن هذا الحدث يتراجع ويتوارى في خلفية المشهد وكأنه لا وجود له بعد أن أدى مهمته السردية الأولى وهي انفتاح النص أمام جملة من الفسيفساء الصغيرة سواء على المستوى النفسي للبطل أو على مستوى الأحداث الصغيرة جداً والتي تكاد تكون غير ملفتة أو غير جديرة بالانتباه. فقد قرر هذا البطل “أن يكون مثل كثيرين سمعهم يصفون حيرتهم وطول بحثهم وفرحهم بعثورهم على الصيد العزيز” (ص 9). فهذا المقطع يقضي تماماً على أهمية الهدية كغاية للبطل، ويعطي الاعتبار الأكبر لرحلة البحث ذاتها، هذه الرحلة التي يتذكر فيها أخاه أحمد الذي كان بارعاً حقاً في الشراء و “يمتلك القدرة على الفصال” (ص 11)، كما يتذكر الحكاية التي رواها له أبوه عن السمكة الكبيرة التي أهداها له أحد الأصدقاء بمناسبة الزواج. وهكذا تنفتح خزائن الذكريات على العديد من التفاصيل المطمورة داخل الأحداث اليومية، فمن “تذكر تمارين الصباح في المدرسة الإبتدائية” (ص 14)، إلى تذكر أنه “لم يشارك أحد من أصدقائه رحلة بحث من قبل “(ص 14). وهكذا يتوالى الانفتاح على الماضي إلى درجة “أنه لا يعرف متى سينتهي أو متى سيتوقف”( ص 15). وكأننا لسنا بإزاء رحلة بحث عن هدية، بقدر ما نحن أمام رحلة بحث داخل النفس الإنسانية المركبة لحظة انكشافها على سطح النص. هذا المنحى في قلب الحكاية وازاحت الهدف الهدف المركزي منها إلى خلفية المشهد وتصدير هدف آخر ربما يكون يكون ثانوياً سنجد مجلاه بشكل أكثر وضوحاً في قصة “كيف بدأت الحياة” والتي تبدأ “عبر رنين جرس التليفون” ثم مكالمة طويلة بين رجل (السارد المركزي) وامرأة كانت حبيبة أحد أصدقائه، وأثناء المكالمة ينفتح السرد_ كالعادة_ على العديد من الذكريات، حتى نصل إلى جملة أظنها مفصلية في قراءة المجموعة برمتها، يقول: “حكيت لها عن إلهام لا لتعرف هي، بل لأنني كنت أريد أن أسمعني وأنا أحكي عنها” (ص 45). فهذا المقطع شديد الدلالة على الاستيراتيجية التي يتبناها الخطاب السردي، فدائماً ثمة هدف معلن للحكاية وهذا الهدف هو الذي يعطي الحكاية مشروعيتها وجدارتها، ولكن خلف هذه الغاية التي يعلنها الحكي ويعنون بها ذاته. ثمة أخرى مستترة وتقف في الخفاء لتسرب ذاتها من وراء حجاب الأهداف الأول.
من محكاة الواقع إلى خلق رائع
لعله من الملامح المدهشة والمائزة لهذه المجموعة والتي صدرت قبل عشر سنوات من الآن (أول يونيو 1999) أنها لا تتعاطى مع الواقع بوصفه معطى سابق الحضور وأن كل ما على السرد أن ينجزه هو محاكاة هذا الواقع المعطى والذي أتم اكتماله على نحو نهائي قبل بدء السرد حسب التصور الاعتيادي السائد. ولكنه يتعاطى مع هذا الواقع ليس بوصفه معطى ولكن بوصفه منتجاً يتم صناعته داخل السرد، حيث نجد الشخصيات تصنع واقعاً افتراضياً ثم التعايش معه وكأنه واقع حقيقي رغم أنه محض خيال. فالافتراضي المتخيل تحوله الشخصيات إلى حقيقي وواقعي، وكأنها تصنع واقعها بأيديها، بديلاً عن الواقع الحقيقي المعاش والذي ملت الشخصيات من الحياة بداخله.
هذا المنحى في خلق الواقع سنجده ساطعاً في قصتي “القاتل ” و”عين واحدة”. ففي قصة القاتل لا يوجد حادث قتل حقيقي، ومن ثم لا يوجد قاتل أو مقتول. ولكننا سنجد المسرود عنه، سالم، والذي “يتأكد داخله أكثر قرار القتل، وأن موعده قد حان” (ص 20). وفي الحقيقة، فإن سالم لا يعرف لماذا سيقتل أو كيف أو حتى من الشخص الذي يريد أن يقتله ولا أين سيقتل أو متى.فكل ما يعرفه هذا البطل أنه “على موعد مع جريمة قتل سيرتكبها، وسيبدع في تنفيذها كمحترف قدير” (ص 19). كما أنه يتماهى مع الواقع السينمائي على الشاشة إذ “شغف برؤية مشاهد القتل في الأفلام، وكلما كانت جريمة القتل محكمة التخطيط،وصورت بأدق تفاصيلها، أحس بأنه هو الذي قتل، ويرتاح عند رؤية القتيل غارقاً في دمائه، ويتخيل نفسه واقفاً ينظر إلى أفق بعيد، يبحث عن ضحية جديدة” (ص 22). إن القتل كحدث سردي لا يحدث في الواقع الحقيقي ولكنه يحدث داخل الواقع السينمائي المتخيل، وهذا الحدث المتخيل يتم استعارته إلى حيز الواقع الحقيقي، وكأن سالم هو الذي قام بفعل القتل هذا. ولا يتوقف الأمر عند حدود التماهي مع شاشة السينما، بل يتعايش سالم طوال الوقت وفي تصرفاته كافة على أنه قاتل حقيقي قام بارتكاب جريمة قتل حقيقية، يقول: “وسار ينظر في وجوه العابرين وهو يخفي يده في جيبه وكأنها مخضبة بالدماء. أتكون هذه بداية وصول قدرته لأعضاء جسده؟” (ص 21). إنه هنا أصبح يتعامل مع الحدث الذي خلقه بمخيلته وكأنه حدث واقعيتماماً، ترتبت عليه آثار مثل إخفاء يده في جيبه “وكأنها مخضبة بالدماء”. فالحدث المصطنع عبر الخيال تجاوز حدود كونه خيالاً محضاً، وأصبح له تبعات واقعية. فالدماء الافتراضية تحولت إلى واقع يلوث يديه ويخشى من رؤية الناس لها. بل إنه يفرط في تحويل هذا الواقع الافتراضي إلى واقع حقيقي، فيسير في الشارع بسرعة وكأن “هناك من يلاحقونه، يحاولون القبض عليه، وهو يسرع، يريد أن يغيب عن عيونهم، ليقطع الطريق إلى مخبأه” (ص 27). فإذا كان قد اصطنع دماء على يديه فإنه، أيضاً، يصطنع من يتعقبون أثره ويلاحقونه إمعاناً في تحويل الواقع الافتراضي إلى حقيقي. فالبطل يخلق الواقع أولاً في خياله ثم يعيشه في الحياة، وكأن الخطاب السردي لا يعترف بوجود واقع معطى سلفاً تتم محاكاته، ولكن يتم انتاجه عبر المخيلة ثم يتم تنفيذه على الأرض الحقيقية، وكأننا بصدد قلب للعلاقة التقليدية بين الواقع والخيال والتي تعتبر أن الخيال هو محاكاة للواقع، فإذا بالواقع يصبح محاكاة للخيال.
هذه العلاقة المقلوبة بين الواقع والخيال والتي تتعاطي مع الواقع كمحاكاة للخيال سنجد لها صدى آخر في قصة “عين واحدة” عبر شخصية البنت التي اختارت بنفسها يوم عيد ميلادها “بعد أن فتحت أجندتها وعيناها مغمضتان وأشارت إلى إحدى الصفحتين المتقابلتين” (ص 32). إنها لا تعترف باليوم الحقيقي الذي ولدت فيه، وتعيد تشكيل وصياغة هذا الواقع، وكأنها تصنعه من جديد، بل وأصبحت تتعامل مع هذا اليوم الذي صنعته بنفسها كعيد ميلاد حقيقي حتى لو نسيه من حولها من أصدقائها ولم يتصل بها أحد للتهنئة فإنها تحتفل بمفردها “بعد يأسها من اتصال أي واحد منهم” (ص 32). إنها تصر على خلق واقعها كما تراه وحتى لو لم يشاركها الآخرون في هذا الواقع البديل فإنها “قالت لنفسها كل سنة وأنت طيبة” (ص 33).
الانفتاح على الخطاب الثقافي
يرتبط الآداء اللغوي للنص بالموروث الثقافي، فيصير تركيب الجملة غير منغلق على طابعه الآدائي داخل السرد بوصفه ينقل أحداثاً فقط، ولكنه يتحول إلى حامل للثقافة المهيمنة وخصوصاً الثقافة الشفاهية، فنجده يسقط بعض الاشتراطات النحوية في مقابل أن تظل دالة على عمقها الثقافي الذي يرتبط بالصيغة في سمتها الشفاهي مثلما يحكي عن “سمكة ضخمة تزن حوالي عشرين، ثلاثين كيلو” (ص 12) إذ تم إسقاط الأداة “أو” والتي من المفترض أن تفصل بين عشرين وثلاثين، حفاظاً على أن تظل الجملة حاملة لمذاقها الشعبي في الآداء.
لا يتوقف الأمر عند حدود اسقاط حرف فقط بل يتعداه إلى إسقاط مفردة، يقول: “هؤلاء العجائز موزعين بين من ينظر إلى ميدان الجيزة، ومن يقرأ الأهرام” (ص 24). فالأداء اللغوي المستقيم يجعل السارد يقول: يقرأ جريدة الأهرام. ولكنهيستجيب للاستخدام الشعبي لهذه الجملة التي تم التواطؤ علي قولها بهذه الألية، متكئاً على أنها أصبحت من الموروثات اللغوية القارة في وعينا الثقافي، وكأن النص يعتمد في تواصليته مع المتلقي على ما يشبه الشفرة اللغوية التي تم التواطؤ عليها عبر التاريخ، فيصبح التواصل مع النص رهناً بمعرفة هذه الشفرة الثقافية، فلو افترضنا أن متلقياً ليس لديه معرفة بشفرات الخطاب الثقافي واللغوي، فربما يعتقد أن العجائز الذين يجلسون على مقهى الجيزة ينظرون إلى أهرامات الجيزة ويحالون التأمل فيها وقراءة خصائصها البنائية، أو ربما يفترض أن المقهى توجد به لوحة للأهرامات، وهؤلاء العجائز يحاولون النظر إليها وقرائتها كنص جمالي.
كما يمارس النص انفتاحه على الخطاب الثقافي عبر العديد من الأمثال الشعبية والأقوال المأثورة التي تتناثر في ثنايا القصص، باعتبار هذه الأمثال والأقوال تمثل تكثيفاً لحمولات دلالية كثيرة وتختصر مسافات واسعة من السرد، بما تحمله في ذاتها من حكايات كثيرة تقف خلفها. وهذه الأهمية التي تنطوي عليها الأمثال والمأثورات يتم التأكيد عليها بوضوح داخل قصة “كيف بدأت الحكاية”، يقول: “عرفت أن الأقوال المأثورة التي تقال بخفة واستهتار تمارس دوراً مؤثراً في أفعالنا، وترجح إحدى الاحتمالات المتعددة التي تتاح لنا” (ص43).
تبقى إشارة إلى أن معظم قصص المجموعة لا يتم فيها وسم البطل باسم محدد، فإما يتم الحكي بضمير الغائب “هو” دون أن يتم تحديد اسم لهذا المحكي عنه أو يتم الحكي بضمير “الأنا” دون أن نعرف اسم السارد الذي يقوم بفعل الحكي، حتى إنه في إحدى القصص يتعاطى مع البطل على إنه إنسان دون اسم، فيقول: “يفر إنساننا” (ص 14) و “إنساننا ينظر” (ص 15) وكأن البطل ليس شخصاً محدداً بدر ما هو تمثيل لأي شخص، فينفلت المحكي عنه من إطار التحديد إلى حيز التمثيل الإنساني الأشمل.