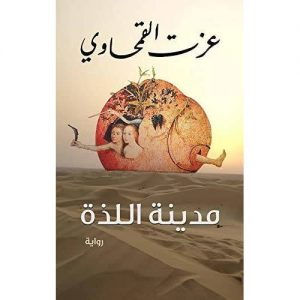حاوره: محمود خيرالله
بسبب فيروس “كورونا” تأجل إجراء هذا الحوار عدة شهور..
كنتُ انتهيت من قراءة “الطبعة الثانية” من كتابه “غرفة المسافرين” في شهر مايو الماضي، وهو في ظني أنشودة شاعرية في مديح الترحال ومآثر السفر، حينما طلبتُ من الكاتب والروائي والصحفي عزت القمحاوي أن نجري حواراً لمجلة “الثقافة الجديدة” عن رواياته وكُتبه وعالمه الأدبي الفريد، وقتها كان الفيروس آخذاً في إصابة العالم بالفزع والاعتزال، المحالُ التجارية والكافيهات والمقاهي كانت مُغلقة على الأحزان، ورائحة الموت اليومي كانت واضحة في الهواء وعلى الطرقات.
سألته: هل تفضل أن ننجز الحوار كتابياً، (أي أرسل إليه الأسئلة، فيرد بالإجابات) لكنه رفض!! قال إنه يفضل الانتظار ولو لعدة أشهر، وهو ما أوقعني في الحرج ـ المهني والأخلاقي ـ فقد تمنى الرجل بمنتهى الرقة أن تزول الغمة أولاً، وأن نتمكن من اللقاء مباشرة ذات مساء قادم، في أحد مطاعم وسط القاهرة، حين تنتهي الجائحة، لنحكي ونضحك بصوت صاخب كما يفعل الأصدقاء، عادةَ، وهو الاتفاق الذي تم تحقيقه بالفعل ـ مطلع سبتمبر الماضي ـ بكل دقة وعناية.
لأنه أحد أصحاب الأقلام المدهشة في الصحافة المصرية، وأحد الذين يخوضون معركة الحياة ببراءة الشراقوة، ولأنه أحد الموهوبين في مجال البورتريه الصحفي، وأحد كبار الزملاء الذين سبقونا إلى فن “الديسك الصحفي“، ولأسباب أخرى كثيرة، قررت أن أعود إلى أعماله، فقرأت روايتيه الجديدتين “مارآه سامي يعقوب” و“يكفي أننا معاً“، ففي الأولى أعجبتني الرحلة التي تجمع الماضي بالحاضر، عبر خيوط حكاية غرامية، ووقائع تبلغ ذروتها في “ميدان التحرير” خلال ثورة 25 يناير، وهو روائي مغرم بتيمة الرحلة التي تكررت بصورة مختلفة في “يكفي أننا معاً“، التي تحكي واحدة من أروع قصص الغرام بين رجل شرقي وامرأة.
بقي أن نقول إن عزت القمحاوي مواليد ديسمبر عام 1961، صدر له حوالي سبع روايات منها: “مدينة اللذة” و“الحارس” و“يكفي أننا معاً“، كما أصدر ثلاث مجموعات قصصية، أولها “حدث في بلاد التراب والطين” 1992 وعدد من الكتب منها “كتاب الغواية” و“كتاب الأيك في المباهج والأحزان“، وقد حاز على جائزة نجيب محفوظ عام 2012 عن روايته “بيت الديب“، وتُرجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والصينية والإيطالية.
حينما التقينا ـ بعد كل هذه الشهور الطويلة من الحظر بدت عليه السعادة وهو يهديني إحدى طبعات “مدينة اللذة“، ويذيع إلي سراً لأول مرة أن روايته المقبلة عن “عزلة كوفيد“، وكان طبيعياً أن أبدأ معه من النقطة الأكثر شهرة عنه، والتي تعكس حجم المفارقة المدهشة في شخصيته، من أن كاتباً ذائعاً مثله اعتاد أن تتعدد طبعات رواياته، لا يزال يخشى ـ إلى حد ما ـ رد فعل القاريء إلى اليوم!..سألتُه:
قلت ذات مرة: “خوف عيسى (بطل رواية غرفة ترى النيل) من الكتابة هو خوفي.. الفرق الوحيد أنني في النهاية أضعف وأسلم الرواية للنشر“.. بعد كل هذه الكتب.. هل لايزال عزت القمحاوي يخاف من الكتابة حتى اليوم؟
ـ نعم، وأصبح الخوف أكبر.. أشعر أنني مع كل تجربة جديدة كمن يمشي في صحراء، ذلك لأنني أحرص على عدم الوقوف في مكان واحد، من حيث الموضوع واستراتيجيات البناء وفنيات الكتابة، وأجد أن كل مرة هي بداية جديدة، لذلك أكون عصبياً جداً وقت الكتابة، وأحيانًا ما يدفعني الأرق إلى عدم النوم لأيام، خصوصاً خلال الكتابة الأولى للرواية، وأضطر إلى الاستعانة بمنومات، ولا أطمئن أبداً إلا بعد أن يقرأ نحو 3 من الذين هم على استعداد لقراءة العمل وبذل الجهد في ذلك، وقد صادفني في الرحلة أصدقاء يكتفون بالثناء على ما فعلت، فاستبعدت تقييمهم، وبت أكتفي من الأصدقاء بمن يناقش ويبدي ملحوظاته وهذا وحده ما يهديء من قلقي، ويدفعني إلى الخطوة التي لم يصل إليها أبداً عيسى “الشخصية الروائية” وهي خطوة النشر، فعيسى لم ينشر أبداً، لأنه يعاني من رهاب الكمال.
ما الذي يثير خوفك في الكتابة إذن؟
ـ أعتقد أن عملية القراءة نوع من الشراكة يفرضها الكاتب على القاريء، هذا الخوف يكون خوفاً من رفض الشريك، الخوف من ألا يُحس الصدق الفني فيما أعرضه عليه؛ لأنه لن يدخل هذه الشراكة إلا إذا كنت قادراً على أن أجعله ينسى نفسه، ويدخل معي عالم الرواية، ليصبح العالم الذي أقدمه له هو عالمه أيضاً.
ولذلك آخذ بتحفظ الأقوال التي تقول إن أي كاتب يكتب لنفسه.“كافكا”، و”فرناندو بسوا” وكل هؤلاء لذين ادعوا أنهم لا يحبون أن ينشروا كان بوسعهم أن يدمروا ما كتبوه ولا يتركوا أثراً، لكنهم فكروا في القارئ، وقالوا ما قالوه ربما بدافع الخوف الشديد أو بأي دافع النرجسية المفرطة، لكنهم في نهاية الأمر تركوا الطريق لآخر ولو في زمن تالٍ لينقذ ما ضعفوا هم عن الدفع به إلى القاريء الشريك. كل كاتب يضمر بداخله قاريء، وعن نفسي فإنني أرجو عطف هذا القاريء ورضاه، وهذا هو المصدر الأساسي للخوف.
ما طقوسك في الكتابة، هل تفضل قراءة الروايات وأنت تكتب رواية أم تلجأ إلى فن آخر مثل الموسيقى أو الشعر أو الفن التشكيلي.. أريد أن أتعرف إلى ذوقك الخاص ووصفك للحظة وطقوس الكتابة عندك؟
ـ بسبب الانشغال الشديد في الصحافة لم تكن لديَّ رفاهية الركون إلى طقوس معينة، كنت أعتبر أن أي ساعة فراغ هي نعمة من الله، وتعودت أن أكتب صباحاً أو مساء أو ظهراً، حسب وجود الوقت، ليس لي موسم كتابة، لكنني أعتبر الإبداع بحاجة إلى صفاء ذهني شديد، أنا دائماً أكتب في مكان ولو غرفة لا يتحرك فيها أحد غيري، لا أسمع أي شيء ولا أشرب أي شيء وأنا لحظة الكتابة. بينما تكون القراءة في خدمة الموضوع الذي أكتبه. أي البحث العملي حول الموضوع الذي أكتب فيه روايتي. أثناء كتابة «الحارس» قرأت العديد من الكتب في الخيل واستطلعت آراء فرسان وركاب خيل، كنت أريد تدقيق فكرة أعرفها بشكل غائم، عن العلاقة بين الفارس والحصان التي تصل إلى حد الرهافة الجسدية، هذا التفاهم الذي يصل إلى حد الاستجابة إلى الأمر الصادر عبر ريح حركة الساقين على جانبي الحصان. والأمر دائمًا على هذا الحو، فما أكتبه حاليًا، وقد انتهيت من الكتابة الأولى له، وسيكون موضوعاً عن “عزلة كوفيد”، وقد أمضيت أوقات الراحة من الكتابة في قراءة أحدث ما كتب عن المرض طبياً.
في مواسم الكتابة تكون القراءة في خدمة النص الذي أعمل عليه، وأي معلومة أستخدمها في النص بشكل عفوي دون أن أقطع استرسال الفكرة، وفي وقت الراحة أبحث عنها لأعرف درجة معقولية ما كتبته، هذه الدقة هدفها فني، فالرواية التي تتناول الوباء لن تكون كتاباً علمياً عن كوفيد، ولكن القاريء يريد معلومة حقيقية لكي يتقبل مني الخيالي.
وفي التجربة التي أكتبها الآن عن حالة العزلة بسبب كوفيد، هناك شخصية ستضطر أن تأخذ عظام أبيها إلى الخارج، ولذلك لابد أن أعرف هل هذا جائز أم لا وأي الموافقات التي يجب الحصول عليها. معلومات من هذا النوع تشغلني بقية اليوم، فإذا كانت لدي جلسة كتابة أو جلستان يومياُ تمتد كل منها ثلاث ساعات مثلاً، فإن باقي الوقت تقريباً أمضيه في تدقيق المعلومات التي كتبتها، وربما التي لن أكتبها، لكن يجب أن أكون عارفًا بما وراء الحدث الذي اخترت أن أكتبه وبما يجعله ممكنًا ومنطقيًا.
ـ قلت من قبل إنك لا تؤمن ـ أبداً ـ بالحدوتة “الفارغة“، وإنه لابد أن تكون الكتابة مشحونة بهم سياسي عام أو مضمر يرتبط بالإنسان في أي مكان.. هل تؤمن برسالة للكاتب؟ وكيف تراها: سياسية أم جمالية؟
ـ أؤمن بما قاله ماركيز ذات مرة، إن رسالة الكاتب هي أن يكتب جيداً، وكما تفضلت أنت، لدى الكاتب مسئوليته الأخلاقية، لكن رسالته أيضاً جمالية، الهم السياسي هو هم أيضاً، لكنه أضيق من الهم الوجودي، إذا لم يكن الكاتب ممسوساً بالموت أو بالمرض أو بالضعف أو بالشيخوخة، لا أتوقع أن يصل إلى القراء بشكل جيد، لأن الكاتب يلتقي مع القاريء في هذه الهموم، وفي هذا المشترك، وكلما زادت المشتركات مع الكاتب شعر القاريء أنه أحد الشخصيات، إحدى الصديقات علقت على صفحتها على فيسبوك على شخصية في رواية “ما رآه سامي يعقوب” وقالت إنها شعرت أنني كتبتها وأنها مراقبة، بسبب التشابه الذي رأته بين نفسها وبين إحدى شخصيات الرواية.
يمكن أن نسمي «الهم الإنساني» باسم آخر: العمق، العمق في الأحاسيس، أما الحدوتة الفارغة فأنا فعلاً لا أستطيع التعاطي معها. هناك نوع من الكتابة، يقدم كما لو كان “فولكلور” خصوصاً الكتابة عن القرى، انظر كيف تعجن الفلاحة! انظر كيف يطاهرون المولود! النظر إلى أن حياة الناس أعاجيب، وهذه ليست كذلك لا يصنع كتابة. لابد أن يكون هناك عمق ما وراء طقس أو حدث ما.
الكتابة إذا أحببنا تشبيهها بالحلويات مثلاً هي قطعة من جاتوه الطبقات «الميلفيه» أو مثل كثير من الفاكهة الآسيوية من الخارج طبقة خضراء ثم طبقة صلبة، ومن الداخل غلاف طازج يؤكل وبداخله عصير حلو، الكتابة تنطوي في داخلها على حالات متعددة، الناعم والخشن وبالتالي لابد أن يمتلك النص هذه الطبقات وهذا التنوع، وإلا ستكون الحكاية بسيطة جداً مكانها مجرد تحقيق صحفي في مجلة يُقرأ لمرة واحدة. في ظني أن الكتاب هو ذلك المطبوع الذي ستحتاج إلى قراءته أكثر من مرة على مدار العمر، ولن يكون هكذا إلا إذا انطوى على كل هذه الطبقات.
في المقابل، أنت من المؤمنين بأن “الكتابة يجب أن تكون نوعاً من اللعب“، لكنك تتمسك مثلاً بالخط الواقعي في الرواية.. رغم أنك جربت القصة الخيالية مرة واحدة في روايتك “مدينة اللذة” ذات الخيال الأسطوري.. لماذا لم تكرر التجربة؟
ـ أولاً أنا أعتقد أن مصطلحات مثل “الواقعي” و”الخيالي” وجدت أصلاً لأسباب الدراسة، والضبط العلمي، لكنك لا تستطيع أبداً أن تدعي أن روايةً لي أو رواية لأي كاتب آخر هي رواية واقعية إلا إذا كنت تعيش مع الكاتب منذ مولده وعلى مدى الأربعة وعشرين ساعة وشاهدت كل ما كتب.
وبسبب استحالة تحقيق هذا الشرط؛ فالرواية عمل خيالي، ولكنه أحياناً يبدو أكثر واقعية، وتبدو حصة الواقع فيه أكبر، وهذا مجرد رؤية عامة بسبب تشابهه مع الحياة، لكننا لا نستطيع التأكد من أن واقعة في رواية قد حدثت بالفعل.
الأمر نفسه ينطبق على ما نسميه «خيالي». «مدينة اللذة» عالم أسطوري لكن حصة الواقع فيه موجودة رغم أن الأسطورة هي التي تحتل الواجهة، بينما المجتمع يقع في القاع. وفي المقابل ستجد ترتيب طبقات قطعة الجاتوه في رواية “بيت الديب” مختلفاً، بحيث يأتي الواقع على السطح وتكمن الأسطورة في العمق، فعمود الرواية سيدة عمرت مائة عام، وتريد أن تكتب رسالة إلى الله ليذكرها عندما رأت الإيميل لأول مرة؛ لأنها تشعر بالحرج للعيش من طول الشيخوخة. هذا الطلب لم يحدث سوى في خيالي. قرية ”العش” بالرواية قرية خيالية وضعتها بين قريتين حقيقيتين في “محافظة الشرقية” وهذا يعيدنا إلى مبدأ (ضع شيئًا حقيقيًا بجانب الخيالي). رواية “بيت الديب” رواية خيالية جداً، وفيها صنعت مفارقة لم تحدث في الواقع، حينما توفي العمدة في موسم جني القطن في نفس اليوم الذي مات فيه جمال عبدالناصر، وخرج نعش رمزي لعبدالناصر يحمل بداخله القطن، وهذا شيء مؤثر جداً حدث في كل القرى دون اتفاق؛ لأن القطن هو المعنى الرمزي للخير الذي استعاده الفلاح بقوانين الإصلاح الزراعي، وبعد الصلاة على جثمان العمدة الحقيقي وجثمان عبدالناصر الرمزي تم تبديل النعشين بالخطأ، وعندما وجد حاملوا العمدة نعشه خفيفًا أطلقوا صيحات الفرح والتكبير، معتقدين أنها معجزة وكرامة للعمدة الميت!
هنا لابد من الحديث عن فكرة صناعة الخيال. نعوش ناصر في كل ربوع مصر واقعة حقيقية، وهذا القدر من الحقيقة يكفي لتمرير الخيال. لهذا لا تستطيع حساب نسبة الخيال والواقع في كتابتي، وليس صحيحاً أنني اكتفيت من الخيال بـ “مدينة اللذة”. وإنما هو شكل من أشكال ترتيب طبقات الكتابة، كما أن “مدينة اللذة” ليست خيالاً محضاً ـ أيضاً ـ لأنها تحوي تحتها مدينة خليجية.
ما الذي أحببته وما الذي لم تحبه في جيل الستينيات في الرواية المصرية.. لديك تجربة عمل مع الروائي جمال الغيطاني وتجربة صداقة إنسانية مع محمد البساطي؟
ـ الوظيفة تجربة ذهبت إلى حالها وبالتالي لا مجال للحديث عن جمال الغيطاني، والعمل الذي أديته في “أخبار الأدب”، هو جزء من أعمالي التي قدمتها لمؤسسة الأخبار. أخبار الأدب هي فرع من فروع المؤسسة، أما التجربة العريضة التي استمرت فهي التجربة الإنسانية، مع محمد البساطي وعبدالفتاح الجمل، أستاذ جيل الستينيات، لم تكن تجربتي معه طويلة لكنها كانت ثرية جداً، وهو كاتب كبير ومثال للكاتب الدور، وبالتالي أستطيع أن أرى عبدالفتاح الجمل في كل انجاز حدث بعده وليس في المتحقق من نصوصه فقط، وأيضاً المتحقق في نصوصه ليس قليلاً سواء في “محب” أو “الخوف” أما محمد البساطي فهي صداقة رائقة جداً وأحببته على المستوى الشخصي، وهو تجربة في الكتابة أوذيت إلى حد ما، لكنني أستخدم هذا الحكم بتحفظ، لأنني لا أعتقد أن أحدا لا يستطيع إيذاء كتابة حقيقية، ربما يفقد الكاتب في حياته مزايا يحصل عليها غيره، لكن الكتابة لا يفوتها شيء. فاتت البساطي أشياء قليلة مثل الجماهيرية، أو الجوائز لأنه لم يكن يوماً مع النظام.
الغنى الذي تتمتع به كتابات محمد البساطي ينبع من الإنصات للصمت، والحق أن تجربة الستينيات إجمالاً شابها شيء من الأساطير الشخصية، البعض بنى صورة أسطورية لنفسه أضيفت إلى نصوصه، لكن الزمن كفيل بإعادة الفحص، فبعد أن تتخلص النصوص من الأساطير الشخصية ويقف النص بمفرده سيتبين ما هو النص الذي يمكن أن يدافع عن نفسه. لدى جمال الغيطاني نصوص تدافع عن نفسها بلا شك، ولدى محمد البساطي نصوص أيضاً تدافع عن نفسها، عبدالحكيم قاسم، يحيى الطاهر عبدالله وإبراهيم أصلان وصنع الله. نحن نستبق الزمن، لكن حكمه هو النهائي.
أنت من جيل الثمانينيات في الرواية؟.. هل تشعر بالانتماء لهذا الجيل؟..هل نستطيع أن نتحدث عن ملامح أدبية في جيل معين أم أنكم كنتم أقرب إلى حالات فردية؟
ـ لا أشعر بالانتماء لجيل، لكن انتمائي الوحيد والمؤلم هو للإنسان، أنا أعتقد أن فكرة التجييل مغلوطة جداً، بدأت مع جيل الستينيات، وهم بدأوا كموجة وكان التصرف غالباً هو “تصرف الشلة”، ولو سألت زميلاً عايشهم سيقول لك إنه عرف حجم المرارات التي بينهم، لكنهم يكونون واحدًا في مواجهة الآخر، حتى في مواجهة نجيب محفوظ، وبعضهم عاش مستفيدًا من أسطورة نجيب محفوظ أصلاً، لكني أعرف تماماً حقيقة شعور المقربين منه تجاهه، وأعرف حقيقة شعور بعضهم تجاه الأجيال التي جاءت بعد ذلك..
عفواً هل وقف جيل الستينيات ضد الأجيال اللاحقة؟
ـ طبعاً كان هناك ميل لدى جزء من هذه النخبة إلى “دعم الحصان غير الرابح”، بحيث يحبون النفخ في ظواهر لن تستمر، ويمهدون الطرق التي ستنقطع بأصحابها، والكثير منهم مارسوا هذا الأمر في أدوارهم الثقافية للأسف، وهذا شأن لا يمكن أن أهتم به أنا كروائي، لكن يستطيع المؤرخ الأدبي أن يقوم بقراءة المشهد في فترة محددة درسًا علميًا، ويقول لنا إن فلان الفلاني كان متنفذاً في الوسط الصحفي ـ في وقت الدراسة ـ وأن هذا الفلان الفلاني راهن على هذه الأسماء، ويرى إن كانت هذه الأسماء موجودة إلى الآن أم لا.. عندها فقط سوف تدرك أن هناك شيئا غير أخلاقي يتم وهو أن البعض من هذا الجيل كان يقوم بالتبشير ـ فقط ـ بمن لن يُصبح مُنافساً.
ولك أن تعرف أنني وجدت نفسي حياتياً أعيش وسط جيل الستينيات، في العمل مع جمال الغيطاني وبحكم الجيرة مع محمد البساطي كما وجدت أستاذهم عبدالفتاح الجمل، هذا من حيث الممارسة اليومية، أما من حيث النص فأنا أؤمن بشيء مختلف عن فكرة الجيل، أؤمن بـ “نَفَس العصر“ وروح العصر. لكل زمن ملامح تظهر لدى من يكتبون في اللحظة التاريخية نفسها مهما كانت أعمارهم، يعني مثلاً “أحلام فترة النقاهة” و”أصداء السيرة الذاتية” لنجيب محفوظ تحسب على قصيدة النثر، فها هو أديب نوبل في التسعين ويكتب نصوصاً تشبه قصيدة النثر، مثلما يكتبها شاب في الثلاثين.
بعد أن نشرت “الأيك” كنص هجين ومتعدد الهويات، فوجئت بعد عدة أشهر بصدور كتاب «أفروديت» للكاتبة إيزابيل الليندي عن الحواس والأكل، وكنت محظوظاً لأن كتابي صدر قبل كتابها. لأن قلة ثقتنا بثقافتنا كان من شأنها أن تجعلني منتحلا! ووبالمناسبة، فأنا لا أرى ايزابيل كاتبة كبيرة ولا أضمر لها كثيراً من التقدير، لأن تجربتها لا تعكس خصوصية شخصية، كما لا تعكس جنسها كامرأة. نصها يبدو نصًا من أمريكا اللاتينية كتبته ورشة، ولديها فحولة رجالية، للمرأة منظور مختلف للأمور، لا أراه في نصوصها.
صناعة الخيال تحتاج إلى انصات للروح أكثر من أن تكون لديك بعض المهارات الكتابية، لذلك أنا لا أسّعر كتاباً مثل كارلوس زافون أوهاروكي موراكامي بتعريفة، بسبب هذا البذخ في الخيال وهذا الإفراط في القوة. والقوة ليست في قوة الشخصية التي يبنيها كلاهما في أعماله، ولكن في الافراط في العجائب، وحماس الرواي الذي يحرص على أن يكون كل شيء غريب بينما الكتابة مثل الموسيقى تحتاج إلى النغم الخفيض، مثلما تحتاج إلى النغم المرتفع. هذان الكاتبان لا يتوقفان عن صناعة المعجزات، تطلع من أعجوبة تخش في أعجوبة، هكذا بلا توقف..
مثل باولو كويلهو مثلاً وقد تعرفنا عليه في ندوة باتحاد الكتاب وكان حضوره هزيلاً كروائي وغير مُقنع كمثقف؟
ـ في زيارته تلك لمصر استضفناه في ندوة في “أخبار الأدب” وقلت له أنت مضاد للرواية، أنت أقرب لمبشر، كان رده (no) حوالي ثلاثين مرة، وبدأ يدافع عن نفسه، لأنه يكتب نصاً أقرب إلى التنمية البشرية.
لكن فكرة وتر الخيال المشدود على الآخر دا منفر، وليس من المعقول أن يكون كل من يلتقيهم مدهشين، ولنا في “ألف ليلة وليلة” مثلاً يمكن أن نتأمله. يجد السندباد العفاريت والصقور في خدمته، عفريت يشيله من هوة وصقر يحطه فوق سفينة، وتتحطم السفينة، فلا يأتي العفريت أو الطائر، ويكون على السندباد أن يتصرف مثل أي مسافر عادي في سفينة تتحطم، فيتعلق بلوح خشب. مبدعو ألف ليلة وليلة صنعوا النغمة الخفيضة في تلك اللحظة، وهذه الطريقة في النجاة هي التي تجعل المتلقي يقبل كل الخيالي في النص. وبالتالي صناعة الخيال محتاجة إنصات للذات، وتذوق الموسيقى.
هل حكاية روايتك “يكفي أننا معاً” صورة من تجربة حياتية عشتها؟
ـ أنا متمسك بأقوالي! حتى رواية “مدينة اللذة” ليست خيالاً صرفاً، بل فيها واقع وفيها تجربة حياة كاملة في بلد عربي، لكن أنا لا أحب أن تكون الكتابة هجائية لمكان ذهبت إليه برغبتي، وإنما أتفهم الحالة الإنسانية وحالة المدينة وافتقاد الأمل فيها هي حالة إنسانية، لا يصح أن تكون حالة ازدرائية، أيضاً في “يكفي أننا معاً” بعض من واقع حياتي وحبي، وفيها من خبرات الآخرين، ودائماً أنا أحس أن الكاتب هو أسعد إنسان في العالم. رغم متاعب الكتابة وقلق الخوف من القاريء أعتبر نفسي محظوظًا بنعمة الكتابة. أعيش روائياً 24 ساعة في اليوم وأفضل عطاياها بعيداً عن طاولة الكتابة ودائماً حين أتعرض لأي حقارات في العمل أو أي صعوبات تجدني رفعت نفسي من المشهد وأصبحت ممتنا لهؤلاء الأشرار الذي تطوعوا بأداء هذا المشهد، لكي يغزوا مخيلتي. ينبغي أن أشكرهم لأنهم حاولوا ارتكاب الشر ضدي، فكان هذا الشر خبرة أحتاجها في الكتابة، وهكذا أتلقى الشر مُخففاً. ومثلما يحتاج الكاتب خبرات الكراهية تلزمه أيضاً خبرات الحب، سواء تلك التي يعيشها هو أو التي يعيشها المحيطون به.
ما الذي تضيفه الصحافة إلى الروائي وما الذي تسلبه منه؟
ـ في بداية حبي للكتابة كنت أظن أن الكتابة الأدبية والصحافة مهنة واحدة، ولذلك لم أتردد في دخول كلية الإعلام، وأنا علمي رياضة، لكن اكتشفت أن الصحافة مهنة خطيرة على الأدب جداً ولكنها لن تكون خطيرة إذا تعاملت معها بحكمة.
وقد عرفت مبكرا أن مصيري أدبي، أكثر منه صحفياً، وأخطأتُ خطأً واحداً في البداية ولم أكرره بعد ذلك، هو أنني أصدرت أول مجموعة قصصية لي “حدث في بلاد التراب والطين” 1992، ثم انتظرت خمسة أعوام لأصدر “مدينة اللذة” 1997، لم أكرر هذا النسيان لكينونتي الأدبية، واكتشفت أن الصحافة مثل النمر إذا توازنت على ظهره سوف تنجو وستكون مفيدة.
الصحافة مثلا، تُعلِّم الكاتب الوصول إلى ما يريد قوله بأقل الكلمات الممكنة، وأنا أقصد الصحافة التي تعلمتها ولا أقصد صحافة هذه الأيام، فهي تعلمك الوضوح والدقة، والسرعة، وهي القيم التي تناسب الألفية الجديدة، والوضوح يعني أن تكون الجملة واضحة في معناها اللغوي، أي بكلمات بسيطة، كيف تكتب نصاً لا يكون مثل مرآة مهشمة تعطيك صورة مشوهة، الدقة في وضوح العبارة وحلاوة اللغة وليس في انكشافها او تسطيحها، لأن الوضوح لا يستدعي الضحالة. واللغة البسيطة تستطيع أن تحتضن مستويات من الظلال.
الصحافة في المقابل، يُمكن أن تسلب عمر الكاتب، لأنها تحقق قدراً من الرضا الزائف عن النفس، وهو رضا معنوي وغير معنوي، خصوصاً عندما كنت أكتب في جريدة توزع مليون نسخة يومياً، شيء مرضي جداً الاستنامة إلى هذا الرضا وهو خطر كبير من أخطار الصحافة، والخطر الأعمق والأهم أن الصحفي الجيد يقاس بسعة صلاته مع الآخرين واتساع أجندته التليفونية، ولابد أن يكون مدفوعاً إلى الخارج، بينما الأدب يريدك ملموماً على نفسك وجواني وداخلي ومعتزل، هذا الاندفاع إلى الخارج هو أكثر ما يستهلك روح الكاتب، وأكثر ما يسطح نصه الأدبي.
ـ أحببت كتاب “غرفة المسافرين“، وهو لعبة أخرى جميلة منك مع الكتابة؟ هل يحتاج الروائي أحياناً إلى استراحة من الحكي؟
ـ اختبرت تلك الاستراحة ووجدتها مريحاة، يمكن لكاتب آخر ألا يجد ذلك الشعور، محمد البساطي مثلاً لم يزاول شيئا غير الكتابة الأدبية، حتى عندما جررته إلى كتابة شهادة عن طفولته تحولت إلى رواية “أوراق العائلة” (وكان يريد أن يهديها لي، لكن دار الهلال كانت لديها تقاليد في الإهداء، بسبب إهداء تسبب في مشكلة). هناك كتاب لا يطلبون الاستراحة من الحكي، أنا الحقيقة روحي بتطلب هذه الاستراحة..
عفواً لديك استراحات أخرى من الحكي في غير “غرفة المسافرين“؟
ـ طبعاً “غرفة المسافرين” تنتمي للخط الذي بدأ مع كتاب “الأيك”، و”كتاب الغواية” كل منها ينتمي إلى موضوع أساسي هو الولع بالقراءة، متعانقًا مع موضوع آخ: الحواس، السفر، هاجس الخلود.
سمها استراحة أو مقدمة للرواية، هي كتابة تشبه فعل “الإحرام قبل الحج“. منذ وقت مبكر اعتبرت الكتابة الصحفية نوعاً من التمهيد للرواية، بمعنى أنني كائن إلى حد كبير سياسي، ولدي معرفة ببعض الأشياء ومنها الزراعة بشكل تفصيلي جداً، وأريد أن أقول رأيي في قضايا، وهذا ما أفعله في المقالات حتى لا أثقل الرواية.
تساعد المقالات على التخلص من الصوت العالي عندما أجلس لكتابة النص الأدبي، بأنك إذا كنت أديت ما عليك وقلت كلمتك في مطبوعة كانت دائما مشهورة، من الأخبار إلى المصري اليوم والقدس العربي والحياة اللندنية. إلى جانب الكتب العابرة للنوع من الأيك إلى “غرفة المسافرين” وأيضاً “العار من الضفتين ـ عبيد الأزمنة الحديثة في مراكب الظلمات“ هذه الكتب حققت لي قدراً من الحرية، ويخرجني من قيود النوع الروائي، وأقول فيه تأملات أو أفكار تقرب من الفلسفة الظاهراتية، أنا أحب الفينومينولوجيا وأشعر أن الحواس هي مدخل مهم جدا للمعرفة، وبالتالي هذه الكتب تتخلص من الأفكار الكبيرة ومن الخطاب السياسي المباشر، وتتخلص من القيود التي يفرضها النوع الأدبي، كل ذلك حتى لا تكون الرواية تخليصاً لثأر شخصي أو سياسي، أو استطراداً فكرياً خارج الحدث.
أنت روائي.. كيف ترى عبارة “نحن نعيش في زمن الرواية” وهل تتضمن انتقاصاً من الشعر؟
ـ أولاً هذه المقولة وصلتنا متأخراً جداً. حينما وصلت إلى أسماع الدكتور جابر عصفور مقولة “زمن الرواية” كان العالم قد غادر، لكن ـ بعيدًا عن سطوة جملة تبدو شعارًاـ فالرواية زمانها مستمر منذ سرفاتنس. هي فن الزمن الحديث ومقرؤيتها أعلى من الشعر، يعني أن تأتي وتضع بداية ونهاية لزمن وتقول هذا زمن الرواية فأنا لا أعتقد في صحة ذلك.
منذ ظهرت الرواية بشكلها الحديث وهي في المقدمة، وتعيش زمنها من أول أيامها، ولو قمت برصد أعداد دواوين الشعر التي سببت احتجاجات في أوروبا مثلاً لا يذكر بالنسبة إلى عدد الروايات التي أدت إلى نفس الأثر، فالرواية عموماً فن جماهيري، والشعر هو فن الخاصة، ولا ينبغي التضحية بفن الخاصة لصالح الفن الجماهيري، وبالتالي على دور النشر أن تلتزم بحصة صناعة الثقافة في عملها، وينبغي على الدار أن تنشر بين وقت وآخر ديوانًا وهي تعرف أنه سيخسر، لكنه سيضيف إلى المكانة ورأس المال الرمزي للدار.
الشعر ضرورة ثقافية ينبغي ألا تدهسها مقولة زمن الرواية.
……………………..
*نقلاً عن مجلة “الثقافة الجديدة”، أكتوبر 2020