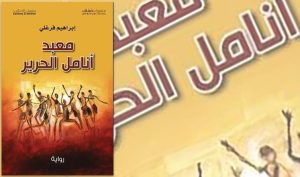عبدالرحيم طايع
لم تكن الأشهر الستة الأولى من العام 2019 سارة قط، بل حملت أيامًا محزنة للغاية كان من بينها يوم العشرين من فبراير الفائت، لأننا فقدنا فيه أديبًا كبيرًا له خصوصيته فى أدبنا المصرى المعاصر ومن ثم العربى، هو الروائى والقاص الأستاذ حسين عبدالعليم، صاحب الأعمال البديعة الرائعة، التى من أبرزها: فصول من سيرة التراب والنمل، رائحة النعناع، بازل، المواطن ويصا عبدالنور، سعدية وعبدالحكم وآخرون، موزاييك، زمان الوصل، مهر الصبا الواقف هناك. وجميعها صادرة عن «دار ميريت» للنشر، التى يملكها الناشر المهم محمد هاشم. كان العمل الأخير الذى صدر بعد وفاته عن الدار نفسها: أعمال قد تنتهى بما لا يحمد عقباه.
مات الرجل الذى عمل بالمحاماة بعد تخرجه فى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، قبل أن يكمل مشروعه الفذ فى الكتابة، مات فى سن الستين بأحد مستشفيات القاهرة بعدما أصابه فشل كلوى حاد فى الأشهر الأخيرة من حياته، وشيعت جنازته من مسقط رأسه ببلده الفيوم، ولم تصاحب موته ضجة إعلامية يستحقها قلمه النابغ؛ لأنه كان قليل الظهور محدود العلاقات لا يبالى سوى بالإبداع نفسه. فلا يهتم بتوقيع كتبه ولا يحرص على الترويج الإعلامى لها، وليس من رواد المقاهى الثقافية وليست له شلة أدبية كمعظم المشتغلين بالأدب.
أمثاله جديرون بتقدير جهودهم، بل هم الأولى بذلك؛ لأنهم يعيشون ويموتون مخلصين للمواهب الكبرى التى حباهم الله بها ولا يتعالون على الخلق البتة، ولا يتكالبون على الجوائز كتكالب الآخرين عليها، ولا يسعون إلى مجد شخصى ولا ثراء عظيم ولا شهرة طاغية، إنما يسعون سعيًا حميمًا صادقًا هادئ الأنفاس إلى تحقيق أحلامهم الغالية، التى جلُّ ما تتمناه حروفها المنضَّدة الألمعية، أن تبنى مجتمعًا جديدًا وافر الحق والخير والجمال عبر مكاشفة الواقع بأزماته والضغط على جراحه؛ لينتبه لها ويداويها قبل أن تتفاقم لا لينزف الشكوى ويتألم طبعًا.
ينتمى الراحل إلى جيل السبعينيات الأدبى بمصر، وتميز باللغة المتداولة الحية، وبالإيجاز البلاغى المدهش، وبالقراءة العميقة للواقع عبر صور فنية مغايرة، وباعتماد موضوعاته على التاريخ كمنبع للسرد ونسج الحكايات، كما يضعه فى مقدمة الصفوف كونه لم يسقط، من أية جهة، فى شرك راوٍ ولا قاص من العمالقة الذين سبقوه والبارعين الذين جايلوه. ابنته مريم لها مجموعتان قصصيتان هما «غزل السحاب» ٢٠١٢، و«سِرُّ السُّكَّر» ٢٠١٨، صادرتان عن الدار نفسها التى تبنت نشر أعماله القيّمة، وهى خريجة تربية موسيقية ودرست سيناريو بالمعهد العالى للسينما، وقد أدرك والدها مجموعتيها، كما يظهر من تاريخى نشرهما، ورفعهما بيديه بين كتبه فى مكتبته الخاصة كمن يمنحها صك التفوق بجعلها جواره فى المكان العالى معناه، وكمن يراها مكافأة الصبر وعنوان الرضا، وعزاءه فى المشوار المضنى المهلك، وللأمانة هى قاصة متفردة، لا تشبه أباها ولا الآخرين، والبادى أن مستقبلها الأدبى والفنى بالغ الإشراق، وقد قالت عن أبيها يوم تأبينه فى مارس الماضى «نقلًا عن الشرق الأوسط»: كان يتعامل مع الحياة ومشكلاتها بسلاسة مدهشة، وهذه السلاسة انعكست على كتاباته، وظهرت واضحة فى رسم الشخصيات وعوالمها، وعرض تفاصيل حكاياته، والنقلات الزمنية بين الأحداث، وهذا يتجلى مثلًا فى روايته «رائحة النعناع»، وأشارت إلى دوره كأب ومبدع فى تحفيزها على الكتابة، ودفعها للاستمرار فى الإبداع، ونصائحه لها بأن تتحلى بالدأب والاهتمام بالتركيز والحرص على العمل القصصى.
سيرته، بجملتها وتفاصيلها، هى بيان حالة كافٍ وافٍ بسِيَر أعداد من الأدباء الراسخين المتميزين الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الرعاية والعناية ما داموا أحياء، ولا يعرفهم الأكثرون معرفة حقيقية شاملة إلا بعد وفاتهم للأسف؛ فبعدها يعلو الذكر، ولو قليلًا، عما كان، ويدخل فى مضمار مديح الفقيد ورثائه الباكى داخلون كثيرون من المتسمين بالإنصاف، وأيضًا ممن يجدونها فرصة لتلميع نجومهم المنطفئة بإلصاقها بالنجم الزاهر الذى منح غموضُ الموت ضياءه ألقًا مضاعفًا.
أخيرًا، أقترح على وزارة الثقافة جعل إحدى الدورات التالية من مؤتمر أدباء مصر على شرفه، كثناء بسيط تقدمه الدولة المصرية لواحد من مبدعيها النبلاء، عاش مهضوم الحقوق، وأقترح على محافظ الفيوم تشريف أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة باسمه أو باسم عمل له مع لوحة تعريفية به للعابرين.