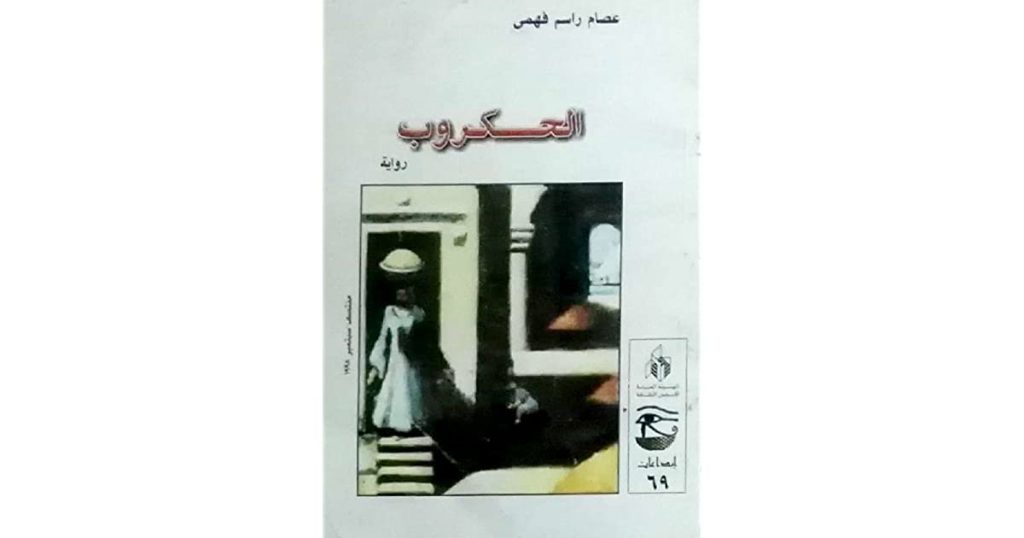ممدوح فرّاج النّابي
في عام 1993 هاجمت قوات الشرطة مسجد “الرحمن” في مدينة أسوان جنوب مصر، حيث كان المسجد – في تلك الفترة – ملاذًا للجماعات الإرهابيّة؛ هاجمت قوات الأمن المسجد عَقب إنذار مَن به عبر مكبرات الصوت بالخروج وإخراج الأسلحة، ليأتي الردّ من داخل المسجد بالأسلحة الآليّة، وتقوم القوة الأمنية بالقضاء على كل مَن كانوا بالمسجد والقبض على الشيخ خالد القوصى، الذي حُكم عليه بالسّجن 15 عامًا (تزوج خلالها داخل السجن وأنجب أبناء).
في الحقيقة أن هذه الأحداث التي وقعت مبكّرًا في الصعيد، كانت إنذرًا مبكّرًا للسرطان الذي استشرى في مناطق عديدة، ولم تلتفت إليه أجهزة الأمن، ومن ثمّ كانت الكارثة في عام 1997 في الأقصر، الشهيرة بمذبحة الدير البحري، والتي راح ضحيتها 58 سائحًا من جنسيات مختلفة، وهو ما كان له تأثيره السَّلْبي على السِّياحة المصرية التي لم تتعافَ إلى الآن.
ما علاقة رواية “الحكروب” لعصام راسم فهمي، بما سبق؟ في الحقيقة الرواية كانت إجابة عن سؤال مهم: لماذا نشأت البؤر الإرهابية في الصعيد؟ وهو الأمر الذي لم يلتفتْ إليه أحد، خاصّة أن الرِّواية تعاملتْ مع مجتمع الحكروب على أنه مجتمع موازٍ لمصر، أي صورة مُصغّرة للمجتمع الأكبر. وكان العامل الاقتصادي بمثابة العامل الأساسي في هزائم شخصيات الرواية، مثلما هو العامل الأساسي لكلّ عقبات التأخّر التي يُعاني منها المجتمع الأكبر.
سيرة مكان
صدرت رواية “الحكروب: أوراق اعتماد شخص” بعد عام واحد من مجزرة الأقصر، وإن كانت أحداثها تشير إلى أنها مكتوبة في منتصف التسعنينات، أي في ذروة توحش الجماعات الإرهابيّة. وهي أوّل عمل روائي للمؤلف الجنوبي (من الحكروب – بأسوان) عصام راسم فهمي، صدرت الرواية في طبعتها الأولى عن الهيئة العام لقصور الثقافة عام 1998.
عصام راسم فهمي من مواليد 1966، ربما هو اسم غير متداول في الأوساط الثقافية مع أن له أعمالاً مهمةً؛ قصصية ورائيّة، وأيضًا له تجارب في السيناريو. ومن هذه الأعمال: “الحكروب” 1998، “رقص أفريقي” 2002، “ضجيج الذاكرة” 2003، “هدنة مؤقته” 2016، وأخيرًا “عقاقير محرّمة” 2019، ويبدو أن ثنائية المركز والهامش، ما زال لها تأثيرها الفادح على بعض الكُتّاب، وعصام واحد منهم، وإن كان هناك مَن استطاع أن يُحَطِّم هذه الثنائية بقوة حضوره داخل المشهد الإبداعي المصري والعربي، ولكن يجب أن نضع عواملَ أخرى ساهمت في هذا الانتشار، إلى جانب الموهبة، وهذه الأسباب لا داعي لذكرها هنا.
صدرت للرواية طبعة ثانية عام 2015 عن دار (كتب الجنوبي) التي يُشرف عليها الفنان التشكيلي محمد الجنوبي، وصدرت بسعر زهيد جدًّا (3 جنيهات)، وإن كان المشروع توقف لأسباب غير معلومة لنا على الأقل.
الحكروب اسم جبل، وقد صار منطقة تجمعات سكنيّة تقع في شمال شرق أسوان، نشأت بعد بناء السّد العالي، تخصّ هذه المنطقة العمّال الذين بدأوا يبحثون عن عمل في نطاق السّدّ العالي، وبعضهم عَمِلَ في السَّدِّ العالي فعلاً. هي أشبه بمنطقة عشوائية من تجمعات مختلفة لأناس عملوا في هذه المنطقة، ولم يستطيعوا أن يعودا إلى أوطانهم. يعيش السُّكان على قمة الجبل، وإن كانوا يمثّلون قاعه بالمعنى الحرفي لمصطلح القاع. وهي في الأصل منطقة جبلية، تتميّز بجبالها الصّخرية يحتضنها الجبل كما وصفه الرَّاوي: “كان مفروشًا وصاعدًا بحسم إلى فوق، وبيوته في حضنه، والعمارات القليلة، التي طلعت في أنحائه على استحياء“. حتى “ترعة كيميا تبدو كـ “حزام أسود قاسٍ يحيط به ويمنعه من التمدد أو الاسترخاء” (ص 63)، وهو ما كان له انعكاسه على سكانها، وهو ما سنلاحظه في الرواية بإطراد. لكن ثمة علاقة طردية بين الحكروب وناسه فكما يقول :” فنحن نعطيه صخب الحياة، ونخرجه من جموده الأزلي” في المقابل هو يمنحهم “حضنه الصخري الواسع، ليحمينا من مؤامرات الغيب، أحيانًا تحدث بيننا وبينه خصومات عندما نضربه برذائل أفعالنا، فيثور ويرمي علينا من فوق قمته سيولاً جارفة تهدمنا وتهشم ما فعلناه منذ سنوات، نعود ونتصالح فيتركنا نصعده مرة أخرى، ويساعدنا على إبطال قانون الجاذبية ويقبل أفعالنا.” (الرواية، ص27 – 28)
وهناك رواية أخرى تفسّر نشأة الحكروب، وهي مروية من قبل الأم بالطبع، هي رواية أسطورية تأتي من منظور تصلّب بنية الوعي هناك، تقول الرواية إن: “الحكروب في الأصل امرأة كبيرة، خلقها الله لرجل كبير، ولما مات رجلها، حزنت المرأة ويبست وتسربت دماء الحياة من عروقها وتحولت إلى جبل بغير روح، وقالت إن جدتها كانت تحكي لها عن موت الرجل الكبير، وكيف تهاوى وانقلب إلى ماء هارب في تجاويف الأرض” (ص، 133).
أما الأم فقد وصفت الجبل بـ”امرأة كبيرة، باركة ومؤسِّسة في الأرض، ومنكسة الرأس، وتلم مفاتنها البارزة بحدة بملاءة سوداء” (ص، 162). وقال جمال عن ناسها: “في الحكروب ناس غلابة كثيرون وناس أوباش قليلون“ (ص، 207). رَبَطَ الكاتب بين الحكروب كتجمّعٍ سُكاني موازٍ للأم الكبرى مصر، في أكثر من موضوع هكذا: “الحكروب دنيا صغيرة“(ص، 69)، وفي روايته “هدنة مؤقتة – كتاب الحكروب” (2016) عاد إليها وصفها هكذا: “الحكروب: يا جماعة دنيا صغيرة، ونموذج بالكربون للبلد الكبير الذى نعيش فيه، هو دنيا مغلقة علينا، ومفتوحة على كل الاحتمالات الكبيرة “(ص 167).
يرصد الراوي تفاصيل المكان وكأنه يُسَجِّله ويحفظه من الاندثار، فتطرد الكثير من الأماكن مثل: الحكروب وترعة كيميا، وميدان الحنفية الكبير، ومسجد الطابية. ومقهي أم كلثوم.
الحكروب تعد الجزء الأول من مشروع عصام راسم عن المكان، فقد أصدر بعد فترة طويلة عن الجزء الأول، رواية “هدنة مؤقتة – كتاب الحكروب” واستكمل الانهيار الذي لازم المكان خاصة بعدما عملت يد الدولة على تقويضه بالكامل، باتباعها سياسة الخصصة، وبيع مصنع الثلج والأسماك ، وهو ما كان سببا لطرد الكثير من العمل ومنهم جمال، وبالمثل طرد الصيادين من بحيرة ناصر.
أبطال نبلاء في الزمن الرديء
الرواية تحكي عن هزائم متتالية لأبطال الرواية؛ جمال يوسف وأصدقائه. تكمن مأساة جمال الحاصل على دبلوم الصنايع قسم السيارات، في أنه فشل في العثور على عمل حقيقي يكسبه احترام أبيه، فهو مع الأسف فشل حتى في العمل في مصنع الثلج، فقد تركه بعد أن افترسه “ألم الكتب والذراع” وصار “مُتعطلاً” وهو ما كان سبب أزمته مع والده، ثم يفتح مشروعًا تجاريًّا بتوريد الأغذية للفنادق والمنشآت السياحيّة، لكن موت صديقه صلاح محمد إسماعيل، يجعله يغلق المشروع.
أما أزمته الكبرى فكانت في فشل قصة حبِّه لهالة ابنة خاله صالح، التي كان يعشقها لدرجة أنه كان يتمتم في سره: “فقط كنت أحبّها، ولم أصنع لي أو لكم خطيئة، وهالة طاهرة كالثلج”. كانت تعمل في محل ملابس، كان يتشمم رائحتها حين تهلُّ. وكلما مرتْ أمام مقهى أم كلثوم “تهز قلوب الرجال“، لكن هم لا يعرفون أنها مريضة “بداء التنيا“. كانت هي “ملاذه“ عندما يطرده أبوه، فهي تصالحه على الشمس والقمر، وتخرجه من خلوته وتحرّره من سلاسل الوقت وتحيله إلى “مخلوق مائي لا يدوسه الزمن“. وهي “سلوته” عندما فقد صلاح؛ حيث كانت تأتي إليه “عذراء جميلة”، وما أن تطوقه بيديها المفرودتين، حتى ينسى “همومه الخاصة وفقد (ه) لصلاح” وأيضًا هي جنته التي عندما تتجلّى له يقطف من ثمارها الدانيّة (ص، 108)، دائما يستحضرها في الغرفة، ودائما “هالة ترفض التجلّي“. لكن الفقر فرّق بينهما، كانت كنبية تشعر بأنهما ليسا لبعض، قالتها مرارًا، “احنا مش مقسومين لبعض …عارف!!؟ (ص، 164)، وهو ما أكده أبوها عندما قال لأمه: “إن البنت والولد ليس لبعضهما” فتزوجت من نصر العتطجي.
في نهاية الرواية يقرُّ بأنه ملوّث لا يصلح لهذه “البنت الطاهرة كعرّافة“. نعم، مَن يتأمّل مسيرته يكتشف أنه زير نساء؛ شهواته لم تردعها أنساق أو صلات أقارب وأصدقاء وإنما كان كالحيوان الهائج، أفرغ شهوته في كل بئر مفتوحة دون أن يضع حسابًا “مَن صاحب هذه البئر“.
بعد خلافه مع أبيه يطرده الأب، وفي هذه الطردة الأخيرة ضاع كل شيء: مرض الأب واستشرى فطر التنيا في البنت الحلوة هالة، واكتسح هدوءها، وجعل القلق الجميل يستحيل إلى ذعر. كما صار له دوسية وفيش وتفتيش، ورحل مسعود بعد أن زوّجَ أخته وداد، ولم يعد له أحد يجلس معه.
تتكرّر مأساة الحبّ والفجيعة مع منصور الذي تزوّج واحدة غريبة، بعيدة عن أنساقهم، كانت تخونه مع الرجال، فتركته وهربتْ، وإن كان ادّعى أنه قتلها انتقامًا لشرفه. وبسببها أهمل حياته وعقله. يلتقيها جمال في المحطة مُعلّقة يدها برجل يرتدي جلبابًا صوفيًّا، فلقد “لقيت محطة لإبحارها المجهول النهائي“. ظلت الرائحة التي عثر عليها في البيت، تؤرقه حتى عرف مَن صاحبها، وفي جلسة السمر كاد أن يقتل عبد الوهاب، لأن رائحة الزفر كانت رائحة السمك.
كانت مأساة جمال كبيرة في وفاة صلاح محمد إسماعيل، الفنان والمفعم بالأمل والبحث عن الجديد في وَسَط القبح، لكن هزمه الفقر. كان صلاح ضمن فلسفته أن الجديد يَفْرِضُ سطوة التغيير على الأشياء، وقال إن الجديد يكمن عنده في السفر” فالحكروب أصبح لها ألفة باردة، أما السفر الذي يحلم به فسوف يعطي حياته لمعة ودفئًا يحركه للأمام” لذا كما قال “لازم أسافر” رغبة في التجديد و”من القاهرة سيركب سفينة ستحمله إلى مقصده“. ومن أجل هذا المقصد باع كردان أمه، ودراجته واستلف من عبد الوهاب صديقهم مُهرب السمك، ورحل إلى البلاد. وما أن وصل حتى ضاعت حقيبته، واستطاع أن يعوّض ملابسه، لكن العمل لم يكن جيدا، وَفقًا لنظرته في الحياة، فعندما أرسل خطابًا لجمال قال: “أُعرِّفك أن هنا لا حلو، ولا وحش، والحياة مش سهلة، لكن مفيش مفر” (ص، 74).
يعود دون حقائب أو هدايا أو حتى بحكايات المسافر، عاد إلى الحكروب منعزلاً “بصمت منعه من طهارة البوح“. فـ”هجر ألوانه، ووجوه الناس التي كان يقرأها باستمتاع، وتدثر بغموض وأسى وغضب ليس لهم من نهاية، ورجع لمحجر الجرانيب وكتب اسمه من جديد في دفتر 79 اليومية كعامل“(ص، 80) لقد كُسر كسرًا موجعًا “يجرح الوجود وكرامته” كما رأى صديقه جمال، هذا الكسر جعله إذا لمسه ينتفض مذعورًا ، وبعد شهور من هذه العودة الغامضة، انزلق بين حجرين من الجرانيت ومات “في محجر الجرانيت“. وقد أدركها قبلها أن الراحة كذبة ملفقة في أقوال الناس، وأن هناك مثل هنا”
آباء وأبناء
تميزت الرواية بالحوارات الفلسفيّة التي تكشف موقفًا وجوديًّا من أزمة الإنسان، ولنتأمل ما دار بين صلاح وجمال عن رؤيتهما للحياة. أو حوار جمال وهالة عن الحب وتأكيده بممارسة الجنس. صلاح الذي مات وهو يجتر مأساة فقره، كان يرى الدنيا نظيفة وحلوة، وإنها “حادثة جميلة وقعت، ولكننا نحن الذين قبحناها بصنيعنا، وكل النظم القائمة والتي ستقوم فيها ما يكفي من وساخة، ولم أُصَدِّقه”.
أما نظرة جمال فكان يرى الحياة كأنَّها “وجدتْ لتجرحنا بضعفنا، ولتحاصرنا بما هو خارجنا، وبما يتخلق فينا من احتياج وفرح وخوف، وكان يجب أن تكون بشكل آخر، أو نحن نخلق بهيئة أخرى” (ص، 68).
- فالدنيا فرن كبير ونحن فيها وقود. أما مسعود فيقول إن نار هذه الدنيا: “تنبعث منا، ولا تملك الدنيا أن تحرقنا دون أن نعاونها في ذلك، فبعضنا يصهر الآخر، والله العظيم هذا ما يحدث بالضبط يا صاحبي”.
أحلام بعرض الأرض للفقراء إلا أنها مُهْدَرةٌ على أرض الواقع، فالضمراني صاحب القهوة، يحكي لجمال عن مستقبل ابنه، ويتساءل هل الطبيب أفضل؟ أم المهندس. أم الضابط؟ الغريب أن الطفل الذي يتحدث عنه ما زال يحبو، إلا أنه كما يقول الضمراني “طفل مختلف عن بقية أطفال العالم”، تنتهي هذه الأحلام على يد الإرهاب الأسود في صورة جمعة الأعور، فقد تربص به وقتله، ووجدوا جثته ملقاه في الترعة.
تكشف الرواية في جزء منها، عن العلاقة بين الأباء والأبناء، في الجنوب، علاقة مختلفة لا مثيل لها، فالأب لا يظهر مشاعره لأبنائه، إلا أنه يحزن لإخفاقهم، علاقة جمال بأبيه المتوترة نموذجًا لافتًا؛ إذْ تتراوح العلاقة بين خوف وسخط على الابن تنتهي بالتعدي عليه، والبصق عليه وطرده، ومع حالة الأب حيث يمور داخله “كما تمور الفرن حزنًا وغضبًا على مصير ابنه وإخفاقه”، ومع كل الصراعات بين الطرفين، إلا أن جمال يحترمه ويخافه، ولا يستطيع أن يدخن أمامه. فجمال يصف هذه العلاقة الإشكالية قائلاً :
– “أنا حُلْمٌ انهد في دماغه من زمان، هو لا يفصح لي عن هذا… غضبه الدائم على يقول ما لا يقوله الكلام، ربما يكرهني لكنني متيقن أنه يكره إخفاقي، عيناه الكليلتان تتهمانني وتلومانني… هو لا يعرف لماذا يصيبني الإخفاق… لا يعرف! لكنني أدرك أن نصف ما أنا فيه قَدِمَ إليّ من الخارج والنصف الآخر صنعته بيديّ.. انتظاره الدائم لأفعالي التي لا تتم يجعله يمل الانتظار ويملني، في عينيه رجاء أفهمه، في صمت صراخ يصم أذنيّ” (ص، 103).
في الطردة الأخيرة، بعد أن أغلق الأبُ البابَ في وجهه، شَعَرَ جمال وكأنّ غلقة الباب “قفلتْ كل أبواب الدنيا أمامي” بل أن هذا الإحساس يتنامى ويلازمه حتى كاد أن يطغي عليه:” وخنقتني المباني العالية والدكاكين المفتوحة، ونظرات الناس المستفسرة.. طرقت الباب ثانية فتحت أمي. كانت حائرة وأخواتي مبعثرات حولها، تطل من عيونهن الضيقة الدهشة صدورهن المتهدجة تنفث رائحة الخوف“.
لكن الأب يطارده بظله المنتصب، وعندما يشعرُ جمال برجولته المُراقة وبالبنت الملفوفة حول إصبعه. وكان يحسُّ أنها تبتعد عنه “كلما توتر” هنا تُشَلُّ أفكار جمال ولم يعد يحتمل فيندفع “الدم الفائر إلى رأسه” وانخرط في فاصل “سبٍّ طويل لليل الثقيل الفاصل بيننا، وللأشياء ” وتصيب الأب قذائفه أيضًا، فيلعنه مثلما لعن الأشياء. لم يجد الأب وسيلة إلا أن يبلع ثورته ويتراجع للوراء “رجع منحينًا كساق الكافورة الواقفة في بيتنا، ومهتزًا كأشجار السيسبان الخاوية والتي تكسرها الريح وترميها في الخلاء. زاد انحناؤه ، وقال تمتمته الغامضة قبل زيارة غيبوبة السكر له. ومع كل ما حدث بينهما: تمنى “أن أسرع إليه وأحمله إلى سريره لكن حيطان بيتنا القديم سبقتني إليه وسندته حتى وصل إلى باب البيت، فلتسامحني أنا الخاطئ يا الله وأغفر لأبي”.(ص، 105)
في المجتمعات الهامشيّة التي تتكوّنُ على هَامِش المُدن، ثمة تيمتان متكررتان، الأولى الجنس، والثانية التطرُّف. هنا الجنس مكتوب بلغة بعيدة عن الإسفاف، بل مرمزة، يقدم كل العوامل التي آلت إليه، وكأنما يبرره، أولها الحرمان كما في بهية زوجة خاله الأصغر وصفي، فالزوج عقيم ومريض بالسرطان، وربما كانت نبرة التسامح التي تعامل بها في أزمته معها تفسر أنه يرجع هذا المصير، الذي انزلقت فيه الزوجة كان ناتجا عنه، وفي الحقيقة مع هذا التبرير، إلا أن هذه المجتمعات لا تتعامل مع هذا الموضوع بذات الطريقة، ومن ثمّ كان التسامح نشازًا. وما يدخل مع هذا العامل غياب الزوج كما كان مع نادية التي هي “في حمرة التفاح الأمريكي تارة وتارة في طراوة أرغفة الخبز التي تخبزها أمي وتبيعها للناس“، فالسبب يرجعه جمال إلى أن زوجها “يتركها ويسافر”، ويتذوقها جمال. وهذه البيئة العشوائية مرتع خصب لجنس المحارم، كما فعل جمال مع زوجته خاله وصفي، وجمال مع صديقه الضمراني، عندما رأها بعد العثور على جثته، وعبد الوهاب مع زوجة صديقه منصور. وعندما يتعرف الراوي جمال على زوجة الضمراني يشعر بالخيانة، فيخاطبه، وكأنه يأنّب ذاته:
– “هل كرهت الحكروب وأنت تنفض الدنيا من عينيك؟ وهل أحببت موتك أكثر منا يا رجل؟ وكيف يا شهم لم تدافع عن حسن ابنك؟”(ص، 241).
- لما لا وكما يقول الراوي الأنا فالشباب في هذه المجتمعات العشوائية بلا عمل و“غارق في الحشيش والبانجو وشرائط الفيديو”(ص، 195). لكن لا يعني هذا أن علاقات النساء متحلّلة، فالعكس صحيح، فهالة رفضت أن تكشف صدرها للطبيب فقالت: “كيف تعري صدرها للأجهزة الكهربائية كي تعالجه من الفطر”.
أما الظاهرة الثانية، فهي التطرف، وقد صوّر الراوي تناميه عبر شخصيتي جمعة الأعور ودجلة، وتربصهما بالناس في الشارع، ثم هجمتهما على غُرْزة الضمراني، لكن توسّع الأمر بما فعلاه من تفجير كنيسة ماري مرقس بالسيل الريفي، ثم تحوّل منصور إلى جماعة جمعة الأعور والاثنان تغيرا؛ منصور لم يعد باقيًّا منه غير جسمه الكبير، وجمعه كما يقول الراوي “لم أعد أعرفه إلا من عينه المفقوءة التي فرقعت في إحدى معاركه القديمة التافهة”، انتهاء بأحداث مسجد الرحمن.
على مستوى اللغة، تذكرنا لغة الرواية بعفوية وشاعرية لغة يحيى الطاهر عبد الله في “أغينة العاشق إيليا” يكفي أن نقرأ هذا المقطع: لنرى جمال اللغة، وإنسيابيتها، وتعبيرها الحي عما يختلج النفس:
- “هذه البنت أحبها لأنها تشاركني تشردي وضيقي وتنتظر معي عندما لا أجيد إلا الانتظار.. تذمرها يأتي من طول بعادنا، ومن اختلاسنا لوقت هنائنا خلسة… والبنت والحلوة هالة التي أحبها تصالحني على الشمس والقمر وتخرجني من خلوتي وتحل سلاسل الوقت من حول معصمي وتحررني من الدقات وتحيلني إلى مخلوق مائي لا يدوسه الزمن، وتحررني ونصعد بالروح إلى فوق ونتكامل ضد الفرقة والجدران والزمن، أحلى خروجاتي تصنعها لي هالة ، ثم أمي “.( ص، 106).
وبالمثل حديثه عن النيل يأتي هكذا:
- “ولكنه النيل سيدنا وسيد المكان، فحين يبارك عمل أيدينا، ترضى الأماكن وتلين وتعتادنا ونعتادنا ونتفق معًا… إن النيل أيها الناس سيدكم وسيد الناس أجمعين، وله عليكم…”. ويتمثّل هذا الخطاب خطابًا شفاهيًّا، يعكس ملامح المكان في البيئة الجنوبية، فالرواي ينتقل من الخطاب الكتابي إلى خطاب شفاهي، حيث يتحدّث إلى جمهور يستحضره ويخاطبه: بـ”أيها الناس”، كما يستحضر هوية المكان عبر لغته المميّزة كما في خطاب الأم لابنها جمال “عامل إيه يا جمال يا ضناي؟” أو باستحضار مفرداته الخاصة على نحو “حُق السُّكّر” والمقصود بها علبة السكر. وغيرها من مفردات تتآخم مع البيئة المنتج فيها النص. كما تتحقق شاعرية اللغة عبر مستوى آخر داخل النص، حيث إطراد الكثير من الأشعار التي تعبر عن ثقافة الإقليم.
أخيرًا، ما زال السؤال القديم يطرح نفسه: هل الأدب بإمكانه مواجهة التطرّف؟ تعددت الإجابات، بل هناك مَن اقتنع بأن التغيير الذي يُحدثه الأدب بطيًئا. ومهما كانت نتائج التغيير، إلا أن الشيء المهم، أنه يحدث وهذا يكفي في ظني.