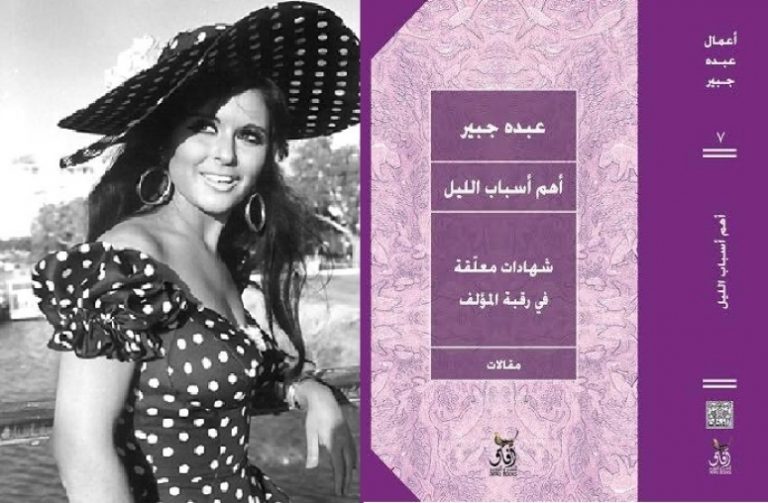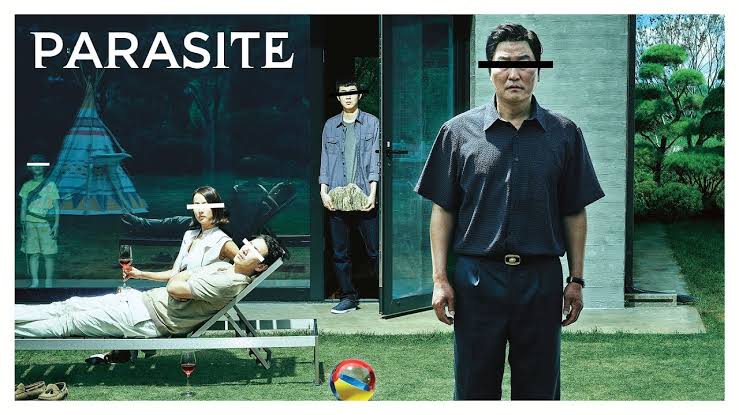مازن حلمي
استطاع المخرج الراحل “أسامة فوزى” أن يحجز لنفسه مكانًا بين كبار المخرجين ببضعة أفلام لا تتجاوز الأربعة، وفيلمًا واحدًا قصيرًا. ما يدحض فكرة الكم، ويجذًّر أصالة وديمومة النوع. هو أمر يدعو للفخر والحسرة في آن واحد. ويثير تساؤلًا بديهيًا: ماذا لو قُدِّر له أن يُخرج مشاريع أخرى للنور؟
“فوزى” ليس استثناءً في حالة السينما المصرية، لدينا طابور طويل لأسماء مخرجين رحلوا وهم يبحثون عن منتج يتبنى أحلامهم، يأتي على رأسهم المخرج الكبير “شادي عبد السلام”. كي نوقف استنزاف مواهب، وأعمار الفنانين القصيرة أحيانًا؛ لابد أن تتكاتف الدولة والسينمائيون في وضع حلول جِذرية لمعضلات صناعة السينما، وتؤمن بقيمة الفن، ودوره؛ إذ بإمكان فنان واحد أن يضع بلاده على خريطة العالم.
وُلد “أسامة فوزى” عام 1961م في أسرة فنية، لأب يعمل في حقل الإنتاج السينمائي، هو المنتج “جرجس فوزى”، وأخوه الأكبر هو المنتج والمخرج “هاني فوزى”. تَخرَّج “فوزي” من معهد السينما قسم الإخراج عام 1984م، بدأ بالعمل مساعد مخرج أثناء دراسته في فيلم “المجهول” مع المخرج “أشرف فهمى”، ثم استمر مع مبدعين أمثال “حسين كمال” و”نيازى مصطفى”. بعد ذلك خاض تجربة الإنتاج مع المخرج “شريف عرفة” في فيلمه الأول “الأقزام قادمون”، خلال تلك الفترة كتب عدة سيناريوهات كانت تلقى الرفض من الرقابة. عاد مرة أخرى مساعد مخرج لكن مع أبناء جيله “رضوان الكاشف- سعيد حامد – يسرى نصرالله” في تجاربهم الأولى. هذا التنوع والتأني أنضج موهبته على مهل.
حتى التقى بالقاص والسيناريست “مصطفى ذكرى” ليحققا معًا فيلمهما الأول “عفاريت الأسفلت” عام 1996م، وقد نال جائزة أحسن فيلم من لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان لوكارنو، واستثمرا نجاحهما، فتعاونا في مشروعهما الثاني “جنة الشياطين ” 2000م على نفس الخط الفني المُغاير. وبعدها ارتبط بالسيناريست “هاني فوزى” في فيلميه “بحب السيما” 2004م، و”بالألوان الطبيعية” 2009م، ثم تعطّل عن الإبداع السينمائي مدة طويلة، يبحث عن منتج لفيلمه الأخير “أسود وردى” دون جدوى إلى أن رحل فجأة عام 2019م قبل أن يكمل طموحه الفني.
يمكن تقسيم عالم “أسامة فوزى” السينمائي إلى مرحلتين: الأولى سينما الفن الخالص، والثانية سينما المجتمع.
كان منشغلًا، في المرحلة الأولى، بتقديم عالم فلسفي جمالي، تملؤه الجدة والغرابة، لم تألفه عين المتفرج بعد، سواءً على مستوى الموضوع أو على مستوى الأسلوب. تمثل ثنائية الجنس والموت بابًا يمكن الدخول منه إلى تلك المرحلة، وعالمه ككل.
في فيلم “عفاريت الأسفلت” ثمة حيوانية، وغرائزية تسم الشخصيات، فالجنس هاجسها الأول، ومحرك دوافعها ونوازعها. تدور في دائرة من الخيانات المتبادلة دون أن تكون محرومة جنسيًا، أغلب الأبطال متزوجون، ولا يعانون من فقر مادى، إنما يتمردون على القوانين والأعراف، ليعيشوا وفق قانون الغريزة واللذة، فيما يشبه الاتفاق الضمني والتواطؤ. بالأحرى: هم يخلقون جنة بديلة بشروطهم، لكنهم يحافظون على شعرة تربطهم بالمجتمع. أي يظل تمردهم سريًا؛ تعبيرًا عن تناقض وازدواجية ما، وعدم قدرة على تحمّل مسؤولية الاختيار. يحضر الموت بتلك الجنة الأرضية لا بجلاله وهيبته، إنما بوصفه شريكًا في فعل الخيانة؛ فاللقاءات تتم بين القبور بلا خشية أو حرمة للموتى. كما تجتمع الشخصيات المتصارعة عند رحيل الجد؛ لتتفق على رفض بيع البيت القديم (مأوى نزواتهم)، فالموت نقيض الحياة، تُطوّعه الشخوص الدرامية؛ لخدمة أغراضها الدنيوية المنحطة.
ما يفعله المخرج هو فضح أخلاق الطبقة الوسطى، وتعريتها على الشاشة دون إدانة أو وعظ أخلاقي. فقط يبرز جانب خفى من النفس البشرية بلا ضجة. يمد الخيط إلى آخره في فيلم “جنة الشياطين”، تقطع الشخوص الجسور مع المجتمع كليًا؛ فالتمرد الجزئي يصير شاملًا، والجنة الخفية تصير معلنة. يتمرد البطل “طبل” على اسمه ووظيفته وطبقته بادئًا حياة جديدة مع الصعاليك واللصوص والمقامرين. هنا يصبح التمرد غاية، وما يتبعه من عبث وتشرد وجنون. إذا كان ملمح الحيوانية لدى عفاريت الأسفلت فعل الخيانات الجنسية، فهم في جنة الشياطين يتحولون فعليًا إلى هيئة ذئاب في مشهد مطاردة العاهرة. إنها حالة من التحرر القصوى. لم يأخذ “مصطفى ذكرى ” من رواية الروائي “جورج آمادو” (الرجل الذى مات مرتين) أبعادها السياسية أو الاجتماعية بل اقتصر على فعل التمرد الوجودي، وشَيَّد من رؤاه الذاتية أجواء عدمية، وحشيّة.
في المرحلة الثانية يعلو صوت المخرج على صوت الفيلم، يبث أفكاره مباشرة للمتفرج متكئًا على حوارات داخلية “مونولوجات” طويلة، ومناقشات فلسفية، واستخدام تقنية الراوي؛ ما يجعلها أقرب للدراما التلفزيونية والبرامج الحوارية.
إن انتهاك المحرمات، وطرح القضايا المسكوت عنها لا ينتج بالضرورة دراما عظمية، بمعنى أن الإعلاء بالمضمون لا يستغنى عن الشكل. بالتالي هي ليست تكملة بل نقيض حالة الشاعرية والجنون الأولى. في فيلم “بحب السينما” يحاول “فوزي” تدمير هيمنة سلطة الدين على مصير الفرد من خلال النقد الاجتماعي الحاد، عبر سيرة ذاتية لبطل من أسرة مسيحية متزمتة يهوى السينما. وفى فيلم “بالألوان الطبيعية” يخصّ علاقة الدين بالفن، ومدى حرية الفنان في التعبير. مما يعكس انحطاط الوعى الجمعي قبل أن يعكس ردة فنان يتأثر بأفكار وظروف مجتمعه، بدلًا من السير في طريق الجمال يتوقف؛ ليتساءل عن جدوى السير ومشروعيته!
تمتاز أفلام المرحلة الأولى بالكثافة الزمنية، فى حين تستغرق الثانية وقتًا أطول نسبيًا؛ ربما لأن طبيعة اللذة والمغامرة قصيرة تشبه الحلم، والطفولة والذكريات الجميلة من الصعب إمساكها، بينما جدران العادات وأسوار المؤسسات الدينية، والاجتماعية، والسياسية تحتاج معارك ومواجهات كثيرة، كي تهدم، أو تحدث ثغرة فيها. مثلما توجد ثيمات متكررة، هناك أيضًا مشاهد يتكرر وجودها منها: مشهد مناجاة البطل للرب ثم سقوط المطر؛ يبحث من خلالها عن إجابات لأسئلة تشغله مثل علاقة المرء بربه، هل يعبده حبًا أم خوفًا؟ وهل الفن حرام أم بعضه؟ وغيرها من الأسئلة الوجودية الكبرى. ربما يسأل المجتمع قبل أن يسأل نفسه. إنه يرتفع من الجسدي إلى الروحي، ومن البشرى إلى السماوي. يظهر ذلك على حركة الكاميرا واتساع المشاهد. من ضيق ومحدودية لقطة المرحلة الحسية إلى مشاهد عين الطائر، واللقطات الواسعة. الشخصيات هناك مشغولة بالخطيئة، فيما هنا مشغولة بالتوبة وطلب المغفرة. هنا جنون الأرض مقابل رحابة وعقلانية السماء.
لا يمكن تصنيف سينماه بالواقعية، هو يمزج الواقعي بالخيالي، يحافظ على جذر واقعى يكاد يقترب من الطبيعية، ثم بقفزة من الخيال ينقلنا إلى عالم سحري متخيل عبر حكايات الحلاق التراثية في فيلم “عفاريت الأسفلت” ضافرًا الاثنين في نسيج واحد. من هذه المراوحة إلى واقعية سحرية في فيلم “جنة الشياطين” حيث يخلق شخصيات غريبة، حيوانية، جامحة لا نستطيع تصديق وجودها أو نفيه؛ محاولًا تحقيق حلم العودة إلى بدائية الإنسان الأول. مرة أخرى يعود إلى واقعية نقدية، مشيعًا أجواء من الكوميديا السوداء والمفارقات الصادمة التي تلائم الطرح دون أن يتخلى على عنصر التخييل، وهو يعدّ علامة بارزة في أسلوبه الفني.
يعتبر شكل الدائرة هو الشكل السردي الأثير لديه، فلا نهايات لحكاياته، فالبدايات تماثل النهايات. إنه يدور في عالم مغلق بقانون العادة والقهر. شخصياته إما مقموعه ومكبوتة لا تفكر في تغيير مصائرها، أو بوهيمية عبثية متجاوزة الواقع. يطمح إلى صدمة المتفرج بمغزى وأسلوب الحكاية، لا بتشويقه وتسليته بتتبع نهاية ميلودرامية أو سعيدة.
رغم أنه لا يكتب أو يشارك في كتابة السيناريو، إلا أنه يقترب من مفهوم سينما المؤلف، فيتعاون مع مؤلفين تلبى رؤاهم نداءاته الفكرية، والجمالية، مترجمًا بلغه بصرية خاصة، وبأساليب حداثية، وموضوعات متكررة تحفٍ سينمائية لا تتشابه أو تتماه مع أحد. بل تدل على عالمه وحده.
أعطي المخرج “أسامة فوزى” نموذجًا لفنان لا يتنازل، لا يهادن، لا ينجرف مع التيار مهما واجهه من عقبات. فنانٌ أحب سينما تعشق الحياة. حاول تقويض سلطات الدين، والجنس، والسياسة، واجتراح طرائق جديدة في السرد البصرى. ستبقى أفلامه باقية في ذاكرة السينمائيين ومحبى الفن السابع.