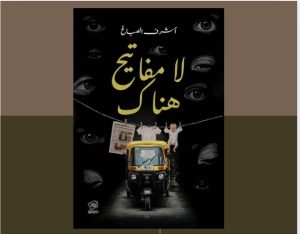سعيد نصر
نتحدث في دنيا العشق عما نسميه “الحب من أول نظرة”، وعلى المنوال ذاته يمكننا أن نقول إنه في عالم الرواية يوجد ما يمكن أن نسميه “الإنجذاب من أول عبارة”، حيث استطاع عمار على حسن صنع هذا في روايته “جبل الطير” حين بدأها، بجملة مدهشة تحدث هزة نفسية وعاطفية فى قلب وذهن المتلقى، تقول: “حين فتح الشيخ سمحان النافذة لم يجد الجبل مكانه”.
فبهذه الجملة استطاع الكاتب أن يأخذ بوجدان القارىء وعقله، ليروح ويجىء مع أحداث الرواية طوال رحلة الشيخ سمحان للوصول إلى مرحلة “حق اليقين”، عبر مروره بمرحلتى”علم اليقين” و”عين اليقين”، وهى رحلة مثيرة يتداخل فيها الواقعى بالأسطورى، وفق سردية تصالح بين العقل والقلب، وبين العلم والدين، تحملها رحلة طويلة جدا تشمل تاريخ مصر وحضاراتها الممتدة لسبعة ألاف سنة، لتقول أيضا إن الهوية المصرية الحالية خليط لهويات متعددة، انصهرت جميعا فى بوتقة واحدة، بفعل النزعة الصوفية المتسامحة، وصارت طابعا قوميا للمصريين.
ينظر “سمحان” من النافذة فلا يجد الجبل مكانه، فيندهش ويرتعد من المشهد المرعب، ويتذكر كلاما كان سمعه من شيخه “عبد العاطى” قبل وفاته، فيحاول إيقاظ زوجته لترى ما يراه، ولكنها تغرق فى النوم وتتركه أسيرا لهذا لموقف المفاجىء، فيسمع صوت ديكة تؤذن وبقرة (علم فيما بعد أنها مبروكة وتحلب وهى عاقر) تعزف بخوارها لحنا مميزا أنساه مشهد مطاردة أبو حذيفة السلفى له ، وهو يصرخ فى وجهه بأعلى صوت “كافر .. كافر”، فيخرج من باب بيته ومعه قُلته للبحث عن سر اختفاء الجبل، فيجد جنة وارفة الظلال حلت مكانه، فيتذكر قصة أهل الكهف والـ “سنين عددا”، وسرعان ما يجد أن الجنة التى كاد يلمسها من شرفة بيته، تتباعد كلما مشى ناحيتها، وعندما قطع المسافة بين البيت والجبل، بمقياس الألف خطوة، وجد المغارة هى الأخرى قد اختفت، فراح يتذكر محطات رحلته الصعبة وتجربته المشحونة بالأوجاع، ويسترجع العذاب والمحن التى عاشها للوصول من خلال أوراد الطريقة الشاذلية، وحلقات الذكر فى الحضرة النبوية إلى مرتبة الولى الصوفى، ليكشف الكاتب لنا من خلال هذه الرحلة العجيبة معالم التراتبية الدينية المتسامحة ذات المسحة الصوفية والمترهبنة فى كل العصور، الفرعونى والمسيحي والإسلامي العربي، والتى جعلت قلب المصرى ينزع إلى الاعتدال الديني، ويزاوج بين الدنيا والآخرة معا.
يمر بطل الرواية بست عتبات زمانية ومكانية، وكلها عبر الاسترجاع، أولاها طهنا الجبل ، وفيها انفتح أمامه “الباب”، بعد حراسته لمقبرة حتحور، والنداء الأول عليه من “عبد العاطى” لدخول “الحضرة” مع الشيخ والمريدين. والثاتية هي كنيسة العذراء فى جبل الطير، ودخوله للعالم الروحانى ، حيث مقابلته لـ “جميلة” فتاة أحلامه وزوجته ورفيقته. والثالثة هي مدينة البهنسا وفيها عاش عزلة الزاهدين ، حيث انكفائه فى بيته والتفكير بعمق فى مدلولات الأشياء المحيطة به ، والرابعة في المنيا ، وفيها اشتغل فى هيئة الآثار، ودخل فى صراع مع المتطرفين الدينيين، فرضوه عليه ولم يسع هو إليه، وذلك بسبب محاولتهم التفريق بينه وبين زوجته، وخامستها هي العودة مرة أخرى إلى ما بدأ منه بطل الرواية، ليعيش فى قريته مع أمه بعد وفاة أبيه، وفيها ترضى والدته بزواجه من مسيحية وتتخذها ابنة لها، وتعاملها معاملة الأم لابنتها الوحيدة، وتأخذه نورانيته إلى العمل فى تجارة الملح لاعتقاده أنه مفيد للناس أكثر من الذهب، وذلك بعد أن يرى جبل الطير من جديد، فى إشارة من الكاتب لعودة هوية مصر المتسامحة على مر الزمن فى نفسية البطل مرة أخرى.
ويختتم الكاتب روايته بعتبة سادسة معاكسة يسير فيها “سمحان” إلى الأمام ويعيش المستقبل الزاهر حين يعلو إعمال العقل، ممثلا فى العلم والعلماء، دون الافتئات على دور القلب، ممثلا فى العارفين وأولياء الله الصالحين. وفى بداية هذه الرحلة يسأل سمحان نفسه، وهو يتوق إلى خضرة الجنة الوارفة، طار الجبل أم غطس؟ ويشعر بمناد يبشره بمرتبة الولاية، وينادى عليه هاتف من السماء، فيلبى النداء فى ثبات، وقلبه يطير من السعادة، تاركا الديك يحتمى بحجر والبقرة إلى جانبه، فيجد نفسه يتقدم فى الزمن إلى الأمام فيرى “مصر المستقبل” فينفتح له باب بناية إلكترونية، فى مدينة علمية عالمية على أرض مصر، فيقول له عبد العاطى إذهب إلى حفيدك ويخبره أن زوجته حبلت قبل وفاته ، بفضل مضاجعة الليلة الأخيرة، فيدخل بناية منخفضة، فيرى علماء تاريخ وأنثربولوجيا ولغات قديمة، وحفيده بينهم، يشغلون شبكة اتصالات إلكترونية فى معاملهم لتسجيل وفرز أصوات عرب الحجاز فى فترة سيدنا محمد(ص) وملأ فرعون مع سيدنا موسى، فيندهش مما يراه، ويدور حوار بينه وبين عبد العاطى وحوار بينه وبين حفيده يتضمنان خلاصة الهدف الأساسى غير المباشر من الرواية، والمتمثل فى أن تحقيق السعادة فى الحياة تحتاج لطائر بشرى جناحيه” القلب والعقل” ، “العلم والدين”، “المادة والروح” ، وأنه لا سعادة حقيقية للإنسان بدون أحدهما، وأن المصالحة بينهما وقبول كل منهما للأخر، هى أساس التسامح الإنسانى، والدليل على ذلك قول الحفيد لجده: “الأنبياء والأولياء والقديسين أعملوا عقولهم فى كثير من الأمور”.
وتخدم الحوارات بلغتها الشاعرية وتعبيراتها النورانية الهدف العام للرواية، خاصة حوارات سمحان مع عبد العاطى وحوارات سمحان مع حفيده ، وتعمل على غرس مفاهيم عن العلاقة المتناغمة بين العلم والصوفية فى ذهن المتلقى، فعندما كان داخل البناية مندهشا مما يسمعه ويراه، وقبل أن يذهب لملاقاة حفيده فى معمله بالبناية الإلكترونية، وسماعه منه ما يروق له ، وما لا يروق، ومنه مبالغة المريدين فى كراماته وإضافتهم عليها ما لم يفعله، وهو أحد أخطر أمراض الطرق الصوفية، سمع سمحان صوت “عبد العاطى يهمس فى أذنيه ودار بينهما هذا الحوار:
” ـ هذه كرامات العقل الذى يرينا العجائب.
. وكراماتنا، هل تقادمت وصارت نسيًا منسيًا؟
ـ ستبقى، لكنها تخصنا نحن فقط، وهناك دومًا من يشككون فيها، أما ما يخرج من هذه المعامل الضخمة فأدلته الدامغة معه، ويكون للناس أجمعين.
وسرت موجة من كآبة في نفس “سمحان”، لكنها سرعان ما تبددت حين قال له “عبد العاطى”:
ـ لا نزال نسبقهم.
رفع رأسه إليه وفى عينيه استفهام، فأجابه:
ـ لم يطو أحد منهم الزمان والمكان.
تهللت أساريره، لكنه لم يلبث أن وجم وهو يقول:
ـ هذه حكايات يسمعها الناس عنا، ولا يفعلها غيرنا، أما هذه المعامل فيراها الجميع، ويرون ما ينتج عنها، ويستفيدون منه، ويستمتعون به .. كرامات العلم مفتوحة بلا حساب، وتقع فى جلاء النهار.
ضحك “عبد العاطى”:
ـ تردد ما كنت أقوله لك.
ـ حقائق لا يمكن نكرانها”.
ويسعى الكاتب فى كل أقسام الرواية لتوضيح وتأكيد حقيقة مفادها أن الشعب المصرى نازع إلى اعتدال، يجعله كارها لاستمراء العنف، ومتسامح دينيا بطبيعته، بما يمكنه من حراسة الهوية المصرية من الاختطاف والانزلاق بها إلى براثن التعصب الدينى والتطرف الفكرى. فقصة حياة سمحان بطل الرواية تحمل فى مدلولها إشارة رمزية لهذا الشعب، باعتباره الحارس الأمين لتلك “الخلطة السحرية” التى تميز المصريين، بدليل حراسة” سمحان” لكل الأثار المصرية بمختلف عصورها، بالروح نفسها، وتأثره بها وتفاعله معها ، وتأثيره فيها، وذلك خلال رحلته الواقعية و الروحانية والعجائبية التى كشفت عنها الرواية.
ويتميز نص” جبل الطير” بأنه مجازى، وقابل للتأويل من خلال النظر إلى ما وراء ظاهره، والبحث عن معناه الباطنى، وهذا أجمل ما فى الرواية، وبالتالى يمكن أن يكون المقصود بالجبل الذى اختفى فجأة عن عيون سمحان هو اختفاء قيمة عليا كانت راسخة رسوخ جبل الطير بداخل الإنسان، كاختفاء قيمة الحرية فى قلوب بعض الناس، بسبب صراع دموى على الحكم مثلا. وممارسات السلفيين داخل الرواية بزعامة حذيفة تعزز من صحة تلك الفرضية، وهو ما يحتاج من الإنسان وقفة مع النفس ومكابدة للبحث عما ضاع منه وتثبيته من جديد، ما دام يؤمن بأنه الحق والحقيقة. وهذا التأويل المشروع يصل زمن الرواية على امتداد سبعة آلاف سنة بالواقع المعيش فى كل زمان ومكان، وبالتالى يضفى عليها طابعا خاصا يجعل منها رواية كل العصور، أو رواية ماضى وحاضر ومستقبل المجتمع المصري.
ويعتمد الكاتب فى روايته على الواقعية السحرية، إذ فعلت لغة الوصف النفسى للأماكن والشخصيات والأشياء، مفعول السحر على القارىء، إذ استطاع الكاتب من خلالها أن يسيطر على قلبه وعقله، ويبقيه فى روايته الطويلة مشدودا بعنصر التشويق فى كل عتباتها وأحداثها، وساعد على تحقيق ذلك اعتماد الكاتب على البنية الدائرية، أو الزمن الدائري، حيث يصعب على من يقرأ أن يقوم بتحديد بداية النص ونهايته، إنما ينبعث فيه عبر نوبات من التيه والوعى، والغياب والحضور، تجعله بعيدا عن الإحساس بالملل، وبوسعه أن ينتقل بين أقسامها المتعددة مدفوعا بالشغف والفضول لمعرفة كل كبيرة وصغيرة فى حكاية زواج سمحان “المسلم” من حبيبته “المسيحية”، وتظهر رغبة الكاتب فى معالجته لهذه القضية من منظور تسامحى وعقلانى، يعكس موقف الزوجين معا، حيث يجد الكاتب أن هذه الزيجة دلالة على وحدة الدين والوطن، وليست أبدا مدعاة للفرقة والفتنة الطائفية، وهى رؤية مناقضة تمام لموقفى حذيفة السلفى وراهب الدير المتشدد، فكلاهما يحاولان استغلالها فى إحداث فتنة طائفية، ولكن كل على طريقته.
ويغلب على الرواية صبغة محلية شديدة الخصوصية ، فهى مصرية الزمان والمكان، ولكنها فى الوقت نفسه تضع القارىء أمام مرآة تاريخية يرى فيها حلم العالم كله من خلال مصر المتسامحة على مر العصور، ما يجعلها وبحق بمثابة رواية تنحو نحو العالمية ، ولم لا؟ والرواية تدافع عن سلامة أفكار تحتاجها القرية الكونية بكاملها ، وتحارب فكر يئن منه العالم كله، وذلك من خلال رمزية حتحور وأخناتون والكنيسة والجبل، فى دولة غالبية سكانها مسلمين، وتصدى سمحان بكل ثبات لجماعة حذيفة، وتعتمد الرواية على الجدلية الفكرية كطريق للوصول إلى اليقين والمعرفة الكاملة، وتضع العلماء التطبيقيين فى مرتبة “الولى العالم “، وهى ولاية تشهد بكراماتها “الكثرة “، على خلاف الولى الصوفى” الذى يشاهد كراماتها، “القلة”.
وتتمثل الأولى فى سمحان ورايته وحضرته ، وتتمثل الثانية فى حفيده بدراسته ومعمله. وتكشف الجدلية الفكرية فى الرواية من خلال حكى وسرد قائم على ثالوث شاعرى ” المجاز والتورية والاستعارة” النقاب عن طبيعة مصر المتسامحة مع نفسها ومع الآخرين على مدار الزمن، بما يجعلها قبلة المعتدلين والمتسامحين فى كل بقاع الأرض، وهى الطبيعة التى يسعى لتشويهها السلفيون التكفيريون.
ويحسب للكاتب اختيار أسماء شخصيات الرواية بدقة، وهو ما ينطبق على الأماكن أيضا، حيث جاءت كل الأسماء ملائمة لطابعها الصوفى وللصفات التى يجب توافرها فى المتصوف، باستثناء حذيفة التكفيرى، فسمحان من التسامح، وجميلة من الجمال ، وعبد العاطى من العطاء، ورشيد من الرشادة، وعبد الباطن من العلم الباطنى اللدنى، وعادل منسى، من العدل والعزلة، وفتحى من الفتح الربانى. وتكونت شخصية سمحان الصوفية نتيجة لمؤثرات روحية شكلت فيه هوية مصر التسامحية، الثابتة والمتجذرة فى قلوب المصريين ، والشامخة أمام كل الأفكار الوافدة، وكأنها تتفاخر بأعلى صوت “يا جبل الطير الروحانى ما يهزك ريح السلفى المتطرف” ، فسمحان تأثر جدا بقصة موت عمه رشيد ، قبل أن يكمل تعليمه، وكتبه التى حركت فى رأسه أسئلة كبرى، وكراسة المرشد السياحى عادل منسى، وما فيها من شرح للآثار المصرية بشكل يؤكد حقيقة أن مصر منبت الدين والتوحيد والخير والسلام، ونداءات “عبد العاطى” إليه، وأقواله ذات الدلالات الصوفية، وحضرته ورايته التى حملها سمحان من بعده برغبة المريدين.
ويمكن وصف “جبل الطير” بأنها رواية موسوعية معلوماتية، فهى تتناول تاريخ مصر فى ثلاثة عصور، وتتضمن الكثير عن أثارها وأديانها وروافدها الثقافية وتياراتها الدينية ، ويستغل الكاتب معلوماته الصحيحة، والتى هى خلاصة أبحاث أكاديمية وتجارب سياسية ، فى فضح وتعرية التيار المتأسلم، أمام نفسه وأمام الأخرين، من خلال آراء انتصر فيها للتيار الإصلاحى والتسامحى.
وقد فعل الكاتب هذا عبر إسقاطات ومناقشات وحوارات قائمة على الحجة والمنطق، بين شخصيات الرواية، حتى يكون لها أقوى تأثير فى ذهن المتلقى ،منها إسقاط طائفة “الأميش” ومناهضتها للإصلاح الدينى فى الغرب خلال العصور الوسطى على التيار المتأسلم ومناهضته للإصلاح الدينى والسياسى فى العصر الحديث، ومنها حوار جميلة مع برهان الراهب وقولها له عن المتعصبين: ” أمثال هؤلاء وبالًا على كل الأديان”، ومنها حوارات ومناقشات لسمحان مع أبو حذيفة السلفى ، تناولت التناقض بين آيات القرآن من عدمه، وأوضح سمحان أن آيات القرآن ليس فيها أى تناقض ، وحديث الرسول بأن النساء ناقصات عقل ودين، وشرح سمحان أن السلفيين فهموا كلام الرسول بطريقة خاطئة، ولم يدركوا أن كثيرا من الأحاديث النبوية منسوبة أو منتحلة، وكذلك مسألة تكفير الناس والجهة المنوطة بتطبيق الشرع والقانون. وبدا سمحان مقتنعا بأن هذا واجب السلطة السياسية وليس أصحاب اللحى، الذين يفرضون وجهة نظرهم على الناس عنوة.
ويظهر المضمون التاريخى بوضوح شديد الرواية، حيث يرتحل البطل فترات زمنية ممتدة، يتم صياغتها بسرد عجائبى مثير ومدهش، من خلال التخيلات والرؤى والأحلام والهاتف العجائبى والأساطير، وينجح الكاتب من خلال هذا المضمون فى استدعاء حقائق تاريخية كانت خافية، ويثبت قدرته على النفاذ إلى ما وراء الظواهر، بما فيها الظاهرة الصوفية باعتبارها محور ارتكاز الرواية، فالتطرف السلفى، على سبيل المثال لا الحصر، له ما يفسره فى التطرف الغربى فى العصور الوسطى.
وتحاول الرواية إزالة الغبار العالق على الصوفية والمتمثل فى المبالغة فى كرامات الأولياء، وذلك بلغة هادئة ومقنعة، ومن خلال حديث مؤثر يقول فيه الحفيد لجده: ” هناك من يرد غيبتك الأبدية، ويحكى عنك كرجل طيب وهبه الله كرامات لم تؤت لغيره فى زمنه، وهناك من قال عنك أشياء فوق الخيال، ونسبوا لك أعمالًا فوق النواميس .. بعض مريديك بدأوا الحكايات، ودارت فى القرى وعادت غير ما ذهبت، وتداولها حتى الأطفال بعد أن أضافوا إليها من مخيلاتهم الخصبة، والنساء الثرثرات غذوها بأشياء مثيرة، حتى وصل الأمر إلى أن قالوا عنك إنك كنت تضاجع جدتى عشرين مرة كل يوم، ثم تغتسل وتصلى ساعات طويلة دون أن تخور ساقاك”، وهى المبالغة التى نفاها سمحان جملة وتفصيلا، ليرسم قاعدة عامة لتحديد الفكر الصوفى الصحيح وقصره على المأخوذ من الكتب الموثقة والمشهود لها من أهل العلم، وذلك بقوله لحفيده بعد أن هز رأسه:
“أنا رأيت مشاهد متناثرة، قدَّر الله لى أن أراها، وكل ما عداها لا أعرف عنه شيئًا حقيقيًا، ولا وسيلة لي لمعرفته سوى التى يسلكها الناس، مما تركه لنا الأولون فى كتب، وهى ليست سوى ما اختاروه، أو ما اعتقدوا أنه الحقيقة، أو ما دافعوا به عن منافعهم وأهوائهم وميولهم، وكذلك ما حملته ذاكرة الناس من تفاصيل خالطتها خرافات وأكاذيب، وأشياء أخرى صنعتها الأغراض المتضاربة.”
وتكتمل فكرة الرواية وهدفها النبيل المتمثل فى المصالحة الصوفية بين العلم والدين ، والقلب والعقل ، وكرامة الرؤية وتجربة المعمل، وذلك من خلال مشهد حوارى بين الجد وحفيده حكاه الكاتب على النحو التالى:
“وسعل قليلًا، ثم بلع ريقه وواصل: أما ما تفعلونه أنتم فسيدوَّن على هذه الأجهزة، وسيعيش، وسيكون بوسع الذين يأتون بعدكم أن يختبروه، ويضيفوا إليه، ولن يتركوه للناس يوزعونه عبر الأيام على ألسنة تنطق من وحى خيال خصيب، أو على نفوس مريضة لا تتفوه إلا بما هو معوج أو غارق فى الهوى.”
وتبدو إيحائية الرواية هنا فى أنها انتقدت أقوال السلفيين عن القدرة الجنسية الهائلة للرسول، من خلال مبالغة المريدين فى القدرة الجنسية لسمحان، دون أن تقول ذلك بشكل مباشر، خاصة أن الإيحاء يكون له أثر أكبر على القارىء، خاصة عندما يكون السرد الروائى قائم على السرد العجائبى، كما هو موجود فى “جبل الطير”، حيث توجد أحاديث مشكوك فى صحتها تقول أن الرسول كان لديه قوة 40 رجلا ، وكان يعاشر زوجاته التسع فى ليلة واحدة، دون أن يعطى رجال الدين السلفيين أى تفسير منطقى ومقنع للعلاقة بين هذه الصفة والنبوة والرسالة.