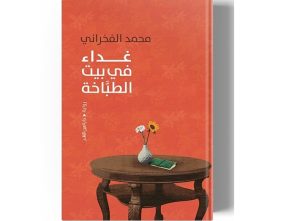آمال نوّار
في ذكرى مرور مئة وعشرين عامًا على ولادته (1899-1932)
في ذكرى ميلاد الشاعر الأميركي هارت كرين التي حلّت في 21 تموز/ يوليو الفائت، استرجعتُ في خيالي برهبةٍ قفزته من السفينة “أُوريزابا” إلى البحر الكاريبي، وتساءلت: لِمَ يا تُرى يصارع المنتحر الموج؟! هل شاخ قلبه فعلًا في عمر الثانية والثلاثين؟! لم يكن كرين شاعرًا ذاتيًا، وإنما يميل إلى الكتمان والتحفّظ؛ ألهذا لم يمنح ذاته سوى إلى حافظ الأسرار؛ البحر؟ لم تكن أشعاره لتعكس همومه، وإنما أحلامه؛ فهل مارس الكتابة للفرار من نفسه؟ كيف نفهم هذا المتفائل في شعره واليائس في عيشه، المرح مع أصدقائه والمكتئب في أعماق ذاته؟ كيف تسنى له تشييد “الجسر”؛ ملحمة أميركا الأسطورية، بينما هو موغل في سلوكيات التدمير الذاتي، واقعًا بين مطرقة الكُحول وسندان الجنس؟ أسئلة كثيرة وجدتها تحفّزني على الكتابة عن هذا الشاعر الذي وافق هذا العام ذكرى ميلاده المئة والعشرين، من دون أن يلتفت إليها أو إليه أحد في المنابر الأدبية والثقافية الأميركية أو غيرها.
هارت كرين المنتمي إلى جيل العشرينيات من القرن الماضي؛ شاعر حداثي، طليعي، ذرب اللسان. شعره كرنفالُ بلاغةٍ منمقُ الأسلوب، وعرسٌ لغويّ صعبٌ، بعيدُ المقاصد، وشديد الإبهام. جمع بين تأثيرات الشّعر الأميركي التقليدي من ناحية، محتفظًا بحساسية خاصة مشتقة من شعرية والت ويتمان، وتأثيرات الشعر الأوروبي ومختبر الحداثة والتجريب من ناحية أخرى. عُدَّ رومانسيًا في عقود الحداثة الكاسحة، ولقّبه الشاعر روبرت لويل: “شيلي عصرنا”؛ لكنّ الزمن لن ينصفه كي يحظى بشهرة شيلي أو كيتس أو بايرون أو سيلفيا بلاث أو رامبو أو غيرهم من الشعراء الذين حباهم موتهم المبكر صفة القداسة تقريبًا. وعلى رغم أنّ الشاعر والناقد الأميركي آلن تايت، وصفه بأنّه “المتحدّث باسم روح عصره”؛ فهو أيضًا لن يحظى بشهرة شعراء عصره أمثال: عزرا باوند، وليم كارلوس وليامز، لانغستون هيوز، إي. إي. كامينغز، غرترود شتاين وغيرهم. صعوبة شعر كرين كانت ذريعة نقّاد كثر، منذ غيابه حتى اليوم، لإقصائه عن المشهد، كذلك كانت سببًا في قلّة الترجمات التي حظي بها شعره إلى لغات أخرى، وفي ندرة المهتمين به داخل أميركا وخارجها.
تميّزت شخصية كرين بالحيوية والمرح والمعرفة الفطنة بالأدب والفنون، وأحبّ الرقص، والعزف على البيانو، وإشاعة البهجة في نفوس أصدقائه، وكان يوقِّع اسمه أحيانًا بكلمة Heart التي تُلفظ كاسمه وتعني قلبًا بالإنجليزية. ورغم ذلك عاش حياته القصيرة عديم الاستقرار الجسدي والنفسي، ومدمنَ كحول، وفريسةً للاكتئاب، وقد حاول الانتحار مرتين في عمر السادسة عشر، ومرة ثالثة في نيويورك قبل سنة من انتحاره الفعلي. أقام كرين في غُرَف، وشقق، وبيوت مزارع، وأكواخ، وبيوت للأصدقاء، توزّعت بين كليفلاند ونيويورك وباريس ومرسيليا وإحدى الجزر الكاريبية وأخيرًا المكسيك قبل أن يغيب في مجاهيل البحر.
“الجسر” ملحمته الويتمانية الحداثوية
وجد كرين ما يلهمه ويستفزّه في شعرية تي. إس. إليوت، ولا سيما في قصيدته “الأرض اليباب”، التي رغم اعترافه بعظمتها؛ فقد وصفها بالقصيدة “الميّتة، الملعونة”، و”الطريق المسدود”، لكونها ترفض رؤية بعض الوقائع الروحية والإمكانات المستقبلية. وقد أخذ على نفسه مواجهة الحداثة بشيء أكثر بكثير من اليأس، والعمل على خلق بديل مشرق لأميركا عوض صورتها الإليوتية القاتمة، وذلك من خلال إنجازه الأكثر طموحًا: “الجسر”. وهو توليفة شعرية ملحمية أسطورية تقع في ستين صفحة، وتتكوّن من خمس عشرة قصيدة غنائية متفاوتة الطول والرؤية. يقدّم فيها كرين بنشوة بالغة، وحيوية كانت نادرة في الشعر وقتئذ، صورة بانورامية عن التجربة الأميركية كاملة بوجهها الحضري الكوزموبوليتي، مبينًا أهميتها التاريخية والروحية، ومحتفيًا بثقافتها الحديثة وبالعديد من رموزها وشخصياتها وأماكنها؛ مثل: كريستوفر كولومبوس، بوكاهونتاس، منطقة نيو إنغلاند الحديثة، نفق إيست ريفر. وعلى غرار إليوت، الذي استخدم مناظر المدينة الصناعية الحديثة لخلق شعر رمزي حداثي مؤثر، اتّخذ كرين جسر بروكلين الشهير (الذي لطالما تمتّع بتأمّله من النافذة أثناء إقامته في بروكلين هايتز) رمزًا لأميركا نفسها، بصفته الهيكل الموحّد لمكوناتها، والتجسيد الحيّ لنزعة التفاؤل الأميركية الفريدة، وأيضًا لكونه مصدر إلهام، وباعثًا على حسّ الانتماء الوطني. وقد لجأ كرين في كتابة قصائد ملحمته إلى أساليب مختلفة، تراوحت بين الوزن، والشعر الحرّ، واللغة الخطابية الفخمة، والمفردات العامية، وجعل بناءها الموسيقي متساوقًا مع نمط تدفق موسيقى الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية؛ النوعان اللذان كان يستمع إليهما أثناء الكتابة.
أغلب نقّاد وشعراء زمانه أمثال: آلن تايت، وإيفور وينترز، وراندال جاريل، وكودورث فلينت، وصفوا كرين بالعبقري، لكن مع عدم رضاهم عن إنجازه. وفازت ملحمته بالإعجاب ووُسمت بالإخفاق! لكنّ النقد الحديث مال إلى قراءتها على أنها مزيج هجين، يدلّ على نوعِ كتابة جديد؛ لعلّه “الملحمة الحداثوية”. وظلّت مكانة ديوان “الجسر” (بوصفه ملحمة أم مجرّد سلسلة من القصائد الغنائية)، ومعها مكانة كرين نفسه، موضع
خلاف النقّاد حتى يومنا هذا. فمثلًا، نجد أنّ ناقدًا معاصرًا مثل آدم كيرش، سوف يعدّ كرين مجرّد حالة خاصة في أدبيات الحداثة الأميركية؛ حيث أنّ مكانته في نظره “لم تكن آمنة تمامًا مثل إليوت أو ستيفنز”. في حين سيبهرنا تصريح الناقد الأميركي الأشهر هارولد بلُوم؛ إذ يقول: إنّ الشاعرين اللذين أثارا اهتمامه بالأدب في سنّ مبكرة للغاية؛ هما هارت كرين ووليم بليك، وإنّ أول كتاب اقتناه؛ كان “أعمال هارت كرين الكاملة”. والملفت أكثر قوله: “أعتقد أنّ الشاعر الوحيد من القرن العشرين الذي أستطيع وضعه سرًا في مرتبة أعلى من مرتبة ييتس وستيفنز هو هارت كرين”.
عانى كرين حين بدأ بكتابة ملحمته، ووجد نفسه عالقًا في فكرة “الجسر”، التي ربما بدت ساذجة بالنسبة إلى حجم أسطورة أميركا في خياله. والمشكلة أنه لم يجد في الواقع الأميركي آنذاك، ما يعزّز فكرة الأسطورة. وشعر أنّ الماضي يتفوّق على الحاضر بوجود نوستالجيا دائمة؛ وتاليًا كيف يمكن بناء قصيدة تمجّد المستقبل الواعد في ظلّ افتقار الحاضر إلى الشروط الموضوعية لذلك. وقد عبّر عن ذلك قائلًا: “لو أنّ أميركا اليوم تساوي فقط نصف أميركا التي تحدّث عنها والت ويتمان قبل خمسين عامًا؛ فلربما كان هناك ما أقوله”. ما الذي فعله كرين بهذا الحلم الأميركي الويتماتي الذي سخر منه إليوت ورآه كابوسًا؟ كيف استطاع أن ينهض بجسره فوق كل الوقائع المشؤومة والتي لا تبشّر بالعظمة؟ الأغلب أنّه تغلّب على الواقع بالإيمان بحلمه.
لقد كتب حلمه عن أميركا رغم أنف كلّ الدماء والعرق اللذين سالا في ماضيها من أجل بناء حضارة الرجل الأبيض، ورغم ما عاينه في حاضرها من ثقافة التمييز العنصري، والفروقات الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ ضمّت حاضرة نيويورك، إلى جانب مشاهدها الإسمنتية والحضارية المشرقة، مشهدًا بانوراميًا لسلبياتٍ تقاسمتها الخارطة الأميركية كافة؛ من مشردين، ومدمنين، وأهل مال وسلطة، وزنوج مقموعين، وسكان أصليين بلا مأوى، ومهاجرين بلا فرص، وأهل بغاء، وقوّادين، وقطّاع طرق، ومجرمين. وكان عليه إذًا أن يخترع أميركا أخرى؛ من رموزها، وحجارتها، وحديدها، وأنهارها، وعشّاقها، ومن إيمان الحالمين بها. فأبدع سلسلة قصائد حول مشاهد وثيمات أميركية مضيئة وغنية برمزيتها، يربط بينها جسر؛ الجسر نفسه الذي يربط الآلة بالفنّ، والتاريخ الإبادي بالمستقبل الواعد. ويا لهذا الرمز العبقري الذي اختاره كرين لملحمته قبل أن يعبره إلى السماء!
الخلاف النقدي حول تجربته
بعد ممات كرين مباشرةً، حظيت تجربته الشعرية بإعادة تقييم، لكن من دون الخروج برؤية مغايرة؛ إذ ظلّ يُؤخذ على شعره صعوبته وغموضه، اللذان هما في رأي النقد، ناتجان عن تدخّل إرادة الذّات في الكتابة، والإمعان في ترميزها ومنحها بُعدًا ملغزًا. شعراء بارزون في زمن كرين انتقدوا أشعاره بحدّة؛ مثل: عزرا باوند وماريان مور، لكن في الوقت عينه، كثر من شعراء وكتّاب جيله، أحبوا شعره، وعلى رأسهم تينيسي وليامز، الذي صرّح أنّه “بالكاد يفهم سطرًا واحدًا”، وأن الرسالة، إذا كان هناك فعليًا واحدة، إنما تأتي من التأثير الكلي”. ويُقال إنّ تي. إس. إليوت، قد يكون استعار بعض صور كرين الشعرية لـ “رباعيات أربع”، حيث ثمة في بداية “إيست كوكر” ما يذكّر بالجزء الأخير من قصيدة “النهر” من ديوان “الجسر”.
في منتصف القرن العشرين، مكث النقد منقسمًا حول تجربة الشاعر، لكن بدا أنّ لكرين تأثيرًا أكثر أهمية على بعض شعراء “جيل البِيت” وخصوصًا آلن غينسبرغ، والمدرسة الاعترافية ولا سيما روبرت لويل، وجون بريمان، اللذان كتبا عن كرين في أشعارهما. ولن تتّضح إشكالية الكتابة الشعرية لدى كرين ومبرراتها حتّى ظهور نقّاد باحثين في “نظرية الكاتب الغريب” في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث سيعيدون اكتشاف كرين، بصفته مثالًا للغريب، وسيخلصون إلى أنّ استعاراته الكثيفة الملغزة، وغموض أسلوبه، يعودان جزئيًا إلى ضرورات كونه مثليًا عاش مُحاطًا بالظروف الثقافية والمجتمعية الرافضة للمختلف، مما اضّطره إلى إخفاء ذاته خلف قناع الإبهام. وفي هذا الصنيع، رأى الباحث “تيم دِين” أنه تسنى لكرين عبر لغته المستغلقة والبارعة، اختراق المعايير التي تحكم الحياة الجنسية والنفسية للفرد، وتوليد أنماط للتعبير عن الخصوصية تتعارض مع خزانة السائد، ومع نظام اجتماعي يجد في هوية المبدع الجنسية، ركيزة لتحديد مكانته وإمكانية ذيوع صيته.
لم يفارق هؤلاء الباحثون حقيقة شعرية كرين، التي يتعذّر فكّ ارتباطها بمثليته؛ تلك التي كانت سببًا في غربته، وفي تعزيز شعوره إبان نشأته وسط تقاليد جماعة العلم المسيحي؛ طائفة أمه الروحية، بأنه منبوذ اجتماعيًا. ناهيك عما لإحساسه بالغربة من دور أساسي في تكوين بصيرته الخيالية؛ أُسّ شعريته. لاحقًا، برزت أصوات نقدية معارضة، تنتقد هذا التركيز المفرط على السيرة الجنسية لشعر كرين وتراه يَحُول دون مقاربة تجربة الشاعر من منظار أوسع وأشمل. كذلك ظهرت معالجات نقدية جديدة لديوان “الجسر”؛ مثل كتاب “قيثارة الشّرّ لهارت كرين” (1986) للناقد جاك سي. وولف، الذي رأى في الملحمة كيانًا متماسكًا وقويًا بشرط عدم معاينتها من منظار الرؤية اليهودية- المسيحية التقليدية، وإنما الرؤية الأُورفيوسية.
في عام 2006 بعد قيام مكتبة أميركا بإصدار “الأعمال الشعرية الكاملة والرسائل المختارة” للشاعر، ظهرت مراجعات نقدية أكدّت أنّ الخلاف حول ملحمته لا يزال قائمًا، وعلى حدّته. فالشاعران والناقدان المعاصران آدم كيرش ووليم لوغان، لم يختلفا في ترديد أصداء انتقادات سلبية سابقة وَسَمت القصيدة “بالفشل المثير للإعجاب”! لكن في المقلب الآخر، صدر كتاب “شعر هارت كرين: أبولينير عاش في باريس، أنا أعيش في كليفلاند، أُوهايو” 2014، للناقد جون تي. إيروين، وعُدَّ الكتاب الأعمق في معالجة شعر كرين، والأكثر اتقانًا وإلمامًا بموضوعه. وقد لجأ فيه إيروين إلى ثروة من المعارف المتصلة بتاريخ الفنّ والفلسفة والسيرة والذاتية والأدب الكلاسيكي، من أجل تدعيم قراءته النقدية لملحمة كرين “الجسر”، في صفتها التوليف شبه المثالي للأسطورة الأميركية، وفي كونها أفضل قصيدة طويلة في القرن العشرين؛ لأنها الأغنى بالأصداء الأسطورية والتاريخية، والأكثر ابداعًا في دمجها العديد من التراكيب الأدبية والمرئية، والأكثر مهارة وتأثيرًا في أسسها النفسية.
وثمة خمسة كتب أخرى تناولت سيرة حياة كرين وشعره؛ أصحابها: بول مارياني، فيليب هورتون، كليف فيشر، براين رييد، جون أنتيركر. وعمومًا تبقى هذه الإصدارات قليلة بالنسبة إلى شاعر إشكالي مثل كرين مرّ على غيابه سبعة وثمانين عامًا. وتجدر الإشارة إلى أنّ إحدى مسرحيات تينيسي وليامز الأخيرة؛ “على الخطوات أن تكون خفيفة”، تستكشف علاقة كرين بوالدته. سيرة حياة كرين كانت أيضًا موضوع فيلم وثائقي بعنوان “البرج المحطّم”، أنجزه طالب أميركي عام 2011، كأطروحة ماجستير، مستندًا إلى محتوى الكتاب السيري للشاعر بول مارياني. وثمة لوحات فنية عديدة لفنانين تشكيلين معروفين استوحيت من أشعار كرين ومن قصة انتحاره. وكانت مدينة كليفلاند كرّمت ذكرى شاعرها المنسي بمتنزه “هارت كرين ميموريال بارك”. وفيه مجموعة من المنحوتات الفنية؛ إحداها قوس كبير أو جسر يحمل بعضًا من أشعار كرين. أيضًا هناك تمثال بديع للشاعر، في حرم جامعة كايس وسترن ريزرف في كليفلاند، نفذّه النحّات الأيقوني الشهير وابن المدينة نفسها؛ وليم مكفي عام 1985. وثمة نصب تذكاري أُقيم في الموقع الأصلي لمنزل عائلة هارت كرين في المدينة، حيث أمضى الشاعر أكثر من نصف حياته.
تمثال الشاعر هارت كرين، ونصب تذكارية أخرى في مدينة كليفلاند
تنظيراته الشعرية ومراسلاته
في عشرينيات القرن الماضي، أرسل كرين (وهو في منتصف العشرينات من العمر) قصيدته “عند ضريح ملفيل”، للنشر في مجلة “بويتري”، وعندما رفضت الشاعرة والناقدة هاريت مونرو (صاحبة المجلة ورئيسة تحريرها) نشرها بدايةً، كتب لها رسالة مطولة لفكّ شيفرة شعريته، شارحًا لها فكرته حول “منطق الاستعارة”. لم تتأخّر مونرو (وهي في أوائل السبعينات من العمر) عن الردّ على الشاعر الشاب، الذي لم يعجبها منطقه، وكتبت له تحاوره وتعرض رأيها النقدي، ثم لاحقًا قامت بنشر قصيدته في أحد أعداد المجلة، وبجانبها ما تبادلاه من رسائل! أين نحن من ذاك الزمن الشعري- النقدي الجميل؟!
لم يألُ كرين جهدًا في الدّفاع عن قصائده، والتنظّير لشعريته الصعبة، عبر خطاب بليغ وعميق. ومما أشار إليه في تنظيراته؛ مسألة أنّ الظروف الجديدة للحياة تُنبت أشكال تعبير جديدة … وأنّ وعي الحاضر، إذا كان لا بد من معرفته، يتطلب المجازفة بالتحدّث برطانة، وبعبارات مجازية قد تصدم في بعض الأحيان الباحثين ومؤرّخي المنطق. وفي موضع آخر يتساءل: “إذا كان الشاعر مقيدًا باستخدام سلسلة من الصور التي تمّ اختبارها وتطوريها من قَبل، فما مجال الوعي الإضافي والمدركات المتزايدة (ملعب الشعر الفعلي) الذي يمكن توقعه، عندما يتعيّن على المرء العودة إلى الأبجدية، تقريبًا بعد كل نَفَس يأخذه أو نَفَسين”؟ وفي رأي كرين أنّ على الشاعر الذي قرأ بحساسية كبيرة، ورأى بعمق، وخبر الكثير، الوثوق بلغته وبطريقته في التعبير، لكونهما أداتين واعيتين لاحتواء مفاهيم جديدة، وتقييمات أكثر عمقًا وشمولية.
كما هو الحال مع إليوت ومصطلح “المعادل الموضوعي”، الذي استخدمه في مقالته الشهيرة “هملت ومشاكله”، طارد مصطلح “منطق الاستعارة” معظم نقد كرين. في مقاربة نقدية له، متداولة، بعنوان “الأهداف والنظريات العامة”، لم تنشر حتى وقت متأخر، رأى كرين فيما يتعلق بالاعتبارات الفنية، أنّ الدافع وراء القصيدة يجب أن ينبثق من الديناميات العاطفية الضمنية لمكوناتها، وأنّ مفردات التعبير المستخدمة فيها، غالبًا ما لا يتمّ اختيارها بناء على أهميتها المنطقية (الحَرْفية) بقدر ما على ترابط معانيها. ورأى أنّه من خلال هذه العلاقات المجازية المتبادلة، تُبنى القصيدة كاملةً على أساس المبدأ العضوي المتمثل في “منطق الاستعارة”، الذي يُبطل منطقنا الخالص المزعوم، ويُعَدّ الأساس الجيني للكلام كلّه، وتاليًا للوعي وتمدد الفكر. وفي رسالته إلى هاريت مونرو كتب كرين شارحًا: “إنّ منطق الاستعارة متجذّر عضويًا بالإحساس النقيّ (البدئي)، بحيث لا يمكن تتبعه أو تفسيره كاملًا خارج نطاق العلوم التاريخية؛ مثل علم فقه اللغة (الفيلولوجيا) والأنثروبولوجيا”. في دراسة عميقة للناقد أل. إس. دمبو حول ديوان كرين “الجسر”، يتتبع الكاتب بنباهة مسار هذا “المنطق”، ليجده ضمن الخطاب المألوف للرومانسيين: “كان “منطقُ الاستعارة” ببساطة الشكلَ المكتوب لـِ”المنطق النيّر” للخيال… عمليًا، فإنّ نظرية “منطق الاستعارة” يمكن اختزالها إلى مبدأ لغوي بسيط إلى حدٍ ما: المعنى الرمزي للصورة سابق على معناها الحرفي، وبصرف النظر عما إذا كانت واسطة نقل الصورة منطقية أم لا؛ فمن المتوقع أن يدرك القارئ فحواها”.
معظم آراء كرين النقدية وحواراته، تضمنته رسائله التي نُشرت في وقت متأخر بعد مماته، في طبعات مختلفة من أعماله، وفي كتابين هما:”هارت كرين وإيفور وينترز: مراسلاتهما الأدبية” 1978، و”يا أرضي، يا أصدقائي: الرسائل المختارة لهارت كرين” 1997. وكان كرين داوم على مراسلة شعراء ونقّاد؛ مثل آلن تايت، وإيف وينترز، وغورهام مونسون، وكذلك شارك في نقاشات نقدية مع العديد من شعراء جيله؛ مثل وليم كارلوس وليامز، وماريان مور، وشيروود أندرسون.
المتفائل في شعره واليائس في حياته
طفولة قاسية عاشها هارولد هارت كرين (بحسب اسمه الأصلي)، المولود في غاريتسفيل من ولاية أُوهايو، بسبب توتر العلاقة بين أبويه، وخلافاتهما الدائمة الشرسة التي أدّت لاحقًا الى طلاقهما. ترعرع وشبّ في مدينة كليفلاند، مستقيًا الحنان من حضن جدّته لأمه، التي شحذت مخيّلة الطفل بقصصها الساحرة، والتي وجد في مكتبتها الثرية، حلوى أشهى بكثير من تلك التي كان يصنّعها أبوه؛ صاحب معمل الحلوى، ومبتكر السكاكر الشهيرة “لايف سايفرز”. في مراهقته، بدأ بكتابة الشعر، بعد أن قرأ في عمر باكر جدًا، روبرت براونينغ، ورالف والدو إمرسون، ووالت ويتمان، وهضم أعمال المسرحيين والشعراء الإليزابيثين: وليم شكسبير، وكريستوفر مارلو، وجون دون. في عام 1916، قبل إنهاء دراسته الثانوية، غادر كليفلاند إلى مدينة أحلامه؛ نيويورك، بقصد إكمال دراسته الجامعية، لكنّه لم يجد في التعليم الرسمي ما يلبي طموحه الشعري؛ فهجر قاعات جامعة كولومبيا، إلى شوارع المدينة الهستيرية، المثيرة، الهائجة، التي ستقدّم له دروسًا مصنوعة من اللحم الحي.
في نيويورك، عمل في كتابة الإعلانات والتسويق لمجلتين شعريتين؛ إحداهما حداثوية، والأخرى تقليدية، والتقى بالكثير من الكتّاب والرسامين، الذين سيكتسب من خلالهم معرفة مختلف الحركات والأفكار الفنية والأدبية الرائجة، ولا سيما بعد أن اتسعت مروحة قراءاته لتشمل بودلير، ورامبو، وييتس، وجيمس جويس. غير أنّ مشاكل الأبوين، حتى بعد طلاقهما عام 1917، سيحرمان الشاب المحموم بلوثة الشعر والمندفع في التجربة، من الاستقرار والتمتع بكنوز هذه المدينة، التي وجدها مركزًا للحيوية ومصدرًا للإلهام. ولذلك، فقد أمضى فورة شبابه بين عامي 1917 و1924 متنقلًا ذهابًا وإيابًا بين نيويورك وكليفلاند، طارقًا أبواب رزق مختلفة؛ بينها: عامل في مصنع ذخيرة، ومراسل لصحيفة كليفلاند “بلاين ديلر”، وموظف في معمل أبيه، علمًا أنً الأخير حاول جاهدًا ثنيه عن الانسياق خلف مشاريعه الشعرية. مضاعفات الأجواء العائلية المشحونة، وطّدت في نفس الشاعر نفورًا من أبويه اللذين حاول كلّ منهما بوسيلته البائسة، استمالته إلى جانبه؛ الأب مهددًا بحرمانه من الميراث، والأم مبتّزة عواطفه بمرضها العقلي، وهمومها النفسية والجسدية. في هذه الآونة، وجد كرين في معاقرة الكحول والعلاقات الجنسية بعض عزاء، ولكن ليس من دون ألم وخيبة وشعور بالنفيّ والعزل؛ ذلك أنه كان مُثليًا.
أول إصدارت كرين، ديوانه “المباني البيضاء” 1926، وفيه أشعاره الأشهر؛ “رحلات”، وهي سلسلة قصائد إيروتيكية باهرة، كتبها من وحي علاقته العاطفية العاصفة ببحّار يدعى إميل أوبفر. فيها مديح عالٍ للحبّ، يستند إلى رمزية “البحر”، ممثلًا للحبّ بتناقضاته كافة، من حيث تحولاته المعقّدة من الهدوء إلى الهيجان، ومن حيث أنّ فيه الخلاص. لاقت هذه السلسة استحسان النقّاد بفضل شعريتها الباهرة، وصورها الملهمة والغامضة، وثمة من عدّها أعظم إنجازات الشاعر. ورغم القليل من الانتقادات السلبية التي رأت في كرين شاعرًا مرتبكًا، يكتب عواطفه بغموض، موليًا أهمية لموسيقى القصيدة على حساب الإحساس الشعري، نالت مجموعته الأولى إعجاب نقّاد كثر، نظرًا لبحثها عن الجمال المثالي، وتميّزها بالاشتغال اللغوي، والغنائية، والمجازات الباهرة التي تذكّر بشعرية بودلير ورامبو، إلى جانب اتّسامها بنبرة تفاؤلية عالية، عبر الالتفات بثقة نحو الزمن الذي ينتصر فيه الخيال الشعري على اليأس الناجم عن أهوال الحرب (الإشارة إلى الزمن الذي أعقب الحرب العالمية الأولى). حال التفاؤل في أشعار كرين لم تكن لتعكس حقيقة وضعه النفسي في تلك الآونة. فبعد رحيل جدته عام 1928، غرق كرين في اكتئاب شديد، قرر بسببه الرحيل إلى باريس، ومعه مسودّة قصيدته الطويلة غير المكتملة. وهناك سيلتقي شخصيات أدبية وفنية بارزة، فرنسية، ومن مجتمع المغتربيين الأميركيين، وستربطه علاقة صداقة بالناشر والشاعر السوريالي هاري كروسبي الذي سينشر له ديوانه الثاني عام 1930.
كتب كرين القليل في باريس، ولم يسعفه انتقاله إلى الريف في الجنوب الفرنسي، بل استسلم إلى حياة ماجنة. وعندما عاد إلى أميركا، عانى من إحباط شديد، وإخفاق مدمّر؛ بسبب استقبال النقّاد المخيّب للآمال لديوانه “الجسر”. فقد رأوا أنّ ملحمته التي أراد من خلالها جعل أميركا أسطورة تجسّد عقيدةً ما، يتوحّد الناس من حولها، افتقرت إلى التماسك والاتساق، وإلى محور الاستقطاب المركزي، الذي يوحّد أجزاءها؛ فقد تشعّبت بمواضيعها وأساليبها، وتفاوتت في مستوى شعريتها، واستطردت كثيرًا؛ وتاليًا عُدَّت قصيدة فاشلة رغم أنّ بعض أجزائها اعتبر من أفضل الشعر الأميركي في القرن العشرين. وفي النهاية، لم يكن “الجسر” بالنسبة إلى النقّاد، عملًا شعريًا باهرًا، كما راود خيال كرين، بل مجرّد جسر للعبور إلى عمل أسمى وأكثر نضجًا وتألقًا. غير أنّ العمر لن يتيح لكرين إنجاز عمل آخر؛ فهو كان عانى من نوبات اكتئاب حادّة، ودخل حالًا من الشلل الإبداعي، لن يتعافى منها رغم كل المجريات في مياهه الراكدة؛ وفي مقدمتها، حصوله على منحة غوغنهايم عام 1931، ومن ثم رحيله إلى المكسيك بغرض كتابة قصيدة طويلة عن حضارة الأزتيك. وهو كان سافر إليها بحرًا برفقة خطيبته التي كانت في طور الطلاق من صديقه الكاتب والمؤرّخ الأميركي مالكوم كاولي. والشائع أنها المرأة الوحيدة التي استطاعت اختراق جدار مُثليته، ومنها استوحى إحدى قصائده الأخيرة “البرج المحطّم”، علمًا أنّ مشاعره نحوها، ما كانت لتصدّه عن معاودة نشاطه المُثلي. كتابته غير المنتظمة لبعض القصائد في تلك الآونة، رسخّت مخاوفه من خفوت شعلة موهبته. وفي الختام، استنزفه اليأس كليًا، وفي 27 إبريل 1932، أثناء رحلته على متن سفينة بخارية عائدًا إلى نيوريوك، أقدم كرين على القفز إلى خليج المكسيك، منهيًا حياته بالصراخ: “وداعًا جميعًا”! لم يتمّ استرداد جثمانه، واستعيض عنه بعلامة على قبر أبيه حملت النقش: “هارولد هارت كرين 1899-1932، المفقود في البحر”.
…………………….
* نُشر ملخص هذا المقال في القدس العربي في ٢ – سبتمبر – ٢٠١٩