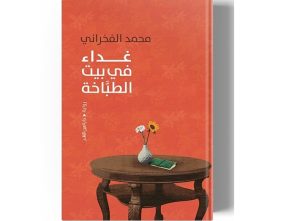آمال نوّار
العودة إلى البدايات، إلى حيث يتلاشى الأبد في قطرة الأزل الأولى؛ هذا من بين ما كان ينشده الشاعر الأميركي “ويليام ستانلي ميروين” الذي أمضى قرابة سبعة عقود من حياته، مطاردًا الشعر في الطبيعة والمخلوقات واللغة والزمن والذات؛ وها قد عاد بسلام، أثناء نومه، في يوم 15 آذار/مارس المنصرم، إلى براءة الماضي المفقود والغياب والصمت والعدم وكل ما كان ينشده في “سوترا” الوجود المُطلق. وها أميركا، من بعد رحيل “جون آشبيري” منذ عامين، تودّع شاعر عظيم آخر من شعراء الجيل الثاني للحداثة، الذين ساهموا في إثراء الحياة الشعرية والثقافية والإنسانية، وفي تقزيحها وتطعيمها بإبداعات فريدة وذات أثر خالد.
“ميروين” الشاعر الكوني بأبعاده المترامية – تلك التي أكثر ما سال لُعاب النقد على البرّاق منها فقط، كَبُعْده الفلسفي لكونه بوذيًا، وبعده الأخلاقي لكونه ناشطًا بيئيًا ومناهضًا للحرب (عارض بشدة حرب فيتنام وغزو العراق في 2003) – لم يكلّ يومًا من التجديد والتنويع والتجريب، أسلوبًا ومحتوى. كتب قصيدة الهايكو والمونولوج السوريالي والأناشيد والأمثال والحِكَم والنثر والمقالة والمسرحيات الشعرية والقصة القصيرة والسيرة، وله ما يفوق الخمسين إصدارًا، علاوةً على أنه ترجم عيون الأدب والشعر في العالم عن أكثر من عشر لغات. احتلت الأسطورة جزءًا كبيرًا من أعماله، لكونها في نظره كنزَ معلومات روحية وفلسفية تستبطن في جوهرها نواميس الحياة. وقارىء “ميروين” لا يفوته رصد منحاه الجليّ شطر العدمية، حيث الحياة منذورة للعنة زوالها؛ ولعلّ ذلك ما يغذّي مفارقاته ولغته اللاذعة والساخرة أحيانًا. ولا يفوته أيضًا سعيه إلى سبر الأغوار الفيزيقية والميتافيزيقية للنفس، والوجود، والطبيعة، بأرضها وبحرها ومخلوقاتها وفصولها ومستقبلها وماضيها، ولا سيما من حيث علاقة كائناتها بالبيئة. ميراث ثقيل ينوء به “ميروين”، ومع ذلك، شعره آية في الصفاء والزُّهْد والعذوبة، كما لو تميمة ضدّ الفراغ، وهو بتماسه المباشر مع الأرض يتماس بيُسْر مع الذَّات حتى في غموضه، ويخفي ضراوته العاطفية تحت سطحٍ باردٍ ومصقولٍ للغةٍ نقيةٍ وهادئة وبسيطة وبالغة الشفافية. بهذا المعنى، كتب المحرر الأدبي في مجلة “الأتلنتيك”، “بيتر دافيسون”: “مرامي شعر “ميروين” بوسع المحيط الحيوي، ومع ذلك، حميمةٌ كهَمْسة”.
الشريان الأكثر ظلمة
معظم الشعراء الذين خاضوا تجاربهم الشعرية منذ أوائل أربعينيات القرن الماضي حتى منتصف الخمسينيات، كانوا متأثرين في بداياتهم بأشعار “عزرا باوند” و”تي. إس. إليوت”، وخاضعين لهيمنتها؛ لكنّهم لاحقًا خاضوا ثورةً في التجريب والتجديد، أسفرت عن حركات شتى: “جيل البِيتْ”، و”مدرسة نيويورك”، و”الاعترافيون”، و”نهضة سان فرانسيسكو” وغيرها. خلال هذه الصحوة، احتلت “الذَّات” أرض المعركة، وباتت الإيحاءات أكثر شخصية، والهدف يقبع في المرآة. بالنسبة إلى “ميروين”، رغم أنّ إقامته القصيرة في كامبريدج في منتصف الخمسينيات، قرّبته وشعراء منطقة بوسطن كـ “آن سيكستون” و”سيلفيا بلاث”، من الشاعر الاعترافي الأبرز “روبرت لويل”؛ فإنه لم ينتمِ إلى أي من هذه الحركات الشعرية. وهنا، يجدر الالتفات إلى ثلاثة معطيات مهمة؛ أولًا: المرحلة الأولى من تجربة “ميروين” التي ضمّت أربعة دواوين؛ بدءًا بباكورته “قناع لجانوس” 1952، التي اختارها الشاعر “أُودِن” لتفوز بمسابقة “سلسلة ييل من الشعراء الشباب”، ووصولًا إلى “السكّير في السخّان” 1960؛ كانت مسرحًا لأسلوبه المبكر في الكتابة الذي أنجب قصائد مثقلة بالإيحاءات الميثولوجية من التراث الكلاسيكي والملاحم القديمة. ثانيًا: تأثّره بـِ “باوند” البائن في بعض قصائد مجموعاته الأُوَل، لم يكن ليتجاوز تأثّره بأعمال الشاعر الإنكليزي “روبرت غرايفز”، وبأشعار العصور القديمة والوسطى التي كان يترجم بعضها آنذاك. ثالثًا: انفتاحه على الشعريات العالمية قراءةً وترجمةً، قاده إلى مختبر الحداثة والتجريب من باب ثقافة اللغة الإسبانية بغناها وغنائيتها وليس من باب اللغة الإنكليزية؛ ذلك أنّ شعراء الحداثة الأوائل الذين قرأهم بدايةً وانبهر بهم أيّما انبهار، كانوا الثلاثي: “لوركا” و”نيرودا” و”خوان رامون خيمينيث”، وكان لغنائية “نيرودا” خاصةً، الذي ترجم له “عشرون قصيدة حب وأغنية للناس”، الصدى الأعمق في غنائية شعريته الدفينة. ولاحقًا في الثمانينيات والتسعينيات، سيكون للديانة البوذية التي تحوّل إليها من المشيخية، ولشعراء الشرق الأقصى الذين ترجم بعضهم، أيضًا أثرهم الدامغ في مجمل كتاباته.
هذه المعطيات إضافة إلى جوانب أخرى، إنسانية وأخلاقية متميزة في تجربته، كنشاطه البيئي ومناهضته للعنف، أخرجت ميروين عن سكة شعراء جيله بكل خطوطها المتفرعة، لتجعله نسجَ وحده؛ متفرّدًا بحضور شعري وإنساني نادر في الحياة الثقافية الأميركية.
فيما يخصّ “الذَّات” التي كانت القلب المغناطيسي والثُقب الأسود للحركات الشعرية الفائرة في منتصف القرن العشرين؛ فهي لم تغب عن شعرية “ميروين”، لكنها شاءت أن تحمل صليبها في براري الرومنسية، مُصغيةً إلى أصداء مَنْ عبروا قبلها (وخصوصًا، “ويليام وردزورث” و”كيتس”)، بينما تشقّ دربها الوعرة الخاصة بها. لم يلجأ “ميروين”، على غرار “الاعترافيين”، “إلى الاعتماد المُسرف على استغلال الذّات تحت التأثير المفاجئ للتجربة الفجّة”، بحسب ما أخذه عليهم الشاعر الأميركي “ستانلي كيونيتز”. “الذات” حضرت في شعريته من طريق التأمل، والمخيلة، حيث لا مطرح للهذر، ولا ثقة بالانفعال الفوري والنيء. “الذات” له، ومن خلفها رؤاها، ليست حكايات تُقصّ على الرصيف بلغة الرصيف (على غرار ما كان يكتبه مثلًا مجايله “فرانك أوهارا”؛ أبرز وجوه “مدرسة نيويورك”)، بل أساطير في مهبّ التأويل اللانهائي.
إنّ تعقّب الرؤى الذاتية غالبًا ما يقود إلى تخوم مدوخة وشديدة الانحدار، حيث “الذات” تقف وحيدة من دون أيّ مواساة أو مؤازرة من أحد. تقف معتمدة فقط على ما تملكه من ثروات شخصية، قُبالة أرض مكتظة بحيوات متكاثرة وأسرار محيّرة، وقبالة فضاء بعيد بُعد الماوراء، وقبالة إيقاعات لا نهائية للطبيعة وتعاقب الليل والنهار، وقبالة التصورات الوهمية للذاكرة والحلم وسلوكيات اللاوعي الغامضة والأحزان والنشوات التي تتراكم بالعيش. كنتيجة لهذه المواجهة الميتافيزيقية العارية مع الأرض وكائناتها، تخلق الذّات البروميثية عالمًا من رؤياها الخاصة، مما يجعل الحدود بين ما هو ذاتي وغير ذاتي صعبة الفصل؛ (أيّ الرؤى ذاتيّة وأيّها واقعية وموضوعية؟!). والذات حينها، كما وصفها الشاعر “ثيودور رَتْكي”، “يُطلق سراحها في الريح ممزقة”. خيط تقاليد الرومنسيين، يمكن تتبعه في كثير من أشعار “ميروين”. يقول في قصيدة “كلما أذهب إلى هناك” من ديوانه “وقت الحديقة” 2016: “لا عجب أنّ العناوين ممزقة؛ تلك التي أشقّ طريقي إليها مُلتهمًا صمت الحيوانات واهبًا الثلج للظلام”. هذا التعقّب للعناوين الضائعة، للظلام والصمت، إنما هو تعقّب للشريان الأكثر ظلمة في التقاليد الرومانسية، لأنه يتمّ في فلك التجريد، ويستبطن دلالات عميقة؛ منها: الانفتاح على الرؤى والماوراء، الاستعداد لتقبل المعارف المبتكرة، الحاجة الملحة إلى السعي نحو الكمال، والذاتية المطلقة في وجه جلالة الطبيعة والكون المُلغز.
الناقد والشاعر الأميركي “رالف ميلز”، صنّف “ميروين” من بين الشعراء الذين يمتلكون نوعًا من الانفتاح والقابلية لتقبّل كل ما هو جديد من الآراء والمعتقدات، وقال فيه ما قاله “هايدجر” في “هولدرلن”: “إنه مكشوف للبرق الإلهي”. المقصود هنا الانفتاح في الرؤى التي تتعدى في كثير من الأحيان التجارب الاجتماعية والسياسية إلى مواجهة عارية مع الكون وهويّة الفرد واحتمالات أن يكون الله غائبًا أو حاضرًا، أو في تصوّر “عدم” فسيح ومهيمن. بالإضافة إلى رومنسيته، ينتمي “ميروين” إلى الشعراء الرؤيويين وأصحاب الصور الذهنية العميقة في الشعر الأميركي الحديث، وذلك من طريق خلقه سلسلة من الصور الشعرية المعقّدة المنبثقة من أعماق اللاوعي. تبقى الصور والأشكال في أعماله غائصة في غموضها بانتظار عزيمة القارىء الذهنية والحدسية والخيالية. يقول أحد نقاده: “يتسلق القارىء الكلمات والصور الشعرية لديه كمن يتسلق صخورًا تحت الماء، فهو غير متأكّد إلى أين ستقوده خطوته التالية”. ويبدو “ميروين” أكثر فطنة من غيره من الشعراء في تحقيق التأثير المفاجىء على القارىء، وذلك من طريق دفعه إلى تأمّل الرعب، تمامًا في مركز أفكاره الوديعة والتقليدية عن الحياة؛ فهو يُدخله إلى قصيدته ثم يختفي تاركًا إياه وحيدًا ومتأملًا في مرآة تعكس أوهامه الخاصة. يقول في قصيدة هايكو من ديوانه “الدريئة المتحركة” 1963: “لا داعي لكسر المرآة / هنا تهشّم الوجه / إنّها صالحة بعد لسبع سنين من الأسى”.
الشِّعر قبل الكلمة
الكلمات في نظر “ميروين” لا تصنع الشعر؛ إنها مفاتيح لا أكثر، لأبواب خلفها فضاءات لا تسعها اللغة. وهو يعرّف الشكل الشعري بأنه تأليف للطريقة التي يتمّ عبرها الإصغاء إلى الشعر في الكلمات، على غرار الطريقة التي يتمّ عبرها الإصغاء إلى حدوث الحياة في الوقت؛ إذ ليس الوقت ما يصنع الحياة. ويضيف: “في الوقت عينه الذي لاحظت فيه أني شاعر تقليدي وصارم وأرثوذكسي بمعنى ما، راودني حلم في إيجاد قصائد كما لو أنها مخبأة في عليّة المنزل؛ قصائد على قدر ما هي تقليدية في غنائيتها، على قدر ما هي مغايرة أدبيًا ومفرطة في شفافيتها”. شعريته إذًا، تتوق إلى شعر غير متكلف وصافٍ وغنائي بألق. وهو ما تحقق في الكثير من قصائده التي نشعر أنها قديمة وحداثية في آن، لأنها أصابت من الشفافية قدرًا جعلها تمامًا في مركز الشعر خارج اللغة والزمن.
فعلُ كتابة القصيدة لـِ “ميروين”، مدخل إلى مستوى اللاوعي، حيث الأشياء كلها لا تزال في إرهاصاتها الأولى، غير مكونة أو معروفة. وفنّ الشعر له، هو تمرين الخيال الذي من خلاله تكون الذات قابلة للمعرفة. وفي وسع الشاعر ممارسة حياته كاملةً من خلال خلق الشكل الشعري، في وقت تكون ملكاته العقلية أقلّ أهمية في عمله الخلاّق هذا. الخيال والشعور والحواسّ؛ هي العناصر التي تغذي القصيدة والذات معًا، وهي أساسية في الحفاظ على هوية الشاعر وفرادته. أثناء عملية خلقه، يشعر الشاعر أنه بمنزلة إله يجلب عبر مخيلته حقائق إلى الوجود، لم تكن موجودة من قبل، ومن دون حياة الخيال، لا يستطيع الشاعر أن يحيا. يقول الشاعر “والاس ستيفنز” في الخيال: “نحن نملكه لأننا لا نملك ما يكفي من دونه”. ومن أجل تعويض النقص الدائم، لا بدّ لمخيلة “ميروين” أن تبقى مأهولة ومجازفة في القبض على المجهول. ومن أجل معايشة مستوى أعلى من الواقع، واختبار شعور أعمق من الوعي؛ فإنّ الشاعر يصوغ قصيدته من مواد الوعي الحيّة. يترجم “ميروين” حكمة “أنطونيو بورشيا” التالية: “نحن ننتزع حياةً من الحياة لنستخدمها في الرؤية إلى ذاتها”. قصائد “ميروين” كلها، مولودة من هذا النبض الخلاّق الذي يسبر غور المجهول. و”الحقيقة لديه كما لدى “مالارميه” و”رامبو”؛ من دون هذا الشرح الشاعري الجليّ والمُشرق الذي يدوّنه الشاعر عليها، تبقى ناقصة.
الشِّعر الخَام
تميّزت أشعار “ميروين” بتنوّع أوزانها – وبعضها كان شعرًا مرسلًا – وبخلو جزء كبير منها من علامات الترقيم. وبخصوص السمة الأخيرة، يُشير إلى أنّ مرحلة جديدة من تجربته على المستوى الشعري والذاتي بدأت خلال فترة الستينيات؛ إذ استشعر بيأسٍ، الخطر المحيط بكوكبنا، واستبد به القلق بسبب الحرب الفيتنامية الشرسة، والقوة النووية المتصاعدة في العالم. ولذا، أراد لكتابته الاستجابة في مضمونها وبنيتها، لقضايا ملحّة تهدّد العالم. أراد منح اللغة حرية الحركة والخفّة لتستجيب لطوارئ العصر؛ ولذا جاءت خطوته في التخلّي عن علامات الترقيم. يقول في حوار معه في “باريس ريفيو”: “إنّ علامات الترقيم تختصّ بالنثر وبالكلمة المطبوعة، وهي من قبيل تسمير الكلمات على الصفحة. وبما أني أصبو إلى حركة الكلمة المنطوقة وخفّتها؛ كانت إحدى الخطوات لتحقيق ذلك التخلّص منها”.
أشعاره في تلك المرحلة، بعد انخراطه في النشاط الإيكولوجي، بدت أنضج وأكثر حداثوية مما كتبه في الخمسينيات، حيث تحررت من الصور الأسطورية، ليحلّ مكانها محرضات أصعب نابعة من الهنا والآن. أوزانه الشعرية كذلك بدت أخفّ وأسرع، عدا تخليه عن أسلوبه القديم في الكتابة؛ فقد كان يجمع بين مفردة قديمة، أكل عليها الدهر وشرب، وأخرى دارجة، في عبارة واحدة (على غرار ما فعله “باوند”) خالقًا بذلك نوعًا من الدهشة أو الصدمة اللغوية. تَخَفُّفُ أشعاره من أثقالٍ معجمية وبيانية، لم يحدّ من نزوعه الدائم نحو خلق تجربة صادمة نوعية؛ فكان أن قفز من حالة إلى نقيضها؛ من فصاحة الكلام إلى فصاحة الصمت، منحازًا إلى شعرية أصعب وأعمق، تحاول قول ما لا يُقال، بلغة التجريد والغموض، وهي بتقشّفها تبدو سهلة التقليد، غير أنّ الصمت النوعي الذي يخلقه “ميروين” بين السطور يستحيل تقليده. وظلّ الصمت ووعي لغزه من المواضيع الأساسية التي شغلت دواوين “ميروين” اللاحقة، التي توزعت على ما يفوق خمسة وعشرين إصدارًا. وبدا شعره فيها بقدر ما هو حاضر بقدر ما هو صامت وخفيّ، حيث المعاني العميقة تتوارى بين السطور مثلما تتجلى في الكلمات.
حول ديوان “القمل” 1967(أشهر دواوين “ميروين”، وأكثرها تأثيرًا في كتابات الشعراء بسبب محتواه المرير الذي أُخذ على أنه استنكار لحرب فيتنام)، كتب الشاعر والناقد “لورنس ليبرمان” قائلًا: “يبدو الأمر كما لو أنّ الصوت يرشح للقارئ كأصداء من بئر عميقة للغاية، ومع ذلك، يصيب مسامعه بطاقته الخام”. مضيفًا أنه “يجب قراءة القصائد ببطء شديد، لأنّ معظم قوتها الخارقة مخبأة في إيحاءات يجب الإصغاء إليها في الصمت القائم بين السطور، وكذلك في الصمت الأكثر غرابة داخل السطور”. الصمتُ “لغتنا الأولى”، بحسب تسمية “ميروين”، ولا شكّ في أنه ضليع في هذه اللغة؛ فالأشياء تجيء فجّة إلى مخيلته، من مكان قديم، ومن زمان غابر، أو تجيء كما يقول: “من قبل أن يكون للأشياء أسماء بعد”.
في السبعينيات، اتّجهت أشعار “ميروين” أكثر فأكثر نحو “المطلق”، مما استوجب نوعًا من النفي والإنكار لقيمة الهويّة الذاتية؛ فالمُطلق لا يُمكن مناله من دون فضيلة إنكار الذات. هذه خسارة على الشاعر الحقيقي تكبدها. لذا، نقع على الكثير من السلبية والإنكار في دواوين ميروين اللاحقة، حيث الأشكال تتمظهر بما هي ليست عليه، وتوصف بنواقصها. هي محاولة من طريق اللغة، للتعبير عن العدم الذي تجسّده الأشكال السلبية. وخلال رصده لجمالية النفي إذا صح التعبير، يفتح “ميروين” الطريق أمام شعر باطني لكنه ليس فياضًا، وحميم لكنه ليس ذاتيًا، ومُستوحى لكنه ليس خارجًا عن السيطرة. في لحظة أسى يكتب “ميروين” في قصيدة “الأرملة” من مجموعة “القمل”: “ليس أنّ الجنة غير موجودة، بل أنها موجودة من دوننا… إنّ كلّ ما لا يحتاج إلينا، حقيقي”. يبدو الإنسان في هذه المعادلة فقيرًا إلى الحقيقة ومطرودًا خارجها؛ الإنسان الذي وضعه “ميروين” في أعماله الأولى في مركز الخلق، وسيدًا على كل شيء، عاد لاحقًا ليجعل من مركز البراعة والتفوّق هذا، مركزًا خاويًا ووحيدًا ومنعزلاً. يقول “ميروين” : “في زمنٍ ما، يُخيّل للمرء أنه باردٌ كخواطر الطيور، وعالقٌ على جرف صخري في البحر، كحيوانٍ طوطمي، يبشّر بتنبوءات لا يُسبر غورها، محاولًا المساعدة لكن من دون طائل”. معضلة “ميروين” الدائمة، كيفية استغلال موهبته الشعرية، إيمانًا منه بأنّ على الشاعر الاضطلاع بمهام ومسؤوليات على غرار “نوح” أو “بروميثيوس”، تتعلّق بخير البشر والكائنات. وعليه، فالضمير الأخلاقي لدى “ميروين”- الإنسان (كمدافع عن البيئة)، كان يستنهض توأمه لدى “ميروين”- الشاعر، أو ربما العكس؛ الضمير الشعري هو ما أجّج الأخلاقي. من أجل هذه الرسالة، كان لا بدّ لشعره وللغته أن يخضعا لنظام صارم. يقول “والاس ستيفنز” في مطلع قصيدته “مُتذوِّق الفوضى”: “نظام صارم هو فوضى، وفوضى عارمة هي نظام”. ولا ريب في أن “ميروين” كان على دراية بأنّ التحديات الحقيقية التي يواجهها، ضمنية، ومن داخل صمت الذات وصمت النصّ، ولذلك، فإنه تحت هذا النظام الصارم لشعره كانت تكمن فوضاه الهائلة.
مرثاة للوحوش والمعاني الخضراء
عُرف عن “ميروين” انحيازه للطبيعة والحيوانات، فهما في نظره ليسا أقلّ قداسة من الإنسان. لقبّه الشاعر “إدوارد هيرش” بـِ “ثورو عصرنا”(“هنري دايفيد ثورو” مؤلف كتاب “والدن” الشهير الذي سجّل فيه تجربة عيشه في أحضان الطبيعة بعيدًا من الحياة الحضرية المدنية)، وكان لقبّه من قبل بـِ “أورفيوس”، لبهاء طلعته. وما أكثر الألقاب التي نُحتت لوصف شاعر، الشِّعر من نَحْتِه. ورغم تجذّر الطبيعة في شعر “ميروين”؛ شاعر “الغنائية المتقشفة”، إلّا أنها لم تُنبت قصيدة غزل عاطفية، بل مرثاة تأملية، بلغة أبوكاليبسية ورؤيوية، تناضل بالتفكّر وصوت الضمير الوجداني، ضدّ انتهاك الحروب المدنّسة للحياة المقدّسة، والقُبح للجمال، وضدّ مأساة الكائنات المنقرضة والآيلة الى الزوال، وتدين تنين التصنيع والاستهلاك، وجشع الإنسان المعاصر. ولعلّ أكثر ما استوقف “ميروين” في زمننا، مسألة استعلاء الإنسان على المخلوقات من حوله، وفكرة أنّ الطبيعة بما فيها سُخِّرت لأجله؛ هذان الأمران أقلقاه بشدّة، بسبب ما لاغتراب الإنسان فيهما عن الطبيعة من عواقب كارثية، وخصوصًا أنّ “ميروين” كان يملك الجواب عن السؤال السائد: هل نحن جزء من الطبيعة أم منفصلين عنها؟ فقد أوضح في إحدى الحوارات معه بأنّ “المرحلة الصناعية أشاعت القلق من العلاقة مع الطبيعة… وهناك تلك الفكرة التي تعزّزت في عصر النهضة، بأنّ الروحانيات في الأساطير مرتبطة بالحوريات والجنيات. الطبول قُرعت الى درجة الابتذال. وماذا بعد؟! لم نكن لننفصل عن الطبيعة! السحر موجود في الطبيعة، وهو ليس شيئًا مريبًا وغير طبيعي، إنه طبيعي”.
منذ أواخر السبعينيات وبعد اعتناقه البوذية لعب “ميروين” دورًا بارزًا في الحفاظ على البيئة، ولا سيما في سعيه لاستعادة الغابات الإستوائية المطيرة لجزيرة ماوي في ولاية هاواي، وفي محاولته لإنقاذ النباتات المستنفدة، بما في ذلك مئات الأنواع من النخيل، وذلك في قطعة أرض نائية من تسعة عشر فدانًا على الساحل الشرقي للجزيرة المذكورة، كانت مزرعة أناناس قديمة ومهملة؛ فاشتراها وحوّلها إلى غابة ومنزل، وانتقل منذ الثمانينيات للإقامة فيها مع زوجته الثالثة في عزلة شبه تامة. يستحق أن نلقبّه إضافةً إلى ألقابه بـِ “نُوح النخيل”، لأنّ غابته تلك، كانت السفينة المنقذة لأنواع من النخيل كفر بها الإنسان ولم تكفر به.
يقول في قصيدة “مكان” من ديوانه “المطر خلل الشجر” 1988: “في اليوم الأخير للدنيا / أودّ أن أغرس شجرة”.
فيما يخصّ الحيوانات؛ فهي في نظره أرواح، خلّدها في أيقونات شعرية، يُواصل زيتُها الراشح معجزتَه فينا كلما قرأناها. ففي عام 1969 صدر له “أنيماي” (“Animae”؛ كلمة لاتينية تعني “روح”)؛ ديوانٌ حافل بقصائد عن الحيوانات، وقبله كان أصدر “متماهٍ مع الوحوش” 1956؛ أكثر دواوين ميروين إظهارًا لحقيقة هويته وأصولها. والأخير سفر تكوين، زاخر بعوالم من اللغة والخيال، وبمحاولات إعادة خلق اللغة، حيث أنّ السؤال الصعب الذي يضعه “ميروين” نصب عينيه: كيف يمكن إعادة إحياء اللغة؟ هل يتمّ ذلك من طريق الشعر؟ ويجسّد هذا الديوان تبجيل الشاعر للحيوانات التي من خلالها، يبجّل الحياة نفسها. ومن دون هذا التبجيل لا يسع الإنسان أن يكون حكيمًا. وهو يرى أنه على عكس الإنسان، لم يسقط الوحوش والقديسون من النعمة، وظلّت لديهم قَدَم في الجنة. والأغلب أنهم أكثر قداسة من الإنسان؛ لكونهم احتفظوا بالومضة الأصلية. الوحوش والملائكة أيضًا في نظره يتماثلان، لكونهما غير ناطقين. هذه اللاحاجة إلى الكلام، وهذا التحرر من اللغة، يجعلهما غير قابلين أن يخون أحدهما الآخر. إنهما يعيشان ببساطة في حالة ما قبل الوعي؛ حالة العماء اللغوي، وهي الحالة التي تتوق شعرية “ميروين” للقبض على جوهرها؛ لأنّ الشعر يسبح في فضائها بطبيعته الخام ما قبل اللغة. في قصيدة بعنوان “الماعزة البيضاء، الحمل الأبيض”، يتحدّث “ميروين” عن العماء اللغوي، قائلًا: “إنها لا ترى الصيف ولا فكرة الصيف، إنما المعاني الخضراء، الظلال، الضوء الذهبي…”
بورتريه
ولد ميروين عام 1927 في مدينة نيويورك، ونشأ في يونيون سيتي في ولاية نيوجرزي (عام 2006 أُعيد تسمية أحد شوارعها باسمه)، ثم في سكرانتون من ولاية بنسيلفانيا. مفتونًا باللغة منذ نعومة أظفاره، كتب بعض التراتيل لوالده القسّ المَشْيَخي، غير أنّ الأخير لم يلتفت لموهبة طفله. عام 1948 تخرّج من جامعة برينستون بشهادة في اللغات الرومانسية، وكان دخلها بمنحة دراسية، ودرس فيها على يد الشاعر والناقد آر. بي. بلاكمور والأستاذ المساعد الشاعر جون بريمان، وفيها بدأ كتابة الشعر وترجمته. في 1952 سافر الى إسبانيا مع زوجته الأولى ليعمل مدرسًا خصوصيًا لأبناء الأثرياء والمشاهير، وكان من بينهم ابن الشاعر والروائي الإنكليزي “روبرت غرايفز” الذي كان يزوره في جزيرة ماريوكا. في هذا العام أيضًا، نشر مجموعته الأولى “قناع لجانوس” التي حملت في طياتها تأثرًا واضحًا بالأساطير القديمة وأشعار باوند، ونقدًا لاذعًا للواقع آنذاك (أميركا ما بعد الحرب).
بعد طلاقه، انتقل إلى لندن عاكفًا على ترجمة بعض الأعمال الأدبية لمحطة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهناك تزوج ثانية من سيدة انكليزية تكبره سنًا، كان تعاون معها في مسرحية شعرية. في 1956 سافر إلى بوسطن إثر حصوله على منحة كاتب مسرحي مقيم في مسرح الشعراء في كامبريدج؛ وكان وقتها مهتمًا بالمسرح الشعري، وهناك نشر عملين مسرحيين، ثم مجموعته الثالثة “متماهٍ مع الوحوش”. بعدها، انتقل إلى الإقليم الفرنسي؛ “دوردونيي”، ليستقر في بيت ريفي مع زوجته الثانية، وذلك إلى حين انفصاله عنها وعودته الى نيويورك في 1968. خلال إقامته الفرنسية أصدر ديوانه الرابع “السكّير في السخّان” 1960، الذي طغى عليه جو الرحلات الأوديسية الطويلة، وبدا محتواه أكثر ظلمة وعبثية من سابقاته.
لأن ميروين عايش زمن التحولات العالمية الكبرى، وجد نفسه مشدودًا إلى العصور القديمة؛ فعمد إلى ترجمة العديد من أشعار وملاحم تلك العصور مأخوذًا بقيمها العتيدة من شرف وشجاعة وفروسية ونبالة. والأرجح أن ممارسته للترجمة لها الفضل في إغناء شعريته وتوسيع آفاقها؛ فهذه الوصفة السحرية، حباه بها الشاعر “عزرا باوند” وهو لما يزل في غرارته الشعرية وبداية تطوافه الأوروبي؛ إذ نصحه رائد الحركة التصويرية بكتابة ٧٥ سطرًا يوميًا موضحًا أنّ السبيل إلى ذلك، تعلّم لغة أجنبية والترجمة عنها، وبذلك يمكن بلوغ الهدف الأبعد وهو التمكّن من اللغة الأُم. نقل ميروين عن اللغات الإسبانية، والفرنسية، واللاتينية، والإيطالية، والروسية، روائع الأعمال الأدبية والشعرية، بينها: “حياة لازاريلو دي تورميس”، و”المطهر” لدانتي، إضافةً إلى مختارات شعرية لأوسيب ماندلشتام، وبورخيس، ورينيه شار، وبول إيلوار، وجوزيف برودسكي، والرومي وغيرهم. كذلك شارك مع آخرين في ترجمة الشعر عن اللغة السنسيكريتية، والييدية (لهجة ألمانية قديمة ينطق بها بعض اليهود)، والإنكليزية الوسطى، والكيشوا (لغة هنود أميركا الجنوبية)، واليابانية (نقل أشعارًا لمعلم الزن الياباني، “موسو سوسيكي” الذي كان أيضًا مصممَ حدائق وسيّافًا بارعًا).
عام 1963 كان لديوانه “الدريئة المتحركة”، وقع المفاجأة، على صعيد الشكل والمناخ، لما احتواه من قصائد عارية بنهايات مفتوحة، تشي بتأثره بتقنيات الشعريات الأوروبية، وبانقلابه على نفسه وعلى نواميس النقد الأميركي الحديث. بهذا الديوان دشّن ميروين أسلوبه الجديد في الكتابة الذي سيطبع معظم دواوينه اللاحقة. الناقدة هيلين فاندلر في مراجعتها النقدية لـكتاب “ميروين” النثري “أطفال عمال المناجم الشاحبون”، ولديوانه “حامل السلالم” الصادرين عام 1970، نوهّت بأنّ الكتابين شعر، وما الإشارة إلى النوع على غلافهما إلا من باب التضليل! عام 1977، احتفى النقد بـِ “بيوت ومسافرون”؛ كتابه الثاني الرائد في قصيدة النثر، وبديوانه “زهرة البوصلة”. ومن بين إصداراته التي توالت حتى مماته: “العثور على الجزر” 1982، “أسفار” 1993، “الزهرة واليد” 1997، “نهايات الأرض (مقالات) 2004، “ارتحال” 2005، “القمر قبل الصباح” 2014.
تُوجَّت تجربة ميروين بالعديد من الجوائز الشعرية الوازنة؛ ففي عام 2010، نال لقب شاعر البلاد الرسمي (أمير الشعراء)، وقبل ذلك، حاز في 2005، الجائزة الوطنية للكتاب عن مجلد “ارتحال: قصائد جديدة ومختارة”، وفي 2004 جائزة لانان للإنجاز على مدى الحياة، وجائزة الإكليل الذهبي، وفي 1999 عُيّن كواحد من بين ثلاثة مستشارين لمكتبة الكونغرس، وفي 1993 حصد جائزة تانينغ المرموقة التي تمنحها أكاديمية الشعراء الأميركيين. وكان حاز جائزة بوليتزر مرتين: عام 1971 عن “حامل السلالم” 1970، وعام 2009 عن “ظلّ سيريوس” (الشِّعرَى اليمانيّة) 2008. وتجدر الإشارة إلى أنه في المرة الأولى أعلن عن رغبته في التبرّع بقيمة الجائزة لدعم قضية مناهضة الحرب مما أثار استهجان الشاعر “أُودن” لرفضه تسييس الجائزة؛ فكان ردّ ميروين بأنه لا غضاضة في انتهاز تكريم مهم كهذا للتعبير عن اشمئزازه من الإنجراف الحاصل في هذا الشّر.
في 1976 انتقل “ميروين” إلى هاواي للتعلّم مع معلّم الزّن “روبرت آيتكين”، وبعد زواجه في 1983 استقرّ هناك نهائيًا. بمعونة زوجته، “بولا شوارتز”، التي أصبحت في سنواته الأخيرة ناسخة أشعاره نظرًا لضعف بصره، استطاع أن يجمع في غابته أكبر مجموعة نخيل في العالم (ثمانمئة نوع)، ومعها أسس عام 2010 “ميروين كونسيرفانسي”؛ هيئة لحماية الغابات، وذلك للحفاظ على أشجار ونباتات منزلهم وغابتهم.
عام 2014، كان ميروين الشاعر الإستثنائي والناشط البيئي المتفاني، موضوع فيلم وثائقي بعنوان “حتى لو كان العالم كله يحترق”. إصداره الأخير “دبليو. إس. ميروين الأساسي” 2017، ضمّ مختارات أساسية من أعماله الشعرية والنثرية وترجماته على مدى مسيرته الزاخرة. من وحي قصائده، تسأل الشاعرة الأميركية “نعومي شهاب ناي” التي كانت زارته في واحته الهادئة: “كيف يمكن لقصائد غامضة قليلًا أن تساعدنا على معرفة الكثير عن حياتنا”؟
………………..
* مجلة “نزوى” العدد 99، يوليو 2019