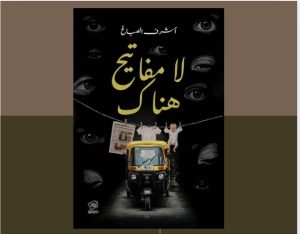إيهاب الملاح
لا أظن أن أحداً، عقب الفراغ من قراءة رواية الطاهر شرقاوي الجديدة “عن الذي سيربي حجرا في بيته”، الصادرة عن دار الكتب خان منذ أشهر قلائل، والحائزة على جائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة المنقضية، من الممكن أن يفارقه شعور بالإعجاب والإحساس بتميز هذه الكتابة وتفردها، كتابة لا يجيدها أو يبرع فيها سوى الأكفاء من الكتاب القادرين على اقتناص “اللحظات العابرة” قبل انزلاقها على أسطح الذاكرة, وتثبيتها للتأمل الذي يكشف عن “كثافتها الشاعرية” بقدر ما يكشف عن دلالاتها المشعة في أكثر من اتجاه.
«عن الذي يربي حجرا في بيته»، هي الرواية الثانية للطاهر، بعد روايته الأولى «فانيليا» الصادرة عن دار شرقيات في عام 2008، سبقتها صدور مجموعتين قصصتين، «البنت التي تمشط شعرها»، و«حضن المسك»، كانتا لفتتا الأنظار بشدة إليه، واستطاع من خلالهما تكريس اسمه كأحد كتاب القصة الجدد المتفردين، والمتميزين بالبحث الدؤوب عن إعادة اكتشاف جماليات اليومي والمألوف في استخدام اللغة، والاشتغال عليها في بساطة وعمق في آن. وسرعان ما تأكدت وترسخت قيمة الطاهر الشرقاوي الأدبية والإبداعية، بوصفه كاتبا مقتدرا للقصة القصيرة، مع صدور مجموعته اللافتة «عجائز قاعدون على الدكك»، الصادرة عن دار نهضة مصر 2010م.
أما روائيا، فطرح الطاهر الشرقاوي اسمه كأحد أهم الأصوات الروائية في جيل كتاب الألفية الثالثة، بلغته الخاصة التي تلفت الانتباه إلى حضورها الفريد وتأثيرها على متلقيها الواعي بخصوصيتها, وطزاجتها ودهشتها واندهاشها في آن.
«عن الذي يربي حجرا في بيته»، رواية قصيرة تقع في 124 صفحة من القطع الصغير، وهي بقصرها الملحوظ وكثافتها السردية المدهشة، تطرح من جديد إشكالية التجنيس أو النوع الأدبي، فمن الممكن أن يقرأها البعض باعتبارها “قصة قصيرة/ طويلة”، أو يعتبرها آخرون “نوفيللا”، لكن وأيا ما كان تصنيف من يقرأها، فكاتبها قد قرر أن يطلق عليها صفة “رواية”، وهي كذلك في نظر واعتبار كاتب هذه السطور.
ثمة مستويات لمتعة تلقي رواية الطاهر شرقاوي، «عن الذي يربي حجرا في بيته»؛ الأول منها، والمباشر الذي يبدهك مع أول مطالعة أو معاينة لسرده: جمال الحكي، وسحر الحواديت. أما المستوى الأعمق من بقايا المتع؛ فتتمثل في: وخْز السؤال، ومغزى الفكرة، ومتعةُ الاكتشاف، وسرّ الصنعة، ونشوة التأمل، ومقاربة قانون اللعبة “الروائية”، حيث معنى الفن محدد في “أن تقول وكأنك لا تقول، تحكي وكأنك لا تحكي”، وأخيرا اندماج الواقعي بالرمزي على نحو متماسك وخلاّق في المعنى العام للرواية.
رواية الطاهر تبدأ وتنتهي في عالم مألوف المفردات والعناصر والتفاصيل، في رقعة مكانية محدودة، منزل في شارع في حي في مدينة، يعيد الطاهر خلق مفردات هذا العالم ونسج علاقاته وإضفاء “دهشته؛ دهشة الطفل المكتشف” المتلذذ باكتشافه للتفاصيل، أو دهشته الفرحة عندما يضفي على ما حوله من أشياء ما يريد هو أن يراه، لا ما يراه غيره، وأن تكفيه قناعته وإيمانه بما يرى دون الحاجة إلى الاستعانة برؤى مغايرة.
هكذا ينسج طاهر روايته، وهكذا يتحرك راويه “المندهش/ الراصد/ الخالق”، السارد بضمير الأنا، في مساحة ضيقة محدودة، لكنه يستجلي ويستكشف ويصف ويوصّف هذا العالم المحدود بما يجاوز محدوديته الظاهرة، من خلال مونولوج طويل وممتد بين بطل الرواية وساردها وبين ذاته، وبين الأشياء المحيطة به، بالتوازي مع “الديالوج” المنقطع والمتقطع مع “سيرين”، التي يحدثنا عما يفعله رنين الهاتف الذي يحمل من ورائه صوتها، بنفسه، قائلا:
“تصاعدت دقات قلبي أكثر، طبل صغير يسكن بين ضلوعي، نظرت إلى شاشة الكمبيوتر، تعرفت على بعض الكلمات العشوائية في المستند المفتوح، دق قلبي على غير العادة..”
ونمضي بطول الرواية ونحن نتعرف على هذا الراوي الرائي للعالم بدهشة ولذة ومتعة، متجددة، حيث “الذات المندهشة مما لا يثير الدهشة”، لكنها تخلقها أو تضفي دهشتها الخاصة على المألوف والعادي، حتى نصل إلى التماهي بين الواقعي والغرائبي، فنسمع عن (الذي يربي حجرا في بيته)! أو عندما نقرأ أن “مصاصي الدماء يسلون أنفسهم بالتسكع في شوارع المدينة”!!
ولا يتحقق اكتمال دهشة الذات ونزوعها إلى الاكتشاف والخلق معا إلا بضرب من التوحد, التوحد الذي ليس بعدًا عن الناس، وإنما محافظة على التطور الخلّاق للوثبات الحيوية في النفس, أو تصعيد الشوق الروحي إلى الامتلاء الإنساني, عبر لحظات التأمل الباطني الذي يضع الأنا في مواجهة نفسها, مستبطنة حضورها الحي, محررة الطاقة اللا محدودة للروح عبر قنوات الجسد المحدود.
أسلوب السرد المباشر للرواي المتكلم، ورغم أنه الصيغة التي حكيت بها الرواية من البدء وحتى الختام، إلا أنها احتوت تنوعا لافتًا في نبرة السرد، حيث يمكن أن نلحظ الراوي وهو يحدث نفسه فيما يشبه “النجوى” والاستغراق في حديث الذات، يقول الراوي:
“قلت ذلك لنفسي مبررًا وجود مقعد واحد فقط، الإجابة أراحتني قليلاً، بعد أن كان هذا السؤال يلح على تفكيري كثيرًا، كلما زرت الحديقة أو مررت بجوارها، لماذا مقعد واحد؟ وهل كان هناك العديد من المقاعد ولأسباب مجهولة تمت إزالتها، فلم يتبق سوى هذا المقعد؟ فكرت في سؤال رجل الحديقة عن السبب، لكنني تراجعت عندما تذكرت أنني لا أعرف بالضبط ما هي وظيفته، بالإضافة إلى أنني لم أكن متأكدًا إن كان سيرد على استفساري أصلاً، الحيرة التي انتابتني بخصوص المقعد، جعلتني أقوم بفحص أركان الحديقة، مدققًا في الأرض بحثًا عن آثار مقاعد منزوعة ربما كانت موجودة ذات يوم، محاولاتي تلك لم تسفر عن العثور على أي دليل، بل أكدت لي بشكل يقيني: “أنه مقعد واحد لا ثاني له”.
هذا التنوع اللافت في إطار استخدام صيغة (الرواي المتكلم/ ضمير الأنا)، والجمع بين تنويعات تقنية تحت هذا الإطار تبدو الغاية منه في كل الأحوال الكشف عن دلالات الحدث الذي يتعامد على زمنه النوعي, والغوص عميقا في الشخصية بواسطة الاستبطان الذاتي للأنا التي تتحدث, أو استبطان الأنا التي يتحدث عنها القص، أو التعرف على ذوات أخرى من من خلال الأنا. وعلى هذا النحو نستطيع أن نفهم كيف استطاع الروائي ببراعة أن يدخلنا إلى عالم شخصية “سيرين”، ومن داخل هذا العالم نتعرف على عوالم أخرى، عوالم النساء اللائي يحطن بها ويرغبن في أن تفسر لهن أحلامهن، كل هذا نراه ونتعرف عليه من منظور “أنا” السارد، وحيث يروي لنا، نقلا عنها:
[“أنا خبيرة في الأحلام”.. هكذا قالت “سيرين”، وهي تحكي لي أن سيدات العائلة والجيران والمعارف، كن يحكين لها أحلامهن، فقط حكي الحلم ولا شيء آخر، لا يطلبن تفسيرًا أو تأويلاً، إن تكلمت “سيرين” فخير وبركة وإن لم تفعل فقد أخرجن ما يكتم على صدورهن، كن مؤمنات بأن البنت التي عاشرت الأحلام، والتي تعرف ما لا يعرفه أحد، هي الوحيدة التي ستفهم وتنصت بلا ملل أو تذمر، أو حتى دون إعطاء تفسيرات لا معنى لها مثل الأخريات، واللاتي كن يقلنها من أجل بث الاطمئنان في قلوبهن القلقة، هذا اليقين الذي يقبع بالداخل، يجعلهن يمارسن طقوس الاعتراف بكل حب، قبل أن يشعرن بأنهن خفيفات وفرحات بشكل لم يجربنه من قبل كثيرًا. يأتين خصيصًا إلى البيت بحجة الزيارة والحرص على صلة الرحم، ثم ينفردن بها فى حجرتها، يتأكدن أولاً من وجود الأم في المطبخ ومن إغلاق الباب، قبل أن يبدأن في سرد أحلامهن دون نسيان ولو تفصيلة صغيرة، ثم يقتربن من أذنها ويهمسن: “إنه سر” ويرحلن، لكنهن يعدن ثانية بعد أيام أو أسابيع، ويكررن نفس الموضوع..]
لغة الرواية، تفرض حضورها الفريد على وعي متلقيها، لافتة الانتباه إلى عالمها الذي يتمحور حول “كشف العالم” وإعادة خلق العلاقات بين الإنسان والأشياء المحيطة به، مكانا ونباتا وحجرا، ليصل في النهاية إلى سبر أغوار هذه المدينة التي يسكنها (نقيض القرية وضدها)، أو بالأحرى التي تسكنه وتغويه وتغريه دائما بالبحث عن أسرارها، في هذه المدينة التي فيها “يخرج مصاصو الدماء في وضح النهار، بل إنهم يستيقظون من نومهم مبكرًا، نشيطين ومستعدين بشكل جيد لعمل اليوم، يكونون أول من ينزل إلى الشوارع، قبل أن يبدأ عمال النظافة في إزالة بقايا الليل، أو يخرج الخبازون من أفرانهم عيش الصباح، يطبقون شعارهم الخالد، والذى يحرصون على ترديده قبل النوم: “كلما بكرت فى النزول، زادت حصيلتك من الصيد”.. ولن يستغرب القارئ – والأمر كذلك- أن يجد مفردات وأوصاف لتفاصيل من عالم الأحجار المثير؛ أنواعها وأشكالها وألوانها وصفاتها.. إلخ تتداخل ولغة الرواية, أو يجد حالات بشرية يستبطنها الروائي استبطانا نفسيا بارعا, تنزاح فيه الحدود بين الفن والتحليل النفسي، والوصف المستقصي الدؤوب عبر اللغة الفاتنة، للأشياء والظواهر والتفاصيل، واختلاجات المشاعر، وانعكاساتها وتأثيراتها، كل ذلك مما برع فيه الطاهر وبلغ فيه غايات لا ينالها إلا أصحاب الفتوحات اللغوية.
يقول مؤرخو الرواية إن روائيي القرن التاسع عشر كانوا يكتبون لأنهم يعرفون أو يعتقدون أنهم يعرفون، ولذلك كانت رواياتهم تقدم إجابات صريحة وقاطعة عن الإنسان والكون والوجود وأسئلته، أما كتّاب الرواية في القرن العشرين فإن دافعهم إلى الكتابة هو أنهم حائرون ولا يعرفون، ولذلك فإن رواياتهم ليس إلا مجرد أسئلة كبيرة معلّقة في الهواء.
لكن الطاهر شرقاوي، أحد كتاب الألفية الثالثة البارزين والموهوبين، يسعى إلى الكتابة بدافع “الدهشة”، دهشة التحديق في هذا العالم، ودهشة إعادة اكتشافه من جديد، ودهشة خلقه مجددا.