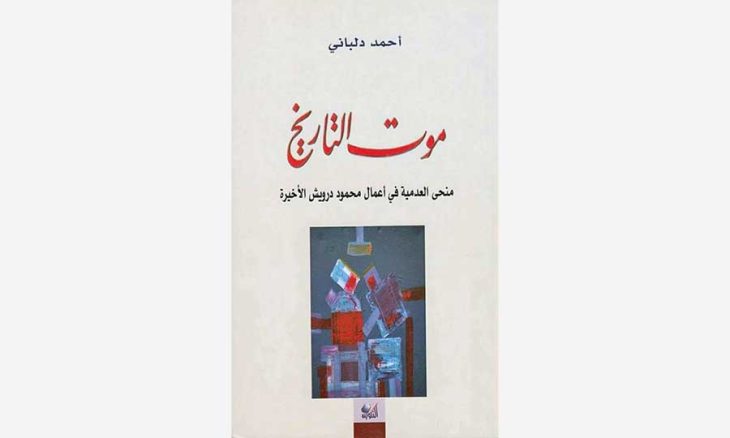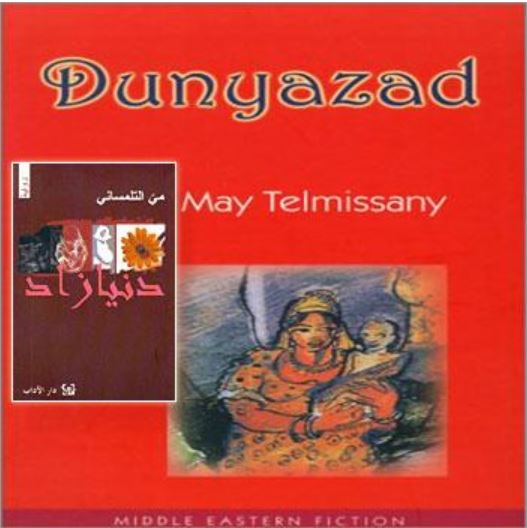محمد عبدالله الخولي
مُدّ كفّكَ
واسرقِ الفُرصَ القليلةَ
كلّ ثانيةٍ حياةٌ
والحياةُ تفِرّ من فوقِ السّلالمِ
صراع الأنا الشاعرة/ الإنسان، كثيرا ما تتجلى في شعر سلمى فايد، طوباوية ربما لا تظهر في تجليات ناسوتها البشري، بقدر ظهورها في لاهوتية النص، ثمة حجاب يفصل بين عالمين.. عالم الناسوت/ الجسد، وعالم اللاهوت النص/ الحياة كما تراها الشاعرة، والتي هي مبتغى الذات المستترة في عوالمها التي تخلقها الذات حال فقدها ” أناها” في عالم الناسوت البشري، ومن هنا يحتدم الصراع بين ماهو ظاهر وما هو مستتر خفي، يتطلب ذاك الصراع محاولات مستمرة من الذات الباطنة، لتحقق وجودها على السطح، وإن كان أدنى ظهور للذات، ما تجلى منه مصطبغا بعلامات النص، التي تشكل نسقا علاماتيا، تتبلور فيه الذات/ الأنا..، “
واسرق” هو فعل باطني على التحقيق-،. ما يسرق أيضا- غير مرئي في عوالم ناسوتنا البشري، سرقة يتطلبها الصراع من أجل بقاء ” الأنا” ويشكل النص أول درجات ذاك الصراع ” الحياة – السلالم” الحياة. محاولة الوجود الذاتوي،. مقتضيات الطبيعة البشرية/ الموت/ السلالم، تلاحق / صراع، سرقة.. تقتضي القنص السريع للظفر بالحياة، سلالم تهبط منها بسرعة فائقة أيضا- تتلاشى الحياة تنتهي.
..
..
لم يعُدْ مِما جمَعتَ الآن إلّا
لحظةٌ
فيها تؤلّفُ نُكتةً عمّا رأيتَ
تسيرُ
تلمسُ جلدةَ الأرضِ/الحقيقةَ
تستفزّ حماقةَ الجدوى
وتسخرُ من وقوفِكَ
كلّما شُفتَ البدايةَ
مثل مجنونٍ
يُخوّفُهُ السّقوط
تختزل الحياة في لحظتين.. لحظة المحاولة من أجل البقاء، ولحظة أخرى تختبر فيها الذاكرة اللاهوتية، فور هبوط الذات / الأنا من سلالم الحياة، لحظة كان الصراع فيها محتدما بين ناسوت الجسد ولاهوت الروح، ولحظة أخرى تتجلى فيها الذاكرة في أعلى النص لتختبر الجسد/ الناسوت/ الذكريات، سخرية من تلك المحاولات التي سرعان ما اختزلت في ذاكرة النص، تتراءى أمام عيني ناصها/ مبدعها، وهو يسخر مما كان من محاولات . . حتما- باءت بالفشل وكان هذا مقدرا لها ازلا، فلا تجل لعالم اللاهوت في الناسوت البشري إلا بعملية صلب محققة على جسد النص/ الحياة، كصلب المسيح- وفق معتقد النصارى- ودون ذاك الصلب، سيظل اللاهوت منسحقا تحت سلطاوية الحكم الناسوتي.
….
الوقتُ
مسألةُ الهروب
الطّوب
يسقطُ
والحياةُ
تفرّ من فوقِ السّلالمِ
والمُصيبةُ
عُمرُها أزَلٌ منَ القصصِ التي
منحَتْ أُلوهتَها بكلّ بساطةٍ
لخيالِ كاتبِها البسيط
تلك الفقرة تسمى العلامة الشارحة والمشرحة والممسرحة لما ألغز في النص، وكأنها .. أعني تلك الفقرة، امتداد لما ارتآه الناقد، وكأن الباث/ المبدع، يضع كفا فوق كف الناقد، فما استشرفه المؤول أقر به مبدع النص في تلك الفقرة الشارحة لما كان مطلسما في العالم النص .. قبلا-
فهذا الطوب يسقط/ يتهاوى. . وكأنه يحاكي تلك المحاولات اللاهوتية لتحقق حياتها في عالم النص/ الناسوت، وأن تلك المحاولات .. ، كانت مقدرة ازلا،. وما كانت سلوى حلم بسيط بساطة من اعتقد أنه لن يتهاوى التمثال ويسقط الطوب، وتتهاوى الأحلام من فوق السلم، ومن ثم تختزل في نص مؤلم موجع كنص سلمى فايد.
..
كان البناءُ السّهلُ
مِن لحمٍ وأوردةٍ
وأنتَ هناك
ما قبلَ البدايةِ
لستَ مُضطرًّا لتسرقَ فُرصةً
الطوبُ يسقطُ
مِثلنا
من جثّة التمثال
تتحدث سلمى فايد وهي تقرأ في سفر اللاهوت أو مزمور سفر التكوين في العالم الغيبي، يحكي ما كان هناك، الحلم/ الإنسان الذي تجلى إتيانه عبر أوردة الحياة ثم تشكل الناسوت وتحقق وجوده في العالم الظاهر، تدعو الشاعرة ذاتها في عوالم لاهوتها ألا تأتي إلى الظاهر فكل المحاولات السابقة باءت بالفشل، وظل الناسوت قابضا على زمام الحكاية دون جدوى.
. .
أَشعِلْ ما تراهُ مُناسِبًا
وانفُخْ دُخانكَ
فوق..
فوق..
في عينِ الخديعةِ
لحظة من كبرياء مزجت بخيبة أمل، ربما توارت خلف أدخنة من سيجارة الألم التي سيظل دخانها هو الحبل الوحيد الواصل بين فكرتين .. اللاهوت/ الناسوت.
لحظةٌ
لترى براءتَكَ احتِمالًا
للإدانةِ
هكذا تحكي الحكايةَ
دونَ قُمصانٍ وأربطةٍ
وتسقطُ
مثلَ كلّ الطوبِ
تشربُ
مرّةً
في صحّةِ الجدوى
ما اختزلته سلمى في النص، باحت به هنا بوحا تخلى عن كل محاولات الخفاء، ربما يكون هذا البوح من عالم اللاهوت إذ تجلى على سطح النص، ربما يكون وداعا أخيرا، يحكي فيه اللاهوت/ الذات/ الأنا، عن محاولاته الأزلية في الوجود الحر، وكلما حاول فكاكا، كبّله الناسوت بحكم أسباب الحياة التي يرفضها اللاهوت بالكلية، لأنه يجد نفسه دائما وأبدا واقعا في شباك الناسوت مهيمنا ومسيطرا عليه، ولكن الصراع باق ما بقيت سلمى فايد وبقي نصها يصارع فيه اللاهوت / الذات الواقع الذي يرفضه رفضا قاطعا.. وسيظل نص سلمى فايد مسرحا لصراع العوالم، التي تنبثق من عالم اللاوعي، بعد اختمارها في المخيلة الذاتية، فموضوع النص أو الصورة الشعرية- على حد قول- ” غاستون باشلار” هي العالم في صورته التي تحمل في طياتها الذات المبدعة، بعد أن أقام الشاعر علاقات جديدة، ربما فرغت المفردات ذوات التركيب من ذاكرتها التاريخية، وجذرها اللغوي، ودلالاتها الموضوعية، لينبثق لنا العالم في صورة مبتكرة، مطبوع عليها صورة الذات، التي سيظل النص حاملا لها، مهما تخافت في بنيته التحتية العميقة.