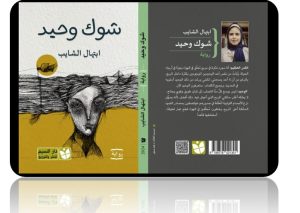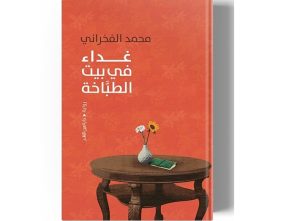د. رضا عطية
يرتاد الكاتب أحمد عبدالمنعم رمضان في كتابه الرابع، “أحلام الدويلير”، مجموعة قصصية، منطقة جديدة، حدًا ما- عليه، بخوض غمار الحلم والتجوال في رؤى اللاوعي كفضاءات لحكاياته ومجال لسرده، رغم ما يربط هذه النصوص التي تضمها هذه المجموعة بسابقتها من كتابات أحمد عبدالمنعم رمضان التي تنزع إلى خلط الواقعي بالغرائبي، غير أنّ رمضان، يدخل، بنا، هذه المرة، بكامل نصه في آفاق الغريب المتمخض عن رؤى اللاوعي وتهويماته الحلمية.
تفسح الأحلام الطريق أمام اللاشعور ليلفظ مكبوتاته وتعرية رغبات الذات الدفينة والتنفيس عن مشتهياتها المقموعة وفتح خزائن ذكرياتها المنسية أو المتناساة بفعل التقييد النفسي والضبط الشعوري الذي تمارسه الذات إزاء مخبوءات باطنها، وكوامنها الخامدة والمعرَّضة لتأجج نشاطها المباغت وثورتها المفاجئة في آنٍ.
كتابة الحلم هي كتابة شفرية؛ فالحلم ممارسة إحالية وحيلة إسقاطية للذات تقوم بها بوصفها عملاً تعويضيًّا عن رغبات يشق تحقيقها أو رغبات طواها الزمن في سراديب اللاشعور وجيوب الذاكرة، كذلك قد يبدو الحلم تعبيرًا عن مشاعر مقموعة لتحريمها أو لمضادتها للقانون الأخلاقي أو العرف الاجتماعي، فتمسي الممارسات الحلمية بمثابة عمل تطهُّري تمارسه الذات، لكنّ لاوعيها يعبّر عن رغباتها ومشاعرها المكبوتة عبر آليات رمزية وأقنعة تشفيرية.
تعتمد “أحلام الدويلير” بنية تضامية في تشكيلها النص الكلي وترتيبها نصوص المجموعة، فثمة ترابط علّي ما يصل بين نصوص المجموعة؛ حيث تبدأ بأصل الحكاية، مصدر الأحلام، ذلك الرجل الشيخ، بائع الأحلام، مرورًا بـ”باب الأحلام” بما يتضمّنه من أحلام، ثم “باب الكوابيس” بما تمثّله تلك الكوابيس من أحلام سلبية، وبما يرمز له الباب مكانيًّا إلى الانفتاح على داخل ما والعبو والنفاذ إليه وصولاً إلى “بين الأحلام والكوابيس” كمختتم للمتضامة السردية المتمحورة في فضاءات الأحلام.
بائع الأحلام: الذات ومناوشة السلطة الحلمية
يستهل الصوت السارد/ الرائي خطابه السردي بما يقدمه في نص بعنوان “أصل الحكاية” عن “بائع الأحلام”، ذلك الرجل العجوز الذي كان يبيع الأحلام للمارة وكان أيضًا يسلبها من العذراوات، ويبدو استعمال السارد لمصطلح “الحكاية” التي يقدِّم لنا بأصل لها ليضفي مسحة أسطورية ما على أحلامه، فيقول الصوت السارد:
منذ أن وعيت على الدنيا – وكان هذا منذ زمن بعيد يصل إلى السبع سنين – وهذا الرجل العجوز يجلس على ناصية شارعنا بجلبابه الأبيض الناصع، لا يتسخ جلبابه أبدًا ولا يتحرك هو من مكانه، يأتيه طلبة المدارس الأكبر مني سنًا في أثناء عودتهم من مدارسهم، يقفون معه بضع دقائق فتلمع عيونهم بالنشوة والابتهاج حتى يخرجوا من عنده والابتسامات تحتل وجوههم، كذلك طلبة الجامعات، أما الفتيات فكانت خدودهن تتورد ويسرعن ويهرولن في طريقهن منه وإليه. قلما توقف عنده رجل عجوز ممن فى سن أبي، فقد أتم أبي الأربعين عامًا منذ أسبوعين وأصبح عجوزا. كانت أمي دائما تحذرني من الذهاب إلى هذا الرجل بائع الأحلام فإنه يُذهب العقل، يخطف الروح، ويفسد الحياة والمستقبل، وتدعوني أن أحفظ جدول الضرب فهو أفيد لي وأقيم.
قال لي جارنا الذي يكبرني بعام واحد إن الرجل العجوز يسرق الأحلام من عيون العذراوات ويبيعها لزبائنه، وإنه يقضي ليله في العبث بعيونهن خاطفًا أحلامهن بخفة ورقة، دون أن يشعرن. سألني جاري أن نذهب إليه لنجرب متعة الأحلام، رنّت كلمات أمي بأذني، رفضت دعوته وعدت إلى المنزل. بعد ساعتين، ذهبت إلى الرجل العجوز متشوقًا لمتعة الأحلام المسروقة. (ص ص9-10).
يرتد الحالم أو الرائي/ الصوت السارد في استعاداته الحلمية إلى سن السابعة، حيث مرحلة الطفولة المتأخرة وبدايات تشكل وعي الذات بالعالم وتكوُّن لاوعيها واحتوائه رغبات ما ومخاوف ما من العالم، ويأتي هذا الرجل العجوز، بائع الأحلام، ليمثل الوسيط الذي يملك حلاً سحريًّا يساعد الذات على امتلاك العالم أو إخضاع العالم لرغباتها. كما يبدو هذا العجوز كائنًا أسطوريًّا، بمحافظته على مظهره وجلبابه دونما اتساخ، رجل لا يؤثِّر الزمن فيه، هو الذي يمنح الأحلام، وهو الذي يسلبها من العذروات، ليبدو كسلطة ما.
نجد التشكيل السردي لدى أحمد عبدالمنعم رمضان في “أحلام الدويلير” يجيد تشييد الحكاية الحلمية من “فواعل”/ شخوص تتفاعل فيما بينها في نسق درامي لشبكة العلاقات التي تجمع بينهم، فإذا طبقنا تقسيم فلاديمير بروب في نظريته للفواعل السردية، أبطال الحكايات الشعبية والخرافية، سنجد هذا متحققًا بشكل كبير في شخصيات هذا الحلم، أو بالأحرى الحكاية الحلمية لدى رمضان، فهناك البطل، أو الفاعل الذي هو الرائي أو الحالم، الصوت السارد للحكاية وفي المقابل هناك المرسل إليه الذي هو ذلك الرجل العجوز، بائع الأحلام، وتبدو الذات في تفكرّها باللواذ بذلك الرجل في حالة صراع (إقدام- إحجام) وتردد ما في الذهاب إليه حتى تحسم أمرها باللجوء إليه. وهناك الموضوع الذي يدفع الفاعل إلى التحرُّك نحو المرسل إليه الذي هو الحلم أو الرغبة في الآخر، الاستحواز على الآخر، كما كان في أحلام الذات الساردة هذا الآخر من المرغوبات فيهن سواء المعلمة، “ميس دينا” أو زميلات الدراسة، رفيقات الصبا والمراهقة، وهناك المساعد أو المعين الذي يكون هنا صديق البطل، أو الفاعل، الجار الذي يكبره بعام الذي يدفعه إلى الذهاب لذلك الرجل العجوز، “بائع الأحلام”، في المقابل هناك “المعارض” أو “العائق”، الذي تمثله، هنا، الأم، بممانعتها ذهاب الابن إلى بائع الأحلام. وتعمل هذه البنية المعقدة للفواعل المُشكِّلة لبنية الحلم على إزكاء الاتقاد الدرامي للأحداث الواقعة في الحكاية الدرامية من ناحية والإسفار عما يعتمل بداخل الذات من ترددات جدلية وخيارات متعددة حتى ليبدو أنّ هؤلاء الشخوص قد يمثلون أقنعة رمزية لترددات الذات في خياراتها.
وإذا كان للحلم قوانينه الخاصة التي قد تختلف عن قوانين الواقع الموضوعي أو تناقض مبادئه، فإنّ تمثُّل الذات للزمن وعلاقتهم به تبدو، هنا، مختلفة؛ إذ يجيء وسم الذوات بالعجز والشيخوخة من سن الأربعين، وكأنّ إحساس الذات بوطأة الزمن وأثره على الذوات يبدو أثقل في الحلم، ولكن لِمَ تبدو سلطة الأم وفاعليتها، هنا، في الحلم، أكبر من فاعلية الأب؟ هل تمثّل الأم، هنا، حضورًا شبحيًّا للرقيب الأخلاقي الذي يمارس عمل الكف الأخلاقي للذات عن الممارسات الموسومة باللاأخلاقية أو الغير نافعة؟ هل تمارس الذات، في الحلم، بأثر العقدة الأوديبية، إقصاءً ما للأب وقتلاً رمزيًّا وتهميشًا له؟
وبالرغم من أنّ الذات قد بدأت حكايتها مع الأحلام بشرائها من ذلك البائع العجوز إلا أنّ هذا الحال لم يدم، كما يخبرنا السارد:
لابد من حلم يعيد إلىّ حيويتى ونشاطى. ذهبت إلى حيث يجلس العجوز، لم أجده، سألت عنه الباعة المجاورين، أخبروني أنّه اختفى منذ أيام، لم يظهر منذ الأسبوع الماضي.
لم ألاحظ غيابه رغم مروري بناصية الشارع يوميًا.
جلست على الأرض منتظرًا عودته، افترشت الرصيف ومرت الساعات دون أن يظهر له أثر، ظن طفل صغير أنني أبيع الأحلام بدلاً منه، اقترب مني حثيثاً، تخبطت خطاه حتى وصل إليَّ مادًا يده القصيرة بعملات كثيرة صغيرة، مد يده دون أن ينطق بكلمة ونظر إليَّ متخوفاً، أخبرته أن بائع الأحلام لم يعد موجودًا هنا، ابتأس الطفل وأطرق برأسه وقال وهو ينظر إلى أمواله دون أن ينظر إليَّ “لو الفلوس ليست كافية، فقد آتي بالمزيد غدًا.” سكتُّ فرفع عينه إليَّ ببطء وأضاف “ولكن هذا كل ما بداخل حصالتي والله.” ابتسمت وسألته أن يأتي غدًا وسيكون حلمه جاهزًا. انفرجت أساريره، شكرني، ختم جملته بكلمة (يا عمو) واختفى عن نظري.
خرجت ليلاً، تجولت بين حجرات نوم العذراوات، سرقت من عيونهن الأحلام، احتفظت بحلم تلك العذراء ذات الجسد الفائر بجيبي الخلفي من أجل ليلتى.
جلست فى صباح اليوم التالي على ناصية الشارع، عاد الطفل الصغير وابتسامته تسبقه، كانت خطواته أسرع من الأمس، تقدم ومد يده بالأموال وهو يسدد نظراته المترقبة إليّ، أعطيته حلمًا طازجًا لفتاة جميلة شقراء. (ص ص12-13).
يبدو أنّ ثمة رغبة ما لدى الذات/ الحالم بتجاوز تلك السلطة الفوقية التي يمثلها الرجل العجوز، مانح الأحلام وبائعها، وسلبه إياها، ثمة رغبة تداخل الذات بأن تكون فاعلاً في لعبة الأحلام، وكأنّ الذات تريد أن تتجاوز السلطات البطريركية، حتى جعلتها المصادفة، ذهاب الطفل لشراء حلم من بائع الأحلام المتغيب عن مكانه، تتمكن من الاستيلاء على سلطة منح الأحلام باستيلابها من العذراوات وبيعها.
الذات والآخر: بين المراقبة والقنص
لئن كانت الأحلام تبدو، في الأغلب، تمثيلاً، بحسب التصوُّر الفرويدي، للرغبة الجنسية للذات الحالمة، فإنّ حضور الآخر، الجنس الآخر في الحلم، يبدو تأكيدًا لهذه الرغبة الجنسية التي يفسح لها الحلم مجالاً للتنفيس والتعبير عن نفسها:
وقفت أمامه بثقة أكبر من ذي قبل، قامتي مفرودة، وشعري يلمع من أثر (الجل)، قلت له بصوت أكثر خشونة إنني أريد حلمًا يناسب سني، لقد بلغت السادسة عشر ولم تعد أحلام ميس دينا وليوناردو تناسبني، أريد حلمًا آخر، حلمًا ساخنًا، تكون شريكتي فيه هند التي تجلس بالصف قبل الأخير بالفصل، أو .. لا .. لا.. فلتكن ميّ، ميّ، ألا تعرفها؟؟ تلك البيضاء المدملكة التي تصغرني بعام، بالصف الثاني الثانوي، صاحبة أشهر نهدين بالمدرسة، ولكني غيرت رأيي مرة أخرى، وطلبت منه أن يكون كل من هند وميّ بالحلم، يتقاسمان الليلة على سريري. لمحت صورة شارون ستون على غلاف مجلة لدى بائع الجرائد المجاور، لم أكن أعرف اسمها، أشرت إليها وطلبت منه أن يضيف تلك الشقراء على الحلم أو ليكن لها حلم منفصل. دفعت الكثير مقابل ذلك الحلم. (ص10).
فيما يبدو أنّ الحلم تاريخ لرغبات الذات وفقًا لمراحل حياتها العمرية والنفسية؛ فبينما تجنح الذات في أحلام السابعة، بدايات مرحلة الطفولة المتأخرة، إلى الميل الجنسي نحو المعلمة (ميس دينا)، فيما يُعدُّ امتدادًا أو إشباعًا موازيًا للرغبة الأوديبية بميل الطفل جنسيًّا، في هذه المرحلة، نحو الأم، فتكون المعلمة هي أيضًا، بديلاً للأم- فإنّ ثمة تحولاً ما في مرحلة المراهقة والصبا نحو الرغبة في من هن قرين عمري للذات أو من هن يمثلن إيقونات للشهوة الجنسية، فتمثل الأحلام مرآة للتحولات النفسية للذات.
وفي إطار صراع الإقدام- الإحجام قد تتوارى أحيانًا الذات في علاقتها بالآخر، الجنس الآخ،ر مكتفية بدور المراقبة كما في نص بعنوان “دائرة معوجة” الذي يحكي فيه الصوت السارد عن زميلته “ميرهان” وعلاقتها بزميلها في الصف، “خالد”، وولعها برسم الدوائر التي لا تأتي مستقيمة في استدارتها كما تريد:
عادت لمنزلها وكررت محاولاتها الطفولية لرسم دائرة مستقيمة، حاولت مرارا وتكرارا، كادت تنجح، اتسمت محاولاتها بعصبية مفرطة. احمرت وجنتاها وأذناها الصغيرتان، فشلت وألقت بقلمها بعيدًا.
في اليوم التالي رأته فسألته، هل تجيد رسم الدوائر؟؟ تعجب من سؤالها المباغت وأجاب بنعم. قالت له “بدون بَرْجَل؟؟” أجاب نعم. “منتظمة، دون اعوجاجات؟؟” تردد قليلاً ثم أجاب بالنفي .قالت له “وأنا كذلك”.
أتت بقلمها الرصاصي، رسمت دائرة غير منتظمة كالعادة، أو أكثر من المعتاد، وكتبت بداخلها اسميهما، خالد وميريهان … لم تحاول إعادة رسمها رغم اعوجاجاتها الواضحة وانحرافاتها البيّنة. نظرت إليه فاحتضن يدها واندمجا في دائرتهما الخاصة.
قالت له “أتحب البيتزا ؟؟”، هزَّ رأسه بالموافقة… قالت “فهل تعزمني على واحدة إذن؟؟”
ابتسما وانطلقا بينما تتشابك يداهما، مشيا ممسكين بدائرتهما المعوجة، متشبثين بها. لم تحب ميريهان قط الخطوط المستقيمة، كانت تظنها أسهل من اللازم، تفتقد لنعومة وتعقيد الدائرة، كانت تحب البيتزا وتكره السندوتشات… كانت تفضل الدوائر بما فيها من اعوجاجات وتقوسات، مهما شابتها العيوب. ظلت ميريهان تحاول رسم دائرة منضبطة أو تذكر اسم العالم صاحب المقولة إياها، ولكنها كانت دائما تفشل وترضى في آخر الأمر بدوائرها المعوجة الجميلة .(ص18: 20).
تكتفي الذات، هنا، في هذا الحلم، بدور المراقب، للعلاقة الحادثة بين رفيقيها، العاشقين، فيما تبدو الأنثى، الزميلة، “ميرهان”، باحثة عن كمال ما، دائرة مستقيمة، غير معوجة، فلا يتحقق، وبالرغم من تمسُّك الأنثى برغبتها في دائرة غير معوجة رسمًا، فإنّ ارتباطها بآخرها، قد جعلها تتنازل عن شرطها هذا، وكأنّ الحب يعمل على تخفف الذات من أحلامها المثالية ليدفعها إلى قبول ورضا بما تفرضه موضوعية الواقع.
وتتراوح مساعي الذات نحو الآخر في أحلامها بين الاكتفاء بمتابعته عن بعد أو الالتحام به والعبور إليه، كما في نص بعنوان “الحب على رقعة شطرنج” التي تحكي مراودة السارد لفتاة تقف منتظرة القطار على الرصيف المقابل بمحطة مترو الأنفاق:
تقدمتُ خطوات إلى الأمام، تقدمتُ نحوها، أمسكت بمضرب التنس ووضعت مقبضه على حدود الرصيف حتى بات ممتدا في الفراغ فوق القضبان متجها نحو الجانب الآخر، فوضعت هي جيتارها بنفس الوضعية من جانبها ليصنعا جسرًا فوق القضبان يمتد بيننا. تطوع المنتظرون بجواري على الرصيف بأن ثبتوا يد مضرب التنس من ناحيتي. ووقفت هي لتثبت يد الجيتار من الجهة الأخرى لتلتقي مؤخرتاهما بمنتصف الطريق متممين الجسر الممتد بيننا. وقفت مرتعشًا على مقدمة المضرب متجهًا نحوها فوق الكوبرى المرتج تحت أقدامي. (ص23).
تتبدى، هنا، في هذا المشهد الحلمي، فاعلية التخييل السوريالي للوعي الحالم في رؤاه، باعتبار تجاوزية الحلم لأي منطق، سواء منطق الطبيعة أو قواعد المكان وحسابات الزمن، فيكون التلاقي بين الذات وآخرها الأنثوي عبر التحام مؤخرة مضرب التنس بمؤخرة الجيتار وكأنّ الذات تقطع خط القطار بما في يدها ويد آخرها من أدوات لعب وتسلية، تعبيرًا عن السعي إلى تجاوز حوائل المكان وعوائقه، ليمسي الحلم فضاء لاشتغال الوهم، وتخطّي عقبات الواقع.
هياج الدوبلير: الذات من الرضوخ إلى الثورة
في نص بعنوان “هياج الدوبلير” الذي يُشتق منه عنوان هذه المجموعة “أحلام الدوبلير” يكشف الفضاء الحلمي عن توترات الذات/ “الدوبلير” بين قبوله دوره كبديل للبطل في مشاهد يمارس فيها عنف بقسوة إزاءه:
كانت مهنته التى اعتاد أن يقوم بها، اعتاد أن يُضرب بدلا ممن يظن الجميع أنهم أثمن منه، وحيواتهم أقيم من حياته، حتى هو ذاته شاركهم ظنونهم، واحتفظ بصور أبطاله فى حافظة نقوده وعلى حوائط منزله وداخل أحلامه.
كانت اهتماماته مختلفة عن الاهتمامات العادية لأصدقائه، فكان يهتم بخلفيته، عنقه، رقبته، وكل ما يمت لظهره بصلة. وكأى دوبلير بالحياة، كان ينظر بعين الشغف إلى الأبطال، يتمنى أن يكون بمكانهم، وأن يقع تحت يده دوبلير فيوسعه ضربًا، ولكن بكتب تاريخ الدوبليرات، فهذا لم يحدث أبدًا، هو مخالف لنظام الكون الذى وضعه الأبطال وتواطأ على تمريره المخرجون، واستفاد منه المنتجون. لقد ارتضاه الجميع بما فيهم الدوبليرات الذين أيقنوا أن هذا هو دورهم بالحياة. حتى عندما قرر مجموعة من المخرجين التمرد، الخروج عن القواعد وقلب النظام، وطالبوا الدوبليرات بارتداء أفضل الملابس، وأن يحلوا محل الأبطال، أن يطلوا بوجوههم على الشاشة لأول مرة، أن يضربوا الأشرار، ينقذوا العالم، ويقِّبلوا الفاتنات، ثار الدوبليرات على هذا النظام الجديد، رفضوه، قبلما يرفضه الأبطال!! لقد خشوا من مواجهة الكاميرات وعدساتها اللامعة، خافوا من مس ضيائها لوجوههم الرقيقة. لقد آمنوا أن الدوبلير هو هذا الشخص الذى يقضى حياته فى تلقى الضربات، وهو لا يختلف كثيرًا فى ذلك عن أى شخص عادى، فالإنسان خلق ليتلقى أكبر عدد من الضربات دون أن يسقط، حتى يضعف وتخور قواه، فيسقط صريع أحدهم. (ص ص115-116).
يبرز هذا النص/ الحلم تبديات الأزمة النفسية والوجودية التي تتفاقم داخل تلك الذات المهمَّشة التي تبدو وكأنّها أنموذجًا أيقونيًّا دالاً ينوب عن غيره من الذوات التي ارتضت الانسحاق افتداءً لغيرها ونيابة عن الأبطال، النجوم الذين يحصدون المجد. ثمة استثمار لرموز وعناصر لعبة التمثيل السينمائي حتى يبدو هذا النص الحلمي كأمثولة تعتمد على مبدأ المشاكلة المجازية والتوازي الاستعاري في التمثيل الأليجوري لمأساة الإنسان، في تفجير شعري ناجم عن الاستثمار الترميزي لصور الواقع وقوانينه.
يكشف هذا النص عن اعتيادية الهامشية والقبول بالانسحاق لدى الدوبلير/ الإنسان المنسحق حد عدم استطاعة هؤلاء “البدلاء” أن يلعبوا دورًا عكس الذي ألفوه وأن يتصدروا المشهد كأبطال، في تكريس لمألوفية الانسحاق وتأكيد لثبوتية القوانين المهيمنة على مسارات الوجود.
غير أنّ ذروة الحلم تتبدى في انقلاب هذا “الدوبلير” وتمرده على قواعد اللعبة وخروجه عن “النص”:
وقف أمام البطل واستسلم لضرباته المتلاحقة، سقط أرضًا، سالت دماؤه، بدا منهارًا، فصفق الجميع واحتضن المخرج البطل مهنئًا إياه.
كان كثير الوقوف أمام مرآته، يتبادل الحديث مع هذا الذى يواجهه فيها ويطيلان المناقشة، يتجاذبان الكلام ويختلفان ويعلو صوتهما، وقد يضرب أحدهما الآخر، قد يلكم وجهه الزجاجى فينجرح كلاهما، وتسيل الدماء على يد أحدهما وعلى وجه الآخر الذى يبدو متهشما ومنقسما إلى أجزاء متناثرة. كانت تنتهى كل هذه الأحزان بالتهام قطع من الشيكولاته الرخيصة محلية الصنع وهو مسترخ على كنبته المتهتكة.
وقف الدوبلير أمام البطل الذى سدد نظراته إلى العدسات المواجهة، استعد البطل لركل السكين التى يمسكها الدوبلير بيده اليمنى، أن يطيرها بركلة من قدمه اليسرى، ثم يهم بتوجيه بعض اللكمات إلى مختلف أعضاء جسده، يسقط على أثرها الدوبلير، فيصفق الجمهور وتتصاعد الآهات… ولكن، وقبل أن ينفذ كل منهما دوره، قبل أن يصرخ المخرج بحسمه المعتاد (أكشن)، قبل أن ينتبه البطل ويتوقف عن الضحك، كان الدوبلير قد شرع فى أداء دور جديد، دور لم يُمْلِه عليه المخرج، أمسك سكينه بحزم، حرك يده اليمنى سريعًا، أسرع من أن تلمحها عين، غرس السكين بصدر البطل، بقلبه تمامًا، بأحشائه، بكل مكان طاله، تسمر الجميع بأماكنهم وتوقف الزمن للحظات، التفت الدوبلير إلى الكاميرا لأول مرة، انعكست صورته على عدستها الدائرية، لم يسعد كثيرًا بمواجهة الكاميرا كما تصور، لم يجد المتعة التى طالما سعى إليها وتخيلها، ازعجته أنوار الكلوبات فزرّ عينيه، ثم رفع كف يده إلى جبهته حاجبًا النور عن عينه، ولكنه ابتسم، رسم ابتسامة تمامًا كالتى يتقنها بطله القتيل، هكذا ظن أنه يفعل ما يمليه عليه الدور، ابتسم بينما غاصت أقدامه فى دماء البطل. لم يستمر ظهوره بقلب الكاميرا طويلاً، دقيقة أو أقل، ثم انقطعت الصورة ومالت الشاشة إلى الظلمة وتنغبشت صورتها الرمادية المائلة للسواد مصحوبة بأصوات ضجيج متواصل وصراخ وكلمات مندمغة غير مفهومة. كان الدوبلير قد أغمض عينيه، أسدل جفنيه، أرخى كل عضلات جسده، تأوه بصوت غير مسموع، لم يسمعه أحد، لم يسمعه أى من الجماهير، لم تسمعه إلا نفسه. (ص ص116-117).
يبرز هذا التطوُّر الدرامي أو بالأحرى التصعيد الدرامي بالنص/ الحلم حد الانقلاب إلى النقيض والضد مآلات الكبت النفسي الذي تعيشه الذات المهمَّشة/ الدوبلير حد الانقلاب نحو الممارسة الدموية، ولو على صعيد الحلم، بما يكشف عن الصراع النفسي المحتدم الذي تتأجج نيرانه بدواخل الذات وفي أحراش لاوعيها.
في سرد أحمد عبد المنعم رمضان ثمة صياغة سينمائية تُمَشهِد الأحداث والمواقف وتسجل اللفتات الدقيقة، حيث العناية بخلفيات الشكل ضمن الصورة الكلية التي تشكِّل بنية المشهد، وهو ما يُكسِب السرد إيقاعًا دراميًّا ونفسيًّا.