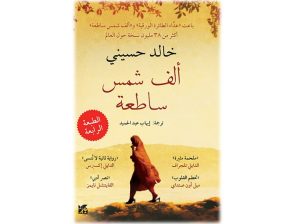وائل النجمي
استوقفتني ملاحظة (إيتان جلسون) ـ في تقديمه (لجاستون بشلار) ـ عندما قال: «بودي لو استطعت التوضيح كيف أن أصوله الريفية ومعرفته الحميمية بما تنتجه الأرض قد مارست تأثيرها على تكوينه الثقافي وعلى مجرى تأملاته الفلسفية»[1]، وعندها راودني السؤال التالي: ماذا عن تأثير المكان لدى المبدعين ذوي الأصول الجنوبية من كُتَّابِنا وأثره على سردهم؟ بأي قدر أثرت معرفتهم وخبرتهم بالمكان الجنوبي في تشكيل مكانهم السردي؟ وإذا ما وضعنا في الحسبان الشكوى المرة لأهالي الجنوب من الإهمال والتهميش، وفي مقابل ذلك نلتقط أيضا اعتزاز أهل الجنوب بميراث طويل من العادات والتقاليد، ويفخرون بأنهم – وحدهم – مَن يَمْلِكُون أسرار مكانهم، ذلك المكان الذي رغم قساوته الواضحة عليهم إلا أنهم يعتزون به، وبطبيعته وبأسراره، مما يجعلنا أمام حالة من حالات الرفض/الاعتزاز بالمكان، وهي ثنائية غريبة التركيب، فهل ظهر انعكاس ذلك في السرد الجنوبي؟ أم تجاوز المبدعون الجنوبيون عن هذه الخصوصية – رغبة في الوصول لقارئ قد لا تعنيه هذه التركيبة من خصوصية المكان الجنوبي؟
الأمر الثاني، لو افترضنا وجود هذا الانعكاس فإني أتسائل: هل سيتلقى القارئ الجنوبي التوظيف الجمالي للمكان في سرد الجنوبيين بنفس الطريقة التي سيتلقاها القارئ في مكان أخر؟ وتبدو هذه الأسئلة مادة خصبة للتأمل، وتنحو عن الاجابة السريعة في الوقت ذاته، وفي محاولتي هنا سأكتشف بعضا من الأبعاد التي نحتاج أن نرصدها حول هذه الأسئلة، إن ما أقدمه هنا هو خطاطة أولية أكثر من كونها اجابات واضحة، والنماذج التي اخترتها ربطها معا التنوع الذي تتيحه في الرؤية، فرأيت أنها تصلح للفحص الأولي لهذه الأسئلة، بيد أن هناك نماذج أخرى ستأتي لاحقا في دراسات أخرى، منها (أحمد أبو خنيجر)، و(عبد الجواد خفاجي)، و(نبيل بقطر)، و(أدهم العبودي)، و(هيام صالح)، و(رجاء الفولي)، و(إسحاق روحي)، و(خالد العجيري)، و(قسمة كاتول)، و(جمال فتحي)، و(محمد علي إبراهيم)، و(دعاء عثمان)، وغيرهم من روائيين وساردين الجنوب.
نبدأ من (محمد صالح البحر) – في روايته «حقيبة الرسول»، إذ يقول الراوي فيها: «لم يكن احد يعرف الجبل مثل أبي.»[2]
تتصدر المقولة بمفردها منتصف الصفحة، «الجبل» هنا يقف امامنا عبر تَشَكُّلين: الأول المكان الروائي، فالراوي يعلن لنا عن مكان ستدور فيه الأحداث، والآخر: الفضاء النصي، الذي هو أعم من مكان الأحداث، إننا هنا أمام «الجبل» كرمز ثقافي حضاري، كل قارئ سيتأثر بلفظة الجبل بحسب ما يُمَثِّل له من ايحاءات، هل هي إشارة للصحراء كموروث ورمز لانطلاق الثقافة العربية؟ أم هو رمز للصمود؟ أم رمز للبُعد والوحدة؟ كل هذه الرموز ستبقي حاضرة، خاصة مع التشكيل السيميائي النصي الذي شكله الكاتب بوضع الصفحة فارغة في الثلث الأعلى، وكأننا نشاهد فيها أفق الجبل الشامخ في الفراغ، لكن ماذا عما يرمز له الجبل في الموروث الجنوبي؟ إننا في الجنوب نتعامل مع الجبل بشكل آخر، إن الجبل في أماكن كثيرة هنا في الصعيد هو مكان للحياة، مكان للعيش، هناك قرى كثيرة تقع في الصعيد في أطراف الجبل، وفوق سفحه أحيانا، وهي قرى تتخذ لنفسها مسمى «حاجر الجبل»، وفي الوقت ذاته هناك النقيض أيضا، أماكن أخرى يمثل الجبل فيها مدافن الموتى، أي أنه يصلح أن يكون إشارة للحياة، أو إشارة للموت، فأيُّ تلك الاشارات يؤكد عليها النص؟ سنكمل القراءة حتى نرى:
«لم يكن احد يعرف الجبل مثل أبي.
وكان الجبل يقوم على رأس البلدة من جهة الغرب، منذ أمد لا أعرف مداه على وجه الدقة. لكن طالما أن عيني تفتحتا عليه منذ البداية، وقد كان كاملا وعاليا وعظيما، تكسوه تلك الحمرة التي تلمع في الشفق، وتهبه المهابة والقداسة الدائمتين، فلا بد أنه كان موجودا منذ أمد بعيد. لا يعنيني في ذلك حساب تاريخه جيدا، كيف هو ممتد في الزمن، فالأزمان السابقة ملك أصحابها فقط، أولئك الذين عايشوا أحداثها وطعموا حلوها ومرها، ملكوا الجبل وحده، من فترة التكوين، وصولا إلى ما ساعد به في إرساء قواعد الأرض، وما حمل من فوقه من طير وحيوان وبشر وأسرار، اما أنا فليس لي من التاريخ سوى تلك السنوات التي أعايش أحداثها، وتجول ذاكرتي فيها، مثل حصان جامح في الأرض البراح لا شيء يحده وليس من قوى تقدر على إيقافه أو توجيهه صوب ما هو محدد سلفا واستقر الرأي عليه.»[3]
تكشف لنا هذه الموضعة السردية للمكان عن جوانب تأويلية وجوانب تخيلية ستؤثر على تلقي الرواية، إن الإعلان الاستهلالي للمكان الذي قدمه الراوي يوضح عدة إحالات تؤثر على أفق التأويل لدى القارئ: بدءا من الموقعة المكانية للواقع القاسي الصعب الذي يعيش فيه الجنوب: «الجبل الذي يقوم على رأس البلدة»، مرورا بإحالات العَظَمَة والقوة التي يمثلها الجبل، ثم المهابة والقسوة، لقد بدأ الكاتب يوظف خبراته المكانية بكونه أحد من يعيشون في الجنوب بشكل أكثر من رائع، دامجا ذلك برؤيته الكونية ورؤيته للأفق الإنساني أيضا، إنها تأملات في المكان محملة بعمق فلسفي تحلق في أفق الفضاء الإنساني بعامة، ورغم ان الكاتب يقدم لنا نصا روائيا إلا أنه ينجح في تأصيل صورة شاعرية في مخيلتنا حول ذلك الجبل الذي يخلع الراوي عليه حُلَّة التاريخ، ذلك الجبل بما له من عراقة تاريخية، وبدوره العظيم في إرساء الأرض، إن قوة الكلمات التي يقول فيها: «ملكوا الجبل وحده»، فمن ذلك الذي يستطيع أن يملك الجبل إلا إن كان هو في عظمة الجبل، وراسخا في مواجهة هموم الدنيا، أو كما يقولون في المثل يا «جبل ما يهزك ريح» كناية عن صمود الشخصية، فهنا المكان انعكاس لصمود الشخصية وقوتها.
إذن تتأكد أمامنا مقولة (غالب هلسا) التي يقول فيها: «(…) أن العمل الأدبي حين يفتقد المكانية فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته. إنني أشعر عند قراءة عمل كهذا أنني أقرأ ظلا شاحبا لعمل قرأته من قبل»[4]، لكن هذا ينطبق على أي نص بالتأكيد، ففيما خصوصية الجنوب في هذا؟ فلنكمل معا بعضا من سرد (البحر): «لم يكن صعود الجبل بالأمر الهين، أحيانا كانت الصخور تختفي لتحل مكانها رمال ثقيلة، تثقل الخطو وتتعب الجسد، لكن أبي اعتاد ذلك، قدماه قد تدربتا على الارتكاز جيدا بحيث تميل إلى الخارج وتنبطح كلها فوق سطح الرمال، تجمع تحتها أكبر قدر ممكن يساعدها على الثبات، لقد بدتا مثل خفي جمل عريضين وحانيين، وحين كان التعب يدركني بحيث لا استطيع التقاط أنفاسي، كان أبي يحملني مرة ونرتاح مرة(…) وهناك كان السن الرفيع الحاد الذي نراه من بعيد يختفي لتحل بديلا عنه تلك المساحة المستوية من الصخر الأحمر(…)»[5]
إنني أجادل بأن الجنوب ألقى على كُتابه خبرات ورؤية مكانية خاصة، مكنت الكثيرين منهم من تحقيق خصوصية سردية استقرأت رؤية خاصة بالمكان، واستخدمته ووظفته في طاقاتها الابداعية استخداما مغايرا عن الاستخدامات الروائية الأخرى للمكانية، ونحن لا زلنا مع (البحر) الذي من المفارقة أنه بينما بدأ مقطعه السردي الأول بالجبل، فقد أنهاه بالتأكيد أربعة مرات بأن أبيه كان يمتلك حياة كاملة شملت البيت والزوجة والصديق، وكأن المكان الذي بدأ به «الجبل» يقف نقيضا من هذه الحياة، أو يقف بإزائها معادلا موضوعيا كاملا لها، أو كأنه يقول حياة الجنوب : جبل.
أشرت في دراسة سابقة إلى ما يفتقره الناقد والباحث حول الدراسات الموثقة لظواهر كثيرة نشعر بها لكنه يحتاج للدليل العلمي عليها، فشخصية الصعيدي – في الواقع وليست في السرد – وأثر البيئة عليه بحيث تتشكل بطريقة ما، ووفق عادات معينة، نجحت بعض المدنية في تغليف بعضها بمظهر المدنية المعاصرة، لكن بقي بعضها الاخر عصيا على التغيير، كلها ظواهر أشعر بها وأحسها والتقطها، لكني لا أجد الدراسة العلمية الدقيقة لها حتى أستطيع أن أعتمد عليها، ومن ثم استطيع التقاط الازاحة التي يحدثها السرد عن الواقع لتحقيق فاعلية جمالية، لذا أؤكد هنا على ضرورة اجراء مثل هذه الدراسات، لكنني سألجأ إلى آلية أخرى الآن أستطيع منها أن ابرهن على القيمة المغايرة للوصف المكاني في السرد لدى المبدع الجنوبي، فالمعاناة التي تركتها الجغرافية القاسية للمكان، جعلته – ذكرا أو أنثى – حساسا في توظيف المكان بشكل جمالي، تقول (منى الشيمي) في احدى قصصها: «مزارع كلية الزراعة صامتة في الخلف، والصوبات نائمة تحت هدأة الليل، وصف رؤوس النخيل يبدو جواري مستسلما تماما لنعومة الظلام، والهواء البارد يدور ويكوم الأتربة في ركن بعينه على السطح. صوت الهدير القوي للسيارات القادمة من الهرم وفيصل يصلني في مكاني، لكن بصوت خافت ومنتظم.»[6]
لماذا اختارت الكاتبة البدء بوصف «مزارع كلية الزراعة»، وأثر السكون والصمت بهما، بينما هناك في الوقت نفسه حركة وضجيج في شارع الهرم وفيصل؟ وماذا عن التصوير الشاعري المستفيض في وصف عمل السكون ومداعبته بالمزارع والحقول، وعلى النقيض الوصف السريع الفاقد للتأصيل الشاعري لهدير السيارات؟ هل اختارت الكاتبة المكان الأقرب لنشأتها أولا لتقديم تقريرها عنه في سردها، ثم جعلت ذلك مؤشرا للصراع الذي يعتمل في داخلها ما بين الخجل الموروث الذي جاءت به من مكانها في الصعيد، والجرأة التي تحاول أن تكتسبها وهي تقيم في القاهرة، فمثلما كانت حالتها النفسية بين صراعين، عبرت عنهما – بوعي أو بدون وعي – عبر تجسيد المفارقة بين الزحام والضوضاء والصخب الذي يعتمل في شارع الهرم وفيصل، وبين الهدوء الذي يلف مزارع كلية الزراعة، والصوبات النائمة في هدأة الليل، ورؤوس النخيل المستسلمة للريح، إن المكان يتم توظيفه ليصبح رافدا من روافد السرد في حد ذاته، إنه أحد عناصر التلقي، وما أطرحه للمناقشة هنا هي افتراضية أن القارئ الجنوبي وهو يقرأ مثل هذه المقاطع سيتلقى وصف الصوبات والنخيل بشكل يختلف عن تلقي القارئ الشمالي، ربما هناك تناص بين البيئة الجنوبية وبيئة الأرياف الشمالية في مفردات الزراعة والنباتات، لكن الفرق شاسع من حيث جغرافيا التواصل بين القرى والمدن والمساحات الوعرة التي تختلط في الوقت نفسه بالمساحات الخضراء، إن انشطار الذات الصعيدية بين الخضرة والجبل، بين الرغبة في التقدم وأسر العادات والتقاليد، كل تلك أمور جعلت الحس المكاني مرهفا لدى الجنوبي.
إذن وفق ما يقوله (ميشال بوتور): «(…) فالمكان الخيالي هو إذن تخصيص لهذا “المكان” المستحضر والمضاف إلى المكان الحقيقي.»[7]، أتسائل: كيف خصص الجنوبيون مكانهم خياليا؟ كيف استطاعوا التغلب على وعرته وبؤسه حتى يصنعوا من هذه العناصر الفقيرة الصعبة جمالا فنيا؟ فلنتأمل وصف (عبد السلام إبراهيم) التالي: «فإذا هو ثعبان طويل مستبد بطلعته يسعى بين الخوص الجاف المرصوص فوق جريد النخل المستعرض الذي يكسو سطح السقيفة، فأحدث جلبة رقيقة، تهادي من أعلى السطح إلى جدار الطوب اللبني المتعرج، ذلك ما شهدته الخالة حليمة دون أن تنطق بكلمة (…)»[8]، لماذا كل هذا الوصف الدقيق للسقيفة في لحظة تحرك الثعبان على القش؟ إنه تأثير المكان الذي لا يستطيع الراوي أن يهرب منه في مواجهة ظواهر عديدة نلمسها في الجنوب لكننا لا نعرف إن كنا قد عَبَّرنا عنها تعبيرا صحيحا في السرد أم لا؟ وأقصد بتعبير صحيح أي تعبير وفق الواقع كما هو، وليس كما ينعكس على معتقداتنا حوله، فضلا عن تحديد الانحراف الحادث في التعبير الجمالي بين الواقع والمتخيل.
يقول (محمد صالح البحر): «أحببت الجبل كما أحبه أبي، ولما كان الجبل كل حياة أبي فقد أضحى كل حياتي من بعده، وتترامي أطراف الجبل من تحتي ممتدة وموغلة إلى الأسفل في غور سحيق ومخيف، يتسع وتصغر صخوره الحجرية كلما نزل إلى الأرض، فيما تبدو الرمال مسطحة وفي استواء مرآة أحسن الصانع صقلها، لونها الأصفر الفاقع تتكسر من فوقه آثار أقدام كل التواريخ السابقة بكل ما حملت فوقها (…)»[9]
لا شك أن (محمد صالح البحر) يعتمد على قدر كبير من الترميز والتشفير، فلا شيء عنده يأتي على ما هو عليه في الحقيقة، لكن لا شك أيضا أن المكان بارز وواضح ويضغط بتأثيره على الراوي، فضلا عن توظيفه في سياقه الصحيح – لكن ذلك ليس ما أناقشه الآن – استحضر هنا مقولة (سيزا قاسم): «ويرتبط المكان ارتباطا وثيقا بمفهوم الحرية. (…) وتنطوي علاقتنا بالمكان – إذن – على جوانب شتى ومعقدة تجعل من معايشتنا له عملية تجاوز قدرتنا الواعية للتوغل في لا شعورنا.»[10]، فبأي قدر يخاطب الكاتب الجنوبي اللاشعور من خلال استخدام التوظيف المكاني؟ في أحايين كثيرة يبدو الكاتب الجنوبي مداعبا لاشعور القارئ، بإيصال رسائل خاصة يطلقها المكان الجنوبي تعبيرا عن فقره ومشكلاته، ومع ذلك يبدو عاجزا عن مواجهة مشكلات مكانه مواجهة مباشرة – إلا في حالات نادرة، فيقوم المبدع بتشفيرها وتقديمها برؤية أخرى، رؤية أوسع تختلط فيها أحيانا البيئة الجنوبية بالبيئة الشمالية، لكن سمتها الجنوبي هو المميز لها.
فلنتأمل السرد التالي من (عبد السلام إبراهيم) لتوضيح ما أقصده: «متأبطا قطعة قماش بيضاء صعد حائط الجبانة المرتفع، هبط ثم مشي ناظرا تحت قدميه يتفادى القبور المبني فوقها هرم والمكتوب عليها، والمطلية بألوان مختلفة، والقبور التي تساوت بالأرض والمحفورة بمخالب الكلاب والمهدمة، بينما كان يحدق في تلك التي ليست عليها علامات أو طوب مرصوص، كادت قدمه أن تنزلق في احداها، بشهقة عالية سحبها.»[11]
جمالية السرد تتحقق هنا عبر التدقيق في تفاصيل المكان، وعبر ايحاءات الصعود والهبوط لكي تهيء المتلقي لقبول انفعالات ومشاعر بطل القصة الذي يمر في داخله بصراع جم، صراع مصدره الأساسي ذكريات الحياة، والفقر المدقع، والمهمة الشاقة التي هو على وشك القيام بها[12]، فالتوظيف المكاني يأتي مخاطبا للاشعور الخاص بالمتلقي وضاغطا على الوجع الإنساني بعامة من خلال استلهام تفاصيل المكان التي قد لا تبدو للآخرين ذات القيمة نفسها.
في مجموعة «رشح الحنين» (لمنى الشيمي) بدأ السرد من أشجار المانجو، وانته بأشجار المانجو، في رواية «حقيبة الرسول» (محمد صالح البحر) بدأ السرد من الجبل وانته بالجبل ثم بالنزول من الجبل إلى المدينة، أما في «كوميديا الموتى» بدأ السرد من خشبة المسرح، وانتهى بجدار أم حليمة الذي تستقر فيه الثعابين، فالدائرة المكانية تحققت عبر النصين الأولين، وإذا ما توسعنا من مكان السرد إلى فضاء السرد فإن النص الثالث أيضا يبدو في دائرية مكانية تخدم العالم الافتراضي الذي سيطر من خلال الجو الملغز، والغموض المتشرب في الوقت ذاته بحياة الجنوب، وبالرؤية الإنسانية الكبرى لواقع الإنسان في أي زمان وأي مكان في مواجهة الحياة، وفي كل الأعمال لم يكن المكان مجرد موقعا للأحداث، لم ينفلت المكان سرديا من بين أيدي الرواة، بل بدا محققا لوظيفة أكبر في ضمن عناصر السرد، هي وظيفة التلقي، وظيفة الأفق المفتوح للفهم والمعاني التي يحملها النص لوعي وللاوعي القارئ سواء عبر المكان، أو الشخصيات أو الأحداث أو الحوار.
قلت أنني لن أقدم اجابات حول الأسئلة بقدر ما اقدم تهيئة للطريق أمام دراسة تأثير المكان في السرد الجنوبي، وهي الدراسة التي ينبغي لها أن تتم عبر محاور ليست نقدية فقط، بل نحن في حاجة ماسة لدراسات اجتماعية وأنثروبولوجية وجغرافية، وتاريخية أيضا، وإذا كانت نظرية الأدب المعاصرة تؤكد أهمية المكان بوصفه أحد عناصر الفاعلية في الأدب، وبوصفه مفردة من بين المفردات تماما كالاستعارة والكناية والتشبيه وغيره، فإنني اعتقد أن الدراسة هنا تؤكد على ضرورة عمل دراسة موسعة حول المكان الجنوبي، وتقارن بين المكان في الواقع، والمكان في المتخيل السردي، إننا بحاجة لتكاتف بين تخصصات عدة، وفي إطار عمل مسحي ميداني، وفي الوقت نفسه تحليل سردي مقنن، لكي نستطيع أن نخرج بنتائج مؤكدة حول الظواهر السردية التي نشعر بها، وندلل عليها، لكننا لا نملك اليقين العلمي حول تحققها في الواقع أو في السرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – إتيان غلسون: مقدمته لكتاب: جاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط3، بيروت، 1987م، ص36
2- محمد صالح البحر: حقيبة الرسول، دار العين للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010م، ص7
3 – السابق، ص 7-8
4 – غالب هلسا: مقدمة ترجمة: جاستون باشلار: جماليات المكان، مرجع سابق، ص6
5 – محمد صالح البحر: السابق، ص9-10
6 – منى الشيمي: رشح الحنين، سندباد للنشر والاعلام، القاهرة، 2010م، ص34
7- ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة : فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت – باريس، ط3، 1986، صـ 41
8 – عبد السلام إبراهيم: كوميديا الموتى، مشروع النشر الإقليمي إصدارات فرع ثقافة الأقصر، 2010م، صـ 66
9 – محمد صالح البحر: السابق، ص29
10- سيزا قاسم: ضمن كتاب: جماليات المكان، عيون المقالات، ط2، الدار البيضاء، 1988م، ص62-63
11 – عبد السلام إبراهيم: كوميديا الموتى، صـ 66
12- حيث سيقوم بطل الشخصية باستخراج جثة أبيه وتكفينها من جديد لأنه لحظة وفاته لم يكن لدى الأسرة ثمن الكفن وتم دفه والده بدون كفن، ويحضر الابن – بطل الشخصية – للجبانة لاستخراج جثة ابيه وتكفينها وسترها من جديد في التراب.