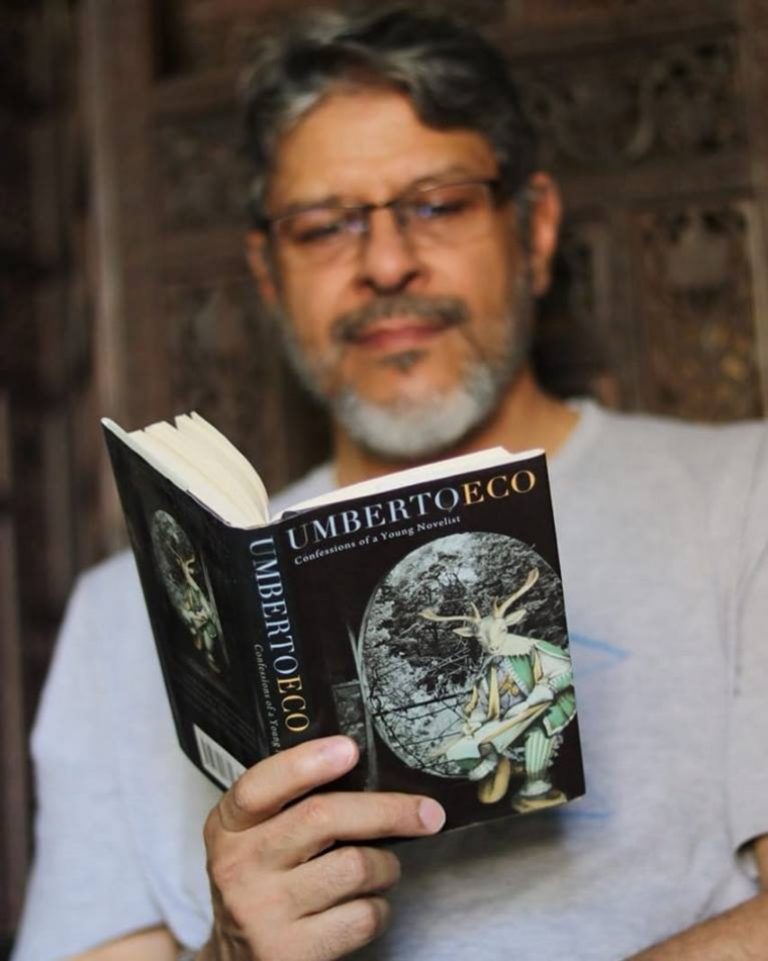ليليا جازيزوفا
ترجمة: محمد خلفوف
في هذه القصائد تتحدث الشاعرة الروسية ليليا جازيزوفا عن حياتها في تركيا، وشعورها بالاغتراب و الوحدة بعيدة عن وطنها روسيا… وكيف تقوم بتمضية الوقت من خلال مراقبة العالم والأشياء من حولها.
1
أنظر إلى المطر التركي،
جالسة في المقهى،
مع الغرباء.
وهذا هو السبب في أنهم يبدون لطفاء و قريبين.
النظر إلى المسلة المصرية
والناس يركضون بدون مظلات،
مداعبة قطة تموء باستمرار،
تنتظر نصيبها من سعادة اللحوم.
أن يتأخر المرء عن رحلته
و…بالعودة إلى المقهى
للنظر مرة أخرى
إلى المطر التركي،
أثتاء انتظار رحلة أخرى.
2
هناك القليل من الكلاب هنا،
والقطط مطرية ومتطلبة،
إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للعيش هناـ
الوقت يذوب مثل البقلاوة في فمك.
ولحسن الحظ
لايمكنك حتى الوصول إلى روسيا عبر هاتفك الخلوي،
ويجب أن يكون المرء على هذا النحو،
لعدم الوصول الى روسيا.
…أشعر وكأنني حجر
عند سفح الجبل
ومصيري.
وتبدو ديوني لأحبائي سريعة الزوال.
غير موثوقة وخفيفة،
حياتي في إسطنبول…
3
أنا أكتب على المناديل
جالسة في المقهى
في برج السلطان أحمد.
لاتوجد ورقة أخرى
من يعرف
هذا ما أريده في إسطنبول
لتعبئة الورق التركي
بأحرفَ سيرسلية.
ماذا يبشر؟
دورة تركية؟
نوبة قصيرة من السعادة التركية.
4
أعرف خطوات إسطنبول التسع،
الأخيرة التي تؤدي
إلى المقعد المفضل لدي.
ربما الأعز عندي.
أجلس عليه في المساء،
وأطل على مضيق البوسفور…
ماذا أتمنى أن أرى هناك؟
النظر الى البدر
وإلى المارة المتأخرين،
بدأت أفهم ـ
لم يكن على هذا المقعدـ
أن خطوات إسطنبول التسع أخذتني.
أنا ببساطة حصلت على كتاب جديد
عن الحياة الأجنبية في يدي.
……………………
*ليليا غازيزوفا: شاعرة روسية مقيمة في قيصري، تركيا ـ شاعرة وكاتبة مقالات ومترجمة. ولدت في قازان (روسيا) ، وتخرجت من معهد قازان الطبي وكذلك من معهد موسكو الأدبي (1996). تشمل منشوراتها خمسة عشر مجموعة شعرية منشورة في روسيا وأوروبا وأمريكا. تُرجمت قصائدها إلى العديد من اللغات الأوروبية ونشرت في مختارات دولية. حصلت على العديد من الجوائز الأدبية ، وهي السكرتيرة التنفيذية لمجلة Interpoezia الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، فضلاً عن تنظيم مهرجان كليبنيكوف الدولي (قازان – إيلابوغا). تقوم حاليًا بتدريس الأدب الروسي في جامعة إرجييس، قيصري ، تركيا.
التفكير في صديق ليلاً
هيرمان هسه ترجمة: ريهام مرسي...