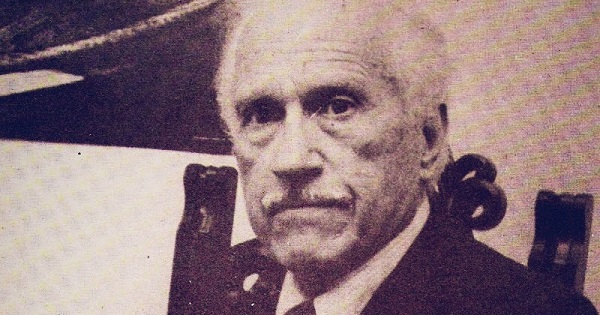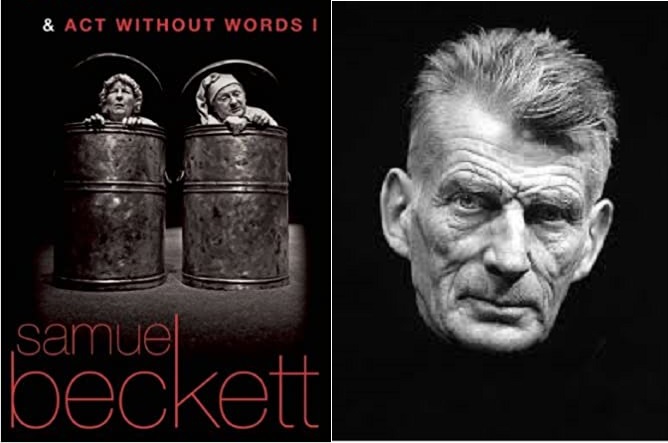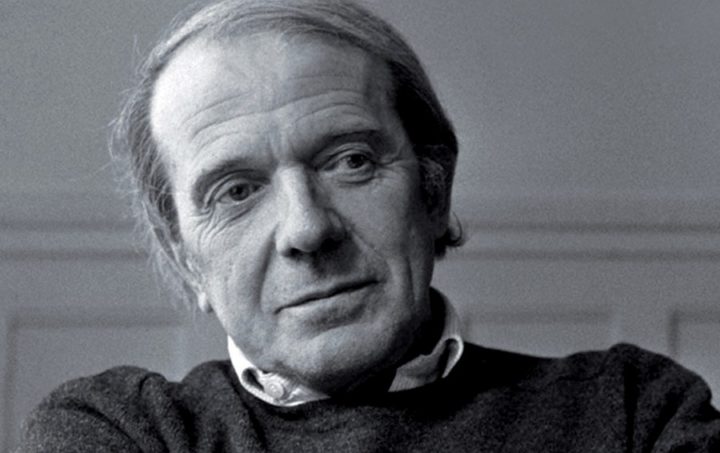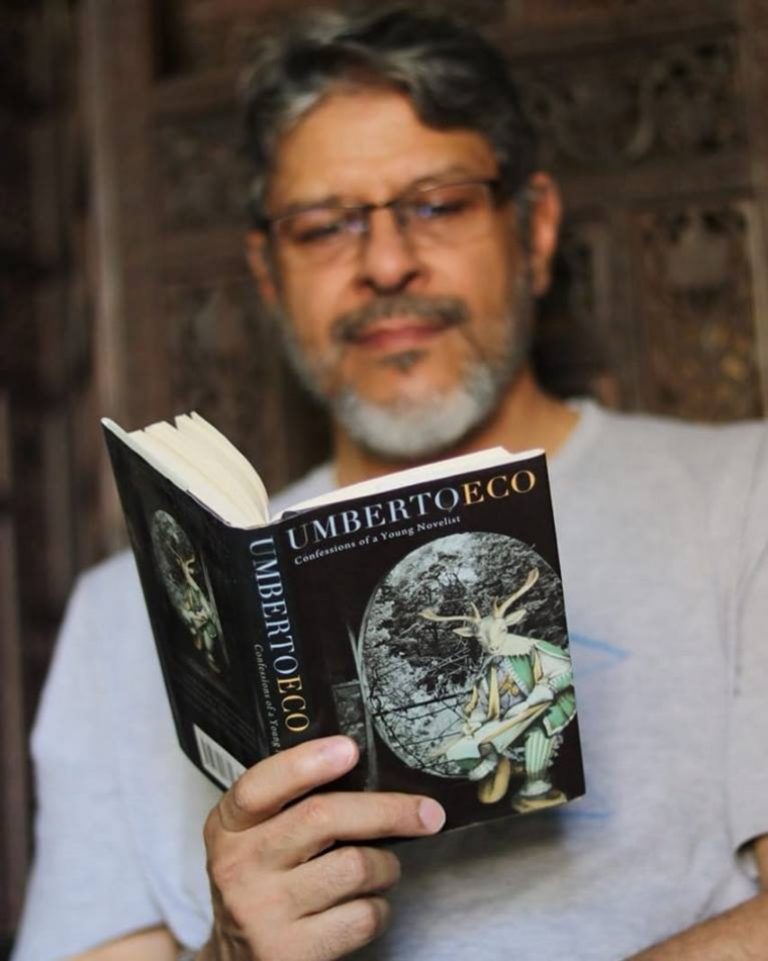التكييف المسرحي:برنارد دوفيلد/1953 Brainerd Duffield–
عن قصة القُرعة لِ:شيرلي جاكسون Shirley Jackson–
ترجمة: د.إقبال محمدعلي

لقراءة قصة القرعة لشيرلي جاكسون اضغط هنا
****
“شخصيات المسرحية:(ثمانية رجال و خمس نساء مع مجموعة كبيرة من الكومبارس)
* تومي، ديكي، مارتن، ديلاكروي، هاجسِن، جاك ويلكنس، العجوز ورنر، جو سمرس.
* السيدة دَنبر، السيدة واتْسون، الآنسة بيسوم، بِيلفا، تَسي هاجسِن”.
***
المشهد:( يجري في ساحة الميدان العامة للقرية، في 27 حزيران من السنة الحالية)
(الظلام، يسود خشبة المسرح… إضاءة بلون الكهرمان تبدأ في الاِنتشار بالتدريج لتضيء وسط الخشبة. إثنان من الأولاد ( تومي و ديكي)، يدخلان الساحة ونظرهما مركز على الأرض، يلتقطان بين آونة و أخرى، قطعة من الحصى أو الحجارة و يضعانها في جيوبهما) …… (( يجب أن لا يستمر البحث أكثر من دقيقة قبل بدء الحوار)).
تومي: أنا أحتفظ في جيبي بأفضل الحجارات.
ديكي: و أنا أيضاً.
تومي: (يشير جهة اليمين)، علينا بعمل كومة جديدة هناك و حراستها بالتناوب.
ديكي:حسناً. و إن حاول بعض الأولاد سرقتها، سنكون لهم بالمرصاد.
(يبدأ الولدان بتكديس الحصى في المكان الذي أتفقا عليه.. تدخل فيما بعد، بنتٌ أصغر منهما سنّاً، تقف تراقبهما..لم يَعر الولدان لوجوده إهتماماً بسبب إنهماكهما بمتعة تكديس الحجارة…يبدأ جرس البرج يدق بضربات منسجمة).
ديكي:(مدمدماً)، البنات يحببن التسكع.
تومي:أعرف ذلك.. و يفسِدنّ كل شيء.
( تحاول الصغيرة إضافة بعض الأحجار إلى كومتيهما لكنهما أدارا ظهريهما لها..شعرت بالإهانة، فتركتهما و خرجت).
( في هذه الأثناء يدخل رجلان( مارتِن و ديلاكروي) إلى وسط المسرح، يتحدثان بصوت خافت).
مارتن:الأولاد، أول من يأتي على الدوام.
ديلاكروي:صحيح. سيأتي الآخرون، بعد سماعهم قَرَعات الجرس..
مارتن:(يتطلع إلى السماء)، يوم رائع لمثل هذهِ المناسبة.
ديلاكروي:فعلاً. فقريتنا أكثر خضرة من القرى الأخرى في الولاية.
( يدخل هاجسِن، ممسكاً بيد ولده الصغير (ديفي) متوجها حيث يقف الآخران).
ديلاكروي: (موجها الكلام لِهاجسِن)،كيف حالك يا بيل؟
هَاجسِن:فريد..هوراس..(يصافح الرجلان).سعيد برؤيتكما.هل تعرفتما على ديفي؟
مارتن:(يربت على شعر ديفي)..نعرفه بالتأكيد. كيف حالك يا ديفي؟ (يوجه الحديث لِهاجسِن)، أهذهِ سنته الأولى في المشاركة؟
هاجسِن:نعم.لم يشارك في اليانصيب سابقاً. أليس كذلك يا ديفي؟(ديفي يوميء برأسه علامة الموافقة).
مارتن:هل ستصبح مزارعا جيداً مِثلَ والدك حين تكبر؟( ديفي يوميء برأسه علامة الموافقة)، هكذا الأولاد و إلا فلا.
ديلاكروي:(بِود) أبني شيستر،يرغب الذهاب إلى “المدرسة الزراعية” ليتعلم من الكتب البائسة..أخبرته، ان من الأفضل له، البقاء في البيت و التعلم مني كما تعلمت أنا مِن أبي.
مارتن:أنت على حق. عليه أن يعمل في الحقل، ليساهم بدفع الضرائب.
ديلاكروي:أخبرته ان الفلاح لا يحتاج لتشغيل مخه قدر ما يحتاج لتصليب عضلاته.
هاجسِن:ظهرٌ قوي، هذا ما يحتاجه الحَقلْ.
ديلاكروي:أين زوجتك؟
هاجسِن:(صمت قصير)ستلحق بنا قريباً.(قالها بقلق وقنوط).
( تدخل السيدة، دنبر و السيدة واتسون و تتجهان صوب الأطفال.. يستمر الرجال بالتحدث بحركات إيمائية).
السيدة دنبر:(أثناء السير) و كيف حالك مع الجو هذه الأيام يا شيلا؟
السيدة واتسون:لا بأس.
السيدة دنبر:لم يخذلنا الجو قَط، في “السابع و العشرين” من هذا الشهر.
السيدة واتسون:كان شهر حزيران بارداً، ممطراً.
( تدخل الأنسة بيسوم و تتوجه حيث تقف النسوة)
السيدة ديلاكروي:(تهز رأسها)، لم يَرحمنا المطر الغزير، هذه السنة.
السيدة واتسون:المفروض، ان يغيّر اليانصيب الحال.
السيدة دنبر:هذا ما يقوله المَثَل. ( يقع نظرها على الآنسة بيسوم).أنظروا من هنا!! مرحبا آنسة بيسوم. لم تتغيري البتة منذ آخر لقاء لنا.
الآنسة بيسوم:(بشيء من الأستياء)، و من قال أنني تغيرت؟
السيدة دنبر:(تتفحصها بدقة)، أخبروني انك اصبحت بدينة جداً و يبدو من النظر إليك، ان الأخبار لم تكن صحيحة.
السيدة واتسون:بالتأكيد غير صحيحة…سمعت إنّ لديكم زواجاً في العائلة.
الآنسة بيسوم:صحيح، إبنة أختي نينا، تزوجت من الشاب سام جيليات من بلدة رِكبي.
السيدة واتسون:هذا يعني، أنها من الآن فصاعداً، ستشارك في سحبة اليانصيب مع عائلة زوجها؟
الآنسة بيسوم:بالتأكيد. هذا هو التقليد المُتَعارف عليه.( تتوجه بالحديث إلى السيدة دنبر)، أعتقد يا جيني، بأننا لم نلتقِ منذ أحد الشهر الماضي. ألا تزورين المدينة؟
السيدة دنبر: عند الحاجة، فقط.آخر مرة زرتها كانت بمناسبة ذكرى الاِحتفاء بشهداء الحرب، و أبعد مكان أذهب إليه اليوم، قفص دجاجاتي.
السيدة واتسون:سَواءً أرَدْنا أمْ لَمْ نَرِدْ، مَزيّة اليانصيب الوحيدة، انه يجمعنا.
الآنسة بيسوم:أنا على يقين يا جيني، أنكِ مَنْ يتحَمَل مسؤولية العناية، بكلايد. كيف حاله الآن؟
السيدة دنبر:سيتعافى. غير أنه سَيُجَنّ لعدم قدرته الخروج من البيت و تفويت متعة المشاركة في اليانصيب.
الآنسة بيسوم:أنا واثقة من ذلك. (الآنسة بيسوم و السيدة واتسون تنظران إلى السيدة دنبر بتعاطف. تواصل النسوة الثرثرة فيما بينهن، بصوت غير مسموع).
(ديكي و تومي أبتعدا لمواصلة البحث عن الأحجار خارج خشبة المسرح. بدأ بعض أهالي القرية يفدون إلى المكان، يتراشقون الحديث الذي تحول فيما بعد إلى ما يشبه الهمس).
مارتن:بعد شرائي الجرار، قررت ان أزرع التبن بدلاً من البرسيم.
هاجسِن:أعتقد أنه سيكلفك نفس المبلغ لحصاد فدان واحد؟
مارتن:تقريبا.القطيع لا يهمه ماذا يأكل وبهذا لن تقلقني تقلبات الطقس.
ديلاكروي:(بضحكة مكتومة)، لا تقلق بشأن الطقس يا هورس”القُرعة في حزيران، تعطي الذرة بالكيزان”.
هاجسِن:(بأبتسامة باهتة)،هذا ما تعلمناه، ألا تتفق معي يا فريد؟
(يؤيده ديلاكروي بهزة من رأسه).
الآنسة بيسوم:(تنظر فيماحولها)، لم ألمح تيسي هاجسِن اليوم، هل رأيتِها؟
السيدة واتسن:كلا.بيل يقف هناك و بجانبه الصغير ديفي.
الآنسة بيسوم:أريد ان أعيد لها وصفة البطيخ المخلل التي فازت بها بجائزة الجمعية.
( يدخل جاك ويلكنس،و يوميء برأسه محيّياً السيدات)
جاك:معذرة سيداتي. كيف حالك سيدة دنبر و كيف حال كلايد؟
السيدة دنبر:شكراً جاك، أنه بخير الآن، و سيزيل الأطباء جبيرته في الأسبوع القادم.
جاك:و من سيخبره بنتيجة اليوم؟
السيدة دنبر: وعدته بإرسال تومي بأسرع ما يكون، بعد إعلان النتيجة.
جاك:(بأبتسامة عريضة) جيد. (يتركها و ينضم إلى جمع الرجال)..( النساء يتبادلن الإبتسامات من أماكنهن).
الآنسة بيسوم:جاك ويلكنس، فتى في غاية اللطف.
السيدة واتسن:انه محظوظ، فهو يمتلك نَفسَ نظرة والدته.
السيدة دنبر:للأسف، الكثير من الشباب،بدأوا يهجرون القرية و العدد بات يصغر، سنة بعد سنة.
الآنسة بيسوم:أتفق معكِ. أخبرني جو سمرس، ان عدد من سجلوا هذه المرة لا يتجاوز المائتي رجل.
السيدة دنبر:هل هذا صحيح؟
السيدة واتسن:أنه لأمر مريع!
(يدخل العجوز ورنر ببطء، متوجها إلى الوسط. يحييه أهل القرية أثناء سيره).
ديلاكروي:هاهو العجوز ورنر، إنّه مفعمٌ بالحيوية كما عهدناه.
هاجسِن:كيف الحال سيد ورنر؟
ورنر:بخير. (ثم يغمز له)،الروماتيزم يأتي و يروح.
مارتن:ما هو شعورك اليوم، بأعتبارك أكبر مواطن في القرية؟
ورنر:هل سمعتني أشكو كبر السن!!
هاجسِن:(بأبتسامة)،أخبرني بعدد المرات التي حضرت فيها قرعة اليانصيب؟
ورنر:أصبح عمري، واحداً و ثمانين سنة في شهر تشرين الثاني الماضي. وكانت أول قرعة يانصيب شاركت فيها، حين كان عمري خمس سنوات…عليك الآن، ان تحزر!!
ديلاكروي:هل تخلّفت مرةً عن الحضور، خلال هذه السنوات؟
جاك:ما زال قوي السمع،كما ترون.
ديلاكروي:أنه رائع.
ورنر:و سأعاود الحضور لمراتٍ قادماتٍ أُخر.
جاك:(بأبتسامة عريضة)نعم.دعهم يسمعوك ايها العجوز المحنك.
مارتن:(مخاطباً النساء)، هل سمعتن ما قال العجور ورنر “أنه سيعاود الحضور و لسنوات قادمة أُخر”.( همسات استحسان من الواقفين على الخشبة).
السيدة واتسن:شَهِدَ سبعة و ستين قُرعةَ يانصيب.
السيدة دنبر:تخيلي ذلك.
ورنر:اتمنى لو كنتم قد شهدتم هذا المكان في الماضي.كان لقرعة اليانصيب معنى آخر، حين كنت صبيا.
( تدخل بيلفا سمرس لابسة السواد، وتقف في الجانب الآخر المقابل للنساء وبيدها أدوات الحياكة التي ستشغِل بها وحدتها، طوال العرض، متجنبة التحدث مع الآخرين).
الآنسة بيسوم:حان الوقت.
السيدة واتسن:(تنظر حولها)، اعتقد ذلك. أرى جو سمرس، واقفاً على درجات مكتب البريد.
السيدة دنبر:انه يحمل الصندوق.
الآنسة بيسوم:أين أخته؟ هل هيَ هنا؟
السيدة دنبر:(توميء بأتجاه بيلفا)، أنها هناك، تجلس لوحدها كالعادة.
الآنسة بيسوم:لا أعرف كيف بأمكانه تحَمُّل هذه المرأة!
السيدة واتسن:أكره وجودها في بيتي.
(الناس مستمرة في الحديث بصوت خفيض. يدخل توم و ديكي مرة أخرى.يشاهدان قطعة حجر و يتدافعان راكضين لإلتقاطها).
تومي:إلتقطتها قبلك.
ديكي:أرجِعها لي.
تومي:في الحُلم.( ويدفعه)
ديكي:توقف.عليك ان تتوقف عن دفعي و إلا..!!
( يبدآن بالصراع. تتوجه إليهما السيدة دنبر و تمسك بتومي من معصمه).
السيدة دنبر:توقفا!
تومي:إتركيني. صدقيني، اناكُنت أول من رآها..
السيدة دنبر:لا عليك.. فلديك الكثير من الأحجار.!
( حاولت ان تمسك بديكي من ياقة قميصه إلا أنه نجح في التملص منها).
السيدة واتسن:إرجع.. انتظر و سترى ما سأفعله بك عند عودتنا إلى البيت.
مارتن:(يصيح على ديكي بحدة)، عليك بسماع كلام والدتك، هل فهمت؟.. ديكي:(يتقدم بأحترام صوب مارتن) آسف عم هوراس…( و يتجاوزه مرغماً، نحو السيدة واتسن).
جاك🙁 مؤشراً بأبهامه)، جو سمرس قادم. لم يتبقَ لدينا إلا القليل من الوقت.
ديلاكروي:(بسخرية)، على عوائلنا ان تقف في الطابور، إنتظارا للخبر المشؤوم.
( بدأ القرويون يتجمعون حَسَبَ عوائلهم)
هاجسِن:(لولده ديفي)، قِف قربي،فليس هناك ما يخيف.
( يدخل جو سمرس، مخترقاً الجمع، حاملاَ صندوقاً خشبيّاً أسودَ مع محراك خشبي، يتبعه رجل من المدينة حاملاً طاولة خشبية عالية يضع جو عليها الصندوق الأسود بوقار و مهابة).
جو:شكراً نوربرت.
(نسمع تنهدات القرويون عند دخول جو).
القرويون:ها قَدْ وَصَلَ.. كيف الحال، سيد سمرس. و الرئيسُ جاء أيضاً، يحمل الصندوق الأسود القديم.. مرحبا بك يا جو.. ..هيا، لنبدأ..
( يأخذ جو حزمة ورق من جيب سرواله و يضعها في الصندوق. يتوقف ليمسح العرق بالمنديل من على جبينه.كان غالبية أبناء القرية، يقفون مع عوائلهم، بجماعات صغيرة على الجانب الأيمن من خشبة المسرح. كانت الوحيدة التي تشغل الجانب الأيسر من الخشبة هي ( بيلفا).
جو:(بزهو)، تأخرنا قليلاً اليوم (يؤشر لجاك)، ها انت هنا، يا ابن ويلكنس. هل يمكنك مساعدتي في خلط الأوراق جيداً و بكل ما لديك من قوة. (يبدأ جاك بتحريك الأوراق بالمحراك الذي سلمه إياه جو). استدار جو إلى نوربرت،رجل المدينة:ساعده و عليك أن تمسك المحراك بإحكام..الأفضل ان تمسك الصندوق بكلتي يديك كي لا يتزحزح من مكانه، و ساعد جاك في التحريك.(لاحظ جو وجود بيلفا و سار بأتجاهها، متخطّيا الناس الواقفين في الطابور).. كيف الحال ياجماعة؟
القرويون: مرحبا بالسيد سمرس. كيف الحال جو؟
(كانت بيلفا مشغولة بالحياكة. أستقبلت أخاها بأبتسامة فيها الكثير من الغموض. اثناء المشهد بين جو و بيلفا، يستمر الآخرون بتأدية أدوارهم بالتمثيل الإيمائي)
بيلفا:(بجفاف)، لم يبق إلا القليل يا جو. اتمنى انك لم تنس وضع أسمي مع بقية الأسماء؟
جو:كلا يا بيلفا.. كنت أُراجع القائمة لتوي، و كان أسمك موجوداً.
بيلفا:(تنظر من وراء كتفه)، سيكون يومك طويلاً. الكل يتحدث عن مدى حجم المسؤولية الجسيمة التي يضطلع بها المسكين جو سمرزاليوم ( تهز رأسها بتعاطف مليء
جو: (بتجهم)ان كان هذا رأي الآخرين بيَ فيبدو ان فيه شيئاً من الصحة.
بيلفا:(منشغلة بالحياكة،أثناء الحديث)، أنا أُسلّي نفسي بمراقبة”الرجل المهم”، أثناء تأديته عمله. يركض هنا و هناك، بهمة و ولع، لينفذ المهمة الملقاة على عاتقه.
جو:(ينظر إلى أهل القرية)،سأكون ممتناً، لو خفّضتِ صوتك قليلاً.
بيلفا:و لماذا؟ لم يطلب منك أحد أن تأتي إليّ و التحدث معي.
جو:عليكِ مراعاة الجيران. بالسخرية) إضافةً إلى تحمل أخته الملحاحة.
بيلفا:(بأزدراء)، الجيران!! لو كان كلٌّ منا، لا يخاف ممّا يقوله الجيران، لكنّا قد نجحنا بالتخلي عن هذا الطقس الهمجي الذي لا معنى و لا قيمة له على الإطلاق. نصف شباب القرية ليست لديهم أدنى فكرة، عما يمثله هذا اليانصيب.
جاك:( يدير لها ظهره)، لا فائدة من التحدث معك!
بيلفا:و ما الشيء الذي يمكننا التحدث به، في زمنٍ، تسود فيه الخرافة و تغيب عنه الحكمة .
جو:(يستدير إليها)، علينا أخذ اليانصيب مأخذ الجد. فمن الصعب، تغيير عادات تَعوّد عليها الناس. إنهّا طبيعة البشر.
بيلفا:( تتوقف عن الحياكة و تجيبه بصوت خفيض غاضب)أنا أكره هذه المدينة بأهلها و أنت اسوأهم جميعا.. أنتَ مَنْ دفعه للهروب.. أنتَ مَنْ دفع أخانا للهروب.
جو:أنتِ لا أنا من دفعه للهروب، بسبب تربيتك التي جَعَلته ضعيفاً،جباناَ. أنتِ من دفعه الخروج إلى الشارع لِوعظِ الناسِ بنَبذَ عاداتنا.
بيلفا:تسميه بالجبان؟ كان لديه الكثير من الشجاعة و الأصرار ليقول ما يقول، في وقتٍ،كان فيه الجميع يحاربون أفكاره.
جو:(بأصرار)، ترك المكان برغبته. أنا لم أطرده.
بيلفا:(بإحتقار) مكافحة الآراء المتعصبة في داخل دارك تطلبتْ رجلاً، حقيقياً شجاعاً. الجبان،كان أنت و أمثالك.
جو: هل عليّ الإستماع كل يوم إلى هذا النوع من الأحاديث المجنونة!..إن كنت ترغبين في البحث عنه يا بيلفا، ساعطيك النقود. خذي قطار الصباح و سأضع إسمي فقط، في سحبة اليانصيب مِن الآن فصاعداً. هذا كل ما بوسعي ان أقدمه لك.
بيلفا:أنا لن أذهب إلى أي مكان. سأبقى هنا و أنتظر( تنظر إلى وجهه مباشرة)،أن يظهر أسمك يوماً فأنا لا اريد تفويتَ هذه اللحظة.(يستدير بغتةً و يتوجه إلى وسط خشبة المسرح. تقف جامدة في مكانها لدقيقة أو دقيقتين و تواصل الحياكة).
جو:حسناً جاك.. يبدو أن كلّ شيءٍ جاهزٌ الآن..
جاك:يسرني المساهمة في التهيئة، سيد سمرز.
جو:(لأقرب امرأة)، يبدو ان المشاعر اصبحت متأججة، أيتها السيدات..
السيدة واتسن:(تضحك ضحكة خافتة و تؤمي برأسها موافقة).لا تقلق يا جو، أنت تعرف مدى ثقتنا بك.
السيدة دنبر:كلّ شيء مضبوط، فجو يعرف ما يفعل.
( تتعالى ضحكات النساء القرويات)
ورنر:أتسمعَ صرخات النساء و قهقهاتهن.. لم يكن لديهن الجرأة أيام زمان من فِعْلِ ذلك.
ديلاكروي:انت تَحس بهذه التغييرات أكثر منا يا سيد ورنر؟
ورنر:من المؤسف رؤية جو سمرس، واقفاً يُنكِّت و يضحك، لا أحد يحترم المراسيم. أصبحت العملية، أشبه بالواجب.
جاك:و كيف كانت تختلف سيد ورنر؟
ورنر:كانت تختلف كلياً. كان على الجميع الوقوف بصفوف وقبل القُرعة، يقوم الرئيس بتلاوة كلمته بإيقاع، منغم،كما الأنبياء.
هاجسِن:(ينظر بين الناس مستطلعاً، باحثاً عن زوجته)، أين زوجتي بحق الجحيم؟
( يضحك كلّ من حوله)
مارتن:بيل هاجسِن، فقَدَ نصفه الآخر.
هاجسِن:(يخاطب السيدة دنبر)، هل رأيتِ جيني؟
السيدة دنبر:لا، لم أرها يا بِيلْ.كنت أنا ايضاً، أفتش عنها.
مارتْن:لا أعتقد أنها ستأتي.
الآنسة بيسوم:تَتَخَلّفَ عن حضور قرعة اليانصيب؟ لا يمكن تصديق ذلك!
هاجسِن:لا أدري ما الذي يدور داخل عقل هذهِ المرأة… .!!
ديلاكروي:شهد هذ الصندوق الأسود جولاتٍ و جولات.
ورنر:بالتأكيد. هذا الصندوق موجود قبل ولادتي.بل و حتى قَبل ولادة والدي.
جاك:تَخَيَّلْ!!.
ورنر:يقال انه صنع من نفس قطع أخشاب الصندوق الذي أُستخدِم لأول مرةٍ.
ديلاكروي:أعتقد ان رؤيته تذكرك بالكثير؟
ورنر:أنه يعود لزمن المستوطنين الأوائل في هذه القرية.
جاك:هذا يعني إنَّ علينا أن نصنع واحداً جديداً.
ورنر:(بذعر)، كلا ياولدي لا تقلْ ذلك، حتى و إن كان من باب الضحك.
ديلاكروي:كلا يا جاك، نحن لا نريد تدمير تقاليدنا كما يفعل الآخرون ولن نسمح بتغيرها، وسنبقى متمسكين بها، بكل حزم.
ورنر:أتذكّر جيداً، متى بدأوا بأستخدام الورق لكتابة الأسماء بدلاً من القطع الخشبية.
جاك:عجيب! قطع خشبية؟؟
ورنر:(يوميء برأسه مؤكداً)، رغم أنني كنت صغيراً، إلا أنني ما زلت أتذكرها.
(كان جو مشغولا بمراجعة قائمة الأسماء بتمعن، و كتابة بعض الملاحظات على قطعة من الورق، مستشيراً أحد الرجال الواقفين بجانبه).
جو:(بصوتٍ عالٍ)،ايها الناس، انا على إستعداد الآن لبدء اليانصيب. لكن قبل هذا أريد القيام بقراءة القوائم على الوجه التالي:ذِكر أرباب العوائل و أفرادها في كلِّ بيت، و لكلِّ عائلة.
السيدة دنبر:هيا، باشر عملك سيد سمرس.
السيد ورنر:جو لم يخطيء أبداً.
(تدخل تيسي تضع مئزراً حول لباسها).
السيدة دنبر:عجباً تيسي! لِمَ تأخرتِ؟
تيسي:كنت مُنغَمِرة في التنظيف و نسيت في اي يوم نحنُ.( تضحك بعض النساء بصوت خافت)..علاوة على ان بيل كان قد خرج لقطع الأخشاب…بحثت عن الصغير ديفي فلم أجده، تذكرت حينئذٍ اننا في السابع و العشرين من الشهر، فجئت راكضة (كانت تجفّفُ يديها بمئزرها أثناء الحديث).
السيدة دنير:جئتِ في الوقت المناسب فما زال جو يدقّق القوائم.
تيسي:يبدو ليَ الوقتُ قصيراً جداً بين قُرَعَ اليانصيب، فنحن بالكاد ننتهي من سحبة لندخل سحبة جديدة.
السيدة دنبر:الزمن يمضي سريعاً يا عزيزتي.
تيسي:(تنظر حولها)، أين بيل؟ أها، ها هو هناك.جيني، أسمحي لي بالمرور.
(يفسح لها أهل القرية الطريق، للأنضمام لهاجسِن).
القرويون:هَيْ.. هاجسِن ، لقد وَصَلتْ.. زوجتكَ وصلتْ ..بيل، أنظر .. وصلتْ في النهاية.
تيسي:(تنحني لديفي)، إعطِ قبلة لأمك،(يقبلها ديفي) هذا ولدي المطيع.(تلقي نظرة على هاجسِن. يبتسم لها أبتسامة فاترة و يمسك يدها).
هاجسِن:جئتِ أخيراً؟
جو:(يصيح بدماثة)،كنا سنبدأ دونكَ يا تيسي.
تيسي:(بأبتسامة مصطنعة)، لا أعتقد يا جو، إنّك كنت تريد مني ترك أواني الطعام الوسخة في الحوض؟
جو: بالتأكيد لا يا سيدتي.
(تعم المكان موجة من الضحك)
هاجسِن:لا تتحرك من مكانك يا ديفي، أريد التحدث مع أمك.
(يقف ديفي مع بقية أطفال القرية.يأخذ هاجسِن بيد تيسي و يقف في مكانٍ لا يسمعه فيه أحد. لم يكن غاضباً قدر ما كان قلقا،مشغول البال).. لِمَ تأخرتِ؟؟
تيسي:لا أدري يا جو… كنتُ سارحةَ الذهن..لكنّي هنا الآن.
هاجسِن:و ماذا عن ديفي و محاولاتكِ إخفاءه؟
تيسي:إخفاؤه؟ أنا لم أُخْفِه. لم ظننتَ انني أُحاول أن أخفيه؟؟
هاجسِن:عثرت عليه في عِلِيّة الأصطبل و أخبرني انك طلبتِ منه ان لا يغادرها.
تيسي:كُلّ ما قلته صحيح يا بيل. و ثق انه كان في نيتي الذهاب لجلبه.. كان في نيتي جلبه..صدّقني.
هاجسِن:إذاً، ما سبب تركك إياه هناك؟
تيسي:انه ما زالَ طفلاً صغيراً يا بيل. لتوّنا، احتفلنا بعيد ميلاده.. هؤلاء الصغار ما زالو يلعبون بدُماهِم فلم نشركهم في مِثلِ هذهِ البلبلة؟
هاجسِن:أنا نفسي مررت بهذهِ التجربة في صغري.
تيسي:أدرك ما تقول يا بيل. انا و إياك كبرنا على هذا التقليد منذ طفولتنا.
هاجسِن:هل تعتقدين انك ستفلتين من فعلتك؟ أنت تعرفين أن إسم ديفي مُدرج ضمن إسم عائلتنا، كما و انك تعرفين ان جو سمرس ،يدقّق كثيراً في هذه الأمور، فلم تجعلينا أضحوكة أمام الآخرين.
تيسي:لقد أخبرتكَ أنني كنت عازمة على جلبه. لِمَ لا تصدقني؟
هاجسِن:توقفي عن هذا الهراء. الكثير من العوائل هنا، لا يقدّرون نساءهم بالطريقة التي أفعل، فما الذي جرى لك في الآونة الأخيرة؟
تيسي:قُلت لكَ لا شيء.
هاجسِن:أتمنى أن لا تطلبي مني في المرة القادمة، التخلي عن اليانصيب، كما تفعل أخت جو سمرس البائسة.
تيسي:ليس لهذه الدرجة.. لكنّي أعرف، ان الكثير من الأماكن تخلّت عن اليانصيب و بالأخص القرى في الشمال.
هاجسِن:لن يحصل ذلك.انتظري و سترين.
تيسي:أنا لم أقل ان هذا سيحصل. كلا، أنا أعتقد أنّ لليانصيب غرضاً مفيداً فأنتقال هذا التقليد من جيل إلى جيل، يفترض أن تكون وراءه حكمة ما.
هاجسِن🙁 يهز رأسه مبتسماً)،عليك ان لا تشغلي نفسك في البحث عن العيوب.
جو:(يبلع ريقه)، أظن ان علينا أن نبدأ الآن الإنتهاء من هذا الموضوع كي نستطيع العودة إلى أعمالنا. هل الكلُّ موجود؟
القرويون:دنبر! كلايد دنبر! غير موجود.
جو:(ينظر إلى القائمة)، صحيح، كلايد دنبر غير موجود بسبب كسر ساقه، أليس كذلك؟ من سيسحب له؟
السيدة دنبر:أنا على ما أظن.
جو:الزوجة تسحب للزوج!!!. جيني، هل لديك ولداً في سن الرشد؟
السيدة دنبر:رالف لم يبلغ السادسة عشر بَعد، لذا أعتقد، أن عليّ القيام هذهِ السنة بهذه المهمة، بدلا من الرجل العجوز.
(يسري ضحك خفيف بين القرويين)
جو:(يسجل ملحوظة)،جيد. جاك ويلكينس، هل ستشارك في السحبة هذه السنة؟
جاك:(يرمش بعصبية)، نعم سيدي، أنا و والدتي.
مارتن:جاك، أنت أنسان طيب و أنا فخور، ان يكون لوالدتك رجل يأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة.
جو:أعتقد أن الكلّ حاضر.(بغمزة من عينه)، هل العجوز ورنر موجود؟
ورنر:(يرفع يده)، موجود.
جو: (بإيماءة من رأسه)كنت واثقا من ذلك.يطْرُقُ الصندوق)، هل الجميع على إستعداد؟(نسمعُ همسات القرويين يتبعها صمت و يتوقف معها الضحك).سأقرأ أولاً أسماء:أرباب الأُسَر و ليتقدم الرجال لسحب بطاقاتهم من الصندوق. إحتفظوا بالورقة مطوية و لا تفتحوها إلا حين يأخذ الكل دوره. هل ما قلته واضح؟ (الكل ساكتون، متهيّبون، يمصمصون شفاههم، جامدون لا يتحركون).. يبدأ جو بقراءة القائمة:آدم ( يخرج رجلٌ من الجمع، يتقدم إلى الأمام حيث الصندوق الأسود ويسحب منه ورقة مطوية. (يحييه جو):مرحبا بك يا ستيف( يقبض ستيف على الورقة المطوية بيده بشدة، لا ينظر إلى كفّ يده). يصيح جو على الأسم الذي بعده:آلن (يتقدم الرجل إلى الصندوق و يكرر العملية)، كيف الحال سيد آلن؟ ( و هكذا يمضي المشهد: يصيح جو الإسم، يأتي الرجل، يسحب الورقة المطوية من الصندوق، و يعود حيث كان يقف دون النظر إلى الورقة المطوية في كفه.(يتحول مشهد جو و دعوته أرباب القرية لسحب الورقة، إلى مشهد إيمائي… أبلبي.. باروس…كاَسويل…كولينس…)
ديلاكروي:يقال ان قُرى الشمال، تخلّت عن لعبة اليانصيب.
السيد ورنر:قطيع من المجانين، يستمعون لشباب صغار لا يعجبهم العجَب.. في المرة القادمة سيطالبون بالعودة للعيش في الكهوف، حيث لا أحد يعمل.
ديلاكروي: أنت مُحق في كلامك، سيد وورنر.
ورنر:بعد كلّ قرعة يانصيب،”نأكل يخني الدجاج و الذرة”.
جو:دنبر…
السيدة واتسن:إذهبي يا جيني ..لقد نادى إسمك.
الآنسة بيسوم:(أثناء مرور السيدة دنبر للسحب تصيح)..ها هيَ في طريقها..
جو:فوستر.. كَريفس.. هاجسِن…
السيدة واتسون:أين يحتفظون بالصندوق الأسود يا تُرى بين قُرعة و أُخرى؟
الآنسة بيسوم: في أماكن مختلفة…
السيدة واتسون: سمعت انه تُرك لمدة سنة في أسطبل السيد كَريفس.
الآنسة بيسوم:وسنة أُخرى، وضعه كلِمْ مارتن على أحد الرفوف في محل بقالته.
السيدة واتسن:أتذكر ذلك.
جو:تاتوم…. تاونسيند… تَتِلْ… فِنسَنت…..
السيدة دنبر:(لِتومي)، ليتهم يُسرعون.
تومي:سينتهون قريباً يا أُمي.
السيدة دنبر:تهيأ،كي تُسرِع بإخبار والدك حالما تسمع النتيجة.
جو:ورنر. مرحبا سيد ورنر.
(يذهب ورنر لأخذ ورقته ثُم يعود لمكانه)
ورنر:أخذت ورقتي. هذه سحبتي، السابعة و السبعون.
جو:واتسن. مرحبا ستيلا.
السيدة واتسن:(تسحب ورقتها)، مرحبا جو.
جو:ويلكنس…
الآنسة بيسوم:(اثناء مرور جاك من أمامها)،لا تتنرفز يا جاك.
جو:(بحنان)، خُذْ وقتك يا ولدي.
جاك:(جاك يسحب ورقته)، شكراً سيد سمرس.
جو:(يتفحص القائمة)، إنتهينا،آن دوري الآن.( يسحب بطاقته عالياً ليراها الجميع).. حسناً يا رفاق.
(جمد الجميع في أماكنهم لثوان، إنتظاراً للنتيجة بعد أن كشف الجميع، بطاقاتهم).
القرويون:(بهمس)، على مَنْ وقعت القُرعة؟ أعائلة دنبر أم واتسن؟ هل البطاقة لدى عائلة ماتسن؟ (بدأت الهمهمة تتصاعد إلى أقصى درجاتها).. هاجسِن!بيل! القُرعة وقعت على عائلة بيل هاجسِن. ( إنسلت عائلة هاجسِن من الجمع وشكلت حلقتها الصغيرة).
السيدة دنبر:أذهب و أخبر والدك!
(يلقي تومي آخر نظرة على بيل هاجسِن الذي كان يقف بهدوء، مع زوجته تيسي و ولده ديفي. يخرج تومي راكضاً. كانت عائلة هاجسِن تقف مبحلقة بقطعة الورق التي يمسكها بيل. يصمت القرويون و نظرهم مركز على عائلة هاجسِن).
تيسي:(تصرخ فجأة)، جو سمرس، انت لم تعطه فرصة إختيار الورقة التي يريد.لقد رأيتك، هذا ليس عدلاً!
السيدة واتسن:حاولي ان تتمتعي بروح رياضية، تيسي.
الآنسة بيسوم:جميعناحصلنا على نفس الفرصة.
هاجسِن: إصمتي يا تيسي.
جو:كنا موفقين بإتمام الجزء الأول من عملنا بسرعة قياسية و الآن علينا ان نسرع لإنهاء المرحلة الثانية، (يراجع القائمة)… بيل، أنتَ من قام بسحب الورقة بالنيابة عن عائلتك. هل لديك أعضاء آخرين في العائلة؟
تيسي:(صارخة)، هناك دون و إيفا!
جو:البنات يتبعن عائلة أزواجهن. أنتِ و الجميع يعرف ذلك.
تيسي:هذا ليس عدلاً.
هاجسِن:عائلتي مكونة من ثلاثة أفراد فقط. إبنتي إيفا تشارك السحبة عادة، مع عائلة زوجها. هذا ما عهدنا العمل به.
جو:إذاً، أنتَ رب العائلة المسؤول عن السحب لعائلتك. صَحْ؟
هاجسِن:صَحْ.
جو:كم عدد أولادك يا بيل؟
هاجسِن:واحد فقط. الصغير ديفي موجود هنا الآن. بيل الصغير مات حين كان رضيعاً.
جو:حسناً… جاك هل ما زال هناك أوراق فارغة في الخلف؟( يرفع جاك قصاصتي ورق بيضاءتين أخذهما من بعض القرويين)..ضعهما في الصندوق.. خذ الآن ورقة بيل و ارمِها في الصندوق أيضا.( يقوم جاك بتنفيذ ما طلبه جو)
تيسي:(تخرج عن صمتها) أعتقد، ان علينا إعادة التصويت.(قالتها بأقصى ما يمكن من الهدوء)، ما حدث لم يكن عدلاُ. لم تعطوه فرصة الإختيار. الكل شَاهد ما حدث (ثم صرخت مناشدة)، إسمعوني جميعكم..
(يتراجع جاك عن صندوق الإقتراع. يكرمش بعض القرويين أوراقهم و يدعونها تسقط من بين أيديهم على الأرض).
جو:بيلي، هل انتَ مستعد؟( يلقي هاجسِن نظرة سريعة على زوجته و ولده ويوميء برأسه، علامة الموافقة).تَذَكَّرْ، خُذ القصاصات و اطوها و ليسحب كلٌّ منكم واحدة، و أنت يا جاك عليك بمساعدة الصغير ديفي.( يمسك جاك بيد الصغير ديفي و يقوده إلى الصندوق)، إسحب ورقة واحدة فقط.(يفعل ديفي ذلك). عظيم عليك يا جاك ان تحتفظ بورقة ديفي.( يمسك جاك الورقة بحرص شديد). جاء دورك يا تيسي.( تقف تيسي مترددة للحظات، تنظر إلى الجمع بتحدٍ، تطبق على شفتيها ثمّ تتوجه للصندوق، تخطف ورقة من داخله و تضع يدها خلف ظهرها)… و الآن دورك يا بيل. يتوجه هاجسِن إلى الصندوق و يأخذ آخر ورقة فيه.( القرويون في حالة صمت و توتر).
السيدة بيسوم:(تَكسِر الصمت)، أتمنى ان لا تكون من نصيب الصغير ديفي.
( نسمع همسات أهل القرية).
ورنر:( بصراحة)، لم تَعدْ الإنتخابات كما كانت قديما، ولم يعَدْ الناس كما كانوا سابقاً.
جاك:حسناً..إكشفوا بطاقاتكم و أنت يا جاك إفتح بطاقة الصغير ديفي.(يفتح جاك البطاقة، يتنهد براحة و يرفعها عالياً متمشيا بين الجمع ليتأكدوا من أن الورقة فارغة)…
جو:(يستدير إلى تيسي) تيسي؟ ( لحظة صمت. لم تتحرك تيسي لفتح ورقتها. يستدير جو إلى هاجسِن الذي يكشف عن ورقته البيضاء).
(يطلب جو من تيسي بصوت هاديء، أن تفتح ورقتها):ورقة الحظ وقعت على تيسي. إرفعها يا بيل ليراها الجميع. ( يستدير بيل، و ينتش بقوة، الورقة التي كانت مُعلّمة بنقطة سوداء، من كف تيسي و يرفعها عالياً، ليتمكن الجميع من رؤيتها. يبدأ القرويون بالتهامس)..
جو:(يتقدم إلى الأمام)… ايها الناس، علينا أن ننتهي من تنفيذ المهمة، بسرعة.
( يحمل جاك الصندوق الأسود، المضرب و الكرسي خارج المسرح ثم يعود لينضم إلى الآخرين).
السيدة واتسن:(بحماس)، هيا جيني، إسرعي و أنتِ أيضا يا آنسة بيسوم.
الآنسة بيسوم:لم أعد قادرة على الحركة كالسابق.
(يتوجه القرويون إلى مقدمة الخشبة.ويلتقط البعض منهم الأحجار التي في طريقه.يعطي ديكي حفنة من الحصى للصغير ديفي. يقوم أهل القرية بتطويق تيسي من الجانبين. تيسي تقف لوحدها في أعلى وسط الخشبة، مثل حيوان داخل المصيدة. رفعت تيسي يديها تناشدهم الرحمة… لكنهم و بالتدريج، أحكموا محاصرتها من كل الجوانب…) .
تيسي:هذا ليس عدلا. القُرعة، لم تكن عادلة.
هاجسِن:إصمتي يا تَسْ.علينا ان نفعل ذلك.( رماها بحجر، جفلتْ و رفعت يديها لتحمي عينيها).هيا، هياشاركوني جميعا….
( رمى ديفي حفنة الحصى التي كانت بيده على أمه…عندها، أطلقت تيسي صرخة داوية و سقطت على ركبتيها، ثم بدأت الأحجار تنهال عليها من كل صوب).
تيسي:هذا ليس عدلاً.. هذا غير صحيح ( كانت تحاول حماية وجهها فيما كان أهل القرية يزدادون ضراوة، برميها بالحجارة).
(عبرت(بيلفا) الخشبة وهجمت على جو الذي تفاداها.خرجت من المكان راكضة، غير قادرة على رؤية المشهد الذي يجري على الخشبة..أحكم أهل القرية،تطويق ضحيته و حَجبِها عن الأنظار.. يرجمونها بضراوة و وحشية لا مثيل لهما ومع كل حَجَرِ كانت تزداد صرخاتهم علواً و نشوةً).
أهل القرية:هيا، لننتهِ من هذا الموضوع..إضربوها..نَعَم هكذا، إضربوها.. إقضوا عليها! لننتهِ من هذا الأمر.( يسود الظلام يرافقه صوت رعد خفيف). و فجأة تنقطع أصوات أهل القرية. و يسود الصمت.
ظلام
…………………………………………….
بيرنارد دوفيلد:1917-1979
وُلِدَ في بوسطن، ماساشوسِت، كان كاتباً وممثلاً امريكياً. تخرج من جامعة كاليفورنيا / لوس آنجلوس بدرجة شرف. متخصص بكتابة سيناريو الأفلام و المسلسلات الإذاعية و التلفزيونية. قام بتمثيل دور إحدى الساحرات و القاتل الأول في فيلم (ماكبث)، إخراج آرسون ويلز و شارك كذلك في فيلم “كنز الجزيرة المفقودة” 1952 و فيلم “وسط الصف الأمامي” عام1955.
*بين الأعوام 1947-1955 و حتى وفاته، قام بتكييف و كتابة سيناريو، المئات من الروايات العالمية و القصص القصيرة للسينما،الإذاعة و التلفزيون بطلب من المسارح و الأستديوهات السينمائية و الإذاعية الأمريكية المعروفة مثل Mercury: Ford NBC، Studio One وغيرها، منها: رواية، أليس في بلاد العجائب؛جزيرة الكنز المفقود؛ و حول العالم. وقد اٍنعكس الكثير من مفاهيمه الأنسانية في كتاباته المناصرة للحركات العمالية و نقاباتها، و الحركة النسوية و المناهضة للعنصرية، والشركات المتعددة الجنسيات وعصابات المافيا. على الرغم من نشره أكثر من 50 مسرحية إلا أن توليفه لمسرحية “القُرعة”، ذات الفصل الواحد عام 1953، حققت و لسنوات طويلة، شهرة و نجاحاً لم يسبق لهما مثيل على خشبات المسرح و بالذات المسرح الطلابي.
” قُرعة لا يتمنى أحد الفوز بها “
المسرحية كما في القصة، هَيّجت عنصري الإثارة و الشك لدى القاريء تدريجياً، بشأن طبيعة القرعة. كما أثارت التساؤل، عن العائلة التي ستقع عليها القرعة، و عن الفرد الذي سيفوز بالورقة القاتلة ليكون أو تكون، الضحية البشرية القادمة التي ستوفر لهم موسم حصاد وفير، وفقا للطقوس المتوارثة!!!
نالت مسرحية “القرعة”، نجاحا منقطع النظير. حافظ بيرنارد على هيكل القصة العام بأمانة تامة و لم يَخرُج الحوار الذي أضافه عما كانت تفكر به كاتبة القصة بل مَكَنه و ببراعة الخبير العارف كَشْف الصراع بين جيل الماضي من الفلاحين و رجال الأعمال الذين يمتلكون السطوة و المال المتمثل بـ (جو سمرس، كًريفس، العجوز ورنر، دلاكروي…) وبين من فَشَلوا في التغيير فأضطروا لهجر القرية، ويتمثل هذا بشخصية الأخ الأصغر لِـ (جو سمرس) التي لا نراها بل نسمع بها في المشهد بين جو سمرس وأخته ( بيلفا) التي كانت تُحَقّر أخاها و تنعته بالقاتل المستفيد (ص.13). المشهد الآخر: الجدل بين تيسي و زوجها المزارع، بيل هاجسن، حين حاولت أخفاء صغيرها “ديفي” في الأسطبل (ص 17-19). النظرة المتدنية للمرأة كتابع للزوج، الأب و الأخ، المحرومة من حق التصويت والانتخاب كما حدث مع السيدة دَنبر. (ص.20)
خبرته في مجال السينما و المسرح مكنته من استخدام الإنارة و التعتيم لتوزيع المشاهد في العمل، كحل لمعضلة الكم الهائل من الناس على الخشبة، كما أنه نجح كلياً من خلال ارشاداته باستخدام لغة الجسد و التمثيل الإيمائي الصامت للتنقل بمرونة و بساطة من مشهدٍ لآخر