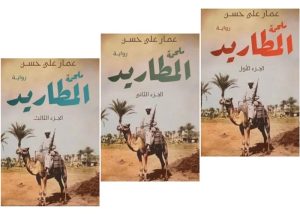د.خالد عاشور
يأخذنا حسن الجزار في مجموعته القصصية “أرض القُطْنة” إلي قلب الحدث مباشرة دون مقدمات، ولعله في ذلك يطبق تعريف يحيي حقي للقصة القصيرة، وهو:”أن القصة حكاية ذات مقدمة محذوفة”.
ورغم أن القاص حكَّاء جيد فهو لا يستهلك طاقته في الثرثرة؛ دعك من “كان”، و”كنا”،و”كانت”،التي تكثر في بدايات قصصه بُغية تحديد الزمان والمكان، فهو ينفلت من تحديد الإطار سريعاً لينقلك إلي قلب الصورة مباشرة؛ حفاظاً منه علي تماسك قصصه وكثافتها، ومعرفةً منه بحدود النوع الأدبي الذي يكتب فيه.
انظر إلي المدي الزمني لقصص المجموعة تجده لا يتجاوز الساعات القليلة، باستثناء قصة “ليلة الوحدة” حيث يمتد مداها الزمني إلي ليلة كاملة لم تخرج بها عن التماسك المرجو والكثافة المطلوبة في ذلك الفن.
وكما تُجسد قصص المجموعة تعريف يحيي حقي السالف للقصة القصيرة؛ فهي تجسيد لتعريف آخر لذلك الفن، صاحبه فرانك أوكونور الذي يقول:”يوجد في القصة القصيرة دائماً ذلك الإحساس بالشخصيات الخارجة علي القانون التي تهيم علي حواف المجتمع، والتي ترمز في بعض الأحيان إلي شخصيات من أمثال عيسي وسقراط وموسي، حيث تكون كاريكاتيراً أو صدي لها”.
ففي قصص الجزار تلتقي وجهاً لوجه مع هذه الشخصيات التي تعيش علي حواف المجتمع، ينتقيها من الريف المصري الذي نشأ فيه وعاشه وعايشه (القاص من مواليد
إحدي مدن الشرقية)؛ فمن مشاهداته نسج لنا في أسلوب قصصي ممتع طقوس الموالد والمواسم والموت والحياة والسعي في سبيل الرزق وأكل العيش والعادات والتقاليد المتوارثة، التي تشكل ملامح هذا الشعب وسَمته الثقافي والتاريخي.
علي أن القاص يقدم شخصيات قصصه من هذه الدائرة في أحلك ظروفها وأقساها حين يعاندها الواقع ويأبي أن يطاوعها ويلين لها؛ فإذا بها تعلو فوقه بصبرها وإصرارها، وتعمل جاهدة علي أن تروضه، بل وتتخطاه. وهي سمة من سمات هذا الشعب؛ أعني قدرته علي التكيف مع شتي الظروف، وقد أشار علماء الاجتماع والنفس وأفاضوا في ذلك درساً، وجسدتها هذه المجموعة القصصية فناً.
وهو حين يلتحم في قصصه مع هذه الشخصيات يشتد إيقاع إبداعه، ويعلو مستوي قَصُّه، ولهذه الدائرة تنتمي أروع قصص المجموعة في رأيي وهي قصص: أرض القطنة- ست بيضات – سيف البحر- حمل حطب- ليلة الوحدة- عجوز- الجنِّيَه
ففي قصة “أرض القُطْنة” يتبدي الواقع القاسي متمثلاً في المرأة المتمسكة بميراث أبيها ـ أو بما تبقي منه ـ عدد من القراريط في أرض القُطنة الملاصقة لمصنع الطوب الذي يمتلكه أولاد أبو عيشة، أبناء عمتها، الذين طالما رفض الأب بيع الأرض لهم، وترك لهم وصيته: “اوعوا ولاد عمتكم يضحكوا عليكو وياخدوا الأرض بعد ما اموت”.
ولأنه “لم يرث أي من إخوتها عن أبيه قدر ما ورثت. ورثوا دوراً ودكاكين وتجارة رابحة وورثت هي رجاحة العقل وحسن التصرف وتثمين ما تملك وما يملك الآخرون”؛ فهي تتصدي لكل محاولات تهامي ابن عمتها لابتزازها تحت ضغط ظروفها القاهرة: الزوج المغلوب علي أمره ومطالب الأولاد المؤجلة وهموم المعيشة التي جعلت “الدنيا كلها مثل ثقب في مخيط”.
تدخل المرأة هذا الصراع غير المتكافيء متشبثة بأقصي ما تسعفها به النفس من عناد وصلابة من أجل رفع سعر الشراء “فالأرض في جميع الأحوال في يد الحاج تهامي فهو المستأجر ولا تستطيع المرأة طرده وهو يري أن أي أموال تدفع مقابل الأرض حرام عليه…فلماذا يدفع مقابل شيء يحتكره”.
وتُحسم المعركة كما هو متوقع لصالح تهامي
“تمنتاشر …تسعتاشر…عشرين… مبروك يا ستي،عدي فلوسك تاني .قالت المرأة والدموع تجرف وجهها الأسمر الحزين: الله يسامحك يا تهامي
كان الرجل قد سند نرجيلته بجواره ونظر أمامه للاشيء. وكأنه يبكي بكاءً أكثر حرقة من
بكاء زوجته نظر إليها في خجل وقال: مبروك ..الله يعوض عليكي”.
إن صورة الواقع القاسية والقاتمة هنا سرعان ما تُعدل منها المرأة بإصرارها وتمسكها بالحياة لها ولأولادها:
“وضعت المرأة جنيهين في يد ابنها وأطبقت علي الباقي بكلتا يديها
اعمل اشتراك القطر واللي يفيض هاته
دس الشاب الجنيهين في جيبه وقبّل ظهر كفها ودخل حجرته
بكره هاشتريلك أجدعها بنطلون وأجدعها قميص من عند أبو والي
فجاء صوت الشاب من الداخل: والجزمه يا مه
والجزمه والشراب يا سيدي”.
ليس ذلك فحسب بل إن الأمر ليستحق ـ إمعاناً في مواصلة الحياة ـ احتفالاً في المساء فيتحلق الجميع حول الدجاجة التي ضحت بها الأم بهذه المناسبة ، والمحشي الذي أعدته الأم ساخناً وخصت زوجها بنصيب أوفر وهيأت أولادها للنوم.
وانظر إلي هذه النهاية السعيدة الي سيتكرر مضمونها كثيراً في نهايات قصص المجموعة: “نهض الرجل واغتسل ومثل عجوز تهش علي دجاجها ظل يتابع أبنائه حتي أوي كل منهم إلي فراشه وأحكم غلق الأبواب والشبابيك وأطفأ النور وظل يتحسس الطريق إلي الفراش حتي اصطدم بزوجته فرقد بجوارها في انتظار أن يغرق الأبناء في نوم عميق”.
إنها ليست النهاية السعيدة السنتمنتالية التي تَسم القصة بطابع السذاجة، ولكنها النهاية التي تتسق مع رؤية القاص لأبطال قصصه الذين تملؤهم روح التحدي لمواصلة الحياة رغم أي شيء، كما وأنها تتسق مع بناء القصة الذي تسير فيه أحداث القصة بشكل تصاعدي حتي تصل بك إلي القمة؛ قمة تحدي الواقع العنيد، قمة الانتصار، قمة الفرح، قمة الحياة، وهي هنا تتجسد في التواصل العاطفي الذي اختتمت به القصة.
وفي قصة “ست بيضات” يلتقي القاريء مع شكل آخر من أشكال تحدي الواقع؛ فالمرأة هنا تٌهييء ابنها للخروج مع أصحابه في يوم شم النسيم، فتُقابل تحدياً من نوع خاص : مكر زوجة أخيها ضحي التي تبخل عليهاببعض “التفتة” وهي الألوان المائية التي تُلَوّن بها أعواد الحصير، والتي أرسلت الولد كي يحضرها لتلون له به البيض الذي سيأخذه معه في ذلك اليوم، ولكن الولد رجع “وهو يبكي: زوجة خالي قالت لي والنبي ما عندنا تفته ولا زفته”.
ولكن هل تستسلم المرأة لهذا “الواقع”؟ كلا إنها تتكيف مع واقعها ذاك، وتستغل أدني المتاح لتصنع واقعاً آخر أحلي وأجمل؛ أحضرت الشاش الذي صُبغ بالأمس وثلاث بصلات نزعت عنهم القشر، ووضعت الشاش المصبوغ في الإناء ومعه بيضتان فتلونتا باللون الرمادي، ثم أعادت الكَرّة مع البصل فتلونت البيضتان الأخريان باللون الأحمر الباهت، وبقيت البيضتان الأخيرتان بلونهما الأبيض الأصلي:
“وعندما وضعت الأم البيض في الكيس البلاستيكي الشفاف وأضافت إليه قطع الفطير المشلتت والروانه اكتسب الكيس في مجمله تشكيلاً بديعاً وفريداً لم يكن في يد أحد من الأطفال مثله وإن لم يخل من طرافة في الألوان
ناولت الأم الكيس لابنها وهي تقول: والنبي ما يطلع من كوع ضحي تعمل كده
فخطف الولد الكيس من يد أمه وفر من المنزل يبحث عن أصدقائه
فسمع صوت أمه من الداخل تقول : أنا حاطه لك بيض كتير عشان تشبع واللي يفيض
منك ترجعه، مش ترميه في الغيطان وخلي بالك علي هدومك م التوت”.
وفي قصة “سيف البحر” يتخطي بطلها واقعه القائم داخل نفسه والمتمثل في رغبته الملحة في أن يقتحم البحر ويهزم رهبته في نفسه وحانت الفرصة في وقت السدة الشتوية حيث المياه ضحلة والمنسوب واطيء
“كان هدفه أن يصل لمنتصف البحر ليقف برهة علي النتوء الطيني المتيبس الممتد بطول المجري والمسمي “سيف البحر” وإن نجح في هذا فسيعبر النصف الآخر حتي يصل إلي الشط المقابل فيعتليه إلي الجسر ثم يعود إلي نقطة البداية ماشياً علي قدميه ….وكم ود لو كان أبوه وسطهم فيلوح له بذراعيه : هاأنذا يا أبي وهاهو البحر. إنني في منتصفه، في أعمق أعماقه لا أخشاه ولا أزن له وزناً. كم حذرتني منه وكم خوفتني منه وأنا الآن أمتطيه …انظر يا أبي إلي أصغر أبنائك …جسور أنا ، هل تنكر ؟ وأستطيع أن أعود إليك بسمك طري أصطاده بنفسي بكلتا يدي دون شباك أو طنبور”.
وحين ينجح الولد في إنجاز مهمته التي هي تحديه الخاص ويقف علي سيف البحر ويصطاد بعض قطع أبو جلمبو وأم الخلول تقابله أمه بتوعد شديد جراء نزوله البحر فيغادرها مسرعاً إلي الشارع لينضم إلي بقية أصدقائه الذين رجعوا مثله بحصيلة صيد وضعوها فوق قطعة صاج قديمة فوق موقد بدائي صنعوه بحجرين وأعوادالحطب:
“وشاركهم الولد وضع الكابوريا وعندما تحول لونها من الأحمر الداكن البرتقالي الجميل أيقنوا أنها نضجت فأزاحها كبيرهم بعصا صغيرة في يده فأوقعها علي الأرض ووضع مكانها أصداف أم الخلول الصغيرة فسمع بعد دقائق أصوات طرقعات لتنفتح الأصداف عن لحم رخو أبيض أشبه ما يكون بالدسم ومد كل ولد يده وأخذ نصيبه”.
وفي “حمل حطب” يقدم القاص تصويراً بديعاً للرجل الذي يبحث عن رزقه وسط أكوام الأشجار التي تقطعها البلدية لتوسع الطريق وتزينه، فيجد الرجل في ذلك صيداً ثميناً، مُحقِقاً ـ ربما دون قصد ـ فكرة تدوير الأشياء، فتتحول تلك القمامة علي يديه هو وزوجته إلي شيء نافع ومربح
و يصور القاص في لوحة بديعة الجهد الذي يبذله الرجل وزوجته وابنه الصغير ورجال الحارة إذا لزم الأمر في استقبال أغصان الأشجار من سيسبان وكافور ونقل هذه الحصيلة إلي أعلي البيت وفصلها حسب النوع وطريقة التعامل معها وتقطيعها وترتيبها وتخزينها. انظر إلي هذه الصورة:
“ولما كانت المرة الأخيرة والحبل يجر تاركاً تحته أخاديد علي سطح الحائط اللبني من كثرة ما نزل وصعد من نفس المكان لسنوات عديدة نظرت المرأة إلي زوجها في الأعلي وكأنها تنادي علي طير في الأفق وقالت: ارجع شوية لا رجلك تتزحلق، وابق انزل من عندك…دا آخر دور”.
أرأيت تصويراً لحميمية العلاقة الزوجية والتعاون الصادق بينهما كما في هذه اللوحة التي رسمها القاص بلغة شفيفة رقيقة تناسب هذه الحميمية خاصة حين يقول: “وكأنها تنادي علي طير في الأفق” ولتلاحظ أيضاً أن الزوج يظل في نظر زوجته “في الأعلي”
ولا ينسي القاص أن يختم القصة بنهايتها السعيدة أيضاً مثل بقية القصص؛ فبعد يوم شاق من العمل:
“كنست المرأة الحارة بعناية ورشت الماء لتهدأالعفرة فخرجت النسوة من بيوتهن يفرشن الحصير أمام الأبواب المفتوحة………وخرج الرجل بعد أن اغتسل والماء يقطر من وجهه وقد ارتدي سروالاً نظيفاً وصديرياً آخر وارتدي جلباباً أمام داره وجلس بجوار صينية الشاي التي أعدتها زوجته ونادي علي العم مصطفي: تعال اشرب الشاي معايا يا أبو محمد، فرد عليه: لا والله لا تيجي انت. ولم يذهب أحدهما للآخر ولكنها تحية واجبة”.
ويعتمد القاص أيضاً علي مقدرته العالية في التصوير في قصة “عجوز” التي استوقفت عين راوي القصة وقت رجوعه من المقهي في وقت متأخر من الليل وسط عربات الكارو التي تبيت في شارع السوق، فهو مكان أقرب إلي المزبلة، أو نهاية حياة الآدميين، ولكنه بالنسبة لهذه العجوز بداية حياتها؛ فهي تبحث فيه عن بقايا الخضر والفاكهة التي تشكل بضاعتها الحقيقية التي تقتات من وراءها. ويبرع القاص في تصوير العجوز في موقفها ذاك وكأنها جنية أو مخلوق من العالم الآخر يرتجف هو منه في موقفه المراقب له بينما هي لا تأبه به حتي حين يتدخل في خط سير عملها ويُذكّرها بشيء نسيته فتجيبه العجوز وكأنه كان معها. لم تفزع من صوته المفاجيء ولا من وجود شخص غريب؛ وكأنها في مكانها الموحش تشعر بالأنس ، أما هو القادم من المقهي مقصد الأنس فيشعر أمامها بالوحشة والخوف.
وفي نهاية القصة تستمر الحياة أيضاً كما عودنا القاص مهما كانت الظروف، تقول القصة:
“ورمت طرف عينها ناحيتي فأردت الاعتذار عن تلصصي عليها فقلت: أساعدك في حاجة يا أمي؟
لكنها لم تحر جواباً
كانت واقفة علي شكل قوس إلي حافة العربة ممسكة إياها بيدها حالما تتعودان رجلها علي الوقوف، ثم استدارت بجذعها ونظرت إلي الشارع الذي أتت منه وكأنها تقيس المسافة التي يتحتم عليها أن تقطعها عائدة إلي منزلها أو كوخها الصغير.
تركت العجوز يد العربة واستدارت إلي حيث أتت فتقابلت الوجوه وبدأت في الرجوع
ومرت من أمامي في تؤدة ولا تكاد ترفع ناظريها عن الأرض فتركتها ورحلت”.
وتأخذ المواجهة مع الواقع في قصة “الجنّيه” بعداً آخر تظلله أجواء أسطورية، تذكرنا بقصة يحيي الطاهر عبد الله “طاحونة الشيخ موسي”. فعيوشة المرأة الفقيرة تذهب للطاحونة لطحن قفة القمح وفي يدها الأخري طفلها الذي تحاول السيطرة عليه بشتي الطرق كي يطاوعها حتي تستطيع أن تذهب للبيت لتحضر الدور الثاني من الطحين ريثما يأتي دورها في طابور النسوان اللائي يملأن الطاحونة؛ فتُرغبه مرة بطبق من المهلبية من بائعته التي تأتي دوماً هنا، وترهبه مرة أخري مما يقال من سير الطاحونة لكي يدور لابد أن يدهن بدم طفل مقتول. وتتشتت المرأة بين حراسة الولد والخروج بطحين جيد وما يستلزمه ذلك من رشوة للعامل الواقف علي مكنة الطحين….الخ وحين تعود عيوشة من البيت لأخذ الدور الثاني من الطحين تجد ابنها وقد انفطر من العياط فتضمه وتأخذه إلي بائعة المهلبية فتفاجأ بأن الجنيه الذي لا تملك غيره قد فُقد. وتعود إلي البيت كسيرة باكية علي مصروف الدار ليستقبلها الزوج بحال مشابهة من الحزن والحسرة. لكن الحياة لابد أن تستمر:
“وبعد فترة صمت نهضت عيوشة وذهبت مطأطأة الرأس إلي الطاحونة لتعود بالقفة الثانية، وعندما عادت أنزلت القفة بمفردها بجوار زوجها الذي لم يكن قد غادر مكانه وجلست غير بعيدة أما الولد فقد انسحب بهدوء إلي الحارة بعد أن فقد طبقاً من المهلبية عساه يجد بالخارج ما يعوض خسارته الشديدة”
فدائماً الأمل يصاحب أبطال القصص في النهاية؛ إما يصنعونه هم بأنفسهم كما في القصص السابقة، وإما يلوح لهم به القاص نفسه كما في هذه القصة ولعل البعد الأسطوري في هذه القصة ـ رغم عدم وضوحه الكافي ـ يفسر موقف المرأة في مواجهة ما حدث لها علي عكس ما عودنا عليه القاص مع أبطال القصص السابقة؛ فالمواجهة هنا طرفها الآخر غيبي وغائب وغير معروف، وحتي مع ذلك فالإشارة إلي الأمل لم ينسها القاص في نهاية القصة حيث العوض المتوقع في الخارج.
ويُوقِّع القاص علي نفس اللحن نغمة مغايرة في مواجهة الواقع. ومغايرتها تكمن في اختلاف نتيجتها عن باقي القصص؛ إذ يواجه عبده الحلو في قصة بهذا العنوان واقعه الأليم ولكن النجاح لا يصاحبه بل يصاحبه الفشل في تخطي الواقع المؤلم.
وتكتسب مآساته بعداً تشيكوفياً كمآسي تشيكوف في قصصه ذات النهايات الحزينة المغلقة. ذلك لأن محاولة عبده الحلو تحمل في طياتها عوامل فشلها؛ فهي لم تتوسل في مواجهة الواقع وتغييره بوسائل مشروعة تبعث علي الإعجاب مثل بقية القصص، بل كانت وسيلته في ذلك: الادعاء وخداع الناس بأن ما يقدمه للناس في المولد هو سيرك مستغلاً اسمه الذي يتشابه مع اسم العائلة الشهيرة التي تقدم مثل هذا النوع من الاستعراضات. وتكون النتيجة سخرية الناس منه ومن عروضه الهزيلة ومن “مسرحه” الذي ظن أن بإمكانه – والدنيا مولد – أن يخرج منه بقرشين، ولا يجد ما يفعله إلا أن يبيع حماره الهزيل لسيرك الحلو الحقيقي تأكله أسوده، عائداً إلي بيته مع زوجه وطفله الرضيع بقروش قليلة دون ما كان يرجوه من السيرك الوهمي الذي نصبه أمام بيته في المولد. وتكون النتيجة أيضاً أن يفقد القاريء التعاطف مع هذا النموذج من نماذج مواجهة الواقع التي التقينا بهم في قصص المجموعة.
وليست المواجهة في قصص المجموعة مع الواقع العنيد فقط بل تتعداه إلي نقيض الواقع نفسه؛ الموت، ويكون الانتصار أيضاً في هذا النوع من المواجهة للحياة، وقدرة أبطاله علي التأقلم مع الواقع الجديد الذي هو هذه المرة يلتبس مع نقيضه؛ ففي قصة “ليلة الوحدة” يتناول القاص فكرة تبدو غير نمطية ولا مألوفة؛ الأسرة التي يتوزع أبناؤها علي غرف منزلهم للمبيت فيه ليلة دفنهم لأمهم، ويكون نصيب بطل القصة المبيت في الحجرة التي غٌسّلت فيها الأم، وهي تجربة قاسية يواجه فيها صاحبها الموت في صورة بقاياه أو رائحته التي تملأ المكان وهو ما يجعل راوي القصة لا ينام بينما زوجته وأولاده يَغطون في النوم. ويختلط الواقع بالحلم وتتبدي له أمه وهي تنصحه بالنوم وعدم القلق فإذا بالصباح قد طلع وإذا بهم يتأهبون للإفطار. فالحياة أقوي من الموت حتي وإن اقتربتَ منه إلي هذه الدرجة التي عايشها راوي القصة.
وإذا كانت قصص المجموعة قد استوفت تعريفين سالفين لفن القصة، فإنها تستوفي تعريفاً ثالثاً يقول: “إن فن القصة هو فن التفاصيل الصغيرة” وهنا نقع علي الكشف الحقيقي في موهبة حسن الجزار؛ فهو يمتلك عيناً لاقطة تحسن الوقوف عند لحظة ما زمانية أو مكانية ثم تطلعنا علي كافة جوانبها بثراء يخدم بناء القصة وتماسكها كما أسلفت.
ففي قصص المجموعة نجد مجموعة من اللوحات الفنية، أحسن الكاتب رسمها بدقة متناهية يجد القاريء فيها متعة فنية من خلال التفاصيل الصغيرة علي نحو يذكرنا بموهبة يوسف إدريس في ذلك (راجع قصة “عود ثقاب” لإدريس ووقوفه بالوصف والتصوير للفتاة التي تشعل عود الثقاب) والقاص عادةً ما يضع عين الكاميرا اللاقطة تلك في يد راوي القصة بل إنه أحياناً يذكرنا بذلك؛ يقول في قصة “عجوز”: “غيرت زاوية الوقوف حتي جعلت العجوز في مجال الرؤية” ثم يبدأ في ترتيب عناصر الصورة، يقول: “….وأخيراً سحبتْ من داخل الصندوق بعض الخرق وبقايا خضار وفاكهة ملأت بها حجرها المفرود، أما الخرق فوضعتها عن يسارها تحت العربية، رصت كل شيء بعناية: الخيار إلي الخيار والطماطم إلي الطماطم، من كل شيء ثمرتان أو أكثر وإصبع موز واحد.
نظرت المرأة للثمار وغابت قليلاً كأنها تحصي عدداً ثم أخذت الخرق ووضعتها واحدة تلو الأخري داخل صندوق العربة واستبقت واحدة فردتها بجوارها علي الأرض ووضعت عليها الثمار دون ترتيب، ولمت أطراف الخرقة وعقدتها إلي بعضها ووضعتها جانباً.
وفي قصة “حمل حطب” نراه يحدد أبعاد الصورة ومكوناتها البصرية وزاوية الرؤية التي هي من أعلي، قائلاً: “كانت الشمس علي وشك المغيب عندما أدلي طرف الحبل من فوق سطح الطابق الثاني فتلتقطه زوجته وتفرده علي الأرض في خط مستقيم وتضع فوقه أكوام الخشب المتساوية ثم تلف الحبل حولها وتعقد الطرف بشدة وتنظر لأعلي صائحة: علي الله … فيجر الرجل الحبل مرة بيمينه وأخري بشماله حتي تصل إليه الكومة فيسحبها إلي فراغ السطح المملوء بقش الأرز والراكز في منتصفه صندوق القمح الطيني فيفك الحبل ويفرد خشيباته فوق القش”
وفي قصة “ست بيضات” يصف القاص عملية تلوين البيض معتمداً علي معطيات اللون في تكوين هذه الصورة، التي تُروي من منظور الطفل قائلاً: “لما نضج البيض اصطادته الأم وأخرجته من الإناء ووضعته علي الأرض وقالت: آدي البيض الأبيض. ثم أحضرت المقص وهي ممسكة بالشاش وتكاد الدموع تنهمر من عينيها وهي تعتب علي زوجة أخيها: طيب يا ضحي
وقطعت شريحة من عرض الشاش ووضعتها بالماء الذي ما زال يغلي مثل الدم في عروقها وقالت: باكر أعطي الشاش لنبوية فتثني طرفه المقصوص علي المكنة ويعود أحسن مما كان … ثم وضعت بيضتين وبعد قليل تعكر الماء واكتسب لوناً رمادياً من أثر الصبغة السوداء وتلونت البيضتان بذلك اللون الغريب
نظر الولد للبيضتين وارتاح قليلاً للنتيجة وإن لم يكن اللون معتاداً أو مألوفاً لعين
اصطادت الأم البيضتين من الإناء وقالت: وآدي اتنين كمان، ولم تسم اللون
ثم أفرغت الإناء وغسلته جيداً ووضعت به بيضتين وغمرتهما بالماء وأتت بثلاث بصلات كبيرة ونزعت عنهم القشر ووضعته في الماء ورفعت الإناء علي النار
وبعد أن غلي الماء ونضج البيض كان قد اكتسب اللون الأحمر الباهت ورأي الولد ذلك جميلاً
أطفأت الأم الوابور ودلقت الماء من الإناء واصطادت البيضتين وقالت: وآدي كمان اتنين حمر…..ولا تزعل يا ابني
كانت البيضات الست بثلاثة ألوان: الأبيض أبيض كما باضه الدجاج والرمادي من أثر صبغة الشاش والأحمر الباهت من لون قشر البصل”.
لقد أطلتُ في هذا الاقتباس وغيره لأوضح أبعاد الصورة كما رسمها القاص الذي برع في إبراز التفاصيل الصغيرة لإثراء بنائه القصصي. وأعتقد أن مقدرة القاص علي بناء الصورة بتلك المقدرة يعود لسببين: أولهما: نشأته الريفية التي أتاحت لبصره أفقاً مفتوحاً وتفاصيل حياة قوامها يعتمد علي العدد والترتيب والتنظيم؛ فالأرض ومكوناتها والمحاصيل وأنواعها والمواسم ومواعيدها والري وطرائقه؛ كلها أمور تعتمد في تفاصيلها علي العدّ والترتيب والتنظيم، كما أنها تعتمد في تركيبها علي الصورة المرئية.
ثانيهما: عمل القاص في مجال الإعلام البصري ومعالجته تقنياً وفنياً وهو ما أتاح له فقهاً بمفردات الصورة المرئية وكيفية تكوينها.
غير أن البراعة في التصوير علي هذا النحو أضرت القاص في بعض المواضع حين استهلكه الوصف والتصوير والتعداد ليخرج بإبداعه في مواضع قليلة عن حدود النوع الأدبي الذي يكتب فيه.
فقصة “الجنازة” لا تعدو – علي الرغم مما فيها من براعة التصوير- كونها صورة قصصية لم تبلغ بعد حدود فن القصة القصيرة.
والصورة القصصية أو الصورة القلمية فن يقف في مرحلة بين القصة والمقالة، نجد تصويراً أكثر وإيحاءً أقل وهو ما يبعده عن دائرة القصة القصيرة، ويعرفه يحيي حقي قائلاً: “إن بطل الصورة إنسان يجد فيه الكاتب مدعاة للتفكه أو مدعاة للتأسي ….وإلي هنا ينتهي عمله فلا تطلب منه فوق ذلك حادثة متطورة أو مواقف تتراكب، إنه إنسان كأنه خارج من قصة أو مرشح للدخول فيها” ( فجرالقصة) وهو ما نراه في قصة “الجنازة” فالقصة وصف مطول لجنازة قطع أهل القرية ستة كيلو مترات في تشييعها سيراً علي الأقدام، علي الرغم من أن شخصية الأم المكلومة بفقد ابنها يقدمها لنا القاص في بداية القصة علي نحو جيد وكأنها بالفعل كما يقول يحيي حقي مرشحة للدخول في قصة.
ولا بأس في النهاية أن تستوفي مجموعة حسن الجزار تعريفاً رابعاً لفن القصة القصيرة أو عنصراً من عناصرها المهمة، وأقصد به اللغة المكثفة التي تبلغ أحياناً حد الشعر. فالقصة القصيرة كما نعرف هي أقرب فنون القص إلي فن الشعر.
ففي قصتي “أرض القطنة”، و” ليلة الوحدة” نعثر علي تعبيرات ومقاطع لغوية بلغت حد الشعر في تكثيفها وقصدها وأحياناً في وزنها، بما يخدم بناء القصة أيضاً.
وربما كان لجو القصتين المفعمتين بالمأساة تأثير علي لغتهما الشاعرية؛ ففي قصة “أرض القطنة” نجدها تُفتتح بهذه الجملة الشعرية التى يستعيرها من شعر أمل دنقل: “البحر كالصحراء لا يروي العطش” وهي جملة تتكرر عند المفاصل الرئيسية لأحداث القصة وكأنها لحن متكرر يضبط إيقاع الأحداث، التي هي منازلة المرأة لابن عمتها في عملية شراء الأرض مع مناسبة مضمونها لخلفية الأحداث.
وينثر القاص خلال القصة سطوراً شعرية تشرح علي نحو أبلغ من السرد ما تمر به المرأة من ظروف قهرية لابست عملية بيع الأرض مثل قوله:”والمشتري إذا استطاع أن يأكل ذراعك فعل/ وإذا استطاع أن يقطع إبهامك ليفوز بالبصمة قطع”
. أو قوله: “والصمت مثل الكلام/ كلاهما لا يفضي لشيء”.
أو قوله بعد إتمام عملية الشراء أو الاغتصاب:
“وكأن السماء تمطر بسخاء/ وكأن الأرض تأبي أن تبتلع الماء/ كانت الدموع تنهمر من عيني المرأة/ فلا شيء يجففها ولا تمتد إليها يد/ بل كأن أحداً لا يراها”.
وحين يقول علي لسان ابنها المشفق عليها في حديث من أحاديث النفس(المونولوج): “ياأيها الحزن الجليل/ كنا نخال البيع فرحاً وسعادة/ فمن بك جاء/ وياأيتها الأم التي ظلت لسنوات تبيع/ تري من سيعطيك الثمن؟/ فلا جنيهات التهامي ثمن/ ولا خجل الأب ثمن/ ولا شيء يا أمي يعوض”.
وفي قصة “ليلة الوحدة” نعثر أيضاً علي التعبيرات اللغوية التي تنضح بالشاعرية بما يخدم بناء القصة التي تدور أحداثها في جو جنائزي، يقول القاص: “مرت الأيام الثلاثة الأخيرة ثقيلة لا تنقضي / فالروح تأبي أن تخرج/ والشفاء يعز فلا يعود”.
ويقول:”فينظر إليها زائغ العينين/ كأنه كان يحتضن الموت/ ولكن الموت أمهله وسكن العجوز”.
ويقول:”أتذكر جيداً/ فقد حملت العبء وحدي/ وبكيت وحدي/ ولا أذكر كيف نمت/ وإن كنت من المؤكد نمت وحدي؟
……………….
*إعلامي وناقد مصري