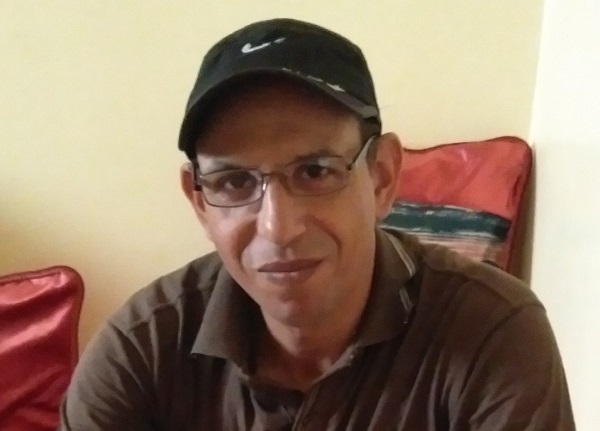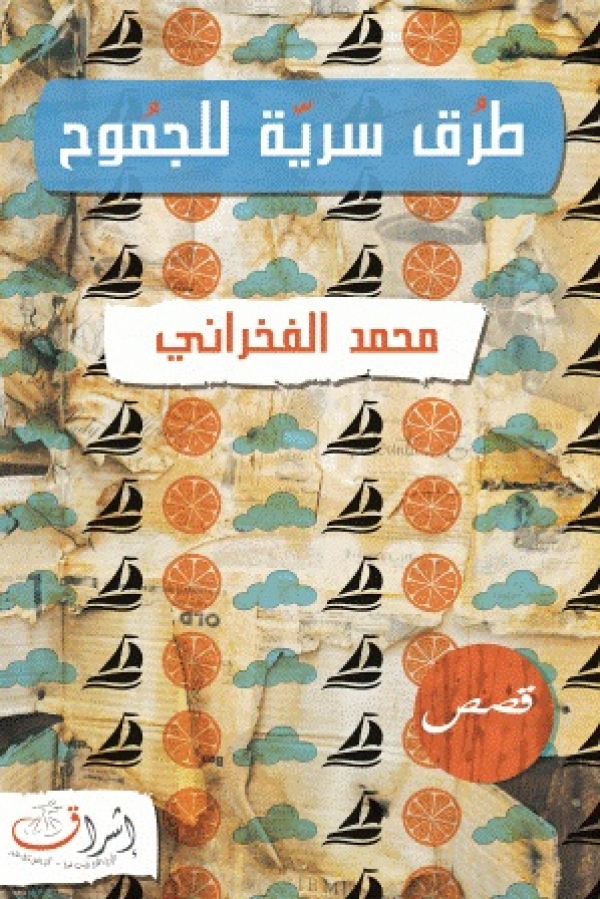البشير الأزمي
أتذكر..
أتذكر أنك قلت لي وأنت في حالة غضب:” افترسني الضياع”..
قلتُ لك انظر إلى مرآتك الداخلية تكتشف ذاتك. اخرج من متاهتك. اختلجتْ عيناك في اهتمام.. ارتجفتَ حنقاً.. لاحت على محياك مسوحُ الحيرة والتردد وصرختَ. كَسَّرَ صراخُك الصمتَ السائدَ بيننا، صرخت وعدتَ تستظل بصمتك.. اعتقدتَ أن صوتك لا صدى له.. انتظرتُ أن يتلاشى غضبُك ويذوبَ حنقُك.
ران على شفتيك حجابٌ كثيف من الصمت. قلت لك اصرخ، ما عاد لك غير هذا الفراغ لتملأه صراخاً.. التفتَّ نحوي، هَززت كتفيك استهانة وقلت:” من بعيد يتنامى صوتٌ يدعوني… الحنين يرِفُّ في ذاكرتي..”. كانت كلماتك مبتورة، متقطعة.
أتذكر..
أتذكر أنك ما استطعت أن تخرج من المتاهة يوماً. قضيت حياتك تجري وراء أوهام تقرع جدار أحلامك. تضطرم بداخلك أشياء؛ نار عشق تنهار جدرانه، فرحة طفولة لم تعد ترسم آلاءها على وجهك.
أحاول اليوم أن أستعيد قولك لي دائماً:” الذاكرة هي المنجى من الضياع.”.
يوم فقدتَ ذاكرتك استوطن الحزن في جسدك وانطفأتْ أحلامُك. ارتسم الإجهاد على وجهك وأضحت نظراتك شاردةً توحي بالضياع، امتقع لونك، تلاحقت أنفاسك، خفق قلبك بسرعة.. صرختَ.. صرختَ وصمتَّ، في صمتِكَ ألم.. وَثَبَتْ إلى مخيلتي صورتُك وأنت تجري والمطر يَهْمي وأنت تصيح:” افترسني الضياع.. افترسني الضياع”.
تقدمتَ من الباب فتحته فَصَرَّ.. خرجتَ وأغلقته خلفك.. أطللتُ من النافذة، عباءةُ الليل أثقلها السكون، شبكتَ يديك خلف ظهرك وحدَّقتَ في السماء. مشيتَ.. ابتلعك الظلامُ والمدى يردد صدى حزنك:
” افترسني الضياع.. افترسني الضياع..”
في الصباح فتحتُ عينيَّ، البيتُ غارق في السكون؛ سكون يبعث على الضجر والملل. عدتُ إلى المدينة. الطريقُ عَتِمٌ ومديد، تَمَلَّيتُ الشوارع والأزقة والدروب باحثاً عنك، تَفَحَّصتُ الوجوه بدافع العثور عليك، بدت لي الوجوه غير وجهك؛ وجوه تعكس حزناً عميقاً.. بدت لي المدينة موحِشة؛ أبوابٌ خَرِبَةٌ.. جدران متداعية.. هاماتٌ منهمكة في أحاديث هامسة تتخللها إشارات بالأيادي والأصابع، عاقدة حواجبها في انزعاج، تنظر بعضُها إلى بعض بغيظ مكتوم. انتابني خوفٌ وحزنٌ وانقباضٌ.. لم تنجني الذاكرةُ، اليومَ، أنا أيضاً من الضياع..
غِبْتَ وخلفت وراءك فراغاً وحزناً غامراً..
نضج النهار..
تَمَطَّى يُهَدهِدُ آمالاً وهمية
تستنفر أشتاتك، تطرد هزائمك..
دع همسك ينساب في هدوء خيباتك..
نم.. أَغرِق وسادتك بالدمع..
اروها كلماتٍ لاذعة..
انتزِعْ من ذاتك بسمة
ترشحُ ألماً.. ترشحُ أملاً..
خلِّفْ وراءك حزناً غامراً
ينهشه الضياع.. يخزه بلا رحمة
استعِدْ ذاكرتك..
اسمح لخيالك ليثمل بالأحلام..