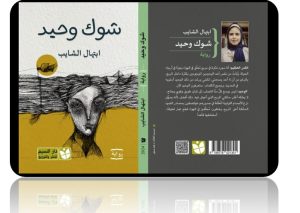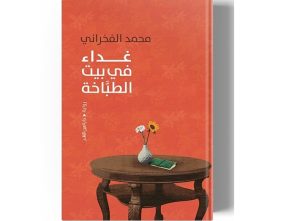ونتيجة لهذا التعاقدِ القائمِ بين الطرفين، والذي أشرتُ إليه من قبلُ، وصلتنا إبداعاتُه الراقية. فكانت “سرير الأسرار” 2008، و” أرض المدامع” 2012، و” هديل سيدة حرة” 2015، و” حكاية مغربية” 2016، و” زهرة الجبال الصماء” 2017. و الآتي، إن شاء الله، سيكون، أيضاً، أجملَ وأعمقَ وأمتعَ، فالحرف والسردُ عند البشير مَعينٌ لا ينْضُبُ.
في رواية ” سرير الأسرار” يستغل البشير، بذكاء مُبْهِرٍ، السريرَ كسفينة ترسو في ميناء الليل لينطلق منها الحكي، ولا غرابة في ذلك، فالليل موطنُ الحَكْيِ ومرفأُ البَوْح.. الليلُ مساحةٌ أخرى بقدر ظلامها بقدر ما تكشف بوضوح عن عورات المدينة، ببائعات الهوى، ورجال الليل؛ ” اللُّوكُو”، و “سَرْطاحا”، و “الوَرْوار”، وغيرِهم.. فبقدر ما كانت المدينة تغرق في بحر الرذيلة، كانت كذلك ” الدار الكبيرة”. وكل هذه الأمور ينطلق منها مبدعُنا ليتسلَّلَ للعمق والداخلي لدى الإنسان المقهور والمعذب، فقد قدمها لنا أنها خصوصيةٌ، وجدناها تعانق الكوني والإنساني، فهذه الظواهر والقضايا ليست مرتبطة بمكان محدد دون غيره، وإنما توجد حيث يوجد القهرُ والاستغلالُ والجهلُ. وقد عبر عن ذلك، البشير في حوار له، حيث قال:” أُعَرِّي حيواتٍ من مجتمعنا ونفسياتِ شخوصِها بما تحتويه من ألم وتذمر وتشظ”.
فكان الحكي، حكيٌ لا يسقط في فخ التسجيلي للأمكنة، بقدر ما يروم الوقوف عند صراع الفاعلين الذين يسكنون هذه الأمكنة، أو يتخذونها معبراً، في مدينة/ مجتمع تحولت فيه أجساد فئة من النساء إلى أجسادٍ مباحة، وأرواحِ مشروخة. لم يقتصر الأمر على النساء بل هذا الشرخُ وتلك الإباحةُ استوطنا أجسادَ الجنسين..
تلك حكاية السرير، و” حكايةٌ مغربيةٌ” حكايةٌ أخرى.
في ” حكاية مغربية“، قدَّمَ لنا الروائي عالماً قائماً على علاقاتٍ تربط فاعليه فيما بينهم على النفعية المبنية على الاستغلال؛
فالقاضي يستغل الساردة للإجهاز على أنوثتها واغتصابها، في الوقت الذي لجأت إليه ليشفع لأخيها المعتقل. وخطيبُ لطيفة؛ صديقةِ الساردة التي أعارتها فستاناً حتى تكون في حالة بهية وهي تزور القاضي، ستنقطع أخباره بعد سنة من معرفته، وكان أهدى لها زجاجات عطر وفُسْحاتٍ على متن سيارته واختفى. والأم تعتبر ابنتها (أسماء) وسيلة لتحقيق غاياتٍ تستفيد منها هي ذاتُها. ص: 23. و الممرضُ يستغل أسماء قصد ممارسة الجنس، وهي اللحظة الوحيدة التي استجابت فيها لمثل هذا النداء, ص: 91.
إن ذكاء البشير، في هذه الرواية لافت للعيان، فبخبرته استطاع أن يقدم للمتلقي ثنائية للحياة والموت، ثنائية تقابلية وتضادية في آن.
فأسماء وهي قرب السرير حيث ترقد أم مشغلتها في المصحة وهي في حال احتضار، أقول أسماء تحتفي بغريزتها الأنثوية وتستجيب لها عندما راودها الممرض عن نفسها. هذا الانكسارُ أو السقوطُ مخالفٌ لما كانت تحلم به أسماء وتؤمن به، حب بائع الدجاج، وهي مازالت طالبةً جامعيةً، لكنه حلمُ حُبِّ هروب؛ هروب من دوامة الخوف التي كانت تكبل حياتها. وهو بدوره حبٌّ لم ينجح، لأن أمَّ رشيد كانت تقف في وجهه بقوة.
كل هذا وَلَّدَ لدى الفاعلين الأساسيين شعوراً بالضعف تارة، وبالانهزام أخرى. فسالت الدموع. ولما كانت للدموع أهميةٌ، قال البشير:” لِمَ لا تُجمَعُ هذه الدموع ويُحْتَفَظُ بها في مدامع، فكانت ” أرض المدامع“.
قديماً كان يقال، ولحد الساعة مازال الأمر وارداً أيضاً:” إن أنت أردت أن تعرف حقيقةَ حقبةٍ تاريخيةٍ لا يكفيك الاستنادُ إلى التاريخ، بل عليك الاستعانةُ بالفنون التي أنتجتها تلك المرحلة؛ من حِكَمٍ وأمثالٍ شعبيةٍ ونحتٍ ورسمٍ وشعرٍ وغيرِها. فنحن عندما نقرأ، مثلا، قول الشاعر تميم بنِ مقبل:
ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم
والبيتُ من قصيدةٍ مطلعُها:
أَناظِرُ الوَصْلُ أم غادٍ فَمَصرومُ أَمْ كُلُّ دَيْنُكَ من دَهْماءَ مَغْرُومُ
ويذهب البعض إلى أن هذا البيت للشاعر المتمرد عروة بن الورد.
أو قول ابن المعتز:
لقد انقضتْ دولةُ الصيام وبَشَّرَ سُقْمُ الهلال بالعيد
ليس المهم من قائلُ البيت الأول، بل الغرضُ من إيراد البيتين هو الإشارة إلى أنَّ العملَ الأدبيَ، وإن اختلفت أجناسه من شعر، أو قصة، أو رواية، أو غيرها من الأشكال التعبيرية يمكنُ أن يكون بمثابة وثيقة إضافية تكشفُ عَمَّا سكتَ عنه في هذه الفترة أو تلك، التأريخُ والتحقيبُ، والتدوين الرسمي، ويكشف الغطاءَ عن أعطابٍ نخرت جسد هذا البلد أو ذاك.
ففي البيت الأول تبدو لنا صورةُ الظلم الاجتماعي، والتدني الذي يعيشه الفرد، إلى حد أنه أضحى يأمل أن يصير حجراً، وهو يُعبِّرُ عن إنسانيته المحطمةِ والهَشَّةِ، والمهَمَّشةِ في حال صدامها اليومي مع الحياة، وفي الثاني كيف يغدو الدينُ دينَ دولة، تُعاقِبُ من خالفه أو تمرَّدَ عليه.
هو الأمر نفسه نرصدهُ بالنسبة للذاكرة الحديثة منها والقديمة؛ البعيدة. فتغدو الكتابة السردية الإبداعية وثيقةً نقرأ من خلالها ذواتنا، واقعَنا بكل تجلياته، أو مرآةً صادقة تعكس لنا صورنا في بشاعتها أو صَبُوحِها.
ففي ” سرير الأسرار” عثرنا على مفهوم الكتابة المسؤولة، كتابةٌ لا تهادن، ولا تُلَوِّنُ البشاعة بألوان الجمال، بمعنى أن الكتابة عند الروائي البشير الدامون كانت كتابةً واعيةً بأفق الانتظار وبحدود الرؤية التي يتبناها ليثيرَ المتلقي ويدفعَهُ إلى إعادة النظر بشكل واعٍ إلى الذات والواقع.
ويستمر السردُ بصيغة المؤنث، لكن هذه المرة، بصوتٍ أمسك مشعلَ المعرفة، فالساردةُ الآتيةُ من ” الدار الكبيرة”، وبعد أن أنهت تحصيلها الجامعي، قررت لفظ غبارٍ ظلَّ عالقاً بها ردحاً من الزمن؛ فتلجُ العملَ السياسي، وتحمي نفسها بالتخفي داخل قصر الباشا.
يعمد البشير إلى توظيف تقنية التوازي بذكاء، فهو يستدعي مرحلةً من مراحل التاريخ الروماني مرحلة حكم ” كاليغولا” لتكون مرآةً تعكس ما عاشته تطوان في مرحلة الثمانينيات من القرن الماضي، بل تصلُ إلى مرحلة أخرى سابقةٍ عليها هي فترةُ الخمسينيات.
فتغرق المدينة في يم الدموع، دموع إخفاقِ المنهزم غيرِ القادر على تحقيق أحلامه، دموع لها قيمة ومعنى، قيمة التعبير عن الجانب المنكسر من الذات. ولما كانت لهذه الدموع قيمةٌ، تغدو المحافظةُ عليها أمراً جدَّ مهم. كلما حنَّ إليها الفردُ أخبرته عن الواقع الاقتصادي المهترئ، والاجتماعي المبني على علاقات نفعية استغلالية بشعة، والسياسي الباسط فخاخه لتصيد الطريدة.
في ” هديل سيدة حرة” تعيش الساردة، وهي دائماً أنثى، وضعاً نفسياً متردياً نتيجة ما خلفه السقوط من مآسي زرعَ بذورَها الأهلُ فيما بينهم عبر ” الاحتفاء بالنيران”؛ نيرانِ أهلِ الأم التي تحرق أهل الأب، فتغدو الحمامةُ ممزقةَ الجناحين، غيرَ قادرة على التحليق في سماء الحرية، والانتماء إلى فضاءين، فضاءِ أهل الأم المنتمية إلى العقيدة المسيحية، وفضاءِ أهل الأب المنتمي إلى العقيدة الإسلامية، فلم يبق للحمامة، في ظرف عصيبٍ كهذا، غيرُ الهديل، هذا الهديلُ الذي تحتفظ به من تلك الوصية التي تُمَنِّيها بالحياة في حلَّةِ سلامٍ تكون بمثابة معبر إلى الخلود تحملها ” حمامة الحمائم”؛ حمامةٌ كالفنيق قادرةٌ على إعادة نبضات الروح إلى الجسد؛ الجسدِ الممزقِ من طرف الذات أو نصفِ الذات؛ أعني الأهل، وتستعيد تبعاً حبّاً يُسْبِي العقولَ ويخلِّصُها من الشَّر.
وتظلُّ الحرةُ حُرَّةً، متشبثةً بمواقفها، حاميةً لأهلها ومنطقة حكمها، رغم أن الأهل ثاروا ضدها في محاولة لعزلها عن السلطة. وتظل متخبطة وهي بين عاطفتين وعقيدتين متقابلتين؛ أميرة مسلمة وأم مسيحية أسلمت، هذان التقابلان يُحدثان في ذات الحرة تمزقاً نفسياً، فتضع جداراً بين الذات وأصل الذات (الأم). مثخنةٌ هي جراحُ الحرة بدماء تنسكب منها بعد طعنات الأم ومخالب ” مانولو المسيحي”، وزوجة إمام المسجد؛ ف”مانولو” ينعتها ببنت المسيحية، وزوجةِ إمام المسجد، بسؤال إنكاري تسأها :” أحقاً أمك مسلمة؟” كل هذا أدخل الحرة في دوامة الوسواس. فَتُرَقَّى من طرف فقيه مسلم، وقِسٍّ مسيحي (خالها)، وحاخام يهودي. غيرُ هؤلاء تقف الجدة إلى جانبها وتطلب منها الرحيل بعد أن تزودها بالسلاح حتى تستطيع الدفاع عن نفسها.
ويستمر حكي الساردة الأنثى في” زهرة الجبال الصماء“، والساردة هنا طفلة غير قادرة على فهم ما يجري حولها: ” كنت أتابع حديثها ( عمة الطفلة) باهتمام كبير، رغم أني لم أكن أفهم أغلب ما كانت تحكيه) ص:12. حديثٌ عن أب غاب ولم يعثر عليه، غاب وغابت معه شامة، في الوقت الذي عُثِرَ فيه على جثتي صديقيه ورفيقي جوقته؛ عبد السلام الطبال وأحمد الزمَّار، أب يغني للجبال، يحيي الحفلات دون مقابلٍ، وينثر الفرح بين الناس لأن الغناء يطهر النفوس من الشَّر، ويخفف من قسوة الحياة عن الناس.
نساء روايات البشير، رغم كون أغلبهن ينتمين للعالم السفلي، والمهمش، والقابع في الفقر، يَعينَ أن التعلمَّ والمعرفةَ شرطان أساسيان لتغيير واقعهن إلى الأفضل، فالساردة في ” أرض المدامع”، كانت على وعي، وهي تحصل على شهادتها، عندما قررت أن تلج العمل السياسي، كما أشرت إلى ذلك من قبل.
والأم في ” زهرة الجبال الصماء” أمية، وتحلم بأن تصبح ابنتها متعلمة، ص.62. فالأم تؤمن بقيمة التعلم وبدوره في جعل الحياة واضحة:” جدك كان يقول إنه بهذا، فك الحرف، نتمَكَّنُ من فهم الدنيا والآخرة” ص 63. في المقابل وجدنا بعض رجال القرية يستنكرون ولوج فتاة ( الساردة) كُتَّابَ مسجد القرية قصد التعلم، ص. 68.
بدرية في ” حكاية مغربية” في مستشفى الأمراض النفسية، تحكي للساردة :” أنها ليست مجنونة وإنما تعاني من وعكة تعبٍ سَبَّبها لها عشق الشعر..” ص 153، ” ساعة مغادرتي المستشفى.. أحضرت بدرية ديوان شعر، فتحت حقيبة يدي ووضعته داخلها وهي تقتلع ابتسامة من مُحيَّاها المنهَكِ، وتمسح دمعة وتوشوش لي: لا تَنْسَي الشعر.. والقمر”. ص 158.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعدّاه إلى الفن، في ” زهرة الجبال الصماء” الأم وهي تخاطب ابنتها تقول:” أبوك نَذَرَ نفسه للغناء، إنه يرى أن الغناء هو السبيل الوحيد للشفاء من شرور النفس، ومما تبثه المرتفعات الرمادية المحيطة بنا من همٍّ ثقيل على القلب” ص12. وأهل القرية بدورهم لهم موقف إيجابي من الفن، تتابع الأم وهي تحكي لابنتها:” القرويون كذلك يعتبرون غناء والدك تحدياً وترفيها عليهم من قسوة الحياة” ص 12. حتى العمة لها موقف إيجابي، تقول:” إن الله لم يَهْدِ البشر إلى الغناء عبثاً.. إنها حكمته الكبيرة” ص 28.
حتى العشق له ارتباط بالحرف:” أنا ما عشقتُ والدك إلا لأنه كان متمكناً من الحرف” ص69. وتضيف: ” عِشْقُ الحرف مسؤولية وتضحية”، والعمة ستحرض (الساردة) على التعلم وستقف إلى جانبها إلى أن تقبل، وستتحدى فقيه الكُتَّاب عندما تَلَكَّأَ في قبول البنت طالبة للقرآن.
نساء ” زهرة الجبال الصماء” كُنَّ، في بعض الأحيان، أكثر قوة ووعياً من الرجال، ففي الوقت الذي يلجأ رجل الدولة المفروض فيه أن يكون واعياً، أقول يلجأ بعد أن عجز الأطباء عن علاجه بعدما أصيب بشلل مفاجئ، إلى الاستفادة من الشريف حيون الوارث لبركة وسر جده حيون الكامل. نجد بعض نساء القرية أكثر وعياً. تقول عمة الساردة وهي تحدث النساء:” ليس كل ما نسمعه مقدساً. لا تصدقن كل ما تسمعنَه. الاعتماد على الله وعلى أنفسنا يصنع قوتنا”. بينما أهل القرية يقدمون للشريف حيون ما يملكون؛ خبزاً أبيض، دجاجاً، معزاً وأبقاراً، والبعض مَلَّكَهُ بساتين. كل ذلك يقدَّمُ للشريف حيون الذي يأتي لمعاينة أراضيه، وتجديد عهده مع الطيور وأفاعي البركة السوداء. العمة لا تتوانى من نعت حيون بالعجز والقصور.
وهنَّ قوياتٍ رغم الصِّعابِ التي يرزحن تحتها، فالساردة، وهي طفلة، والأم، الذي غاب أو غُيِّبَ عنها زوجُها، والعمة العمياء، يتمَتَّعْن بالقوة والصبر اللَّذَيْنِ أَبْدَيْنَهُ وهنَّ يَسْعَيْنَ إلى تهييئ الفحم قصد بيعه لتجاوز الضائقة التي تُكَبِّلُهُنَّ نتيجة غياب الأب. والعمَّةُ تتحدى الرجال ولا تخشاهم، فهي تقف في وَجْهَيْ ” الطرونكو” و” شيبو” وتعلن تحديها لهما وعدم الانصياع لما يسعيان إليه”. ص173.
لكن تبقى المرأة امرأةً، تحتاج إلى رجل فهو موطن الأُنْسِ، فعندما هَمَّتِ الأم أن تقبض على ديك قصد منحه للرجل الذي قايض به استرجاع البقرة، إضافة إلى أشياء أخرى، تقول العمة: ” دعي الديك يُؤْنِسُ الدجاجاتِ المتَبَقِّيَة ويُؤْنِسُنا. على الأقل يكون بيننا ذَكَرٌ حتى ولو كان ديكاً”. ص 151
هذه بضع نماذج من صورة المرأة التي قدمها لنا البشير في أعماله، بقدر سقوط البعض وخنوعهن للواقع المتردي، بقدر وقوف البعض الآخر في وجه هذا الواقع.
وفي المقابل، رجال” زهرة الجبال الصماء” نفعيون، وانتهازيون، وخبيثون، باستثناء قلة، ومنهم “يحيا النسا”، فعندما تعلم الأم كون العجلة المفقودة تمَّ العثورُ عليها وحجزُها، تعي بأنها مُلْزَمَةٌ بتأدية ثمَنِ احتجازها لتخليصها، وهذا عُرْفٌ من أعرافِ المداشر، تَعويضَ المتضرَّرِ عمَّا أفسدَتْهُ البهائمُ وما تَمَّ صَرفُهُ عليها أيضاً. فتكون مَطِيَّةً للرجل ليرغبَ في مبادلة البقرةِ مقابل مضاجعة صاحبتها. ولا يخجلُ عن الإعلان عن ذلك مُدَّعياً ” أنه ما أخذَ إلا حقَّهُ، لكن بطريقته التي فَضَّلَها ويُفَضِّلُها”. ص 183.
و”الْكَعْروط” الذي يعترض سبيل مقدم القرية ليلاً، ويفزعه، لم يقف خبثه عند هذا الحدِّ بل تعدَّاهُ إلى اغتصاب العمة العمياء، وذبح المعزة التي تاهت في الجبال والاحتفاظ برأسها المنزوعِ حتَّى يُوهِمَ ( المرأةَ والعمةَ) بأن الذئب افترسها.
” زهرة الجبال الصمَّاء” حكاية؛ بل حكايات بصيغة الجمع؛
حَكْيُ الساردة عن غياب أبيها، وهي حكاية ترويها العمة التي هي فرد من جوقة موسيقية، تروي أنه خلال حفلة نظمها العريبي طفق الأب يتغنى بشامة أخت العريبي ويتغزل بها، لم يرض العريبي عن ذلك وهدد بقتل الأب، لم تنفع المقاومة ولا التوسلات، ويخبو خبر الأب وشامة، ” غاب أبي وطارت شامة.. لم نعرف إن كانت الأرض بلعتهما أم السماء رفعتهما” ص 25.
حكي العمَّة كيف غاب الأخ واعتداء رجال العريبي، وكيف أصيبت بالعمى بعدما استقبلت عيناها دمَ كل من عبد السلام وأحمد عضوي الجوقة، بعدما أصيبا برصاص رجال العريبي.
حكي ” يحيا النسا” كيف ضبط زوجته مع عشيقها ” افْريفر “، ولم يقتلها.
حكي ” افْريفر” لصديقه الذي سرعان ما أفشى سره، كيف مارس الجنس مع زوجة يحيا النسا.
” زهرةُ الجبال الصمّاء” توليفٌ بين واقعٍ مُزرٍ يتخبط فيه نساء القرية وسكانها، بين فَكَّيْ الفقرِ والحاجة، والخرافاتِ والأساطير التي تعشِّشُ في أذهان الناس، فخدُّوجة المرأة المُسِنَّةُ التي تقود النساء أيام حصادِ البردي تحكي عن القرابة التي بين الإنسان والأفاعي، وهي ترويها عن جدتها التي ترويها بدورها عن جدتها، وأن هذا العداءَ قديمٌ يمتدُّ إلى غابر الأزمان.
وصاحب ” عيون الغزال” سالبُ عقول نساءِ الرِّجالِ يغتسلُ ليلاً وبعيداً عن أعينٍ تلاحقُهُ لجماله، مُخْفِياً عُرْيَهُ الساحرَ الأخَّاذَ بالألبابِ، وكيفَ تحوَّلَتِ الأفعى إلى أُنْثى.
هو ذا جزءٌ من العالم الروائي عند البشير الدامون، هذا العالم الذي ينبني على الحكي؛ حكي لا يستطيع البشير التخلصَ منه، حكيٌ يزرعُ بذرةَ الجمال في حقول نصوصه وعلى لسان فاعليه حتى وإن كان الفاعلون من شرائح اجتماعية لم تنل حظها من المعرفة والدراسة النظامية أو حاملة لمؤهلٍ ثقافي، بالمفهوم الخاص للثقافة. فالعمة في ” زهرة الجبال الصماء”، وهي مجرد مرددة في جوقة غنائية شغفها الحكي. والحكي في قرية الطفلة الساردة شَغَفُ نساءٍ له مرتبةُ الدفء في البيت. الأجدادُ يؤكدون أن الحكيَ والغناءَ يزعجان الجبال الصماء. الحكيُ له سلطة تدفئُ وتهدهد الروح. وحكي البشير في رواياته يهدهد الروح ويمتع الذائقة، وينعش العقل.
تقول عمة الساردة في ” زهرة الجبال الصماء”:
” لم يخلق الله الزهور والورود عبثاً، خلقها لنحتمي بها من القنط والملل وقسوة الحياة”، وأنا أقول: ” روايات البشير زهور وورود لم تأت، بدورها عبثاً، بل أتت لتخبرنا أن موطن الجمال السردي اسمه البشير الدامون.