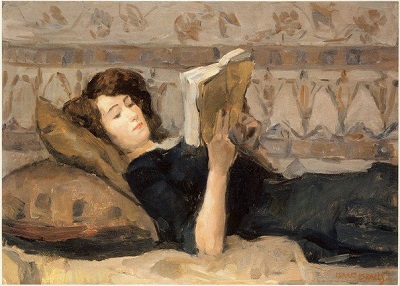ممدوح رزق
يرتبط الغموض، وغياب الحكمة بموضوع آخر وهو انتفاء ما يُسمى بالتماسك البنائي؛ إذ يتم توجيه الانتقادات الثابتة لعدم وجود معطيات كافية، أو تسلسل منطقي للأحداث، أو تفسيرات عقلية مقبولة للتحولات أو الانتقالات المفاجئة، أو تبريرات حاسمة لدوافع الشخصيات وسلوكياتها، أو التزام بالمسارات الأساسية المتناغمة للسرد، أو التوافق بين اللغة ووعي الشخصيات وطبيعة الأماكن، أو الحصول على نهاية مشبعة تنسجم مع السياق الروائي.
يرجع هذا الارتباط إلى ما يقدمه هذا “التماسك البنائي” من دعم للوضوح المنتظر في العمل الأدبي، ولسهولة استخلاص “المعنى”، والحصول على “الاستفادة” أي “المتعة المعرفية والجمالية”؛ فالفهم لن يصبح عملية شاقة إذا كان كل شيء مرتبًا، يتنامى عبر نظام متوازن، وينتهي بعفوية محكمة .. هل يجب أن نتذكر الآن هيكلة تقرير تحكيم العمل لجائزة كتارا للرواية العربية والتي ناقشتها في مقال سابق؟:
“من السهل ملاحظة أنه في مقابل استخدام واضعي هذه الهيكلة لكلمات مثل: (تجريبي ـ غير مألوف ـ غير تقليدي ـ تجديد ـ طريف ـ ابتكار ـ غير مقلّد)؛ سنجد استخدامًا آخر لكلمات مثل: (بناء ـ خبرة ـ سلامة ـ بنية ـ إحكام ـ ترابط ـ تناسب ـ توظيف ـ مواءمة ـ خلاص ـ انتماء) .. كأن هناك خطاب يتم تكريسه عبر هذه الهيكلة يفيد بتحديد شروط للتجريب، وقواعد للخروج عن المألوف، ومعايير للابتكار .. لكن هذا الخطاب ـ بصرف النظر عن فكرة التقييم بالدرجات في حد ذاتها ـ لا يكرّس لهذا حقًا بقدر ما يؤكد أنه نتيجة هذه الشروط والقواعد والمعايير فإن كلمات: (تجريبي ـ غير مألوف ـ غير تقليدي … إلخ) ليست سوى لافتات ضرورية أو عناوين رسمية ينبغي على أي جائزة ـ إن أرادت ذلك ـ أن تعطي بواسطتها صورة متوازنة لنفسها، تحميها استباقيًا ـ بحسب ما تعتقد ـ من النقد أو الاتهام بالرجعية، وفي نفس الوقت لا تحرم وجودها في (الحياة الثقافية) من وجاهة (المعاصرة) عبر استعمال كلمات ليس هناك أسهل من استهلاكها دون اهتمام يتخطى تدوينها في (هيكلة(“.
يبرر خطاب التدوينات شهوة “التماسك البنائي” بذلك الإيمان الجذري ـ غير القابل للمساومة ـ بأن جميع النصوص لابد أن تمتلك ما يُعتقد أنها “صلابة” مماثلة لتلك التي تتسم بها المتون التأسيسية سواء كانت قصصًا تنتمي إلى كتب الديانات، أو حكايات قديمة تُشكل “التراث” بأصوله وتناسخاته الشفاهية والكتابية، أو تاريخًا أدبيًا توطد عبر الزمن كذاكرة جماعية راسخة من النصوص التراكمية التي تعاملت مع هذه القصص والحكايات العتيقة كأشكال متعددة لمنهج مقدس .. تماسك البنية إذن ليس بداهة شكلية، بل دليلًا على إيمان الكاتب بما يعتقده الجميع، وتصديقه للمُثّل والغايات التي يخضع لها القرّاء بصوّر متفاوتة.
من اليسير بالضرورة ملاحظة الصفات العدائية التي يمنحها المدونون لما يبدو أنه “خلل” في هذا التماسك: ترهل .. تفكك .. تشتت .. حشو … إلخ؛ فكاتب الريفيوهات الممتلئ بما يكفي من النطاعة، والذي يميّز نفسه أحيانًا كناقد عن المراجعين الآخرين، لديه مشكلة حقيقية في التحدث عن ذاته؛ فهو دائم الإشارة إلى “القارئ” حينما “ينتقد” أمرًا ما، كأنه يردد طوال الوقت بأن ما يثير استياءه شخصيًا لاشك أنه سيثير استياء القراء كافة، والذين يتم اختزالهم وتجميعهم غصبًا في هذا الكيان الكوني، الكلي، المطلق، الشامل، الثابت، المحدد والمتوهم الذي يُسمى “القارئ” .. لا يوجد شيء نسبي هنا؛ فهذا المُراجع يتحدث باسم الجميع، وحينما يرى تفاصيل “غير مهمة” في عمل ما، أو عشوائية، أو عدم ترابط فإن المشاعر السلبية التي ستنتابه نتيجة لهذا “لابد” أنها ستصيب كل من سيقرأ هذا العمل، وبالتأكيد فإن هذه الأحكام (التقييمية) أسهل بكثير جدًا ـ حيث يظهر الفرق الجوهري ربما بين المراجع والناقد ـ من محاولة اكتشاف العلاقات المخبوءة بين هذه التفاصيل “غير المهمة” والتفاصيل الضرورية الأخرى، أو بناء هذه الصلات وفقًا لبصيرة تبتكر دائمًا ألعابها الخاصة، أو إضاءة الفراغات المتوارية التي يُحتمل أن يتلاقى داخلها ما هو “عشوائي” وما يبدو أنه أصل للحكاية، أو خلق استفهام تخييلي يضم الشذرات أو “الأشلاء المتفرقة” التي تظهر للوهلة الأولى كنتوءات خارج النسق السردي ويعطيها بالتالي آفاقًا تأويلية أبعد من الحدود البسيطة المباشرة، كما أن الإدانة السطحية أسهل بكثير جدًا من الصمت حينما يعجز المدوّن عن أن يقوم بما سبق .. ذلك بالإضافة أيضًا إلى عدم قدرة هذا النوع من كتّاب الريفيوهات على التفرقة بين “القارئ” الذي أبدى بالفعل من خلال مراجعاته عن الكتب نوعًا من الانحياز المشترك مع قراء آخرين في ظواهر معرفية وجمالية معينة، وبين الكائن المختلق الذي لا وجود له، الممثل للقراءة ذاتها ـ مثلما تحدثت في مقال سابق ـ المتنكّر لأي اختلاف أوتضاد بين القرّاء، والذي يفرض عليه قهرًا هذا المُراجع وعلى نحو مجاني كل تعارض أو تنافر بينه وبين عمل أدبي حتى يُكسب رأيه الشخصي ـ أو بالأحرى رؤيته القاصرة ـ مصداقية زائفة خارج حدوده الذاتية اسمها “القارئ”، وكذلك بين “القارئ” الذي تتم مخاطبته ضمنيًا أحيانًا، أو بشكل مباشر في وضعيته الاعتبارية القابلة للتجسد عندما يقبل اقتراحًا معينًا للتفكير أو النظر أو الالتفات إلى زاوية أو إلهام أو تساؤل ما داخل النص من قِبل الناقد، وهو الأمر المناقض لليقين بوجود “قارئ مهمين” من الحتمي أن يرفض “شيئًا سيئًا” بعينه داخل هذا النص.
هنا يعمل الخطاب ـ كما سبق وأشرت ـ كآلية ضبط وعقاب؛ إذ لابد أن يكون ما يراه هذا القارئ من عدم وجود معطيات كافية، أو تسلسل منطقي للأحداث، أو تفسيرات عقلية مقبولة للتحولات أو الانتقالات المفاجئة، أو تبريرات حاسمة لدوافع الشخصيات وسلوكياتها، أو التزام بالمسارات الأساسية المتناغمة للسرد، أو التوافق بين اللغة ووعي الشخصيات وطبيعة الأماكن، أو الحصول على نهاية مشبعة تنسجم مع السياق الروائي؛ لابد أن يكون هذا أمرًا مُسيئًا للعمل الأدبي يتوجب مواجهته، كما لابد ألا يكون هذا حكمًا شخصيًا لهذا القارئ بل يجب أن يكون حكمًا عامًا لجميع القراء، وهو بهذا التعميم القسري لا يحاول ضبط “الطريقة” التي تبناها الكاتب في هذا العمل، وعقابه على استخدامها؛ بل تصحيح جزائي لفساد الصلة أو انقطاعها بين هذا الكاتب والمبادئ الشاملة للحياة التي أكدها تراث إلهي مُلزم، وهو بمثابة الضلال الذي دفعه للكتابة بهذه الطريقة “الخاطئة”.