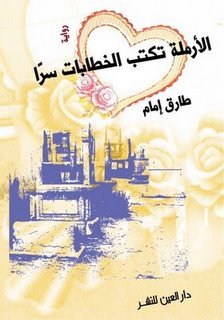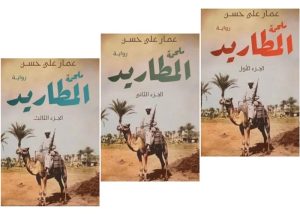توقفت هنا.. وأعدت قراءة السطر وأنا أتساءلُ أيّ موت يقصد؟!
للمرة الثانية ألتقي بثنائية الموت والحياة في إبداعات “طارق إمام”، لكنها تختلف عن تلك في “هدوء القتلة”. ففي “الأرملة”، الطريق الرابط بينهما مهده الحب وليس الإبداع كما كان الحال في روايته السابقة “هدوء القتلة”. فـ”مَلك” الأرملة التي كانت تعمل مدرسة عادت للمدينة لكي تشتري لنفسها قبرا تدفن فيه حيث إن أهلها مدفونون في مقابر الصدقة. لكن يحدث وهي غائبة عن الدنيا أو في “نوبة احتضارها السنوية” في شهر يناير “شهر الوداعات”، أن يصلها خطاب حب يؤجج فيها الدفء ويعيدها للحياة. وبعد أن أقنعها زملاؤها بالعمل كمدرسة خصوصي لشغل وقت فراغها، اكتشفت أن لها رسالة أخرى في الحياة تجاه هؤلاء التلميذات غير تعليمهن اللغة العربية.. أن تكتب لهن رسائل الحب الملتهب. مما جعل لوجودها معنى أو كما أبلغ “طارق” في التعبير: “منح حياتها رعشة كانت بحاجة إليها، كما منح يدها الفرصة لتعبر عن بلاغتها القديمة التي لم تسنح لها الفرصة من قبل للتعبير عنها”. وتحولت البنات من مجرد تلميذات إلى “حكاية تحكى مرة بعد أخرى، قد تبتر مبكراً أو تصل إلى نهايتها التي قد تكون سعيدة أو تعسة. كن بالنسبة لها مجرد مبرر للوجود فحسب، قطيع عيون مندهشة، وقلوب ترتجف”.
يستخدم الكاتب راوياً يحلق فوق المدينة وبيت الأرملة ليسرد ما يحدث بلغة رائقة، وأسلوب وصفي سلس وأخّاذ، لا يخلو من الشاعرية حتى إن كان ما يصفه مقبضاً أو غير جميل. ففي وصفه للرجل المسئول عن المقابر، لا يكتفي بوصف شكله ووجهه وحركة عينيه، بل يجلي تأثير ووقع ما تراه “ملك” في نفسها تجاه ملامحه التي خففت من وقع وحشية الندبة على نفسها:
“شعرت فجأة أنها في مكان آخر. نطرت للخفير من جديد، وجدته ينظر في عينيها مباشرة، وشعرت به يلتهمها بعينيها فأدرات وجهها بسرعة. يدير وجهه في كل النساء، ولكنه يظل بارداً كأنه يتأمل عريهن النهائي في لحظة الموت. هناك ندبة مفتوحة في خده الأيسر، مثل مجرى صغير داكن في وجهه، لم يُرَتّق. حولها ما يشبه الدم مالتجلط بلون بني داكن. رغم ذلك، كانت بنيته القوية وملامحه الحادة تبدو لـ”لملك” كافية لتمرير هذا الجرح المخيف”.
ولعل سمة دقة الوصف وشاعريته في أسلوب “طارق إمام” تساهم بشكل كبير في إجادته رسم شخصياته وردود أفعالها لتبدو شخصية حية جداً يستطيع القارئ أن يطابقها مع شخصيات يراها وقد يشارك مع الكاتب في إضافة بعض الرتوش والكماليات. فأنا مثلا لا أعرف لماذا كلما تحدثت “رجاء” أتخيلها تحرك حاجبيها ويديها كثيراً أثناء الكلام، وتحملق بجرأة بدلاً من النظر، وتمضع كرة لبانة كبيرة بجانب فمها بأسلوب فجّ لا يعني شيئاً سوى أن ثقافتها كعاملة بالمدرسة أو “دادة” لم لم تعلمها التهذيب!!
كما أنه يجيد التمهيد للأحداث بسبل شتى. فعل ذلك منذ البداية جداً تلميحاً من خلال مقتطفين لابن حرزم الأندلسي من “طوق الحمامة” والشاعر المكسيكي “أوكتافيو باز” اللذين لم أنتبه لهما إلا بعد انتهائي من القراءة، فكانت سعادتي لأنها أكدت لي صحة ظني! وذلك دون أن يعطي كثيراً من التفاصيل فيتركه قارئه عند منتصف العمل لأنه لم يعد في حاجة لمعرفة المزيد. وتظل التفاصيل تنكشف شيئاً فشيئاً فلا نعرف عن حياة الأرملة السابقة، قصة حبها، وزواجها بمن لا تحب، إلا في منتصف الحكاية. فقد بدأ بحادثة وصول خطاب إلى غرفة الأرملة الذي هشم زجاج شرفتها ثم رويداً نعرف أن هناك حياة –تخصها وحدها ولا يعلم بها أحد- على وشك البدء، بالتحديد من وصفه لفستانها:
“كانت في نظر الجيران مجرد امرأة تنتظر الموت. ترتدي على الدوام فساتين حداد سوداء لا تخلو من زهور لم تكن مرئية رغم أنها مطرزة بعناية ودقة ذلك أن الزهور كانت سوداء أيضاً”.
المدهش، هو دقة ضبط الكاتب لحركة “ملك” بين عالمي الواقع والخيال، بين ما تعيشه مع تلميذاتها وما تفكر فيه أو تتذكره وقد يتراءى لها كما حدث مع طيف زوجها –الراحل- الذهبي، وما تراه في أحلامها، دون أن يشعر القارئ بفعل فارق مكاني أو زمني، ودون أن تفقد وحدة العمل تماسكها. وهو ما يسمى بالواقعية السحرية التي تحتاج الكتابة فيها لجرأة واعية وموهبة مصقولة. وتوافق واقعيته السحرية سيولة زمنية، فالأحداث لا تـُقدم حسب ترتيب زمني صارم ولا يوجد وقتاً حقيقياً نعيشه. إنما نعيش وقت الشخصية ذاتها ونتحرك بين الأزمنة كما تتحرك في وعيها