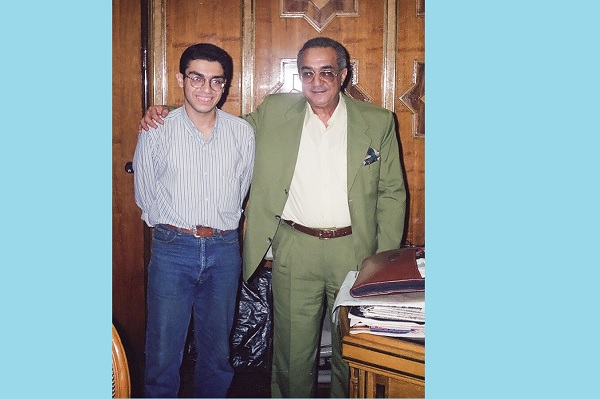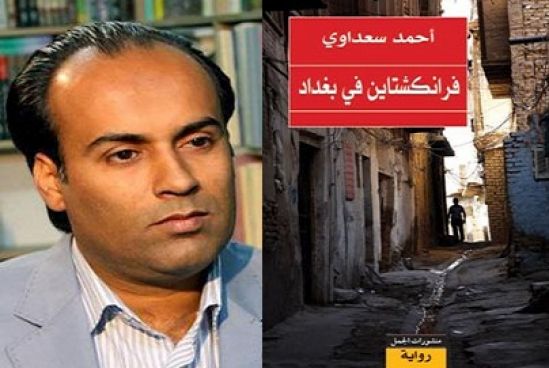حاوره: مهند الصباغ
من المجموعة القصصية «طيور جديدة لم يفسدها الهواء»، مرورا بمجموعته «الأرملة التى تكتب الخطابات سرًا»، وصولًا إلى روايته الأخيرة «ضريح أبى» استطاع طارق إمام لفت انتباه النقاد والقراء، وحصد عددا من الجوائز أهمها جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام 2010 عن رواية هدوء القتلة، وجائزة ساويرس عام 2009 عن الرواية ذاتها، ويعد أحد الكتّاب الشباب الذين أثروا الرواية العربية بكتاباته الغرائبية الفانتازية. الرواية الأخيرة لإمام «ضريح أبى» ناقشت الصراع بين الدين الشعبى فى مواجهة الفكر السلفى والرؤية الأصولية للدين، فكان لنا حوار معه حول رؤيته لما يجرى حاليا على الساحة السياسية، وتأثيرها على الأدب، بالإضافة إلى روايته الأخيرة وتقنيات كتابتها.. فإلى نص الحوار:
■ تعيش مصر الآن مرحلة تأجج ثورى، وفوران فى المجتمع.. كيف تنظر من موقعك كروائى لهذه الأحداث؟
– ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية دعمها الجيش، ولا تجوز معها دعوات المصالحة فى الوقت الحالى، ويمكن وصف الحديث عن المصالحة الآن ب«النكتة»، فلا بد من محاكمات عادلة، وتقصى جيد للوقائع التى شهدتها مصر مؤخرا، ثم نبحث بعد ذلك فى أمر المصالحة مع أى طرف.
الأمر الآخر الذى يهمنى كثيرا هو انتهاء الفترة الانتقالية سريعا، لأن المواطن العادى لن يتحمل عدم استقرار الأوضاع أكثر من ذلك، بالإضافة إلى أن النخبة تختلف عن المواطن، فيمكن لها أن تفسر الأمور بشكل مختلف، عن الملايين الذين احتشدوا فى الميادين فى 30 يونيو، لعدم توافر البنزين، أو لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، ولا بد من أن يشعروا بتغيير سريع، فى بعض الأمور مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور.
كما أرى أن ثورة يونيو أكثر تماسكا وقوة من ثورة يناير التى اعتبرها رومانسية إلى حد كبير، فهناك قدر أكبر من الحنكة السياسية فى إدارة البلاد بعد ثورة يونيو، وهذا له علاقة بطريقة تدخل القوات المسلحة فى الثورة.
■ هل تعتقد أنه يمكن بلورة هذه الأحداث السياسية فى عمل روائى؟
– بالتأكيد، ومن قبل قيام الثورة كانت لدى أفكار لها علاقة بالتغيير، وعدد كبير من كتّاب الجيل الذى انتمى إليه كان لديه إحساس بوقوع تغيير ما، بعد الحراك الذى شهده الشارع قبل قيام الثورة، إلا أننى قررت عدم الكتابة عن ثورة يناير لأنها بمثابة حلقة لم تكتمل، وأثبت الواقع بالفعل استكمال هذه الثورة بما حدث فى 30 يونيو.
بالإضافة إلى أنه لا يمكن للأدب منافسة الصحافة، لأن دور الصحافة هو متابعة ما يحدث بشكل مستمر، بالإضافة إلى أن الأدب تغيير بشكل كبير عن فترات سابقة، كان يقوم فيها بالتأريخ لفترات معينة، لكن الدور الإعلامى للأدب انتزع منه، بعد التطور الكبير فى وسائل الإعلام، فأصبح من الصعب على الأعمال الأدبية منافسة الصحف اليومية وبرامج التليفزيون، أو حتى فن مثل الجرافيتى.
كما أنه لا يجب أن أكتب رواية بمبدأ الانحياز المطلق. الرواية تبنى على المتناقضات والصراع، وإذا أصبحت متأثرا بحدث ما أو متعصبا لانتماء معين، سيكون من الصعب كتابة رواية جيدة، ففى الأدب لا بد من الوقوف على مسافة واحدة من كل الشخصيات، ولا معنى لأن أجلب جماعة الإخوان المسلمين فى رواية لأدينها فقط، فيجب تحليلها والبحث فى تفاصيلها، وعلاقتها بالآخر.
■ وما مدى تأثيرها على الأدب عموما والرواية خصوصا؟
– الأحداث السياسية والأدب ملتبسان بشكل كبير، وأثرت الأولى على الثانى بشكل ملحوظ، سواء من خلال توزيع الكتب، وتنظيم حفلات التوقيع، أو على الكتّاب أنفسهم المهتمين بالحدث السياسى، ويشاركون فيه بشكل دائم، كما أن عددا كبيرا منهم يكتب أعمدة سياسية فى الصحف اليومية، وهذا أمر طبيعى فى لحظة تاريخية مثل التى نعيشها الآن.
■ ما رأيك فى الأعمال الأدبية التى تطرقت إلى الثورة وما بعدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟
– أغلب ما كُتب عن ثورة يناير كتابات انفعالية، بالإضافة إلى أن بعض الأدباء يدّعون الآن أنهم تنبأوا بالثورة، وهذا أمر غير صحيح، ولو افترضنا جدلا صحة قولهم، فقيمة الأدب ليست فى تنبؤه بحدث سياسى معين، حيث إن الأدب به مجموعة من القيم، من بينها القيمة السياسية وهى ليست الأهم على الإطلاق.
■ فى رواية «ضريح أبى» تناولت التراث الشعبى وتأثيره على الأفراد والجماعات..وهذه هى المرة الأولى التى تتطرق إلى هذا الموضوع.. هل حدث تغيير فى وجهة نظرك للفن؟ وهل وصول تيار الإسلام السياسى إلى الحكم دفعك إلى تناول الموروث الدينى وتفكيكه من وجهة نظر فنية؟
– فكرة رواية «ضريح أبى»، بدأت بقصة قصيرة اسمها «العجوز الذى أغضب الموت»، ونُشرت فى جريدة «الدستور» عام 2006، بعدها انشغلت لفترة طويلة بتحويل هذه القصة إلى عالم روائى متكامل، ثم نشرت عدة قصص قصيرة فى الجريدة ذاتها تتناول فكرة الرواية، وكانت بمثابة «بروفات» لتحويل القصة إلى رواية، وبدأت فى العمل على ذلك من عام 2006 حتى عام 2008، حتى توقفت لكتابة رواية «الحياة الثانية» لقسطنطين كفافيس.
وبعد الانتهاء من رواية «الحياة الثانية» لقسطنطين كفافيس، وظهور جماعة الإخوان المسلمين على الساحة، ووصولها إلى الحكم، ألحت علىّ فكرة رواية «ضريح أبى» لاستكمالها، وبرزت بعض العناصر الجديدة فى الرواية، منها الاتكاء على الدين الشعبى فى مواجهة الرؤية الأصولية للدين، والممثل فى الرواية من خلال الضريح الذى يواجه الأشخاص الملتحين، وهم يمثلون الجماعة السلفية فى مصر، بالإضافة إلى أن انتصار الدين الشعبى فى نهاية الرواية له علاقة بالتأثر بالواقع.
■ فى أعمالك السابقة تميزت لغتك بالشاعرية والغموض أحيانا.. فى «ضريح أبى» انحزت أكثر إلى لغة السرد، لغة الحكاية السيالة.. ما سبب تغير لغتك بهذه الرواية؟
– أرى دائما أن الروائى ليس صاحب لغة معينة، فالنص الروائى هو من يأتى بأسلوبه، فلا يمكن للروائى تحديد تقنيته فى الكتابة قبل أن يبدأ، لكن الموضوع ينتج طرق حكيه، لذلك ففى كل رواياتى لا أقوم بالفصل بين الشكل والمضمون، وأعتقد أنه لا يمكن الفصل بينهما، كما أن أسلوب الحكى السيال كان جزءا من فكرة الرواية، خصوصا أننى أقوم بسرد حكاية لها مقاييس خاصة، وأريد من القارئ أن يمضى معى فيها بشكل معين.
■ الرواية قائمة بشكل أساسى على تيار الواقعية السحرية، لماذا لجأت إلى هذه التقنية فى «ضريح أبى»؟ وما رأيك فى قول «إنه تيار مستورد من أمريكا اللاتينية»؟
– سأجيب أولا عن الجزء الأخير من السؤال، ما المدرسة الأدبية التى يمكن وصفها بأنها غير مستوردة، فالمدارس الرمزية والتعبيرية والسيريالية والتكعيبية، جميعها مستوردة من الخارج، إذا فكرنا بهذه الطريقة، وهذه المصطلحات تبلورت بشكل حقيقى فى الغرب، ولم تملك الثقافة العربية إلا الشعر.
الثقافة من وجهة نظرى ليس بها مستورد ومحلى، الثقافة فعل إنسانى، وعلى العالم كله الاستفادة منها، مثلما استفاد العالم الغربى من قصص «ألف ليلة وليلة» فى طريقة السرد، ومنهم جابريل ماركيز وباولو كويلو وإيتالو كالفينو، ولم يتهمهم أحد بأنهم استوردوا «ألف ليلة وليلة» الشرقية، فالثقافة ليس لها وطن، والأهم هو طريقة الاستفادة من الثقافات المختلفة.
بالإضافة إلى أن الواقعية السحرية ليست بدعة، وظهرت نتيجة الثقافة العربية، وتراث الأدب العربى كله له علاقة بهذا التيار، سواء كان «ألف ليلة وليلة»، أو «كليلة ودمنة»، فهذه نصوص عجائبية، ولكن عندما يأتى كاتب ليستغل هذا التيار من الكتابة يُتهم بأنه يستورد أسلوب غربى.
كما أن الكتابة الغرائبية ليست كتابة منفصلة عن الواقع، بل على العكس هى كتابة تقرأ الواقع من منظور مختلف، فليس شرطا أن أقرأ الواقع من باب المحاكاة، فيمكن أن أقرأ الواقع بطرق مختلفة من خلال الأحلام أو مزج الواقعى بالخيالى، وهذا ما يؤكد أن قانون الكتابة الوحيد ليس قانونا، ولو صار هناك قانون واحد للكتابة فلن نجد أدبا حقيقيا بعد ذلك.
واستخدمت هذه الطريقة فى رواية «ضريح أبى» لأن الفكرة نفسها نسجها الخيال، فالأولياء وكراماتهم ومعجزاتهم عالم خيالى وجدانى، والصوفية ككل منحى خيالى فى تأويل النص الدينى، فكيف يمكن أن أكتب رواية ك«ضريح أبى» وأتعامل مع مفاتيحها بشكل عقلى.
■ وما مستقبل الكتابة الغرائبية فى الأدب من وجهة نظرك؟
– هناك أكثر من الكتاب يجرّب فى هذا السياق، منهم أحمد عبد اللطيف، وطاهر الشرقاوى، وأحمد الفخرانى، وبالفعل تم إنتاج نصوص أدبية فى الأونة الأخيرة حققت نجاحا، وإن كانت الروايات الغرائبية ضد الذائقة السائدة نقديا، لكن هذه الكتابة فى السنوات الأخيرة عبر بعض نماذجها حققت نجاحات ملموسة، وحصلت أنا وعدد آخر من كتاب هذا التيار على جوائز عديدة.
كما أننى أعتقد أن هذا النوع من الكتابة تمكن من ثقب جدار الكتابة الواقعية الرتيبة، والتى تحولت فى الكثير من نماذجها إلى كتابة أشبه بالكتابة الصحفية، بالإضافة إلى أن الغرب حسم الجدل حول أنواع الكتابة، فأصبحوا نوعين، كتابة تمثيلية، وكتابة استعارية.
■ كتاباتك تختلف عن الكتابات المصرية السابقة فى جيل الستينيات والسبعينيات والتسعينيات فما الأسرة الأدبية التى تنتمى إليها؟ وما تأثير الأدب العالمى عليك مقارنة بالأدب المصرى؟
– الحقيقة أنى لا أفضل تصنيف الأدب كأجيال، وللأسف هذا خطأ نقع فيه بمصر، ولكنى أرى أن تصنيف الكتاب الحقيقى كتيارات، فكل جيل به أنواع مختلفة من الكتابات، لذلك فأرى أن تقسيم الكتابة إلى أسر أفضل بكثير.
وأرى نفسى انتمى إلى أسرة كبيرة فى الكتابة، منها خورخى لويس بورخيس، وجابريل ماركيز، وجون فاولز وكافكا، ومن مصر كتّاب مثل محمد حافظ رجب فى أعماله الأولى، وهى أسرة ترى الأدب انزياحا عن الواقع، وكل كاتب فيها يكتب بطريقته المميزة تحت مظلة واحدة، وهى كيفية الكتابة عن الواقع دون أن تقدم نصا واقعيا، فدور الفن أن لا يقدم الواقع كما نراه، فتقديمه بهذه الطريقة لا يحتاج إلى فنان، لكن الواقع يحتاج إلى فنان يكتبه كما يراه هو فقط.
وتأثرى بالأدب العالمى كان أكبر من تأثرى بالأدب المصرى، لأن الأدب المصرى فى كثير من نماذجه كان يدور فى فلك تقليدى، حتى الكتّاب الذين حاولوا الكتابة بشكل مختلف كانوا قلة، وعلى الهامش من الرواية المصرية، إلا أننى تأثرت ببعض النصوص العربية مثل «ألف ليلة وليلة» و«كليلة ودمنة» وكتاب «الحيوان» للجاحظ.
■ فى «ضريح أبى» هناك صراع ما بين المدنس والمقدس، الأم والأب، فى الوقت ذاته البطل يبحث عن الأم.. ماذا يعنى البحث عن الأم فى الرواية وتصويرها كانعكاس للفن؟
دائما كان هناك سؤال يشغلنى حول ثقافتنا العربية، التى تقع بين المقدس، كاللغة على سبيل المثال، فإذا حاول كاتب التلاعب باللغة وتحريفها، يمكن أن يتهم بالكفر، لأن اللغة العربية نفسها اكتسبت صفة القداسة من أنها لغة النص المقدس، وبين المدنس من ناحية أخرى، لأنك تعيش بواقع ملىء بالدنس، وبنظرة دونية للفن، فالأم تمثل الإبداع بالرواية، لذلك فاتهمت بأنها زانية وزنديقة، وعليها أن تكفر عن ذنبها.
بالإضافة إلى أننا نعيش حاليا هذه الحالة، بين اعتقادنا بأننا أبناء أفضل الثقافات والحضارات التى استفاد منها العالم كله والتى نقلت المعرفة على مر التاريخ، إلا أننا فى الوقت ذاته أبناء واقع فقير وغير منتج.
■ الجزء الأخير من الرواية جاء فى شكل تأمل وتوقف السرد.. ألم تخف أن يتهمك أحد بخروج الرواية عن حيز الفن السردى؟
– لم أخف من هذا الاتهام، لأنى أعتقد أن الرواية كنص أدبى تتسع للتأمل والحكى، وخلق مستويات مختلفة من اللغة، وفى الغرب أصبحت الآن الرواية بديلًا عن الفلسفة بشكلها التقليدى، فالرواية بهذا الشكل هى الفلسفة وقد نزلت من عليائها لتصبح متداولة على ألسنة الناس، لذلك فأرى أن الجانب التأملى لا يثقل الكتابة الروائية بشرط أن يجيد توظيفه، وهذا يعود إلى القارئ.
■ وما مشاريعك الأدبية الفترة المقبلة؟
– هناك مشروع رواية جديدة، لا أفضل الحديث عن تفاصيلها الآن، وسأتعرض فيها للوضع الملتبس الذى نعيشه اللحظة الراهنة، لكننى أشعر أن أنتظر حتى لا أكتب رواية انفعالية عما يحدث حاليا، وفى الوقت ذاته أستعد لتحويل رواية هدوء القتلة إلى فيلم سينمائى.