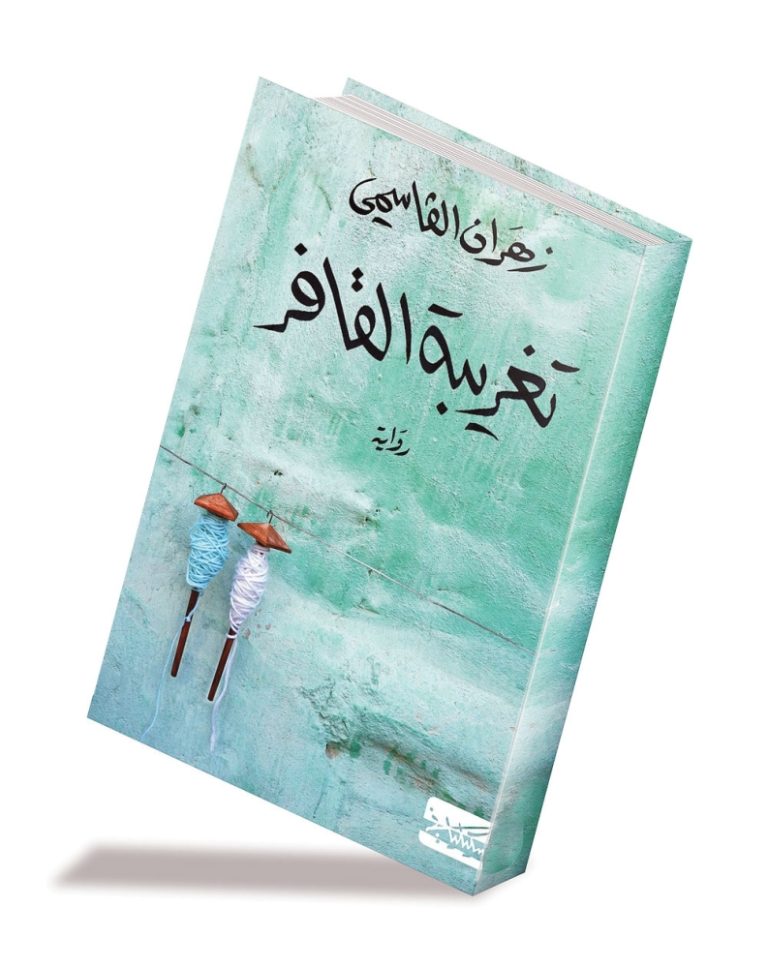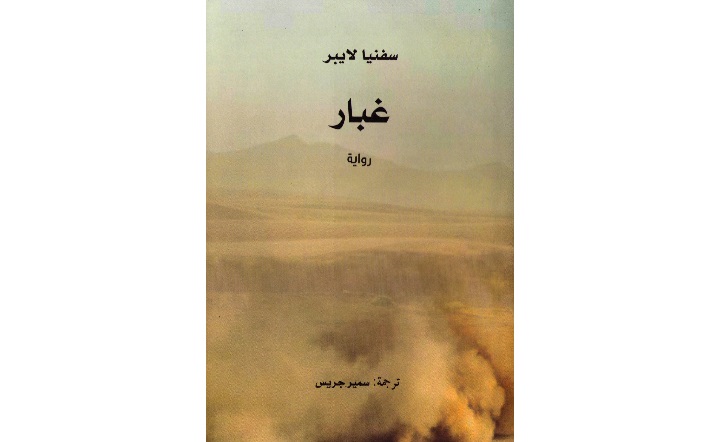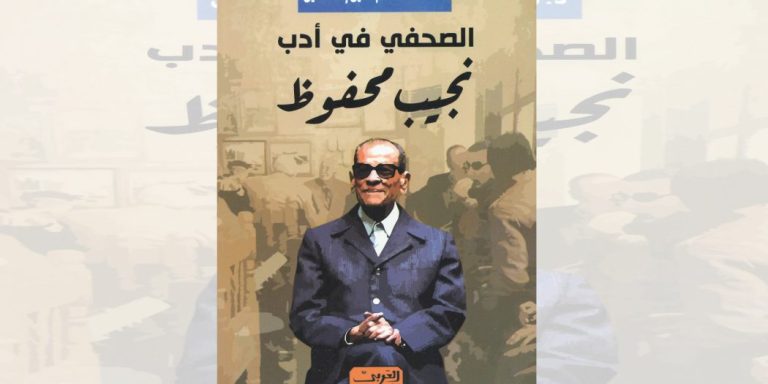كعادة أنيس الرافعي لا يوجد حوار، سوى الحوار مع القارئ، الذي يحوله من مجرد متلق سلبي، إلى شخص متورط بالكامل داخل النص، يخطو مع أنيس خطواته، ويصاحبه في رحلاته وأماكنه، يرتعب معه، ويهجس معه بهواجسه، بشكل كامل داخل العوالم التي ترواح بين الفنون والسحر، والماورائيات الكونية بكل تعقيداتها وتشككات البشر بها، وتساؤلاتهم عنها، ليصبح من الصعب على القارئ أن يدرك الكتابة بشكل كلي من القراءة الأولى، وكأن الرافعي ممثلا لأخوية كونية، تمارس طقوسها عبر الكتابة ومراقبة البشر ومخاوفهم، ويستعيد معهم صورهم الأولى ووجودهم الأول، من خلال فكرة التناسخ التي تعد أساسا لكثير من الفلسات والديانات الشرقية، بالإضافة إلى تماسه مع فلسفة الأنثروبوصوفي القديمة، الخاصة بالفيلسوف النمساوي شتاينر، والتي يرى من خلالها أن الإنسان ماهو إلا كوكب صغير يدور مع كواكب أخرى في فلك كبير. يربط شتاينر بين العمليات الحيوية للإنسان وبين الكواكب السبع القديمة، وهو ما يشبه ما يفعله أنيس كإله صغير يجلس على ماكينة صناعة البشر، يجرب أن يأخذ من كل كوكب سمة معينة ليخلق في نهاية الأمر هيئات جديدة للبشر، بكل ما في الكون من عدوانية ورهافة، ودفء، وتفرد وتواضع وغرور، خصوصا مع أيقونات المانديلا التي افتتح بها أنيس نصوصه، والتي تمثل الدوائر التي عظمها شتاينر، لتؤكد على استمرارية ووحدة الوجود.
مثلما تتهاوى الفواصل بين الفنون، في كتاب أنيس تتهاوى الفواصل بين الأديان والفلسفات، ويتهاوى الفارق بين الكتابة والتأليف، والفارق بين المؤلف ونصه وقارئه. في بداية الأمر لم أقرأ الإشارات المرجعية التي وضعها أنيس ولم أحاول استعادتها، كنت أرغب في التوهان الكامل بداخل الكتاب دون أن تقودني يد الكاتب بداخل متاهته، أحاول أن أفقد هنا والآن وأتجول هناك، هناك، هناك، ألتقط أشكال الوجود المختلفة، وأراقب إيماءات البشر وحركاتهم بعيون الكاتب، أتخيل الحيوات السابقة للبشر والأماكن التي سكنوها، والأرواح التي مرت من خلالهم، والأشكال المختلفة لتجلي البشر والكائنات، ليصبح الرافعي في نهاية الأمر أشبه بشامان أكبر أو ساحر يعيد إلينا صورة بلاد المغرب بكل ما تحمله من خيالات وسحر و أساطير، وأنا أتحدث عن خيالاتي الشخصية عن بلاد المغرب كما يقول الرافعي في كتابه “إن علاقتنا ببعض المدن لها طابع رومانتيكي محض وليس إيروسيا”.
هواجسي ومخاوفي الشخصية تجسدت أمامي في كتابة الرافعي بدءا من الدمى والظلام والأصوات والتناسخ، والمرآة بكل ما تحمله من عالم خلفي لا أستطيع إدراكه ولا أتوقف عن الخوف منه، أفكاري عن الحياة والوجود، وقلقي الدائم مما سوف يحدث بعد الموت، أصوات الكواكب واصطدامات الشموس، والثقوب السوداء التي نمر من خلالها، أو تعبر هي من خلالنا، كل هذا تعاظم بداخلي وتجسد وأنا أقرأ كتاب الرافعي الأخير خياط الهيئات.
أثناء قراءتي لخياط الهيئات عبرت أكثر من مرة على فيديو بعنوان l’exposition للفنان الأمريكي Bill Viola