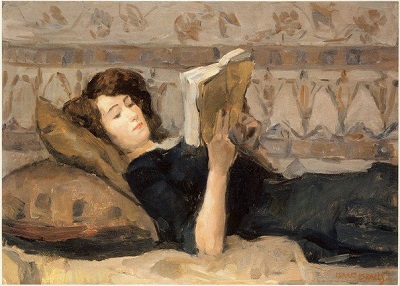ممدوح رزق
وفقًا لهيكلة تقرير تحكيم العمل لجائزة كتارا للرواية العربية سنجد أنها تعتمد على أسس ملتزمة بانحيازها إلى (الانضباط): (اللغة ـ البناء الفني ـ الخبرة الفنية الجمالية ـ الموضوع) ثم تعمل بالتالي المحاور المرتبطة بكل أساس في هذه الهيكلة على تأكيد هذا (الانضباط): (السلامة اللغوية والإملائية ـ التكثيف والإيحاء ـ بنية القصة ـ العقدة ـ الفضاء: الزمان والمكان ـ السرد والحوار ـ العنوان والنهاية ـ الخبرة بفن الرواية ـ خبرة الشكل الفني ـ الموقف الخاص ـ الطرافة والجدة ـ الأصالة ـ العمق ـ المعالجة / الخلاص).
على هذا يتم منح أعلى درجات التقييم بحسب هذه الهيكلة إلى (النص الخالي من أخطاء لغوية وإملائية ـ لغة النص المكثفة الإيحائية ـ بنية الرواية التجريبية غير المألوفة ـ الإجادة “دائمًا” لإحكام عقدة القصة ـ تناسب المكان والزمان للحكاية وتوظيفهما في حركة الحدث داخل البنية ـ التنويع للسرد والحوار في مواءمة مع طبيعة الرواية ـ العنوان الجذاب، والنهاية مفتوحة … إلخ ـ إبراز الوعي بفن الرواية عن طريق؛ الجملة السردية، التكثيف، دور الراوي … إلخ ـ استخدام شكل سردي واعي، كتوظيف التراث لغويًا وحدثيًا ـ إظهار الموقف الخاص والبصمة الذاتية في الفكرة ـ التقاط البُعد الطريف في الموضوع، وطريقة العرض الطريفة ـ ابتكار فكرة الرواية، وطريقة العرض غير المقلّدة ـ تحلي الموضوع بالقيمة ـ الرؤية القوية للخلاص، وتعزيز الانتماء) .. على هذا أيضًا يتم منح أدنى درجات التقييم بحسب هذه الهيكلة إلى (امتلاء النص بالأخطاء اللغوية والإملائية ـ عدم استخدام التكثيف والإيحاء ـ البنية التقليدية القديمة ـ الطابع الحدوتي المهلهل للقصة ـ عدم التناسب، وعدم التوظيف للزمان والمكان في حركة الحدث داخل البنية ـ عدم تنويع السرد والحوار في مواءمة مع طبيعة الرواية ـ عدم عنونة القصة، وتوقع النهاية ـ الإظهار النادر للوعي بفن الرواية عن طريق؛ الجملة السردية، التكثيف … إلخ ـ عدم استخدام شكل سردي واع، وعدم توظيف التراث لغويًا وحدثيًا ـ عدم إظهار الموقف الخاص في الرواية أو بصمة ذاتية في فكرتها ـ عدم طرافة الموضوع، وطريقة العرض التقليدية جدًا ـ الفكرة المستهلكة للرواية، وطريقة عرضها المنقولة ـ عدم اتسام محتوى الرواية بالقيمة ـ عدم طرح الخلاص الجيد، وخلو النص من تعزيز الانتماء).
من السهل ملاحظة أنه في مقابل استخدام واضعي هذه الهيكلة لكلمات مثل: (تجريبي ـ غير مألوف ـ غير تقليدي ـ تجديد ـ طريف ـ ابتكار ـ غير مقلّد)؛ سنجد استخدامًا آخر لكلمات مثل: (بناء ـ خبرة ـ سلامة ـ بنية ـ إحكام ـ ترابط ـ تناسب ـ توظيف ـ مواءمة ـ خلاص ـ انتماء) .. كأن هناك خطاب يتم تكريسه عبر هذه الهيكلة يفيد بتحديد شروط للتجريب، وقواعد للخروج عن المألوف، ومعايير للابتكار .. لكن هذا الخطاب ـ بصرف النظر عن فكرة التقييم بالدرجات في حد ذاتها ـ لا يكرّس لهذا حقًا بقدر ما يؤكد أنه نتيجة هذه الشروط والقواعد والمعايير فإن كلمات: (تجريبي ـ غير مألوف ـ غير تقليدي … إلخ) ليست سوى لافتات ضرورية أو عناوين رسمية ينبغي على أي جائزة ـ إن أرادت ذلك ـ أن تعطي بواسطتها صورة متوازنة لنفسها، تحميها استباقيًا ـ بحسب ما تعتقد ـ من النقد أو الاتهام بالرجعية، وفي نفس الوقت لا تحرم وجودها في (الحياة الثقافية) من وجاهة (المعاصرة) عبر استعمال كلمات ليس هناك أسهل من استهلاكها دون اهتمام يتخطى تدوينها في (هيكلة).
إننا لو افترضنا ـ مثلا ـ وجود عمل روائي يعتمد على التشظي، أو تفكيك البنية الذي يتجاوز (تجريبيتها)، أو التمرد المتعمّد على سلطة اللغة، أو خلخلة النظام السردي، أو انتهاك الحالة التناغمية للمضمون، أو تفتيت ما يُسمى بالعقدة، أو تخريب الانسجام بين المكان والزمان والحدث، أو إفساد التلائم بين الحوار والسرد، أو الخرق الهازئ للمبادئ الشائعة حول فن الرواية، أو العبث بالقوانين والتقاليد الأخلاقية السائدة، أو تقويض المفاهيم النمطية عن (القيمة)، أو السخرية من فكرة (الخلاص)، أو التهكم على (تعزيز الانتماء)؛ لو افترضنا أن هذا العمل الروائي تم تمريره إلى ماكينة التقييم التي تم استعراض أدواتها سابقًا فإنها لن تنظر إلى (انحيازه لطبيعته الخاصة)، أو (تناسبه وتوظيفه ومواءمته لوجوده)، أو (موقفه وبصمته الذاتية المتنافرة مع المنطق الاعتيادي)، أو (قيمته المضادة للثوابت الإنسانية المتداولة) ذلك لأن هذا العمل يتنافى بكيفية تامة وجوهرية مع (الإيمان) الذي تم تجميله ببعض الإغراءات التطهيرية، ليس فيما يتعلق بالرواية والوعي بتاريخها، وإنما بالثقافة ويقينيات الحياة عند واضعي هذه (الهيكلة)، الذين ينتمون إلى ذلك الجزء من العالم .. يطرح عمل روائي كهذا نفسه كاعتداء، كتهجّم متعارض من المبدأ مع حقيقة مطلقة لن يكون هناك مجال للتفاوض معها وفق أي احتمالات حاول أبناء هذه الحقيقة أنفسهم تضمينها من أجل ادعاء شكلي لمرونتها وانفتاحها: (تجريبي ـ غير مألوف ـ غير تقليدي … إلخ).
يعيدني هذا لعبارات سابقة كتبتها في (نقد المراقبة العقاب): (قد يفسر هذا بشكل ما الطغيان التاريخي لما يمكن تسميته بـ “السرديات الآمنة” في الكتابة الأدبية العربية، بما اشترطته كأحكام منظّمة للتلقي مثل: “الموضوع.. المعنى.. الرسالة.. الهدف.. المغزى الدلالي.. الاستفادة.. المتعة الجمالية”، والتي لم تكن هيمنتها راجعة إلى الإجراءات الصارمة للتنميط والفرز والإقصاء “القانون فوق الرسمي”، بل كانت على نحو جوهري ناجمة عن استسلام الكتابة الأدبية الغالب، واللازمني، لأنساق القراءة التي رسخها المقدس الديني).
وُضعت أدوات التقييم هذه ـ وهي مجرد نموذج ـ كإقرار روتيني لعقيدة مثالية .. تعبير بديهي عن إرث مقدس .. هي توثق بصورة حتمية تصديقًا متجددًا لتاريخ هائل من التماثلات الداجنة للكتابة العربية التي تواصل خلق قرّائها (حرّاس القوانين والأعراف) عبر الأزمنة المختلفة .. القراء الذين تربى داخل كل منهم كاتبًا أصليًا يسبق أي عمل أدبي ـ كما هو الحال مع واضعي هيكلة تحكيم كتارا ـ ليقيس من خلاله مدى خضوع الكتابة لهذا التاريخ ـ لا أناقش هنا أي حسابات أخرى تتعلق بالنزاهة ـ؛ فإما أن تثبت طاعتها ـ بحسب الدرجات المتفاوتة ـ أو تُطرد خارج كرمها الإلهي الذي لا يبدأ بالمال فقط، ولا يمر بالترجمات والاحتفاء الإعلامي والتقدير الأكاديمي والنقدي فقط، ولا ينتهي بالإشارة الدائمة إليها كنسخة ضمن التكدسات المتشابهة فقط.