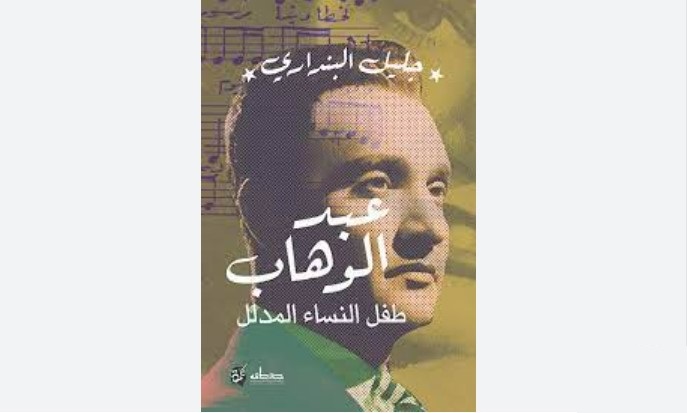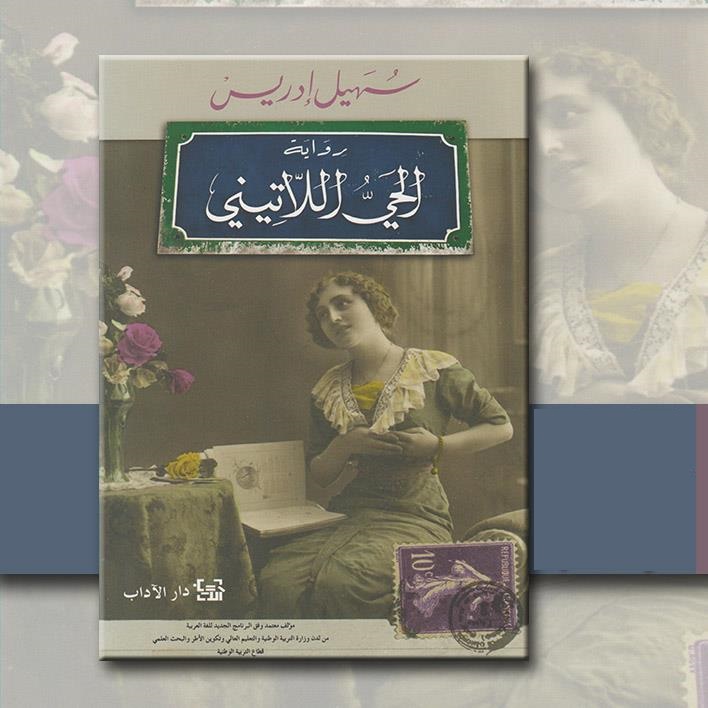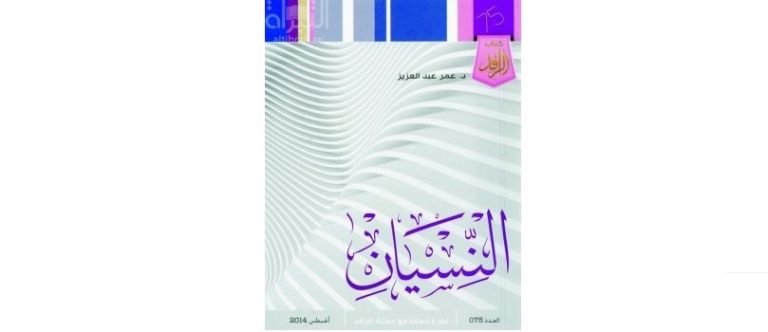فالقارئ لديوان “شخص جدير بالكراهية “يكون انطباعه الأول بعد الانتهاء من القراءة أن هذا النص هو سيرة ذاتية للشاعر، ذلك أن الديوان تبدو واضحة فيه حميمية التفاصيل حد عدم تصديق أن يكون الشاعر في نصوص الديوان قد تناول حياة أحد غيره، كما نجد بنية النص الدرامية أحد المسوغات لهذا الانطباع والتي تأخذ شكلا دائريا، حيث البداية نهاية والنهاية بداية، فالقصيدة الأولى”تنام الأشياء كما تركناها بالأمس ” يدور مضمونها حول رجل تائه، يبحث عن محبوبته، لكنه يسقط قبل الوصول إليها، كذلك فإن آخر قصائد الديوان “لأجلك.. سوف أبكي كثيرا يا حبيبتي ” يتناول مضمونها موت الحبيبة وبكاءه الذي لن ينقطع عليها، ففي البداية سقط هو قبل الوصول وفي النهاية سقطتْ / ماتت هي قبل أن يصل إليها، فكان موتها وفشله سقوطاً لذات واحدة، تكشفها لنا القصائد بأنها الذات الشاعرة / الروح / الحبيبة / القصيدة، إنه شخص جدير بالكراهية هذا الذي لم يستطع كسر المألوف ولو لمرة واحدة، هذا الذي ماتت روحه فيه، ولم يحاول مرة واحدة أن ينقذها.
أفق التوقع
أفق التوقع هو محور عملية التلقي في إستراتيجية التفكيك، والتي يستخدمها “عزمي عبد الوهاب” بمفهومها الهيدجري، عندما يعمد إلى الماضي فيهدمه، وينفيه في نفس الوقت، الذي ينشئ فيه عالما جديدا، هو نصه الشعري، هذا النص الشعري يقوم بجدلية إعادة الهدم والبناء في مخيلة القارئ، فيضع الشاعر ذاته في حالة تماه كاملة مع العالم، بحيث تصبح ذاته والعالم / الدال والمدلول شيئا واحدا، يقف أمام هذه الذات رافضا إياها، نجد التصدير في أول الديوان: “الحياة فوق الأربعين أمر بالغ الحرج” لدستويفسكي، يمكننا أن نقول إن النص الذي يتناوله “عزمي عبد الوهاب” (ذاته / العالم) يمكن تشبيهه بالسهم في حركته، فمستقبل هذا السهم هو مجموع النقاط التي يمر بها من الماضي والحاضر في اتجاه المستقبل غير معلوم النهاية، فهو في الوقت الذي يضع هذه الذات الشاعرة أمام المساءلة ينتهي بنفيها ووصمها بأنها ذات جديرة بالكراهية، أي أنه يخاطب الماضي ويحاسبه، فهو على الجانب الآخر يقيم علاقة مستقبلية معها من خلال النص، نجد ذلك واضحا في قصائد الديوان، والتي تحافظ على هذه الجدلية، ففي قصيدته “حوار لم يكتمل ” نجد هذه الصيغة الاستباقية، التي يبررها استخدام الحوار بينه وبين ذاته / محبوبته، حيث تطلب منه أن يمنحها تخيلا للآتي، أي تخيل، يقول: “أسئلة.. أسئلة.. تختبئ في الأسئلة.. دوما يا حبيبي.. اسمع.. أريد أن تجري معي حوارا فوق العادة.. حوارا إنسانيا.. يتنفسه الصادقون.. جهز أسئلتك.. أية أسئلة وهمية ” وفي نفس القصيدة يواصل الشاعر وضع الافتراضات لعلاقته مع معشوقته / الكتابة فقد يصلان إلى حلول، ومن ثم معايشة كل منهما الآخر، يقول: “إذا افترضنا أن هناك ماردا جسديا وآخر كتابيا.. رغم أنه لا داعي للفصل بينهما.. فتأكد أن مارد الجسد الذي يسكنك.. لو كان أرادني.. لأراده ماردي” أما في الهامش الثاني من نفس القصيدة والذي تبدو فيه ذاته الشاعرة / الكتابة / محبوبته لا تزال رغم برد العالم وتجمد عواطفه محتفظة برقم تليفونه: ” رقم هاتفك كان يتحداني أن أنساه.. هربت في جسد لم تعد فيه روح.. ارتحت لعزلة اخترتها بمحض إرادتي.. ولما بعثتُ لكَ أول رسالة تحت الثلج.. بعد سنتين من الغياب.. كنت خائفة من مارد يخرج من قمقمه.. كنتُ خائفة ” يتقدم الشاعر باحثا عن الذات البديلة التي يستطيع معها أن يقيم عالمه، وفق قوانين ومعايير مغايرة لهذه الذات القديمة، التي تجعل منه / العالم جديرا بالكراهية، إن فشل الذات التي أوصلته إلى محطة ما بعد الأربعين دون أن يأخذ قرارا حرا ولو لمرة واحدة – في نفس الوقت الذي يعبر فيه عن الإخفاق – هو الدافع نحو مطاردتها والبحث عن البديل، ففي قصيدته “حتى تري آثار زفرتك الأخيرة” والتي تعبر عن حالة اتحاد في الحب، اشتباك عنيف تٌجهز فيه الذات الشاعرة / المحبوبة / الكتابة على الشاعر / الجسد وكأنها تقتص منه لفراقه: ” آه من نار أشعلتها في صدري.. آه من أسنانك.. وهي في سبيلها للانقضاض.. آه من شفتيك وهما ترميان باللهب في وجهي” تتواصل الحوارية في هذه القصيدة في مقاطع قصيرة، فيوجه الشاعر بدوره نداءه لها أن تمنحه ذاتاً جديدة غير التي عهدها في لبس الأسود، أن تمنحه امرأة متجددة، تهب عالمه حساً جديدا غير حسه المشلول في الماضي: ” امنحيني امرأتي.. التي تخبئينها في الملابس السوداء.. دعيني أنزع هذا السواد برفق.. حتى يبين أبيضك شاهقا..،،،.. اقبضي على السر الإلهي.. دليه على البئر العميقة.. واتركيه يغوص في مائها معذبا بوحدته ” أما في قصيدة “بيت تسكنه امرأة وحيدة ” فنجد أن الشاعر يواصل شطر ذاته، فهي المحبوبة وهو البيت، تبرز في هذه القصيدة المرأة المحبوبة دون مجازية، وإن كان ما يحيل إلى المحبوبة / الكتابة هي علاقات التجاور التي تصنعها المقاطع ومشهديتها، فعندما يقول الشاعر: “كتبتْ: هبط من أعلى إلى داخلي.. في حالة أشبه بالتعبد.. أنفاسه.. بأذني همهمة تدغدغ حواسي.. صدره يعلو ويهبط.. ينظر إلى رجل بداخله.. صدره لا يعلو ولا يهبط” مجموع العلاقات بين هذه القصيدة والقصائد الأخرى هو ما يحيلنا من فهم حالة الثقة والهدوء لدى الشاعر في ممارسته الحب إلى أن الحب هنا هو حالة وجد تتلبسه أثناء الكتابة، يقول في قصيدة حوار لم يكتمل: “أنت لا تريدني جسدا.. هذا واضح.. أنتَ تدعي الرغبة.. أقصد ذلك المارد بداخلي.. هارب من سجن غلافه وحبر سطوره.. إنه مارد رقيق ودافئ وعاشق” أما في قصيدة “حبيبتي تزوجت أمس” فنجد أن الشاعر يوجه صفعة شديدة للمجتمع وللمثقف – خاصة – سائلا إياه عن جدوى ثقافته التي تقف عاجزة دوما في مواجهة العالم عن الظفر بحبيبها، أي شيء ستغيره قصائد وروايات الشعراء والكتاب من حقيقة فقده لمحبوبته، إن الشعر والأدب لن يغيرا من الواقع شيئا، يقول”ويا أيها الشاعر الحداثي.. قصائدك لن توقف المجاعة.. التي تغتال الفقراء في العشوائيات.. ألا تفهم.. حبيبتي تزوجت أمس، وأنت مشغول بالثورة.. التي ستشعل ميدان التحرير” أما في قصيدة”سيرة ذاتية لشخص جدير بالكراهية” فنجد مصارحة عالية النبرة واعترافا بالفشل في أربعين عاما مضت، دون مقاومة للملل دون ثورة عليه دون أي فعل اختياري، هذه السيرة المملوءة بالهزائم لا يمكن أن تكون جديرة بشيء سوى وصم صاحبها بأنه شخص جدير بالكراهية: “أربعون عاما..من الحرب الصغيرة.. وهو يفعل الأشياء ذاتها.. يقطع الشوارع.. بروح شاحبة.. يلتقي ذات الوجوه العائدة من معارك خاسرة..،،،..لا معنى لما يفعله.. ولا طموح لديه في الوظيفة، اشتكى لصديقته إحساسه باللا جدوى.. فصرخت: إنها القصيدة.. اكتبها واسترح” ويمكننا مؤخرا أن نقول، إنه في ديوان “شخص جدير بالكراهية” تعددت رؤى العالم واختلفت، حيث تعددت معاني الحبيبة وتبادلت الأدوار مع الذات الشاعرة تارة بالاتحاد وأخرى بالازدواج، إلا أنها في جميع الحالات جسدت نزوع الشاعر المتواصل إلى البحث عن معنى مغاير لما يحيط به، فكانت الكتابة هي معشوقته الأبدية التي يستطيع أن يلوذ بها من جمود هذا العالم رغم تعنتها عليه، فالقصيدة والقصيدة وحدها التي تستطيع أن تحرر روحه من رداءة هذا العالم ومن هذا الماضي / الرجل / العالم الذي طالما كرهه لاستسلامه الدائم، تأتي آخر قصائد الديوان “لأجلكِ سوف أبكي كثيرا يا حبيبتي” تعبيرا عن قدسية القصيدة التي تغسل روحه دائما حتى بتذكره إياها ولو مجرد التذكر.