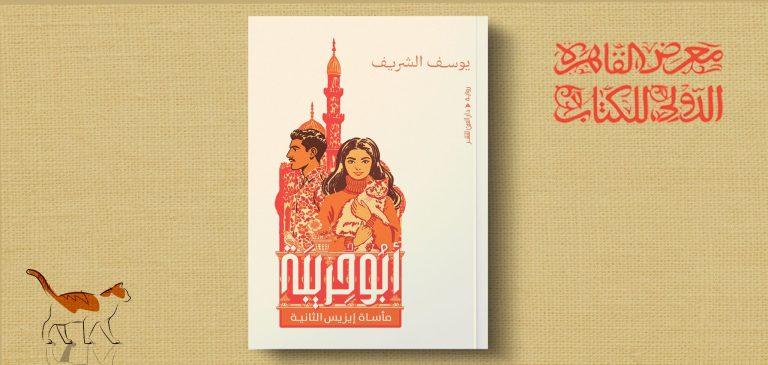كانت ليلى تجلس أمام التليفزيون تُشاهد القنوات الإخبارية بقلب بارد وعقل حالم، تقرأ ملحمة “كلوبشتوك” فيزداد ولعها بتحولات الماضي وعثرات الزمن المحكي، تسرح بخيالها في الآلهة المنسية وآلام المسيح التي لم تمنع الحروب، وفي زهور الرب التي تغنّوا بها قديمًا، تزاد الشاشة تصبغًا بالدماء والقتلى فتهز رأسها آسفًا على الوقت الذي يمر دون تدخّل اليد الإلهية لإنقاذ البشر من خطاياهم. كان هناك أعز أصدقائها وحبيبها السابق وأخوها الذي يصغرها بعامين، التحم ثلاثتهم في مسيرة طويلة دون أن يعلموا أن هناك صلة خفية تربطهم بخيط من حرير في قلبها، كانوا يرددون الهتافات ويترحمون على شهداء أُلقوا بقسوة تحت أقدامهم، وهي، تجلس هناك خلف نافذتها الصغيرة تردد تراتيل متياس كلاوديوس*:
“باردة هي نفحات المساء
احفظنا يا رب من العقاب
واجعلنا ننام هادئين
نحن وجارنا المريض أيضًا”
***
وقفت ليلى تتابع قفزات العصافير المرتبكة على سور البلكونة المواجهة لشرفتها بعد أن فزعت من أصواتهم التي أخذت تعلو وتتزايد في اهتياج شديد والساعة لم تتجاوز بعد السابعة صباحًا؛ جالت بعينيها التي تقاوم النُعاس بين نوافذ الشقة ــ التي تبدو للوهلة الأولى مهجورة ــــ في محاولة لاستكشاف ما يدور خلف الستائر المنسدلة في الغرف المعتمة، لم تُبصر شيئًا، لكنها انتبهت لتراكم التراب الذي يغطي حواف سور البلكونة ووحدة المُبرد الخارجية، سألت نفسها بطفولية إن كانت العصافير تشعر بشيء غير عادي يحدث خلف جدران الشقة لكنها لم تُسلم عقلها لهذه الفكرة طويلاً لأن النعاس غلبها فمالت برأسها على حافة شرفتها وأرخت يدها في الهواء.
اعتاد الجار الذي يسكن قُبالتها أن يخرج كل صباح ليُدخن سيجارته وهو يحمل صحنًا صغيرًا مليئًا بالحبوب ليضعه على حافة سور بلكونته ليُطعم العصافير التي تطير في براح السماء وتسكن ليلاً شجرة وحيدة في نهاية الشارع؛ كانت تتعجب من أن الجار لم يفكر يومًا أن يشتري عصافير ويُسكنها في قفص. اسمه حسين، خمسيني، جسده الهزيل ومظهره الأشعث يعطيه عُمر أكبر من عمره بكثير، سُعاله لا يتوقف وحشرجة قوية تُميز صوته الخشن الذي يُنادي كل نهار على باعة الفواكهة والخضروات .. كان مُقتدرًا لكنه يثير في قلبك شفقة ما لا تعرف لها سبب، يعيش وحيدًا بعد أن أخذ الموت زوجته، مُدخنٌ شره، يملك سيارة قديمة بلون النبيذ العتيق تحمل لوحتها رقمان وحرفان، مكانها ثابت أسفل العمارة التي يسكنها، يغطيها بغطاءٍ حوّل التراب لونه إلى رمادي بمرور الوقت، في أحيان كثيرة تنام قطط الشارع الصغيرة داخل إطارات عجلات سيارته لأنها ساكنة دائمًا.. قبل أعوام كثيرة كان الجار يعتاد النزول إلى السيارة ليزيح عنها غطاءها المتهالك وينظفها بفُرشاة تنظيف طويلة ليُزيح عنها التراب المتراكم، يجلس بداخلها ويتلمس برقة شديدة مقاعدها الجلدية التي يدل مظهرها اللامع على أن جسدًا لم جلس عليها من قبل. اعتادت ليلى في طفولتها أن تنتظر مواعيده المقدسة في تنظيف السيارة فتُحضر أكياس الحلوى وتجلس متخفية في شرفتها وهي تراقب التراب المتطاير من سيارته التي ظنت دائمًا أن الأشباح تسكنها.. لم يكن الجار يركب سيارته أو يستعملها في مشاويره الخاصة، لم يكن الجار يملك أصلاً مشاوير خاصة.
***
استيقظت ليلى فجأة وفتحت عيونها على اتساعها والخوف يبدّل ملامحها الدقيقة شيئًا فشيئاً، شفتيها ترتعش كأن مسًا من الجنون أصابها فأخرسها، لم تنطق بكلمة عندما استقامت بجسدها ونظرت إلى سيارة الجار فلم تجدها، وصوت العصافير لم يهدأ بعد!
**
كنت أُراقب الموت ..
وقت الثورة يا بُني كنت في حلم طويل بدأ على شرفتي الصغيرة وظل يُراودني كثيرًا، كنت فيه أرتدي ثوبًا أبيض طويل وعلى رأسي تاج مُزهر من الورود وأمشي بتهادي في أراضٍ خضراء كُتب على نواصيها مدينة الملهاة.. كنت وحيدة والعصافير من حولي يأكلها الجوع، لم أنتبه إلى أنهم تجمعوا في سرب طويل وسرقوا فجأة التاج من فوق رأسي، لم يأكلوه، لكنهم طاروا به بعيدًا صوب سحابة تُلقي ظلاً أحمر على الأرض ثم هبطوا فجأة من عليّهم واستقروا فوق تربة طينية أشبه بقبر طويل، اقترب منه والخوف يأكُلني وقرأت المكتوب على شاهده :
“هنا يرقد شبح طالما راقبتيه.. فاتركِي أشباحكِ وواجهي الحياة”
…………..
[*] شاعر ألماني، ولد عام 1740م.