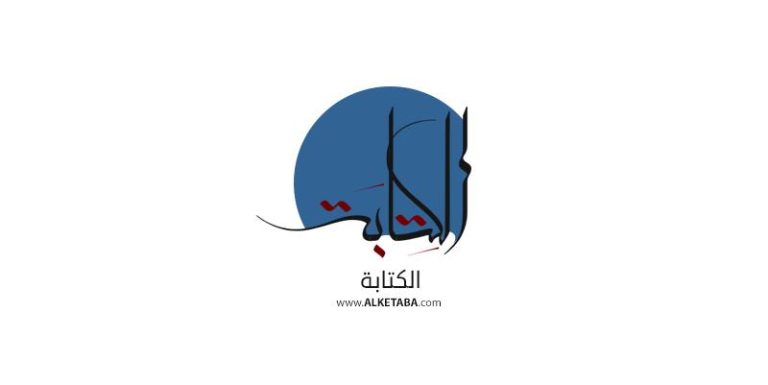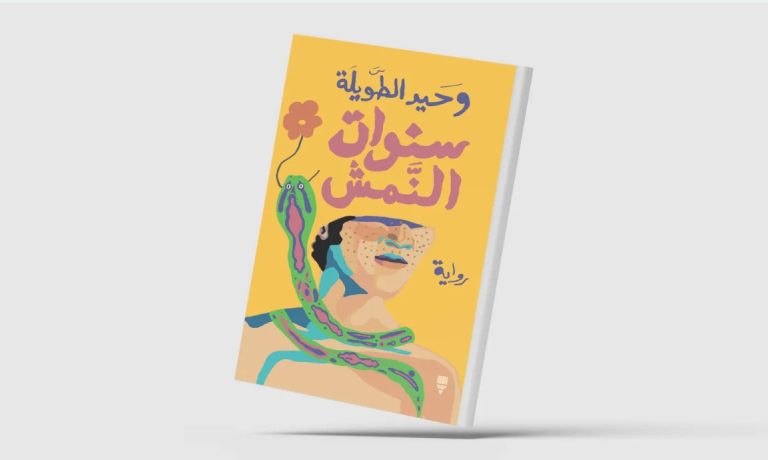البنية والسرد .. واللعب مع القارئ
تبدأ الرواية بوجود المعالج النفسي ” مطاع ” في حفل ما بعد فعاليات مؤتمر ” شحذ الوعي القومي بين الأمم” ، لنكتشف أن المشهد الذي يبدو شديد السخرية، يُغلفه الخوف بشكل أو بآخر، فنهاية الفصل نجد أن الجميع يكتب التقارير ضد الجميع، الخوف أكل نفوسهم وتغذى عليها، الكل يكتب ضد من ؟ لا يهم ، هل ما يكتبوه صحيح ؟ أيضاً لا يهم ، المهم أن يُقدم الجميع فروض الطاعة والولاء خوفاً من البطش. وهذا بالتأكيد ما لايحبه فيلليني، فيلليني المُحب للحياة، لا يُفضل هذه الأجواء ولا يحب هذه المشاهد.
إذا تأملنا بنية الرواية، فنجد أنها رواية أصوات، وإن كان الصوت الرئيسي فيها هو صوت ” مطاع ” ، رغم تواجد أصوات آخرى مثل صوت ” زوجة الجلاد” و ” الجلاد “. وهذا جعل الشخصيات تتكشف شيئاً فشيئاً، البوح كما ساعدها في التحرر من الامها ساعد أيضاً القارئ على الغوص في نفوس الشخصيات. فالغموض الذي يُغلف بداية الرواية، يبدأ بالإنحسار بالتدريج ليعطي الشخصيات الفرصة في كشف ما يعتمل في نفوسها المُهترئة بفعل ماضي وحاضر تسعى السلطة إلى تدميره وإخصاء أي فكر ينمو، فالسلطة تُفكر، إذن لماذا يُفكر المحكومين؟
” مطاع ” سابقاً، ” ” مطيع ” حالياً، الذي خرج لحريته بعد أن فقدها في السجن، عاد للحياة مشوهاً، فاقداً لأي رغبة في العيش، لا يحيا سوى لهدف واحد، الوصول لجلاده لينقم منه. مطاع المُحب للسينما العاشق لفيلليني، يسرد ماجرى له في حبسه، كما يسرد فبس من ذكرياته أو ما تبقى منها، والأهم أن القارئ غاص داخله وكشف معاناته .. هل عرفت معاناة المقهور؟ ما هو احساس الضحية ؟ إذا لم تكن تعرف أي من هذه الأحاسيس فاشكر المولى أولاً وتأمل ما يحكيه مطاع ثانياً، وهذا يُحلنا للُب الرواية معاناة المقهورين الذين تدهسهم السلطة بأحذيتها المُدببة. ” تتمنى لو أنك حشرة تستطيع الطيران لتمر من أي ثقب إلى نافذة الحياة لو أنهم اخترعوا حشرة الحرباء كي تستطيع أن تكون صغيراً ومتلوناً كما شئت لتختفي وتهرب بسلام، حتى لايضربك بغتة من خلفك مخبر ثقيل اليد عريض القفا وأنت واقف في حضرة الضابط خشية أن تحط كلمة منك على كتف سعادته فتكسر الرهبة في حدود المكان ” .
إذا كان يوجد ضحية فلابد أن يتواجد جلاد، هنا نرى الجلاد بأكثر من رؤية، فإذا كان للضابط كما يقول الجلاد له أربع أعين، فمعرفته لا تكتمل ألا من خلال أربع، ” مطاع” ، ” الزوجة ” ، ” مأمون ” ، ” الجلاد ” نفسه، كل منهم يروي رؤيته وذكرياته معه، ليس بوصفه ممثلاً للسلطة فقط بل كونه يشكل الطرف الثاني في ثنائية الجلاد والضحية، الضحية أو الضحايا الذين من كثرتهم نفقد القدرة على حصرهم. نوغل في الكشف عن نفس الجلاد، لنكتشف من خلال زوجته أنها أيضاً كانت ضحية وتسعى للأنتقام منه، فالتعذيب الذي يُمارسه في عمله لا يتوقف عند ولوجه لبيته، بل يمتد ويستشري في جسد زوجته الذي استباحه. شخصية الضابط المُتسلط الذي تتلبسه السلطة لا تتوقف عند حد، يُمارس سلطته على الجميع، وعندما يسقط في براثن المعاش، يفقد رمز سطوته وجبروته، يرتخي سلاحه الذي اشهره دوماً للأمام، يفقد الرغبة في الحياة، فهؤلاء إذا تخلت عنهم السلطة، تتخلى عنهم الحياة سواء رغبوا أو لم يشأوا. يذوق الجلاد مما أذاق منه ضحاياه، تلتوي رأسه لليسار، في اشارة منه لرفض الحياة.
ونصل لأحد أفضل فصول الرواية، عندما يحكي الجلاد، كيف تخلى عن انسانيته، وكيفية التحاقه بالعمل في رحاب السلطة، عائلته بحثت عن السلطة، وهو بحث عن حصانة تمنع أي أحد من سؤاله عن هويته، فاندماجه الكامل في العمل، لم يكن سوى تعويض عن تاريخ اسرته المغلف بالهوان، وكيف انه يرى ان التعذيب ما هو ألا تأديب، ورؤيته للمحكومين بأعتبارهم ليسوا أكثر من نمل يستحق الدهس.
أما ” مأمون ” رمز الوشاه، فالكل مأمون، أسمه مأمون، وهو ليس مأموناً على شئ، بالعكس فدوره لا يختلف عن دور الجلاد، فإذا كان الجلاد يؤدب أو يزهق الأرواح، فمأمون ما هو ألا معبر أو واسطة للقاء بين الضحية والجلاد، فالكل تحول لوشاه، الكل مأمون، سواء بدافع الخوف أو رغبة في الوصول والأنتفاع بمظلة السلطة.
كل هذا السرد لم يأت بشكل مرتب، فالبداية كانت مع مطيع، ثم تتسلم زوجة الجلاد دفة السرد، ويعاود مطاع الحكي، نتفة من هنا ونتفة من هناك، ثم يدخل الجلاد في الحكاية بصوته هو، ليُجادل مطاع، الذي يُجادل نفسه أصلاً في منولوجات داخلية كاشفة عن المزيد من الشخصية التي اهترأت بفعل التعذيب والقهر. حتى تكتمل تلك الأحجار المبعثرة في النهاية لتكتمل الحكاية ونوصد ورائها القفص.
المرأة .. البداية والنهاية أيضاً
المرأة في الرواية ليست وعاءٍ لتفريغ شهوة، أو زوجة مقهورة فقط، بل منبع حنان، دوماً نجد زوجة الجلاد ومطاع يتحدثا عن علاقتها بزوجها الذي انتهكها واستباح جسدها مثلما استباح مطاع دون أي شفقة . هنا المرأة منها تنطلق البداية وإليها المنتهى. زوجة الجلاد التي قدمت زوجها على طبق من الذهب إلى مطيع ليستعيد روحه وأسمه الذي فقده في القبو ولتعود هي مرة آخرى للحياة، هي أيضاً جارته التي قدمت له الحب. المرأة تستحق التأمل ” زوجة الجلاد ” الساعية للأنتقام، وعلى الناحية الآخرى ” الجارة ” الساعية للحب والتي قدمت الحنان لجلب مطاع مرة آخرى.
اللا مكان .. اللا زمان
منذ بداية الرواية والقارئ في حيرة، هل الأحداث تجري في مصر ؟ سوريا ؟ أو تونس ؟ لكن مع بداية الأحداث في التشعب نكتشف أن المكان لا يهم طالما أن الجرح واحد أو كما يجيب مطاع في اجابته على سؤال البروفسير ” سوري، مصري، تونسي، كلها بلاد واحدة وكلنا واحد” ، واحياناً يختلط الأمر تماماً ونشعر أن اجواء الرواية تدور في الصين فذكر اسم ” ماو تسي تونج ” ليس اعتباطاً ، وهذا يُشير إلى أن القهر و الظلم واحد سواء عند العرب أو غير العرب، فالنص ينحاز إليهم في أي مكان وفي أي زمان. الزمان هنا أيضاً غير محدد، لا تدري أهو الحاضر، أو ماضي ، أو مستقبل مخيف. الواقع أن الزمان هو كل هؤلاء ، فالديكتاتورية لم ولن تتغير.
الخلاصة
رغم أن موضوع الرواية عن التعذيب وما تفعله السلطة بالمحكومين ألا أن جرعة السخرية خففت من حدة الرواية، فلو لم تكن الكتابة مُطعمة ببعض التهكم لكانت الرواية ستكون مُقبضة إلى حد كبير، فالسخرية من الحكم الأوحد تتجلى في التعبير عن خوف المقهورين، الشخصيات تخشى الحديث عن أي من المُشتغليين بالسلطة لذا يتحدثوا دوماً عنهم داخل الحمام وصوت الدش يُغطي على همساتهم المرتجفة، ” فكل شيء يحدث في الحمام” ، كما ذكر الطويلة في روايته السابقة باب الليل.
فيلليني في الرواية دوره محوري وشديد التأثير، فمن غيره انبثق من العدم بقبعته وأنقذ مطيع وأعاد له اسمه، بعد ان فقده في القبو من فرط انسحاقه وذله ؟ فيلليني الذي اوعز في عقل مطاع ليتخلى عن الأنتقام ويدع الحياة تمر، فحب الحياة وقوة الفن أقوى من الأنتقام الذي لن يجلب سوى الدماء، وسُيبعد الراحة عنه وهو الباحث عنها.
” حذاء فيلليني ” العمل الأحدث لصاحب باب الليل، الجديد أن هذا النص يختلف كلية عن سابقه، ليس من ناحية التقنية فقط إنما من ناحية اللغة أيضاً، فجاءت الرواية قوية، وتقف صفاً واحداً مع المقهورين في مواجهة الديكتاتورية بالفن وهذا اسمى وأجمل ألف مرة من مواجهتها بالدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتب مصري